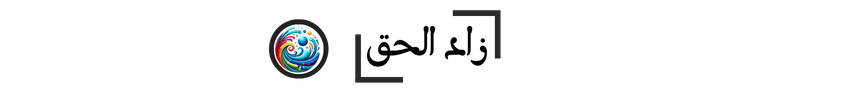آثار الذنوب والمعاصي ابن القيم ملخص كتاب الجواب الكافي لإبن القيم

آثار الذنوب والمعاصي.. ملخص كتاب الجواب الكافي كتاب اين القيم الشهير في التعريف بالذنوب والمعاصي، وآثارها على السيئة..
مقدمة
المذنب في قتال دائم مع نفسه الأمارة بالسوء، تصفعه في كل مرة على قفاه، وتبصق على وجهه، وتخرج لسانها له ساخرة، وتجره من تلابيبه إلى مزابل الفاسدات، فيظل يعاني، وذلك في حد ذاته عذاب..
وقد وفر الله سبحانه وتعالى لنا، وهو الرحيم بنا العالم بضعفنا، بدائل للحرام، خير منه، فالماء واللبن خير من الخمر، لأن بعض المذنبين لا يُذهب عطشه إلا للخمر لأن الشيطان جعله يؤمن بذلك. يمكنه ترك الخمر، ولكنه يفضل عدم تركها، بعكس الزاني الذي تدفعه شهوة أقوى إلى ذلك الذنب، وتصرعه في أحضانه..
فالزواج بامرأة صالحة أمام الناس، علنا، وفرح كل من يشاركه فرحته به، خير من التسلل في الظلام للإختلاء بفاسدة غير صالحة، ولا تصلح لأي شيء حتى الذنب..
ففي الزواج طمأنينة وراحة وحفظ مال، وكل ذلك مضيع على الفاسدات ذاهب سدى..
الزواج إعلان وفرح يشترك فيه الناس مع المتزوج، ويراه الأب والأم والعم والخال، ويغتبطون به، أما التسلل والإختباء بفاسدة، فحرام وجُرم يعاقب عليه الشرع والقانون، ويغضب الرب والمعارف، ويضرب الناس صاحبه على القفى إن لم يقتلوه! فأين عقل الزاني؟
الزواج يُغني عن الشهوة الحرام، لذا شُدد في العقاب على الزاني المحصن، فكيف يزني وهو محصن؟!
“لا راحة مع الحرام”، بل العناء الذي قد يتبعه الضياع، وقد يدفع الواحد الثمن باهظا إن كان من أهل المبالغات ممن لا حدود له.
انظر إلى الباحث عن فاسدة كل مكان، في المقاهي والشوارع وكل الجحور، يظل يدور ويدور حتى يصاب بالدوار، ويعرف القاصي والداني أنه حيوان باحث عن الشهوة، زير نساء، ولا خير في الزير بالمناسبة ولو كان وزيرا، وأول من يتأذى من تفاهته هم أقرب الناس إليه مثل أبنائه لأنه حيوان لا يهتم بغير شهوته.
ثم في الأخير بعد كل ذلك الدوران والتعب ودفع الغالي والنفيس في سبيل تلك الذبابة، يقع عليها فيكره نفسه، أو يضربها أو تضربه، أو يبصق عليها أو تبصق عليه، وقد تفضحه، وقد تسرق نقوده، وقد تجره إلى عصابة تقتله!
فيبحث عنها ويدفع المال لها، ولا تسمح له بغير دقائق معدودة، يتعذب فيها بقذارتها وسواد وجهها وبدنها (سود وجوه الزناة وقذارتهم).
لذا تجد البريء في طريق عودته من الذنب الكريه، يسب ويلعن، ويعض أنامله ندما على ما أضاع من جهد ووقت ونقود وراحة. فهل يقارن ذلك بيبت مستقر فيه زوجة جميلة مبتسمة دائمة (أو حتى غير جميلة).
وما أضاعنا إلا اتباع الغربيين في نظمهم الفاسدة، فقد فرضوا علينا التعليم في مدارسهم من الصغر إلى التخرج من الجامعة، نتعلم كل التفاهات، ونترك ديننا الذي يساعدنا في حفظ أنفسنا وحدودنا ومعرفة بربنا، ويحفظ الناس من شر بعضهم البعض (من يعرف الله ليس كمن لا يعرفه)، ثم إذا تخرج من الجامعة قالوا انتظر حتى تحصل على وظيفة، ثم إذا حصل عليها، والغالب أنه لا يحصل عليها، قالوا انتظر حتى تجمع مالا وتبني بيتا، فيظل ينتظر وينتظر، وفي أثناء كل ذلك يقع على الذباب، حتى يفوته القطار، فيأتي ليتزوج وهو في الأربعين أو الخمسين، مثقل بالحرام، متعب من الدوران، لا طاقة له على القيام بشيء! أليس خيرا له من ذلك الزواج باكرا، ثم بعدها انتظار الشهادة اللعينة وما تجره من وعود فارغة كاذبة.
ولا يغرنك بأكاذيبه الكثيرة، فهو أكبر كذاب يزين القبائح في الدنيا (هو والنفس الأمارة)، ويسود الدنيا في وجهك حتى يرميك في أحضان الكلاب، ويسود حياتك بعد إشراقها، ويلطخ أغلى شيء عندك وهو شرفك.
ففي الأول يريك الفساد ضاحكا مريحا ممتعا مربحا، لكن حقيقته تتكشف يوما بعد يوم وأنتِ في طريقك إلى الغرق أكثر وأكثر! حتى يأتي اليوم الذي تعرفين فيه أن الشيطان قد غرك، نسال الله تعالى لنا ولك السلامة.
لسنا في هذه الحياة الدنيا لبناء المنازل وجمع السيارات وإعالة الأبناء واللهو واللعب فقط، نحن هنا لنعمل من أجل الفوز بالجنة، وذلك امتحان ليس بالسهل بل يتطلب الكثير من التقوى والصبر حتى ندخل الجنة، خير دار وأدومها، دار لا يدخلها إلا الصالحون في الدنيا (لا يوجد فيها نذل ولا فاسدة)، فلا مرضى نفسانيون فيها ولا مجرمون، ولا حزن ولا غم، ولا عجز ولا عوز، كل ما نريده موجود متوفر، وتحت أمرنا وفي اللحظة لا عناء حتى في طلبه!
الجنة درجات، لكل واحد فيها أضعاف ما لملك من ملوك الدنيا، ولا حاجة للمراحيض، ولا وجود للأمراض ولا للأحزان والهموم، ولا للشهوات الناقصة.
الملائكة يدخلون علينا من كل باب، وربنا يضحك إلينا، والأنبياء الكرام معنا وكل الصالحين (لن يدخل الجنة إلا من كان قلبه سليم، لذا عليك بقلبك قبل عملك)..
الجنة غالية لذا وجب التحزم لها في الدنيا، والتمسك بالتوبة والتقوى، والصبر فهو أهم شيء، ومن لا صبر له لا تقوى له ولا أي شيء آخر.
ومن ضاقت به أرض فيوجد غيرها، فيها ألف فرصة وفرصة، فالبادية والقرى الوادعة الصغيرة البريئة قد تكون خير ألف مرة من المدن المكتظة بالفاسدين والمجرمين والمزعجين، حتى بيت الواحد أصبح محاطا بالعمارات، هذا يشرف من تلك النافذة وذاك من تلك، وهذا يعربد وذاك يصرخ، ولا قيمة عند أحد فيها لحق الجوار! إلا ما رحم ربي.
فالقرية تساعد على الإستقامة وعلى العبادة وقراءة القرآن بخصوصية، وعلى راحة البال، أما المدينة فلم يعد الواحد يأمن حتى من جاره في ظل انتشار الشقق التي لا هدف لأصحابها إلا جمع المال، يكترونها لكل من هب ودب. والجيران قد يكونوا مجرمين أو حشاشين أو فاتحين بيوتهم كمحلات عهر ولو بالعربدة!
سمعتُ يوما صوت هاتف غريب، فإذا به هاتف الجار الجديد أحد الأفارقة من بلد إفريقي قريب، كان يتفرج على مواقع الجنس في هاتفه من على البلكون المشرف على من حوله دون حتى أن يخفض صوت الهاتف!!
أعتقد أن على الدولة إن كانت حريصة على مجتمعها الضائع وحده، أن تضع قيودا للكراء، فلا يُوفر إلا للمتزوج أو العامل النظيف، بدل المجرمين والحشاشين الذين يسرقون ليدفعوا ثمن الكراء، ويفعلون في شققهم كل المحرمات وعلنا! وإذا احتاج أحد منهم للمال قد يفكر في السطو على جاره لأنه أصلا فاسد وخبيث! أما اللعين صاحب الشقق فجشع لا يعنيه ذلك كله، المهم عندهم هو جمع المال، فهل على أهل الحي أيضا أن يضعوا قوانينهم ودساتيرهم، لأن حرية أهل الجشع والخبائث تعدت الحدود.
وقد قال الشاعر :
رب إن عظمت ذنوبي كثرة … فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان لا يرجوك إلا محسن … فمن الذي يدعو ويرجو المجرم
مالي إليك وسيلة إلا الرجا … وجميل عفوك ثم إني مسلم
فمن أذنب ثم تاب توبة صادقة وندم على مافعل وأقلع عن الذنب، وصمم العزم على أن لا يعود فإن الله سيغفر له، ولو عاد إلى الذنب مرة ثانية ثم تاب توبة كالأولى غفر الله له ورحمه، فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة”. رواه الترمذي.
ومما يعين على التوبة والاستمرار على العمل الصالح بعدها الالتجاء إلى الله تعالى بكثرة الدعاء له، وخاصة في أوقات الإجابة ، وكذلك المحافظة على أداء ما افترضه الله تعالى عليك ، وكذلك مصاحبة أهل الخير الذين يدلون على طاعة الله تعالى ، والحذر من قرناء السوء والبعد عنهم ، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل . ومما يعينك على التوبة أيضاً البعد عن دواعي الذنب وأسبابه واجتناب مواطنه وأهله ، ولا شك أن السفر إلى الدول التي تبيح المحرمات وتنتشر فيها باب عظيم من أبواب الوقوع في الكبائر ، ولذا فإنا ننصحك بأن تتم تعليمك في بلد إسلامي إذا تيسر لك ذلك ، فإن لم يتيسر وكان العلم الذي تطلبه ليس فرضا عليك ( وهذا هو الغالب ) فلتبادر بالعودة إلى ديار المسلمين ولتطلب بها علماً آخر ينفعك وينفع جماعة المسلمين ، وعليك بصحبة الصالحين ومخالطتهم ، كما جاء في حديث الذي أراد أن يتوب من القتل : فقال له العالم : انطلق إلى أرض كذاو كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . رواه مسلم
ولتعلم أن التوبة ليست نافلة من النوافل إن شاء العبد فعلها وإن شاء تركها ، بل هي فرض على كل مسلم ، أمر الله تعالى بها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31} وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة . رواه مسلم
صدقني لن تفهم الدين جيدا إلا بفهم العقيدة التي يفر منها الكثيرون، ومن ذلك التركيز على معرفة أهل البدع، من هم ما أسسهم ومن رد عليه وكيف، ما أدلته؟! بهذا تحصل على ثقافة قوية في الدين، وتحصن نفسك من البدع، بدل الكذبة الشيطانية المنتشرة في الناس اليوم، أن تناول البدع دخول في حلافات لا فائدة فيها، وكيف يعرف الواحد الخير إن لم يعرف عكسه وهو البدع؟! تأكد أن كل طرف لديه أدلته، فأيها أقرب للصواب؟ بل قل أيها متبع للكتاب والسنة، بذلك تعرف أن المجال ليس اهتماما بما هو تافه، بل اهتمام بالأهم وهو العقيدة التي هي ركن الإسلام الأول، بدونها لا يقوم. والدليل أم المشرك لا يُنظر في اعماله، فلماذا اعتبر البعض الخوض فيها كالخوض في الوحل؟ وفيها أهم شيء، وهو إنقاذ الناس من الشرك!
لكل داء دواء
قال ابن القيم رحمه الله:
ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: “ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء”.
وقال تعالى: “وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين”، و”من” ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله شفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب.
والأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعى قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره.
الدعاء هو أنفع الأدوية
وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن.
ومن أنفع الادوية الإلحاح فى الدعاء (ويوجد منها أدعية أو دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر).
ومن الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه (أي ظهور نتائجه):
1- أن يستعجل العبد ويستبطئ الاجابة.
واذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الاجابة الستة وهي: الثلث الاخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والاقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الامام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلوة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله والح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل اليه باسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا (دعاء يغفر الذنوب)، ولا سيما إن صادف الادعية التي أخبر النبي أنها مظنة الاجابة، أو أنها متضمنة للأسم الأعظم، فمنها:
ما في السنن وفي صحيح بن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه “أن رسول الله سمع رجلا يقول اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله الا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله بالأسم الذي إذا سُئل به أعطي وإذا دُعى به أجاب”.
وذكرا ابن أبي الدنيا في كتاب المجانين في الدعاء عن الحسن قال: “كان رجل من أصحاب النبي من الانصار يكني أبا مغلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك، قال فما تريد بدمي فشأنك والمال، قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، قال أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات، قال صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه فى آخر سجدة أن قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيت أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، ثلاث مرات، فاذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل اليه فقال قم، فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم، فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوتَ فسمعتُ لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوتَ بدعائك الثاني، فسمعتُ لأهل السماء ضجة، ثم دعوتَ بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يُوليني قتله”. قال الحسن فمن توضى وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب.
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. ولما كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الامة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم، وكان عمر رضى الله عنه يستنصر به – أي بالدعاء – على عدوه، وكان أعظم جنده وكان يقول للصحابه لستم تُنصرون بكثرة وإنما تُنصرون من السماء، وكان يقول إني لا أحمل هَمَّ الإجابة ولكن هم الدعاء، فاذا أُلهمتُ الدعاء فإن الإجابة معه.
فمن أُلهم الدعاء فقد أريد به الإجابة فإن الله سبحانه يقول: “ادعوني أستجب لكم”.
2- أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولكن تغالطه نفسه بالإتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتشويف بالتوبة والإستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة… إلخ.
وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال “أستغفر الله” زال أثر الذنب وراح هذا بهذا! قال لى رجل من المنتسبين الى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده مائة مرة وقد غُفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي، وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها، واذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء! قال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء من يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة!
ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فِعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي.
ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل!
ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين، وكثرة التردد إلي قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل الى الله بهم، وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده! (أقول: هذا مثل اغترار متصوفة زماننا، إلا أنهم يغترون بالزنادقة لا الأولياء).
وكإتكال بعضهم على قوله تعالى “إن الله يغفر الذنوب جميعا”، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها!
وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يُرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند.
قال معروف: “رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق”. وقال بعض العلماء: “من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا”. وقيل للحسن “نراك طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي”. وسأل رجل الحسن فقال “يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تنقطع؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف”.
وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، فآثرها على الآخرةن ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء: “الدنيا نقد والآخر نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة!”، ويقول بعضهم: “درة منقودة ولا درة موعودة!”، وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله.
وقول القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه انه اذا تساوي النقد والنسيئة فالنقد خير وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة كما في مسند أحمد!
وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حَمل على العمل وحث عليه وساعده وساق اليه فهو صحيح، وإن دعا الى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور.
وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية، فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا، فهو المغرور.
ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئا رجاؤه لثلاثة أمور، أحدها: محبته ما يرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني.
والله سبحانه وصف أهل السعادة بالاحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن.
ومن تأمل أحوال الصحابة رضى الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. هذا على بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من أثنتين: طول الأمل واتباع الهوى، قال: “فأما طول الأمل فيُنسي الآخرة، وأما إتباع الهوي فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل”.
وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، فيقول لا، ولا أزكى بعدك احدا.
ضرر الذنوب والمعاصي
ينبغي أن يُعلم أن الذنوب والمعاصي تضر (كبائر الذنوب وصغائرها)، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟
ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجُعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع؟ وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومَقتَه أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك.
وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رأس الجبال؟
ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل الى ما يصنع بهم بختنصر فقال: “بما كسبت أيدينا سَلَّطْتَ علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا”.
وعن قتادة قال يونس: “يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم”.
وقال العمري الزاهد: “إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن تري ما يُسخط الله فتتجاوزه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا”. وقال: “من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لأستخف بحقه” (أقول: تأمل في الذين يسكتون اليوم عن أهل البدع المفسدين للدين، يجاملونهم بدل النصح لهم والتحذير منهم أو الأخذ على أيديهم، ومنهم من يثني عليهم، ويعتبر بدعهم صوابا).
وذكر الامام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: “قال أبو بكر الصديق يا أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها “يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم”، وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه – وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه – أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده”.
وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله: “إذا أخفيت الخطيئة فلا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تضر غير العامة”.
وذكر الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية أن النبي قال: “ستظهر شرار أمتى على خيارها حتي يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فينا اليوم”.
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: “يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء! قيل بما ذاك يا رسول الله؟ قال بما يري من المنكر لا يستطيع تغييره”.
وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله يقول: “يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه”.
وذكر الامام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: “إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه”.
وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: “إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإنا كنا لنعدها على زمن رسول الله من الموبقات”.
وقال الامام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت هلال بن سعد يقول: “لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر إلى من عصيت”. وقال الفضيل بن عياض: “بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله”.
وقال حذيفة: “إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الرمداء”.
وعن عامر قال: “كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما”.
وعن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الديْن اغتم لذلك فقال: “إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة”.
وذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: “اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يكفيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا يُنسى”.
وقال سليمان التميمي: “إن الرجل لَيُصيبَ الذنبَ في السر فيصبح وعليه مذلته”.
وقال ذي النون: “من خان الله في السر هتك ستره في العلانية”.
يتبع..