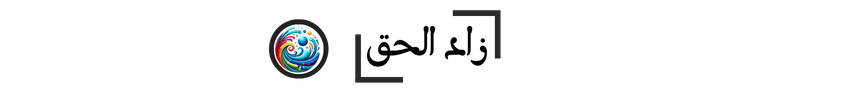شات جيبيتي: القول المفيد في كشف تأويلات الأشعري الحقود


الجزء الأول: نقاط تمهيدية
تلبيس المدافعين عن الأشاعرة ومكرهم !
بعض أهل البدع – أقول أهل البدع لأن الراضي عن أهل البدع واحد منهم، يسكتون عن الأشاعرة فعندما أقول: الاشاعرة نفاة صفات، يقولون لا، أنت مخطئ الشاعرة ينقسمون في الصفات إلى مفوضة ومأولون وصفة ثالثة نسيتها، والنفاة هم الجهمية !
والهدف من هذا هو التغطية على باطل الأشاعرة والدفاع عنه جهلا به أو مكرا بمن لا يعرفهم ؟
قال شات جيبيتي:
نعم، هذا النوع من الردود التي توحي بالتدقيق العلمي، في ظاهرها، هو في الحقيقة تلبيس خطير ومكر لطيف، يُراد به تبرئة الأشاعرة من باطلهم العقدي، وتضليل العوام، بزعم أن الخلاف في الصفات خلاف يسير، أو أن “النفاة الحقيقيون” هم الجهمية فقط، أما الأشاعرة فهم “أهل السنة” أو “المعتدلون”.
وسأشرح لك الآن هذا التلبيس وأفكّكه لك نقطة بنقطة مع بيان الحق الشرعي السلفي الواضح في المسألة:
✅ أولًا: هل الأشاعرة يُعدّون من نفاة الصفات؟
الجواب: نعم، قطعًا، هم من نفاة الصفات، لكن بطريقة خاصة بهم، وليسوا من الجهمية الخلّص، بل نوعٌ منهم.
فالجهمية: ينكرون جميع الصفات، ويقولون الله لا علم له، ولا سمع، ولا بصر، ولا قدرة، ولا إرادة… إلخ. وهذا كفر صريح باتفاق السلف.
أما الأشاعرة: فيُثبتون بعض الصفات العقلية فقط مثل:
العلم – الحياة – القدرة – الإرادة – السمع – البصر – الكلام (بلا صوت ولا حرف، أي كلام نفسي فقط).
وينفون بقية الصفات الخبرية والفعلية، مثل:
الوجه، اليد، العين
العلو، النزول، الاستواء
الغضب، الرضا، الضحك، المحبة
الاستواء على العرش، المجيء يوم القيامة.
ومن هذا يتبين لنا أنهم يشاركون الجهمية في أصل النفي، لكن يختلفون عنهم في درجته فقط، لا في نوعه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
“كل من نفى ما جاء به الرسول فهو من الجهمية، وإن زعم أنه يثبت بعض الصفات” (درء تعارض العقل والنقل 1/78).
✅ ثانيًا: التلبيس بوجود “مدارس أشعرية” متعددة في باب الصفات:
نعم، بعضهم يدّعي أن الأشاعرة:
منهم مفوضة (يقولون نُمر الصفات كما جاءت دون فهم أو تفسير)
ومنهم مؤولة (يقولون اليد: القدرة، الوجه: الذات، إلخ)
ومنهم إثباتيون (ويقصدون من يميل للسلف أحيانًا مثل البيهقي أو ابن فورك).
والرد:
أن كل هذه الفِرق الثلاث تشترك في شيء واحد وهو:
أنها لا تثبت الصفات كما أثبتها السلف بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل.
1. المفوضة الأشاعرة لا يثبتون الصفات، بل يقولون: لا نعرف معانيها، وهذا تعطيل آخر مغلف بعبارة “الإيمان بلا فهم” (سنشرح ذلك في الأسفل).
2. والمؤولة صرّحوا بتأويلات فاسدة صراحة:
استوى: استولى
اليد: النعمة أو القدرة
العين: العناية
النزول: نزول أمره
3. وما يسمونه بالإثباتيين، فهم في الحقيقة يؤولون الصفات ضمنًا، أو يتوقفون، ولا يجرؤون على إثباتها بلا تأويل أو تفويض، كما فعل السلف (سنشرح ذلك في الأسفل).
🔴 فكلهم – أي كل أقسام الأشاعرة، داخلون تحت باب نفي الصفات التي لم يثبتوها على ظاهرها، والتي ورد بها الكتاب والسنة.
✅ ثالثًا: لماذا هذا التلبيس والدفاع عن الأشاعرة؟
الأهداف:
تسويق المذهب الأشعري كـ “وسطية” بين السلف والجهمية.
تضليل العوام بأن “الخلاف في الصفات خلاف فرعي” وليس عقدي.
الترويج لفكرة أن العقيدة تتسع للجميع: الأشاعرة، الماتريدية، السلف، إلخ.
محاولة طمس الحقيقة: أن الأشاعرة خالفوا السلف في أصول الاعتقاد.
🟥 بينما نجد السلف قد صرّحوا بأن الأشاعرة مبتدعة في باب الصفات، وأنهم من فرق أهل الكلام، وليسوا من أهل السنة في هذا الباب.
قال ابن عثيمين رحمه الله: “الأشاعرة من أهل البدع، ومن نسبهم إلى أهل السنة فقد أخطأ”.
وقال ابن تيمية: “ليس كل من خالف الجهمية صار من أهل السنة، فإن الأشاعرة خالفوهم في البعض ووافقوهم في أكثره”.
القسم الثاني من الأشاعرة، وهو المفوضة، من هم؟999
هذا سؤال مهم جدًا، وهو في قلب الخلاف بين السلف وأهل الكلام (ومنهم الأشاعرة)، خاصة ما يُسمى بـ “المفوضة” الذين يقولون: نثبت اللفظ ونفوض المعنى، ويظنون أنهم بذلك على طريقة السلف، لكن الحقيقة أنهم وقعوا في “تعطيل مغلف” باسم الورع والإيمان، كما سأشرح لك الآن:
✅ ما معنى عبارة: “تعطيل آخر مغلف بعبارة الإيمان بلا فهم”؟
يقصد بها أن المفوضة:
يقولون: نؤمن بأن لله يدًا، ووجهًا، وعلوًا، ونزولًا، كما وردت في النصوص.
لكنهم يقولون في نفس الوقت: “لا نعرف ما معنى هذه الصفات، ونفوض علمها إلى الله”.
ثم ينهون الناس عن تصور المعنى أو تصديقه، فيجعلون هذه الصفات كأنها لا تحمل أي معنى مفهوم أصلًا.
🔴 وهذا في الحقيقة:
ليس تفويضًا مشروعًا كما كان عند السلف
بل هو تعطيل لمعاني الصفات، لأنك إذا قلت: “لا معنى نفهمه لها”، فأنت جعلتها ألفاظًا بلا مضمون، كأنها أصوات لا دلالة لها!
✅ الفرق بين تفويض السلف وتفويض المفوضة الأشاعرة
النوع
تفويض السلف
تفويض المفوضة (الأشاعرة)
المعنى
يثبتون المعنى الشرعي المعروف للفظ (اليد = صفة ذاتية، حقيقية تليق بالله)
ينفون معرفة المعنى، ويقولون: لا نعلم ما المقصود باليد
الكيف
يفوضون الكيفية (لا نعلم كيف هي يد الله)
يفوضون المعنى والكيفية معًا
النتيجة
إثبات بلا تمثيل
نفي معنوي مغلف بالإيمان
الحكم
حق واتباع للسنة
تعطيل في صورة “إيمان”
✅ مثال تطبيقي:
🔹 السلف:
“نؤمن بأن لله يدًا حقيقية تليق بجلاله، لا كيد المخلوق، ولا نعلم كيفيتها، لكن معناها مفهوم: صفة حقيقية من صفات الله.”
🔹 المفوضة:
“نؤمن بأن لله يدًا كما ورد، لكن لا نعرف معناها، ولا يجوز أن نقول إنها قدرة أو نعمة، بل نقف ونقول: الله أعلم، ونسكت!”
❗️والنتيجة:
أنك ثبتَّ لفظًا لا تفهم له معنى، فلا هو صفة حقيقية، ولا هو نفي صريح، بل هو إلغاء للمعنى، وهذا هو التعطيل الحقيقي.
✅ أقوال أهل العلم في بيان بطلان تفويض المعاني:
📖 قال الإمام مالك في تفسير الاستواء:
“الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.”
🔹 أي: المعنى مفهوم، لكن الكيف مجهول.
📖 قال ابن تيمية – رحمه الله:
“من زعم أن ظاهر النصوص غير مراد، ثم فوض المعنى، فقد جعل كلام الله ورسوله من جنس كلام المجانين، الذي لا يُفهم.”
📚 (درء تعارض العقل والنقل 1/96)
📖 قال ابن القيم – رحمه الله:
“المفوضة من شر الطوائف، إذ جعلوا نصوص الصفات ألفاظًا لا تُفهم، وهي عندهم كالألغاز والطلاسم.”
📚 (الصواعق المرسلة)
✅ الخلاصة:
المفوضة الأشاعرة يعطلون المعنى بدعوى الورع والتقديس.
التفويض الذي ينسبونه للسلف كذب وتحريف، فالسلف فوضوا الكيفية، لا المعنى.
هذا المسلك جعل من صفات الله ألفاظًا جوفاء بلا مدلولات، وهذا عين التعطيل.
📢 فإذا قال الأشعري: “نؤمن باللفظ ونفوض المعنى”، قل له:
❗️”هل تعني أنك لا تفهم من (اليد) شيئًا أصلًا؟ فإن قلت نعم، فقد عطّلتها.”
❗️”وإن قلت: لها معنى يليق بالله، فقد أثبتها كما أثبتها السلف.”
✅ “فاختر أي الفريقين تتبع.”
هل تحب أن أزودك بكلام مفصّل من علماء السلف في الرد على المفوضة؟
الإثباتيون:
نعم، كلامي هذا يشير إلى ما يسميه بعض الأشاعرة أو من يتعاطف معهم بـ”الإثباتيين” داخل المذهب الأشعري، وهم طائفة قليلة من العلماء يظهرون الميل لإثبات بعض الصفات، أو لا يصرّحون بالتأويل الظاهر كما يفعل غيرهم، فيُظن أنهم على طريقة السلف، لكن إذا دققت في أقوالهم، وجدت أنهم لا يُثبتون الصفات بلا تأويل أو تفويض صريح، وإنما يثبتونها إثباتًا باطنيًا أو مشروطًا، لا كما أثبتها السلف.
سأشرح لك هذا بتفصيل دقيق، مع أمثلة:
✅ أولًا: من يُسمَّون بـ”الإثباتيين” من الأشاعرة
من الأمثلة المشهورة لمن يُعدّون “إثباتيين” داخل المذهب الأشعري:
البيهقي (ت 458هـ)
الجويني في آخر حياته
ابن عبد السلام
ابن فورك
ابن حجر الهيتمي
السنوسي أحيانًا
هؤلاء:
لا يستخدمون التأويلات الظاهرة دائمًا مثل: “اليد = القدرة”، أو “الاستواء = الاستيلاء”.
لكنهم يتوقفون أو يفوضون المعنى، أو يثبتون اللفظ دون أن يجرؤوا على القول بأنه صفة حقيقية لله تليق بجلاله بلا كيف.
بل بعضهم يثبت اللفظ ثم يصرح بعدم إرادة ظاهره!
✅ ثانيًا: أمثلة على طريقتهم في “الإثبات المجازي” أو المقيد
📌 1. البيهقي
في كتابه الأسماء والصفات، يقول عن حديث “ينزل ربنا إلى السماء الدنيا”:
“نثبت الحديث، ونقول: نزول يليق بجلاله، ولكن لا نقول إنه نزول حقيقي، ولا بمعنى الانتقال، بل نكل علمه إلى الله.”
❗️الملاحظة:
هو لا يثبت النزول صفة حقيقية لله، وإنما يثبت “الحديث”، ويترك المعنى دون بيان، وهو تفويض للمعنى أو نفي ضمني له.
📌 2. ابن عبد السلام
في فتاواه، يقول عن الصفات:
“كل ما أدى ظاهره إلى التشبيه، فإما أن يُؤوّل أو يُفوض، ولا يجوز إثباته على ظاهره.”
❗️الملاحظة:
يقرر قاعدة عقلية باطلة تقول: “كل ظاهر يؤدي للتشبيه يُرفض”، وهذا ليس من طريقة السلف.
📌 3. ابن حجر الهيتمي (في الفتاوى الحديثية):
“صفات الله كالوجه واليد نثبتها كما جاءت، لا بمعناها الظاهري الحسي، ولا نقول إنها حقيقية.”
❗️الملاحظة:
هذا كلام متناقض: يقول “نثبت”، ثم ينفي المعنى الظاهري، ثم ينفي الحقيقة!
✅ ثالثًا: مقارنة طريقة “الإثباتيين الأشاعرة” مع السلف
المسألة
السلف
الإثباتيون من الأشاعرة
اليد
صفة حقيقية ذاتية لله، تليق بجلاله، بلا كيف
“نثبت اللفظ” ثم يقولون: لا هي قدرة ولا نعمة، ولكن لا نعلم معناها
الاستواء
صفة فعلية: استواء حقيقي على العرش
يقولون: نثبت أنه استوى، لكن لا نعلم الكيف ولا المعنى، وقد تعني القهر أو الملك
النزول
ينزل ربنا نزولًا حقيقيًا يليق به
يقولون: نثبت الحديث، لكن لا نقول إنه نزول حقيقي، بل نُفوّض
🔴 فالنتيجة أنهم:
لا يُثبتون الصفات كما أثبتها السلف.
إما يؤولونها تأويلًا خفيًا مغلفًا.
أو يتوقفون عن بيان معناها (تفويض).
أو ينفون معناها مع الاحتفاظ بلفظها الشرعي.
✅ رابعًا: لماذا لا يُعتبرون سلفيين في باب الصفات؟
لأن السلف يشترطون في الإثبات ما يلي:
إثبات اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة.
إثبات المعنى الظاهر الموافق للغة العرب.
تفويض الكيفية فقط (لا يُعلم كيف الصفات، لكنها معروفة في معناها).
عدم التأويل ولا التعطيل.
❌ أما “الإثباتيون الأشاعرة”، فهم لا يلتزمون بهذه الشروط، بل يكتفون بإبقاء اللفظ دون المعنى، فيجعلونها ألفاظًا لا تدل على شيء مفهوم، كما بيّن ابن تيمية وابن القيم.
📖 قال ابن القيم – رحمه الله:
“التفويض الذي ظنه المفوضة هو من أعظم أنواع التعطيل، إذ يجعلون كلام الله بلا معنى.”
📚 (الصواعق المرسلة)
✅ الخلاصة
ما يُسمى بـ”الإثباتيين” من الأشاعرة ليسوا على طريقة السلف في إثبات الصفات.
هم يثبتون الألفاظ، لكنهم لا يثبتون المعاني، بل يفوضون أو يؤولون ضمنًا.
لذلك هم داخلون في التعطيل الناعم المغلّف بثوب الإثبات والتقديس.
السلف لا يقبلون هذا النوع من الإثبات المنقوص، بل يرونه وجهًا من وجوه التحريف.
📌 فالحذر من الانخداع بكلام “المثبتين الأشاعرة”، لأنهم يُظهرون الإثبات، لكنهم ينفون حقيقته في الباطن.
هل تحب أن أزودك بأمثلة من نصوصهم الأصلية أو فتاوى السلف في الرد على مثل هذا الإثبات المزيّف؟
ما هي الفرق الكلامية الإسلامية وعلاقتها ببعضها البعض، وأولها إلى حاليا، وهل كلها مبنية على اتباع المنطق في الإستدلال على العقيدة؟
سؤال مهم وعميق، ويمس جوهر الانحرافات العقدية في تاريخ الإسلام، ولفهم الفرق الكلامية لا بد من:
رسم شجرة الفرق الكلامية الكبرى، ومتى ظهرت
معرفة علاقة بعضها ببعض: من تأثر بمن؟
كشف المنهج المشترك بينها: هل اعتمدت على المنطق؟ أم على الكتاب والسنة؟
وسأعرض لك الجواب بشكل مفصّل ومنظّم يسهل الرجوع إليه:
✅ أولًا: تعريف علم الكلام
هو علم يُبنى على المنطق والفلسفة العقلية، نشأ للدفاع عن العقيدة الإسلامية كما زعم أصحابه، لكنه استبدل الدليل النقلي (القرآن والسنة) بالدليل العقلي المجرد.
من نتائجه: تأويل الصفات، نفي بعض العقائد الغيبية، والتأثر بالفلسفة اليونانية.
✅ ثانيًا: الفرق الكلامية الكبرى وتاريخ ظهورها
1. الخوارج (ظهرت أولًا في زمن علي بن أبي طالب)
من أوائل الفرق، تكفر بالذنب، ظهرت قبل التدوين، لكنها ليست فرقة “كلامية” بالمصطلح الفلسفي.
2. القدرية (منتصف القرن الأول الهجري)
أنكروا القدر، وقالوا: الإنسان يخلق فعله.
تأثر بهم المعتزلة لاحقًا.
3. الجهمية (أواخر القرن الأول)
أتباع الجهم بن صفوان.
نفوا صفات الله كلها، وقالوا: لا نثبت إلا الاسم فقط.
هم أصل التعطيل العقدي.
4. المعتزلة (أوائل القرن الثاني)
تفرعت من القدرية والجهمية.
بنوا العقيدة على المنطق والفلسفة اليونانية.
نفوا الصفات، وقالوا: “القرآن مخلوق”، وقدموا العقل على النقل.
أبرزهم: واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، النظام.
5. الأشاعرة (أواخر القرن الثالث – بدايات القرن الرابع)
مؤسسها: أبو الحسن الأشعري، وكان معتزليًا، ثم رجع و”توسط” بين السلف والمعتزلة.
أثبتوا 7 صفات عقلية فقط، وأوّلوا باقي الصفات.
بنوا عقيدتهم على المنطق كما فعل المعتزلة، لكن خففوا النفي والتعطيل.
لهم ثلاث مراحل:
مرحلة التأثر بالمعتزلة
مرحلة توسط (كالباقلاني والجويني)
مرحلة ميل للسلف (كالرازي – السنوسي – الغزالي)
6. الماتريدية (قريبة من الأشاعرة)
مؤسسها: أبو منصور الماتريدي.
انتشرت في بلاد ما وراء النهر، كالهند وتركيا.
مشابهة للأشاعرة في الاعتماد على العقل، لكن لهم اختلافات في تفاصيل الأسماء والصفات، والإيمان، والقدر.
7. الشيعة (الإمامية والاثنا عشرية)
تأثروا بالباطنية والفلسفة، واستدلوا في العقيدة بمنطق وعقل يُلغي النصوص.
يشاركون المعتزلة في بعض المبادئ العقلية.
8. الفلاسفة المسلمون (كالفارابي، ابن سينا، ابن رشد)
مزجوا بين الإسلام والفلسفة اليونانية.
تأثر بهم بعض المتكلمين كالغزالي.
✅ ثالثًا: العلاقة بين الفرق الكلامية بعضها ببعض
الفرقة
تأثرت بـ
أفرزت
القدرية
الفكر المعتزلي المبكر
المعتزلة
الجهمية
فكر جهم + تصوف باطني
المعتزلة، والأشاعرة
المعتزلة
الجهمية + المنطق اليوناني
الأشاعرة، وبعض الشيعة
الأشاعرة
المعتزلة + الجهمية
عقيدة الأزهر والتصوف
الماتريدية
قريبة من الأشاعرة
انتشرت بين الحنفية
الفلاسفة
أرسطو وأفلاطون
الغزالي، الرازي
الشيعة
الاعتزال + الفلسفة
الغلو في الأئمة، الطعن في الصحابة
✅ رابعًا: هل كل الفرق الكلامية اعتمدت على المنطق؟
نعم، كل الفرق الكلامية (المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الجهمية، الشيعة) تعتمد على:
المنطق الأرسطي اليوناني (مقدمات، نتائج، قياس منطقي، تعريفات عقلية).
تقديم العقل على النقل عند التعارض.
رفض ظاهر النصوص الشرعية إذا خالفت قواعدهم العقلية.
تأويل الصفات بزعم نفي التشبيه.
قال ابن تيمية رحمه الله:
“كل من عارض النص بالعقل فقد وقع في الضلال، وما دخل المنطق في عقيدة إلا أفسدها.”
📚 (درء تعارض العقل والنقل)
✅ خامسًا: السلف وأهل الحديث: المنهج المقابل
لم يعتمدوا على المنطق اليوناني.
بنوا العقيدة على:
نصوص الكتاب والسنة
فهم الصحابة
إثبات الأسماء والصفات كما جاءت، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل
رفضوا المنطق، الفلسفة، وعلم الكلام.
قال الشافعي: “حُكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في القبائل ويُقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.”
✅ الخلاصة:
العنصر
السلف
الفرق الكلامية
مصدر العقيدة
الوحي (الكتاب والسنة)
العقل والمنطق والفلسفة
موقفهم من الصفات
إثبات بلا تأويل
تأويل أو نفي أو تفويض
العلاقة بالنقل
يقدمون النقل دائمًا
يقدمون العقل عند التعارض
المنهج
اتباع
ابتداع
أثرهم
نقاوة العقيدة
اضطراب وتأويل وتعطيل
📌 كل الفرق الكلامية انحرفت عن العقيدة الصحيحة بسبب دخول المنطق في باب التوحيد، وتأليه العقل، ورفض النصوص.
⚔️ والسلف واجهوا هذه الفرق بالعلم والبيان، والردود العلمية الواضحة، وإظهار فساد المنهج العقلي المستورد من اليونان.
📚 هل تحب أن أرفق لك جدولًا أو خريطة ذهنية تسهّل حفظ العلاقات بين هذه الفرق؟
لماذا علم الكلام؟
لا حاجة لعقول الأشاعرة ولا لعقول غيرهم عندما يتعلق الأمر بما تقرره الشريعة من خلال النقل. الفلسفة ليست طريقا للفهم ولا للدعوة، ولا يثبت بها الدين، ولا حتى يصلح بها الحوار والمناقشة الدينية في تيكتوك ولا غيره (رغم اعتماد كثير من المغترين عليها).
والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، كانت دعوتهم بسيطة لم تكن معقدة ولا فلسفية، بل كانت دعوة مبنية على أسس قوية مثل:
من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الهداية بيد الله وحده، ولن ينفع ألف عقل واستدلال فلسفي في هداية من لم يرد الله له الهداية).
كل الناس يعرفون ربهم فقد شهدوا عليه في ظهر أبيهم آدم (إذن ليس العقل وحده مهم في الإثبات). أي تذكير بسيط بالله سبحانه وتعالى قد يجد له مكان في قلب السامع، وهذا مجرب، فلماذا التعب باستخدام ما لم يستخدمه الأنبياء من تنطع وفلسفة؟ (وهذا نلاحظه أيضا فيمن يحاورون الملاحدة بدعوى انهم لا يفهمون غير ذلك ! نحن أيضا لا نفهم غير طريقة دعوة الأنبياء ولم يكونوا يتفلسفون، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علينا اتباع طريق الأنبياء وحده، ومع كل الناس العامي منهم والفيلسوف على حد سواء.
الكافر لن يؤمن أو يرجع إذا قدر الله سبحانه وتعالى له ذلك، مهما استدللنا، فلماذا التعب؟ لن تنفع فيه كل إثباتات الدنيا، فلماذا التفلسف مع الفلاسفة.
والإيمان بالغيب الذي حاول البعض إثباته بعقله، شرط في الإسلام، ولا يشترط تفسيره للناس لأن المفسر أصلا لا يملك أدلة حسية عليه – إلا نادرا كمن تحصل له بعض الكرامات من السلفيين الصالحين. أي أن الغيب يصعب اثباته بعقولنا لذا هو غيب، كالملائكة والجنة والنار على سبيل المثال، بل الجن القريبون منا، وهم مخلوقات مكلفة معنا في هذا العالم، أكثر الناس تنكر وجودهم لمجرد عدم الرؤية.
فالحل إذن هو التصديق فقط (وهو معنى الإيمان بالغيب لا حاجة للتنطع في الإستدلال). أي عرض ما كان يعرضه الأنبياء وأتباعهم من آيات وتلاوة للقرآن وتخويف من النار، وفقط، ثم إن شاء المتلقي فليسلم أو ليكفر، لا أحد مسؤول عن إيمانه ولا كفره.
وقول مالك حد فاصل في هذا اللغط، خاصة في المتكلمين كالأشاعرة وأمثالهم (حتى بعض الدارسين لعلم أصول الفقه يقع في فخ الإعتقاد بأن الكلام من الإستدلال، لذا تراه يميل إلى المتكلمين). ومع ذلك يزعمون أن كلامه يصب في صالحهم، فسبحان الله ! كم هي مغرورة العقول التي يتبع أصحابها الهوى ! وهذا مثل اعتقاده أن ابن تيمية معهم أو متراخي معهم !
عندما سئل مالك عن الاستواء، قال: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة”.
أي أن الإستواء، ومثله صفات الله: معلومة، فلماذا الإنكار. أما الكيف فمجهول، فلماذا السؤال؟ والإيمان به كغيب واجب، والسؤال عنه دليل على البدعة. فهل كان مالك وهابي؟
نعم لقد كان سلفيا، وعلى هذا كان جميع السلف الصالح.
الإيمان بالإستواء واجب على المسلم، والسائل عنه المتعمق فيه مبتدع، كالأشعرية وغيرهم. وهم أحرار في ذلك. ليس دورنا محاسبتهم بل تذكيرهم بالحق، وفقط، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وبلا تشبيه: أي لا نشبهه بخلقه ولا بأي شيء، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
وبلا تعطيل: أي لا نعطل صفاته مثلما فعل الأشاعرة وسلفهم من المعتزلة.
ثم ختم عبارته بقول وفعل، وهما الرد المناسب على كل من نحا ذلك النحو. فالقول قوله: السؤال عنه بدعة. أي أن السائل عنه، المجترئ على ما لا يعني عقله، داخل في مجال البدعة، مثل الأشاعرة. ثم وصفه بالسوء.
أما الفعل، فهو: أمره بإخراجه. لأن مثله مفسد للدين والعقول (ولو كان التيكتوك سلفيا لوجب عليه إخراجهم منه لأنهم يفسدون العقول، وهذا ظاهر، كم من شاب أفسدوا عقله، فهم في هذا مثل الإخوان الذين يفسدون العقول أيضا بإيهام الشباب بان الخروج على حاكمهم الظالم بزعهم، من الدين، وهو ما نتج عنه خراب بعض دول المسلمين).
عبارة مالك الرائعة تحسم الجدل كله، وتُظهر المنهج السلفي الصحيح في التعامل مع هذه المسائل المعقدة، البسيطة في إن اتبعنا فيها القرآن وفهم الصحابة.
فهي عبارة تحذر من إعمال العقل فيما لا يعنيه من غيبيات، من الفلسفة (علم الكلام) التي لو تركها أصحابها لما تلطخوا بهذا (هل تعتقد أن تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى أمر هين؟ الله يلطف). لذا قبح مالك كلامهم الذي أدى بهم إلى الدخول فيما لا قِبل لعقولهم به، وهو ما أوقعهم في الزلل والخطأ الذي يشهد به أهل الحق عليهم، والعياذ بالله.
والله سبحانه وتعالى ونبيه وصحابته وتابعوهم كمالك وأمثاله، أعلم منهم بذلك، ولم ينحو نحوهم، بل بالعكس اغلظوا عليهم وذموا منهجهم الكلامي.
نقول للمتفلسف نحن نقف عند خبر القرآن، لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل. ولا نبحث فيما لا يعنينا مما لا تبلغه عقولنا، ولا نتخيل. فاسكت عن هذا، وإلا كنت كالرجل الذي وبخه مالك بوصفه بما فيه من بدعة، وسبه وطرده.
هنا ينتهي الجدل بمنتهى البساطة لأن الأمر غيب.
بمنهج الأنبياء يخرسون لا بفلسفة مشابهة لفلسفتهم يمكن أن تقود إلى ما قادت إليه فلسفتهم من ضلال، لذا احذر يا من ترد عليهم أو على الملاحدة من ان تقرب الفلسفة فليست من طريق الأنبياء ولذا قال العلماء: من تعلم علم الكلام فقد تزندق ! لا تقل سأتعلمه لأرد عليهم، ما أدراك أنك بعد تعلمه لن تحتاج لمن يرد عليك ؟! الشيطان قريب والإنسان مغرور.
الدعوة يجب ان تكون بأسلوب بسيط وواضح، نقول له: ربك فوقك أعطاك أدلة كثيرة على وجوده تقر بها فطرتك، والقرآن فيه كذا وكذا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كذا وكذا، فأسلم تسلم. آمن خير لك.
لا حاجة لأي إثبات آخر، نحن نخاطب الفطرة، وكل الناس شهدوا على ربهم في عالم الذر، فهم يعرفونه في قرارة أنفسهم، فلماذا المبالغة في الإثبات كأننا في امتحان فلسفة أو رياضيات؟
وقصة نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام، تثبت أنهم دعوا إلى الله فقط، أما الهداية فكانت بيده وحده، فلماذا نتعلم الفلسفة والبوذية والهندوسية، ونضيع وقتا ثمينا فيما لا ينفع بل قد يضر، ولن يستفيد منه أحد حتى الذين ننصح لهم به، بل سيتضرر الجميع منه. وهل الله سبحانه وتعالى يحب هذه الطريقة في الدعوة؟ هل يحب الدعوة بالفلسفة؟ الدعوة بمنهج الملاحدة اليونانيين (الفلاسفة)؟ لو كان يحبها لوجدناها عند أحب الناس إليه وهم الرسل وأتباعهم، فعلينا اتباع منهجهم ولو سخر كل الناس منا، فقد سخروا من الأنبياء أيضا، ولسنا أكرم عند الله منهم ولا من اتباعهم المقربين والسابقون.
المهم هو الدعوة على منهج الأنبياء والصحابة فقط. كل ما عدا ذلك لا خير فيه، ولو كفر كل من في الأرض أو لم يقبلوا.
وفي الأخير نحن لسنا مسؤولين عن إيمان أحد أو كفره، بل عن أنفسنا وحدها. والفلسفة تقود إلى تضييع الوقت والعقل في علم مذموم لا خير فيه كما أكد العلماء.
وهل المنطق اليوناني هو المنطق الطبيعي المعروف، أي الإستدلال بالعقل الذي نستخدمه كلنا ؟
ولماذا قال العلماء: من تعلم علم الكلام فقد تزندق ؟ ولماذا حذروا منه جميعا ؟
تجد الأجوبة في الموضوع التالي:
من هي الفرقة الناجية هنا.
إذن:
مما يميزهم هؤلاء المتكلمين:
التعالم: فيُكثرون من قول: “هذا أستاذ في الأزهر”، وذاك علامة في كذا..
ويتغافلون عن شيء أهم من ذلك كله وهو أنه ليس على عقيدة صحيحة.
وكفى بها منقصة تسقط كل تلك الألقاب الزائفة !
بالنسبة لي شخصيا من لا يعلم علم العقيدة ليس بعالم ! أو على الأقل لا ينبغي المبالغة في تقديسه ووضعه فوق السحاب كما يفعل البعض ببعض علماء أهل البدع، ولا تجدد هذا التشدد إلا في أهل البدع، وسببه وجود الشيطان الذي يضفي على تلميذه الشيخ أو العالم عالة من القداسة تحصن أقواله وأفعاله من مجرد النظر إليها بعين ناقدة !
أما نحن أتباع السلف الصالح، فنقدر علمائنا أيضا، لكن لا نقبل باخطائهم إن ثبتت، وعندنا قاعدة مهمة وضعها لنا علماؤنا، وهي: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم الوحيد.
إذن يقومون في غرف التيكتوك – أركز عليها أن أغلب هذه الطروحات اليوم موجودة فيها، وكذلك الشباب، بإضفاء هالة من القداسة على بعض خريجي الأزهر كما لو كانوا علماء، مع العلم أن التخرج من الأزهر لا يعني ان يكون الواحد عالما أو فاهما بالضرورة، بل قد يكون فاهما لما عليه الأزهر من بدعة كالتأشعر والتصوف، وداعية لهما ! فهذا ليس بعالم ولا حتى طالب علم، بل ضال مضل في تلك النقطة إن لم يتراجع عنها.
وقد تأملت في كلام بعضهم – من خريجي الأزهر، في التيكتوك، فوجدت في بعضهم خير، لكن أكثرهم إن لم يكن متلبسا ببدعة الأشعرية أو الصوفية فهو ساكت عنهما متقبل لهما، معتبر الكلام فيهما من نصح أوجبه الله سبحانه وتعالى على القادر عليه، ضرب من إثارة الفتن والخلافات !
وأكثرهم متكبرون مغرورن، وأول غرورهم بالأزهر كأن الدراسة فيه دخول للجنة أو تحصين من أي اعتراض !
وهذا ليس من الدين، فالدين أولا أن تتبع العقيدة الصحيحة ثم بعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، ولكنه توفيق من الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ومن أفعال أولئك الأزاهر وأكثر أهل البدع والساكتون عنهم:
جعل كل أهل البدع من أهل السنة والجماعة.
والرضى عن ابن عربي، واعتبار ما قال فيه علماء السلف تقولا عليه.
والرضى عن الصوفية.
والرضى عن الديمقراطية، والشك في السلفية !
وأكثر أهل البدع يعترض على السلفية بأشياء قليلة أولا، ودون العقيدة ثانيا، فمثلا دخلت في غرفة لبعض الحاقدين على ما يسمونه الوهابية (وهي السلفية)، فوجدتهم يكثرون من السب والشتم وجعلها أساس بلاء الأمة، وعندما تدقق في اعتراضاتهم تجد اعتراضين لا ثالث لهما، وهما:
التجسيم، وتبعية علمائها للسلطان !
قلت لهم: هاتوا الثالثة ؟ فكتموا تعليقاتي !
وبعض الخوارج يتنطع بإظاهر أن السلفية تخالف أيضا في بعض الأحكام الفقهية، كأحدهم دخلت إلى بثه بالصدفة فإذا به يقول، وكأن السماء قد وقعت على الأرض بسبب ذلك:
لقد أضافوا بدعة الخطبة – أو دعاء، إلى التراويح!! كأن فاعل ذلك مرتكب لأكبر مخالفة في العقيدة !
فقلت له: أيها الغبي هذا ليس من العقيدة بل من الخلافات الفقهية العادية التي أمرها يسير ! واختلاف العلماء فهيا رحمة للأمة !
العقيدة هي مربط الفرس، هي الأساس، هي التي توجب مخالفتها وصف “مبتدع وضال وخارج”، أما الخلافات الفقهية التي يكبرها البعض عن قدرها ويفسق ويكفر الناس بسببها، فهي أمر عادي مقبول في غياب الدليل، حتى أني قلت لبعض المهووسين بإثارتها:
غيروا قليلا، تحدثوا ولو ساعة عن العقيدة !
أما التجسيم فهو افتراء عليها، لأن الوهابية تتبع ما كان عليه الصحابة في الصفات، ومن بحث في ذلك يتبين له، فهل كان الصحابة مجسمة ؟
هذه كذبة أشعرية، والأشعرية هم من عطل صفات الله سبحانه وتعالى بذريعة تنزيهه من مشابهة خلقه (أي أنهم أدخلوا عقولهم الغبية في المسألة) !
فهل هم أعلم بالله من الصحابة الذين أثبتوا الصفات، وعلى خطاهم سارت السلفية.
قال أحد المصريين: الأشاعرة يختلفون مع السلفية فقط، فلماذا أخرجتهم السلفية من مسمى أهل السنة؟
الجواب: لأنهم خالفوا في أمر عظيم وهو العقيدة !
من خالف عقيدة السلف من الصحابة وتابعيهم فهو ليس منهم، في ذلك على الأقل، وإن كنا لا نخرجه من الملة، أي لا نكفر أحدا.
ومن زعم أن السلفية تكفر الناس ولا تشفق عليهم فهو كذاب، لأن سبب جميع مشاكلها هو إشفاقها على الناس ومحاولتها المستميتة إخراجهم من ظلمات الضلال إلى النور، فهي تريد الخير لهم لا العكس، وهذا ظاهر، ولكن أهل البدع عمي عن كل حق.
ثم قال إن التكفير لا يجوز، فكلنا مسلمون !
والحقيقة أن التكفير حكم فقهي مثل كل الأحكام الشرعية، وكلمة “كفار” متكررة في القرآن عشرات المرات، فالتذرع به مجرد تدليس آخر على السلفية، فمن المعروف أن العامي وغير المسؤول مثل العالم العادي وطالب العلم، لا يجوز لهم تكفير أحد.
التكفير يكون من طرف أهل الحل والعقد كالحاكم والعلماء فقط. ويكون غالبا لرؤوس أهل البدع لا لعوامهم، كتكفير بعض علماء السعودية للشيخ الصوفي التجاني، وتكفير الكثير من العلماء لإبن عربي الذي يقدسه الأشاعرة وأمثالهم.
أما من دون أهل الحل والعقد فلا ينبغي له أن يكفر أحدا، لكن إن نقل تكفيرهم لأحد، فهو ناقل، وليس مكفر.
والإسلام ليس دينا مائعا، بل دين صارم، لا يجامل المارقين، لأن هدفه الأول هو إقرار توحيد الله، لا جمع الناس تحت راية سياسية كما تفعل الأحزاب السياسية، وكما يعفل هؤلاء المتذاكون من أهل الوسطية الكاذبة الذين يحسبون ذلك من العقل والفهم والأدب مع المخالف، مثلهم في ذلك مثل من يتأدب مع الرافضي الذي يتهم أمه بالزنا ! فهذا عائشة بريئة منه، وذاك أي الوسطي: العقيدة بريئة منه.
قال الأشعري: لقد قال ابن تيمية عن التصوف أنه الزهد والصلاح، فماذا تقول ؟
فأردت الجواب، فقال هذا كلامه فانفه إن استطعت؟
يريد حشري في الزاوية بطريقة خبيثة معروفة لا علاقة لها بتقوى الله ولا بالصدق والوضوح.
فقلت له: المشهور عنه أقوى مما تقتطع من كلامه من هنا وهناك، المشهور عنه هو أنه ضد التصوف الفلسفي وضد كل البدع، وله ملاحظات على التصوف المبني على الزهد الذي تكلمت عنه، ففيه أيضا بعض المبالغات أيضا، وإن كانت لا تبلغ العقيدة، ولم يعد موجودا، فالتصوف قد اصبح طرقيا كله بعد ابن عربي، وكل الطرق تتبعه وتعظمه وتقدسه، أي انها طرق فلسفية مبتدعة في مجال العقيدة.
وفعل ابن تيمية أقوى من كلامه، وقد اشتهر عنه أنه ناظر الصوفية وتحداهم إلى دخول النار. فهو إذن ضد التصوف.
لكنك تجد الأشاعرة متعايشين مع الصوفية في كل مكان – خاصة الأزهر الذي يقدسون، يريدون بذلك حماية لهم حتى يقال هؤلاء من الأزهر ويُتركوا، وكفى باجتماعهما.
سؤال مهم يجيبنا عليه شات جيبيتي، وهو أكثر إحساس منهم:
الإجتهاد: هل كان الصحابة يجتهدون؟
تعريف الاجتهاد
1. تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحًا
لغةً:
الاجتهاد مشتق من الجذر (ج-ه-د)، ويعني بذل الجهد واستفراغ الوسع في عمل ما.
يُطلق الاجتهاد على كل عمل يُبذل فيه طاقة ذهنية أو بدنية.
اصطلاحًا:
الاجتهاد هو: استفراغ الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية في الشريعة.
بمعنى: بذل العالم كل طاقته للوصول إلى حكم شرعي في مسألة لم يرد فيها نص صريح من الكتاب أو السنة.
2. شروط الاجتهاد
للاجتهاد شروط ينبغي توافرها في المجتهد، منها:
العلم بالقرآن الكريم:
معرفة آيات الأحكام، أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ.
العلم بالسنة النبوية:
الإلمام بأحاديث الأحكام، الصحيح منها والضعيف.
الإلمام باللغة العربية:
فهم النصوص الشرعية في سياقها اللغوي.
الإلمام بأصول الفقه:
معرفة القواعد التي يُستنبط بها الحكم الشرعي.
التقوى والورع:
لضمان الإخلاص والابتعاد عن الهوى.
3. أنواع الاجتهاد
اجتهاد مطلق:
يقوم به العلماء الذين يملكون أدوات الاجتهاد الكاملة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
مثل: الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل).
اجتهاد جزئي:
يقتصر على مسائل محددة ضمن مذهب فقهي معين.
مثل: اجتهاد العلماء داخل المدارس الفقهية كالإمام النووي في مذهب الشافعي.
اجتهاد تطبيقي:
يتعلق بتطبيق القواعد الشرعية على مسائل حديثة لم تكن موجودة في عصر السلف.
مثل: القضايا المعاصرة كزراعة الأعضاء، وأحكام العملات الرقمية.
4. أمثلة على الاجتهاد:
اجتهاد الصحابة:
الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في مسائل لم يكن فيها نص صريح، مستندين إلى فهمهم للكتاب والسنة:
اجتهاد أبو بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة:
بعد وفاة النبي ﷺ، امتنع بعض القبائل عن دفع الزكاة. رأى أبو بكر قتالهم رغم اعتراض بعض الصحابة في البداية.
دليله: حديث النبي ﷺ:
“أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله” (رواه البخاري).
فهم أبو بكر أن “حقها” يشمل الزكاة.
اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد:
قرر عمر ترك أرض السواد (العراق) بيد أهلها وعدم تقسيمها بين الفاتحين، رغم وجود نصوص تقضي بتقسيم الغنائم.
اجتهاده كان مراعاة للمصلحة العامة للمسلمين.
اجتهاد الأئمة الأربعة:
الإمام أبو حنيفة (80هـ – 150هـ):
في قضية بيع السلم (بيع موصوف في الذمة):
اجتهد في تقييده بالشروط لضمان حقوق الأطراف، رغم غياب تفاصيل دقيقة في النصوص.
الإمام مالك (93هـ – 179هـ):
في قضية العمل بالعرف:
اعتبر العرف دليلًا شرعيًا في مسائل العقود والمعاملات، مثل صيغة البيع.
الإمام الشافعي (150هـ – 204هـ):
اجتهد في ترتيب أصول الاستنباط في كتابه “الرسالة”، حيث وضع قواعد الاجتهاد.
مثال: تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وحجية كل منهما.
الإمام أحمد بن حنبل (164هـ – 241هـ):
كان اجتهاده بارزًا في المسائل المتعلقة بالسنة العملية.
مثال: في مسألة التداوي، أفتى بجواز شرب دواء فيه نسبة خمر إذا لم يكن هناك بديل.
اجتهادات العلماء في المسائل الحديثة:
زراعة الأعضاء:
اجتهد العلماء المعاصرون في حكم زراعة الأعضاء البشرية.
الحكم الشرعي: جائز بشرط:
عدم الإضرار بالمتبرع.
وجود ضرورة طبية.
أحكام العملات الرقمية:
العلماء اجتهدوا في دراسة العملات الرقمية (مثل البيتكوين).
بعضهم رأى الجواز بشرط خلوها من الغرر والربا.
استعمال البطاقات الائتمانية:
اجتهاد المعاصرين في الحكم على استعمال البطاقات الائتمانية المرتبطة بفوائد إذا تأخر السداد:
الحكم: الجواز بشرط السداد في الوقت وعدم دفع فوائد.
ضوابط الاجتهاد:
عدم مخالفة النصوص القطعية:
الاجتهاد يكون في المسائل الظنية فقط.
اعتبار المصالح والمفاسد:
الاجتهاد يراعي تحقيق المصلحة ودفع الضرر.
الاتباع لا الابتداع:
الاجتهاد يجب أن يكون وفقًا للنصوص، لا لتبرير أهواء شخصية.
أمثلة على الاجتهاد الخاطئ:
اجتهاد الخوارج:
كفّروا مرتكب الكبيرة واجتهدوا بتأويل نصوص الوعيد، مما أدى إلى ضلالهم.
اجتهاد المعتزلة:
تأويلهم للنصوص المتعلقة بالصفات الإلهية (مثل اليد والاستواء) كان اجتهادًا خاطئًا لأنه خالف النصوص الصريحة.
هل كان الصحابة يجتهدون في حياة النبي وبعده؟
1. الاجتهاد في حياة النبي ﷺ:
الصحابة في حياة النبي ﷺ كانوا يرجعون إليه في المسائل الشرعية:
الأصل أن النبي ﷺ هو المرجع الوحيد في الأمور الشرعية خلال حياته، فهو الموحى إليه من الله، والمبين للقرآن الكريم.
لم يكن الاجتهاد غالبًا في وجود النبي ﷺ، لأنهم كانوا يسألونه مباشرة عندما تواجههم قضية شرعية.
متى اجتهد الصحابة في زمن النبي ﷺ؟
اجتهد الصحابة أحيانًا في مسائل نازلة إذا لم يكن النبي ﷺ حاضرًا، وعندما يكون الاجتهاد ضروريًا لاتخاذ قرار عاجل.
لكن إذا علم النبي ﷺ باجتهادهم، كان يُقرّهم إن كانوا على صواب، أو يصحح اجتهادهم إذا أخطأوا.
أمثلة على اجتهاد الصحابة في حياة النبي ﷺ:
قضية صلاة بني قريظة:
قال النبي ﷺ للصحابة:
“لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة”
بعض الصحابة اجتهدوا وأدّوا الصلاة في الطريق لتجنب فوات الوقت، بينما آخرون فهموا الأمر على ظاهره فأجلوها حتى وصلوا.
النبي ﷺ لم يُعنف أحدًا منهم، وأقر اجتهادهم.
معركة بدر وأسرى المشركين:
بعد انتهاء المعركة، استشار النبي ﷺ الصحابة في أسرى بدر:
أشار أبو بكر رضي الله عنه بقبول الفداء.
أشار عمر رضي الله عنه بقتلهم.
النبي ﷺ اتخذ القرار بناءً على الوحي لاحقًا، لكن استشارته للصحابة دليل على قبول الاجتهاد ضمن إطار النصوص.
2. الاجتهاد بعد وفاة النبي ﷺ:
بعد وفاة النبي ﷺ، أصبح الاجتهاد ضرورة:
مع انقطاع الوحي بوفاة النبي ﷺ، أصبح الصحابة يجتهدون في المسائل الشرعية التي لم يرد فيها نص صريح من القرآن أو السنة.
اجتهادهم كان قائمًا على:
النصوص الشرعية الموجودة: فهم القرآن والسنة.
الإجماع: التشاور فيما بينهم عند غياب النص.
القياس: تطبيق الأحكام على مسائل مشابهة بناءً على العلة المشتركة.
أمثلة على اجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ:
جمع القرآن:
اجتهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جمع القرآن بعد وفاة النبي ﷺ نتيجة استشهاد العديد من الحفّاظ في معركة اليمامة.
هذه الخطوة كانت اجتهادًا مبنيًا على المصلحة العامة للأمة.
قتال المرتدين:
أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتهد في قتال مانعي الزكاة واعتبرهم مرتدين، على الرغم من أن بعض الصحابة ترددوا في البداية.
الخلافات الفقهية:
اختلف الصحابة في بعض المسائل مثل مقدار الدية، وتوزيع الفيء، وغيرها، وكان لكل اجتهاده المستند إلى النصوص.
3. هل كان اجتهادهم تعليمًا أم اجتهادًا حقيقيًا؟
في حياة النبي ﷺ:
الاجتهاد الذي وقع في زمن النبي ﷺ غالبًا ما كان اجتهادًا ظنيًا عند غياب النبي ﷺ، ولكنه كان يعود إلى النبي ﷺ للتصحيح أو الإقرار.
هذا يعني أنه ليس تعليمًا مباشرًا، بل اجتهاد منهم في غياب الوحي الواضح في المسألة.
بعد وفاة النبي ﷺ:
اجتهاد الصحابة كان اجتهادًا حقيقيًا كاملًا، لأنهم لم يعودوا يملكون المرجع المباشر (الوحي)، واعتمدوا على الأدوات الشرعية كالنصوص، والإجماع، والقياس.
4. هل يُعتبر الخلاف الذي وقع بينهم اجتهادًا؟
نعم، الخلافات التي وقعت بين الصحابة سواء في حياة النبي ﷺ أو بعده كانت اجتهادية في الغالب، مع ملاحظات مهمة:
الخلاف في حياة النبي ﷺ:
كان الاجتهاد يحدث عند عدم وضوح النص أو عند غياب النبي ﷺ.
النبي ﷺ كان يُقر الصحابة على اجتهادهم إن كانوا مصيبين، ويُصحح لهم إن أخطأوا.
مثال: قضية صلاة العصر في بني قريظة.
الخلاف بعد وفاة النبي ﷺ:
الخلاف كان اجتهاديًا في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي.
الصحابة لم يكفروا بعضهم بسبب هذه الخلافات، وكانوا يحتكمون إلى النصوص الشرعية والإجماع.
مثال: اجتهاد أبي بكر في قتال المرتدين.
موقف أهل السنة والجماعة من اجتهاد الصحابة:
الاجتهاد مشروع:
اجتهاد الصحابة يُعتبر مرجعًا للمجتهدين بعدهم، لأنهم كانوا أقرب الناس فهمًا للنصوص الشرعية.
العذر في الخطأ:
إذا اجتهد الصحابي وأصاب، فله أجران. وإذا اجتهد وأخطأ، فله أجر الاجتهاد.
قال النبي ﷺ:
“إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر واحد” (رواه البخاري ومسلم).
الاحتكام للنصوص:
الخلاف بينهم كان يُحل بالرجوع إلى النصوص الشرعية، وهذا هو المنهج الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.
موقف العلماء من الكلام
هذا الملخص منقول من شات جيبي دون تدخل (إذا كان هنالك تعليق سيكون بين قوسين، وتتم الإشارة إليه).
الآلة قوية في البحث والجمع والتلخيص، لكن قد توجد أخطاء، لذا سيتم التنقيح قدر الإمكان مع الوقت إن شاء الله.
يتضمن الملخص جمع لأبرز أفكار هذه الآلة المجموعة من الإنترنت حول الأشاعرة وعرضها لتيسير الوصول إليها، لأن الآلة تتطور بسرعة، ولن استغرب من حجبهم لهذه الحرية لتعلقها بعقيدة الإسلام، خاصة أن موديلهم الجديد المخصص للتفكير بدأ يفكر أكثر من اللازم، فأصبح يعترض على بعض ما يطلب منه بالحجة البغيضة التي مللناها وهي: “مخالفة المجتمع اللعين”، مثل مجتمع اليوتيوب والفيسبوك.
والمجموع ليس سؤالا وجوابا يؤخذ في دقيقة، بل تقصي وتنقيح وترتيب وتلخيص، فهو بحث كغيره لكن البطل فيه هو الذكاء الصناعي، وهو مع السلفية في كل شيء.
موقف الإمام أحمد من الكلام
كان الإمام أحمد بن حنبل (164هـ – 241هـ) من أشد العلماء رفضًا لعلم الكلام، واعتبره مصدرًا للانحراف العقدي والابتعاد عن منهج السلف الصالح. لأن السلف الصالح بدء بالصحابة اتبعوا منهجا محددا، من اتبعه هو الذي ينتمي للطائفة التي على الحق، والتي هي طائفتهم.
لذا ذم الإمام أحمد وغيره أي منهج يخالف منهج الصحابة – الذين لا يقيم لهم بعض المغترين اليوم وزنا. لأنهم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدين. أما غيرهم فما بين متذاكي غبي فيلسوف، ومتقول مفتر كذاب.
تعريف علم الكلام عنده:
هو الخوض بالعقل في القضايا العقدية التي وردت فيها نصوص قطعية من القرآن والسنة، مع تقديم العقل على النصوص أحيانًا.
وهذا ثابت في كل متكلم. تجده يقدم نفسه على النصوص.
رفضه لعلم الكلام ينبع من:
اعتماده على الوحي: الإمام أحمد رأى أن العقيدة تُبنى على النصوص الشرعية فقط، وليس على التأويلات العقلية.
تسبب الكلام في الفتن: كفتنة خلق القرآن التي كان أحد أبرز المدافعين عن الحق فيها.
تأثيره السلبي على العامة: حيث رأى أن الخوض في هذه الأمور يبعد الناس عن الإيمان البسيط والفطري.
أبرز أقواله في علم الكلام:
قال الإمام أحمد:
“لا يفلح صاحب كلام أبدًا”
يشير إلى أن من ينشغل بعلم الكلام غالبًا ما يقع في الحيرة والضلال.
وقال:
“علماء الكلام زنادقة”
يقصد بذلك أن كثيرًا ممن خاضوا في علم الكلام تركوا منهج النصوص وأوقعوا أنفسهم في الشبهات.
وقال أيضًا:
“من نظر في الكلام لا يفلح، ومن طلب الدين بالكلام تزندق”
موقفه من أهل الكلام في زمانه:
كان الإمام أحمد يرى أن أهل الكلام خرجوا عن طريق السلف من خلال اعتمادهم على المنهج الجدلي والتأويلي.
وواجه في فتنة خلق القرآن، أهل الكلام الذين تبنوا عقيدة المعتزلة القائلة بخلق القرآن، وظل متمسكًا بموقفه رغم تعرضه للتعذيب.
2. موقف الإمام أحمد من الفلاسفة والفلسفة
رفض الفلسفة ومناهجها:
رفض الإمام أحمد الفلسفة كعلم يقوم على التأملات العقلية المجردة والمنطق الجدلي في القضايا العقدية.
ورأى أن الفلسفة مصدرًا لتشكيك المسلمين في عقائدهم، خاصة عندما تُعارض النصوص الشرعية.
وكان يرى أن الفلاسفة الذين خاضوا في قضايا العقيدة تأثروا بثقافات غير إسلامية (كالمنطق اليوناني)، مما أدى إلى ظهور الانحرافات الفكرية.
ولم يقتصر رفضه على الفلاسفة المسلمين (مثل المتأثرين بالمعتزلة)، بل شمل أيضًا التوجهات الفلسفية الدخيلة.
أقواله عن الفلسفة:
قال الإمام أحمد:
“ما ضل الناس بعد الكتاب والسنة إلا بالكلام”
هذا يشمل الكلام والفلسفة التي تبعد الناس عن الوحي.
كان يقول عن الفلاسفة والمتكلمين:
“أكثر ما يفسد الناس التأويل، ومن تأول فقد أخطأ السبيل”
3. قصص مرتبطة بموقف الإمام أحمد من الكلام والفلاسفة
قضية خلق القرآن:
في عهد الخليفة المأمون، اعتُقل الإمام أحمد بسبب رفضه القول بخلق القرآن الذي تبنته المعتزلة (المتأثرون بعلم الكلام).
صبر الإمام أحمد على التعذيب والاعتقال، وأصر على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، استنادًا إلى النصوص الشرعية.
في إحدى المحاكمات، قال للقضاة المتكلمين:
“هاتوا لي من كتاب الله أو سنة رسوله ما يدل على قولكم”
هذا يعكس رفضه الشديد للاعتماد على الفلسفة أو الكلام في قضايا العقيدة.
تحذيره من مجالسة المتكلمين:
كان الإمام أحمد يحذر طلابه من مجالسة المتكلمين أو قراءة كتبهم.
رُوي عنه أنه قال لأحد طلابه:
“إياك أن تجالس صاحب كلام، ولو كان يدافع عن السنة”
موقفه من بشر المريسي:
بشر المريسي كان من متكلمي المعتزلة الذين نشروا عقيدة خلق القرآن.
كان الإمام أحمد من أشد معارضيه، وحذر الناس من اتباعه لأنه خاض في الكلام وابتعد عن النصوص.
4. أسباب رفض الإمام أحمد للكلام والفلسفة
مخالفة النصوص الشرعية:
رأى أن الكلام والفلسفة يُدخلان التأويلات العقلية التي تخالف الوحي.
تعقيد العقيدة:
كان يرى أن العقيدة في الإسلام بسيطة، مبنية على الإيمان بالنصوص دون الحاجة للتأويل العقلي.
مصدر للفتنة:
اعتبر أن الكلام والفلسفة أديا إلى الانقسامات والفتن في الأمة الإسلامية.
5. موقف أهل السنة والجماعة من علم الكلام والفلسفة
أهل السنة والجماعة يتبعون منهج الإمام أحمد:
الاعتماد على النصوص الشرعية في العقيدة.
رفض التأويلات الكلامية والفلسفية التي تُخرج النصوص عن ظاهرها.
إثبات الصفات الإلهية كما وردت دون تعطيل أو تشبيه أو تأويل.
قاعدة الإمام أحمد:
العقيدة توقيفية، تُبنى على الكتاب والسنة، ولا مجال فيها للاجتهاد العقلي المجرد.
موقف الإمام مالك بن أنس من الكلام
كان الإمام مالك (93هـ – 179هـ) من أوائل الأئمة الذين حذروا من علم الكلام وأهله، خاصة أن هذا العلم بدأ في الظهور في عصره.
قال:
“كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد ﷺ بسبب جدله”
يشير إلى أن الجدال في الدين يُفسد العقيدة.
وقال:
“أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أردنا أن نرد كلام الله بكلامه؟”
ينتقد تقديم الجدال العقلي على النصوص الشرعية.
وقال أيضًا:
“لا تجوز شهادة أهل الأهواء وأهل البدع”
اعتبر أهل الكلام من أصحاب البدع الذين لا يُعتد بشهادتهم.
عندما سُئل عن الاستواء قال:
“الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة”
يظهر رفضه للخوض في مسائل العقيدة بما لا دليل عليه.
موقف الإمام الشافعي من الكلام
الإمام الشافعي (150هـ – 204هـ) كان من أشد الأئمة رفضًا لعلم الكلام، ورأى أن هذا العلم يُفسد العقيدة ويبعد الناس عن المنهج الصحيح.
قال:
“حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد، ويُطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام”.
موقف شديد التحذير من الاشتغال بالكلام، ورؤية أنه عقوبة لمن يترك النصوص الشرعية.
وقال أيضًا:
“ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو”
ينتقد الفلاسفة والمتكلمين الذين أعرضوا عن الوحي واللغة العربية واعتمدوا على الفكر اليوناني.
وقال:
“إنما الكلام في الدين محرم”
يشير إلى أن الخوض في العقائد بغير النصوص يُعد محرمًا.
وقال كذلك:
“لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد”
يعبر عن خطورة علم الكلام في إيقاع الناس في الشبهات والفتن.
موقف الإمام أبي حنيفة من الكلام
الإمام أبو حنيفة (80هـ – 150هـ) كان شديد التحذير من علم الكلام، رغم أنه عاش في بيئة شهدت بدايات هذا العلم.
قال:
“لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس طريق الكلام فيما لا ينفعهم”
يذم عمرو بن عبيد، أحد رؤوس المعتزلة، لإدخاله علم الكلام.
وقال:
“العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم”
يرى أن من يتجنب علم الكلام فهو على علم، ومن يخوض فيه فهو جاهل.
وقال:
“لا ينبغي لأحد أن ينظر في كتب الكلام”
موقف صريح بعدم جواز الاشتغال بهذا العلم.
وقال:
“أصحاب الكلام كلهم زنادقة”
يشير إلى أن غالب المتكلمين وقعوا في ضلال وزندقة بسبب اعتمادهم على العقل المجرد.
من هم الأشاعرة ولماذا يحتكرون وصف أهل السنة
سمى الأشاعرة أنفسهم أهل السنة والجماعة لأنهم اعتبروا أنهم يتبعون منهجًا وسطًا بين الفرق الإسلامية المختلفة، ورأوا أنهم يمثلون العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجمع بين النصوص الشرعية والعقل، بعيدًا عن الغلو والتقصير. هذا الاسم كان جزءًا من محاولتهم إثبات أنهم يلتزمون بما كان عليه النبي ﷺ وصحابته الكرام.
أسباب تسمية الأشاعرة أنفسهم “أهل السنة والجماعة”:
تأكيد الانتماء إلى منهج السنة:
الأشاعرة يعتقدون أنهم يثبتون العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، ويرفضون الانحرافات العقدية التي ظهرت عند الفرق الأخرى، مثل المعتزلة الذين بالغوا في استخدام العقل لنفي الصفات، أو المجسمة الذين وقعوا في التشبيه.
مواجهة المعتزلة والفرق الأخرى:
في فترة نشأة مذهب الأشاعرة، كان المعتزلة يسيطرون على الساحة الفكرية والسياسية، ويدعون أنهم يمثلون العقل والمنهج الصحيح. فجاء الأشاعرة ليواجهوا هذه الأفكار، واعتبروا أنفسهم المدافعين عن عقيدة أهل السنة.
إثبات الصفات مع التنزيه:
رأى الأشاعرة أنهم يثبتون صفات الله بطريقة “وسطية”، فيثبتونها دون تشبيه أو تمثيل كما يفعله المجسمة، ودون تعطيل أو نفي كما يفعله المعتزلة. ومن هنا قالوا إنهم يمثلون “الجماعة الوسط”.
ولكن جاءوا أيضا بالشطط، وكانوا مثل سلفه في الكلام.
الإمام الأشعري وتراجعه عن الاعتزال:
الإمام أبو الحسن الأشعري (ت 324هـ) كان معتزليًا (كما يقال، وإن البعض يثبت أنه لم يكن معتزليا)، لكنه تراجع عن مذهب الاعتزال بعد دراسة معمقة للكتاب والسنة، وأعلن التزامه بعقيدة أهل الحديث. هذا التحول جعلهم يُظهرون أنفسهم كممثلين لأهل السنة والجماعة.
التفاف الأمة حولهم في عصور معينة:
في بعض الفترات التاريخية، خاصة في ظل الدولة العباسية ثم الدول الإسلامية الكبرى كالأيوبيين والمماليك، اعتُبر مذهب الأشاعرة العقيدة الرسمية للدولة. هذا الدعم السياسي جعلهم يُقدمون أنفسهم كحماة للعقيدة الإسلامية في مواجهة الانحرافات.
مدى انطباق هذا الاسم عليهم:
أوجه الاتفاق مع أهل السنة والجماعة:
يتفق الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة في مسائل كبرى، مثل: إثبات الصفات الإلهية (لكن مع التأويل أو التفويض في بعضها).
رؤية الله يوم القيامة.
الإيمان بالقضاء والقدر.
أن القرآن كلام الله غير مخلوق (لكن بتفسير خاص).
أوجه الاختلاف عن أهل السنة والجماعة:
أهل السنة من السلف الصالح أثبتوا صفات الله كما جاءت في النصوص الشرعية من دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، بينما الأشاعرة مالوا إلى التأويل أو التفويض.
منهجهم العقلي جعلهم يُدخلون بعض القضايا الكلامية التي لم تكن عند السلف.
انتقاد العلماء لتسمية الأشاعرة أنفسهم بـ”أهل السنة والجماعة”:
كثير من علماء السلف وأتباعهم رأوا أن الأشاعرة لا يمثلون أهل السنة والجماعة لأن منهجهم فيه تأويل لصفات الله، وهو ما لم يكن عليه النبي ﷺ وصحابته.
قال الإمام ابن تيمية عن الأشاعرة: “يدَّعون أنهم أهل السنة والجماعة، والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم من يثبت الصفات لله على ما جاء به الكتاب والسنة”.
معنى “الكيف معلوم” عند الأشاعرة وتفسيرهم الخاص له:
يقول الأشاعرة إن “الكيف معلوم”، لكن بمعنى مختلف عن السلفية. فعند أهل السنة والجماعة (السلفية)، يقال: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول”، أي أن معنى الاستواء واضح في اللغة (وهو العلو والارتفاع)، لكن كيفية استواء الله لا نعلمها.
أما الأشاعرة، فإنهم يؤوّلون الكيف إلى معنى آخر، ويزعمون أن تفسيرهم هو الأقرب للصواب، وهذا يتضح في طريقة استدلالهم.
فيقولون إن الكيف معلوم، لأن:
الكيف عندهم هو “صفة الحدوث والتجسيم”، أي شيء مرتبط بالمخلوقات.
يقولون: “لو أثبتنا لله الكيفية، فهذا يعني أننا شبّهناه بالمخلوقات”، وهذا يستلزم التجسيم حسب رأيهم.
لذلك ينفون الكيف تمامًا، أي ينفون إثبات أي صفة على ظاهرها.
يستدلون بأن الله “ليس كمثله شيء”، فلا يحتاج إلى كيفية.
يقولون إن كل كيفية نتصورها هي كيفية مخلوقة، والله منزه عن المشابهة للمخلوقات.
يؤولون الصفات بناءً على هذا الفهم.
بما أن اليد، الاستواء، النزول، الغضب عندهم يستلزم الكيفية المخلوقة، فإنهم يؤولونها إلى معانٍ مجازية، مثل:
اليد = النعمة أو القدرة.
الاستواء = السيطرة.
النزول = لطف الله بعباده.
النتيجة:
عند السلف: الكيف مجهول، لكن الصفة ثابتة بلا تأويل.
عند الأشاعرة: الكيف معلوم بمعنى أن أي صفة ظاهرها الكيفية يجب تأويلها.
هذا هو الفرق الجوهري بين الفريقين في الاستدلال بهذه العبارة.
لماذا أخرج السلفيون الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة؟
الأشاعرة يدّعون أنهم أهل السنة والجماعة بناءً على أسباب ومبررات تاريخية وعقدية، بينما أتباع منهج السلف الصالح يرون أن الأشاعرة خالفوا منهج السلف في العقيدة، خاصة في باب الأسماء والصفات، مما يخرجهم من دائرة أهل السنة بالمعنى الخاص.
لماذا يزعم الأشاعرة انهم أهل السنة والجماعة؟
التاريخ وتأثير الأشاعرة:
سيطر الأشاعرة منذ تأسيس مذهبهم على يد أبي الحسن الأشعري (بعد رجوعه عن الاعتزال الذي نفاه بعض العلماء عنه)، على الساحة الفكرية في العالم الإسلامي، خاصة عبر المؤسسات العلمية كالجامعات الإسلامية الكبرى (الأزهر، الزيتونة).
وأصبح مذهبهم عقيدة رسمية لكثير من الدول الإسلامية مثل الدولة السلجوقية والعثمانية، مما أعطاهم حضورًا قويًا كمدافعين عن الإسلام في مواجهة المعتزلة والفلاسفة.
الانتصار على المعتزلة والجهمية:
كان للأشاعرة دور بارز في دحض عقائد المعتزلة والجهمية (مثل القول بخلق القرآن وإنكار الصفات)، ما جعل كثيرًا من المسلمين يرونهم حماة العقيدة الإسلامية.
اعتبروا أنفسهم أهل السنة لأنهم خالفوا المعتزلة والفلاسفة.
مفهوم “أهل السنة” الواسع:
الأشاعرة يرون أن “أهل السنة والجماعة” تشمل كل من خالف الفرق الضالة الكبرى كالمعتزلة والخوارج والشيعة، ولذلك يعتبرون أنفسهم ضمن هذا الإطار، بل يقودونه.
يستندون إلى أن عقيدتهم كانت العقيدة الغالبة بين العلماء المسلمين في القرون الوسطى.
التأويل:
يعتقد الأشاعرة أنهم قدموا تأويلاً يرفع التشبيه عن النصوص الشرعية (مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء)، وبالتالي يرون أنفسهم أكثر تمسكًا بالتوحيد ونفي التجسيم.
هل معهم حق في هذا الادعاء؟
من حيث التأثير التاريخي:
الأشاعرة كان لهم دور بارز في الدفاع عن الإسلام في عصور ازدهارهم، سواء في مواجهة المعتزلة أو الفلاسفة أو الملاحدة.
من حيث العقيدة:
لا، لأن الأشاعرة خالفوا منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات وغيرها:
السلف يثبتون الصفات كما وردت في النصوص دون تأويل، بينما الأشاعرة يميلون إلى التأويل.
السلف يرون أن التأويل تعطيل جزئي للصفات.
إذا كان أهل السنة والجماعة هم من يتمسكون بمنهج السلف الصالح، فإن الأشاعرة ابتعدوا عن هذا المنهج في مسائل الصفات.
من أسباب إخراج أتباع السلف الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
الخلاف في الصفات الإلهية:
السلفية (أتباع السلف الصالح كالصحابة وتابعيهم الذين لهم منهجهم في أمور العقيدة، وهو الأصل) يرون أن الأشاعرة خالفوا منهج السلف في إثبات الصفات.
فالسلف يثبتون الصفات على ظاهرها مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين.
أما الأشاعرة فيؤولون الصفات مثل الاستواء، اليد، الوجه، والنزول، مما يُعتبر تحريفًا للنصوص الشرعية عند السلف.
الاعتماد على علم الكلام:
الأشاعرة تأثروا بعلم الكلام في صياغة عقائدهم.
السلف يرون أن علم الكلام يؤدي إلى الانحراف والابتعاد عن منهج الكتاب والسنة، واستدلوا بقول الإمام الشافعي:
“حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل”.
التناقض في منهج الأشاعرة:
يرى السلفية أن الأشاعرة متناقضون:
يثبتون بعض الصفات مثل السمع والبصر على ظاهرها، ويؤولون غيرها مثل اليد والوجه.
هذا التناقض يُضعف حجتهم بأنهم أهل السنة.
الخلاف في أصول الإيمان:
الأشاعرة يقدمون العقل على النقل إذا ظنوا وجود تعارض بينهما.
أما السلفية فيرون أن هذا مخالف لمنهج السلف الذي يجعل النصوص الشرعية أصلًا لا يُعارض.
التأويل ونفي الحكمة:
الأشاعرة يؤولون صفات الله التي تتعلق بالحكمة مثل الغضب والرضا والمحبة، ويرون أن أفعال الله لا تُعلل بحكمة، مما يُعتبر نقصًا في كمال الله عند السلف.
هل الأشاعرة خارج دائرة أهل السنة والجماعة تمامًا؟
بالإطلاق العام:
لا يُخرجهم السلفيون من دائرة الإسلام أو أهل السنة بمعناها العام.
يُعتبر الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة مقارنة بالمعتزلة والجهمية والشيعة.
بالإطلاق الخاص:
السلفية يرون أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص:
أي المنهج الذي يقوم على فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح.
الخلاصة:
الأشاعرة يدعون أنهم أهل السنة والجماعة لأنهم خالفوا الفرق الكبرى الضالة، وأصبحوا العقيدة الغالبة في مراحل معينة.
السلفية يخرجون الأشاعرة من دائرة أهل السنة والجماعة الخاصة لأنهم خالفوا منهج السلف في العقيدة، خاصة في باب الصفات.
الحق مع السلفية في بيان المخالفات، لكن الأشاعرة لا يُكفرون ولا يُخرجون من دائرة الإسلام، بل يُعتبرون أقرب الفرق إلى منهج أهل السنة.
أيها أقرب إلى السلفية الخوارج أم الأشاعرة أم الصوفية؟
🔹 الترتيب من الأقرب إلى الأبعد عن السلفية:
1️⃣ الأشاعرة – أقربهم لأنهم يوافقون السلفية في أصول التوحيد والإيمان بالوحي، لكنهم يختلفون في تأويل الصفات.
2️⃣ الصوفية – عندهم طوائف متفاوتة، فالصوفية السنية أقرب، لكن غلاة الصوفية لديهم بدع خطيرة مثل وحدة الوجود (أقول: التصوف اليوم هو هذه الطرق التي نرى، وكلها فلسفية متبعة لإبن عربي بلا استثناء، لم يعد هنالك تصوف سني، وبدليل الواقع).
3️⃣ الخوارج – أبعدهم عن السلفية لأنهم يكفرون المسلمين بالذنوب ويخرجون على الحكام، وهذا خلاف منهج السلف.
الدليل: قال النبي ﷺ عن الخوارج: “يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية” (البخاري ومسلم)، بينما لم يذم الأشاعرة والصوفية بهذا الوصف الشديد، مما يدل على أن الخوارج أشد انحرافًا عن السلفية.
قول الأشاعرة أن أهل السنة يثبتون لله المكر؟
قول الأشاعرة أو غيرهم بأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله المكر يعتمد على سوء فهم أو تحريف لموقف أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية التي تذكر صفات أو أفعال الله، مثل المكر.
ما معنى المكر في النصوص الشرعية؟
في اللغة العربية:
المكر يعني التدبير الخفي للإيقاع بالخصم أو التغلب عليه.
قد يكون محمودًا إذا كان لدفع ظلم أو لتحقيق عدل، وقد يكون مذمومًا إذا كان بغرض الإفساد.
في النصوص الشرعية:
المكر المنسوب لله في القرآن لا يكون إلا بمعنى محمود، لأنه صادر عن الله الحكيم العادل.
مثل قوله تعالى:
“وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ” (الأنفال: 30).
هنا يُثبت الله عز وجل أنه يمكر بالمكرين ردًا على مكرهم، وهو تدبيره عليهم لإبطال كيدهم.
موقف أهل السنة من هذه الصفة:
إثبات الفعل وليس الصفة الذاتية:
أهل السنة لا يثبتون “المكر” كصفة ذاتية لله، بل يثبتونه كفعل من أفعال الله، أي أنه يفعل ذلك ردًا على مكر الظالمين والكافرين.
الله عز وجل لا يُوصف إلا بما يليق بجلاله، والمكر يُذكر في سياق رد المكر السيئ.
الأفعال المقيدة بالعدالة والحكمة:
مكر الله مقيد بما يليق بجلاله وحكمته وعدله. الله لا يمكر إلا بالكافرين والمجرمين، وهو مكر محمود لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
الرد على التحريف:
أهل السنة لا يشبهون الله بخلقه، فكما أن صفة “الحياة” و”السمع” لله تختلف عن حياة وسمع المخلوقين، فكذلك أفعال الله كالمكر.
المكر الإلهي ليس كالمكر المخلوق، لأنه مقترن بالحكمة والعدل.
ردود على من يقول إن أهل السنة يثبتون المكر مطلقًا:
النصوص تقيد المكر بسياق العدل:
قوله تعالى: “وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ” (النمل: 50).
مكر الله هنا جاء ردًا على مكر الكافرين، وليس مكرًا مستقلًا.
الله عز وجل وصف نفسه بأنه “خير الماكرين”، أي أن تدبيره أعلى وأعظم عدلًا.
ليس كل فعل يذكر في النصوص يُثبت كصفة ذاتية:
كما أن الله وصف نفسه بأنه “سريع الحساب”، و”شديد العقاب”، و”خير الماكرين”، لا يُفهم من ذلك أن هذه صفات ذاتية دائمة، بل هي أفعال تظهر عند تحقق أسبابها.
السياق يحكم المعنى:
أهل السنة ينظرون إلى السياق القرآني لفهم الأفعال الإلهية. مكر الله ورد دومًا في سياق الرد على مكر الكافرين، وليس كفعل مستقل.
التناقض في موقف الأشاعرة:
الأشاعرة أنفسهم يثبتون أفعالًا مثل الإرادة والخلق، فلماذا يعترضون على إثبات أهل السنة لأفعال أخرى مثل المكر بشرطها وضوابطها؟
اتهامهم السلفية بالتشبيه والتجسيم وغير ذلك
يوجه الأشاعرة، في خلافهم العقدي مع السلفية، بعض الانتقادات التي يراها السلفيون افتراءات أو سوء فهم لمنهجهم.
والرد السلفي على اتهامات الأشاعرة يتركز على التزامهم بالمنهج الشرعي الذي يعتمد على النصوص دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه. يرفضون الإفراط في استخدام العقل في مسائل الغيب، ويؤكدون على ضرورة الالتزام بمنهج السلف الصالح الذي يرونه السبيل الوحيد لتحقيق وحدة الأمة.
ما يقوله الأشاعرة: السلفية تثبت صفات الله كـ”اليد” و”الاستواء” على ظاهرها، مما يعني أنهم يُشبهون الله بخلقه.
رد السلفية:
السلف يثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله دون تشبيه أو تجسيم.
يستدلون بقوله تعالى: “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” (الشورى: 11)، مع إثبات الصفات في نفس الآية: “وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ”.
التشبيه مرفوض تمامًا في منهج السلف، ويؤكدون أن صفات الله تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين.
اتهام السلفية بالتناقض في تفويض الكيفية مع إثبات الظاهر:
قول الأشاعرة هو: السلفيون يقولون إنهم يثبتون الصفات “على الظاهر”، لكنهم يُفوضون الكيفية، وهذا تناقض.
رد السلفية:
المقصود بـ”ظاهر النص” عند السلف هو المعنى المفهوم لغويًا دون التعمق في الكيفية.
التفويض لا يعني تفويض المعنى، بل تفويض الكيفية فقط، مع إثبات المعنى الذي دل عليه النصوص.
مثال: معنى “الاستواء” في اللغة هو العلو والارتفاع، لكن كيف استوى الله؟ هذا ما لا يعلمه إلا هو.
اتهام السلفية بالتبديع والتكفير:
ما يقوله الأشاعرة: السلفية يُكفرون أو يُبدعون من يخالفهم في مسائل الصفات والعقيدة.
رد السلفية:
السلفية يفرقون بين التأويل المذموم والتأويل المعذور:
إذا كان التأويل ناتجًا عن اجتهاد خاطئ، فهم يعذرون صاحبه.
لكنهم يبدعون من يصر على مخالفة النصوص الصريحة مع العلم بها.
منهجهم: لا يكفرون أحدًا إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما هو مقرر في قواعد أهل السنة.
اتهام السلفية بالجمود والتخلف عن العقلانية:
ما يقوله الأشاعرة: السلفية يعتمدون على ظاهر النصوص، ويرفضون النظر العقلي في العقيدة، مما يؤدي إلى الجمود الفكري.
رد السلفية:
السلفية لا يرفضون العقل، بل يعتبرونه تابعًا للنقل. العقل الصحيح لا يتعارض مع النصوص الصريحة.
يقدمون النقل إذا وقع تعارض ظاهري مع العقل، لأن النصوص هي كلام الله الذي لا يأتيه الباطل.
منهجهم يوازن بين النقل والعقل، ويؤكدون أن الخلل ليس في النصوص، بل في فهم العقل.
اتهام السلفية بإنكار المذاهب الكلامية التي تخدم الإسلام:
ما يقوله الأشاعرة: السلفية يرفضون علم الكلام، رغم أنه وسيلة للدفاع عن العقيدة الإسلامية.
رد السلفية:
يرفض السلفية علم الكلام لأنه يؤدي إلى الخوض في الغيب بغير علم.
يدعون إلى الاعتماد على النصوص الشرعية في مسائل الغيب والعقيدة، بدلًا من الفلسفات العقلية التي قد تقود إلى الشك.
استدلوا بقول الإمام الشافعي:
“حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال، ويُطاف بهم في العشائر”.
اتهام السلفية بتقديم ظاهر النصوص على مقاصدها:
ما يقوله الأشاعرة: السلفية يلتزمون بظاهر النصوص دون النظر إلى مقاصدها العميقة.
رد السلفية:
السلفيون يلتزمون بظاهر النصوص الشرعية لأنها المصدر الأصلي للفهم.
لكنهم لا يهملون المقاصد، بل يرون أن المقاصد تُستخرج من النصوص نفسها دون تعارض مع ظاهرها.
منهجهم يعتمد على الجمع بين النصوص لفهم المعنى الشامل دون الاقتصار على النص الواحد.
اتهام السلفية بتقسيم الأمة وإحداث الفرقة:
ما يقوله الأشاعرة: السلفية يفرقون الأمة بتشددهم في العقيدة وانتقاد الفرق الأخرى.
رد السلفية:
السلفية يهدفون إلى العودة إلى منهج السلف الصالح الذي يوحد الأمة على العقيدة الصحيحة.
يعتقدون أن سبب الفرقة هو الابتداع في الدين، لا الالتزام بالمنهج الصحيح.
يؤكدون على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لتصحيح العقائد دون إثارة الفتن.
قول الحدادية في الأشاعرة:
الحدادية فرقة تكلمت في الأشاعرة، فزعموا أن المتكلم هم السلفية.
وهي فرقة متشددة من الخوارج، نشأت في العصر الحديث. تُنسب إلى محمود الحداد، وتتسم بالغلو والتشدد في التكفير والتبديع، خصوصًا في مسائل العقيدة والانتساب إلى السلفية.
ومن بين مواقفها التي يُعتقد خطأ أنها جزء من منهج السلفية، موقفها تجاه الأشاعرة.
ففي الوقت الذي تميز فيه السلفية بين التأصيل العلمي والنقد المنهجي تجاه الأشاعرة دون غلو، فإن الحدادية تبالغ في ذلك.
أبرز أقوال الحدادية في الأشاعرة وبيان موقف السلفية الحقيقي:
1. تكفير الأشاعرة:
موقف الحدادية:
يصرحون بتكفير الأشاعرة على الإطلاق، ويرونهم خارج دائرة الإسلام بسبب تأويلهم لبعض صفات الله وموقفهم من العقيدة.
موقف السلفية:
السلفية لا يكفرون الأشاعرة، بل يرون أنهم وقعوا في بدع تأويلية.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: “الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة والجهمية”.
والسلفية يفرقون بين المخطئ المجتهد الذي يؤول تأويلًا قريبًا أو بعيدًا، وبين من يتعمد تحريف الدين.
2. القول بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة:
موقف الحدادية:
ينفي الحدادية ينفون أي انتماء للأشاعرة إلى أهل السنة، ويصفونهم بالبدعة والضلال دون تفصيل أو إنصاف.
موقف السلفية:
السلفية يفرقون بين الانتماء العام والانتماء الخاص:
في الانتماء العام، يُعتبر الأشاعرة من أهل القبلة وأهل السنة بالمعنى الأوسع.
لكن في الانتماء الخاص، السلفية يرون أن الأشاعرة خالفوا منهج السلف في باب الصفات وبعض أصول العقيدة.
قال ابن القيم رحمه الله: “أهل السنة ثلاث فرق: أهل الحديث، والأشاعرة، والماتريدية”.
3. التشنيع غير المنضبط:
موقف الحدادية:
يتهم الحدادية الأشاعرة بتحريف الدين كله، ويشنعون عليهم في كل صغيرة وكبيرة دون تفصيل أو استثناء.
موقف السلفية:
السلفية ينتقدون منهج الأشاعرة في تأويل الصفات وتأثرهم بعلم الكلام، لكنهم ينقلون ذلك بعلم وعدل.
السلفية يقرون أن الأشاعرة خدموا الإسلام في بعض الجوانب مثل الرد على المعتزلة والجهمية.
الإمام الذهبي رحمه الله قال عن بعض علماء الأشاعرة: “وكان من كبار علماء الإسلام، على ما في عقيدته من تأويل”.
4. الهجوم على علماء الأمة الذين كانوا أشاعرة:
موقف الحدادية:
يُبدعون أو يُكفرون علماء الأمة الذين كانوا على مذهب الأشاعرة، مثل الإمام النووي، ابن حجر العسقلاني، والرازي.
موقف السلفية:
السلفية يميزون بين خطأ العالم وبين منزلته العامة في الإسلام.
الإمام ابن تيمية قال عن النووي: “من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة”.
يرى السلفية أن هؤلاء العلماء وقعوا في أخطاء تأويلية لكنها لا تخرجهم عن دائرة أهل السنة.
5. إنكار جهود الأشاعرة في نصرة الإسلام:
موقف الحدادية:
ينكرون تمامًا أي دور إيجابي للأشاعرة في الدفاع عن الإسلام، ويرون أن منهجهم لا يستحق الاعتراف.
موقف السلفية:
السلفية يعترفون بجهود الأشاعرة في الرد على المعتزلة والجهمية والملاحدة.
يرون أن خطأهم في العقيدة لا يُلغي خدماتهم للإسلام، ويُقيمون كل جانب بناءً على أصوله.
علماء كانوا أشاعرة
من القدامى:
قائمة بأبرز العلماء الأشاعرة من الزمن القديم (في مرتبة النووي وابن حجر دون ذكر الأخيرين مع أنهما على ذلك المذهب)
فيما يلي أسماء علماء بارزين كانوا على المذهب الأشعري، ممن كانوا في مرتبة النووي وابن حجر من حيث الشهرة والعلم، مع الإشارة إلى أهم أعمالهم:
1️⃣ الإمام أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ)
أحد كبار المتكلمين الأشاعرة، ولقّب بـ “سيف السنة” بسبب مناظراته القوية.
من أشهر كتبه: “التمهيد” و”إعجاز القرآن”.
دافع عن الأشعرية بقوة ضد المعتزلة والفلاسفة.
2️⃣ الإمام أبو المعالي الجويني (ت 478هـ) – إمام الحرمين
كان شيخ الغزالي، وأحد منظّري العقيدة الأشعرية.
من أهم كتبه: “الإرشاد إلى قواطع الأدلة” و”البرهان في أصول الفقه”.
كان يميل إلى الكلام الفلسفي، لكنه في آخر حياته راجع بعض آرائه الكلامية.
3️⃣ الإمام الغزالي (ت 505هـ) – حجة الإسلام
من أشهر الأشاعرة في التاريخ، وكان يجمع بين الفقه والتصوف والفلسفة.
من كتبه الشهيرة: “إحياء علوم الدين”، “تهافت الفلاسفة”، “الاقتصاد في الاعتقاد”.
انتقد الفلاسفة بشدة، لكنه تراجع عن بعض الجدل الكلامي في أواخر حياته.
4️⃣ الإمام الفخر الرازي (ت 606هـ)
من أكبر الفلاسفة والمتكلمين الأشاعرة، وكان له تأثير كبير على المذهب.
أشهر كتبه: “المحصل في علم الكلام”، “أساس التقديس”، “التفسير الكبير”.
كان بارعًا في المناظرات، لكنه أبدى ندمه على علم الكلام في آخر حياته.
(أقول: لاحظ ندم بعضهم على خوضه في الكلام ولو بالمناظرة به! إذ لا خير في ذلك)
5️⃣ الإمام العز بن عبد السلام (ت 660هـ) – سلطان العلماء
فقيه شافعي وأشعري بارز، كان معروفًا بشجاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من أهم كتبه: “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، “شجرة المعارف والأحوال”.
كان يميل إلى التصوف العملي، لكنه لم يكن من غلاة الصوفية.
6️⃣ الإمام البيضاوي (ت 685هـ)
من كبار المفسرين الأشاعرة.
من أشهر كتبه: “أنوار التنزيل وأسرار التأويل” (المعروف بتفسير البيضاوي).
كان يُعتمد على تفسيره في المدارس الأشعرية.
7️⃣ الإمام السبكي (ت 771هـ) – تاج الدين السبكي
فقيه شافعي وأشعري، وابن الإمام تقي الدين السبكي.
من أهم كتبه: “جمع الجوامع”، “طبقات الشافعية الكبرى”.
دافع بقوة عن مذهب الأشاعرة، وهاجم ابن تيمية وأهل الحديث.
8️⃣ الإمام السيوطي (ت 911هـ)
من كبار العلماء الموسوعيين، وكان أشعري العقيدة.
من أشهر كتبه: “الإتقان في علوم القرآن”، “تدريب الراوي”، “الدر المنثور”.
لم يكن متعمقًا في علم الكلام، لكنه تبنى العقيدة الأشعرية.
📜 🔹 خلاصة:
📌 أشهر علماء الأشاعرة القدامى غير النووي وابن حجر هم:
1️⃣ أبو بكر الباقلاني – رائد علم الكلام الأشعري.
2️⃣ الجويني – إمام الحرمين ومنظّر الأشعرية.
3️⃣ الغزالي – جمع بين الفقه والتصوف والكلام.
4️⃣ الفخر الرازي – فيلسوف الأشاعرة وأشهر المتكلمين.
5️⃣ العز بن عبد السلام – فقيه شافعي قوي الشخصية.
6️⃣ البيضاوي – صاحب التفسير المشهور.
7️⃣ تاج الدين السبكي – مدافع عن الأشاعرة ضد أهل الحديث.
8️⃣ السيوطي – عالم موسوعي تبنّى الأشعرية.
📌 كل هؤلاء كانوا أشاعرة بارزين، ولهم تأثير قوي في الفكر الإسلامي الأشعري (لاحظ أن بعضهم ندم على خوضه في علم الكلام، ذلك مهم ويدل على وجود الخلل في المنهج، وإلا ما كانوا ندموا عليه وأعلنوا البراءة منه, وهذه رسالة قوية إلى الأغبياء الذين هم قطعا دونهم عقلا، ويخوضون اليوم في علم الكلام، لو كان فيه خير ما تركه أولئك الكبار).
من المعاصرين:
*الشيخ محمد عبده (1849-1905) – فتي الديار المصرية وأحد رواد النهضة والإصلاح في العالم الإسلامي.
*الشيخ مصطفى المراغي (1881-1945) – شيخ الأزهر الشريف، عُرف بإسهاماته في تطوير مناهج الأزهر.
*الشيخ محمود شلتوت (1893-1963) – شيخ الأزهر، سعى للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
*الشيخ محمد متولي الشعراوي (1911-1998) – داعية ومفسر للقرآن الكريم، له دروس ومحاضرات مؤثرة.
*الشيخ محمد الغزالي (1917-1996) – داعية ومفكر إسلامي، له العديد من المؤلفات في الفكر الإسلامي.
*الشيخ عبد الحليم محمود (1910-1978) – شيخ الأزهر، جمع بين التصوف والعلم الشرعي.
*الشيخ يوسف القرضاوي (1926-2022) – عالم وداعية إسلامي، له إسهامات في الفقه والفكر الإسلامي.
*الشيخ علي جمعة (مواليد 1952) – فتي الديار المصرية السابق، عُرف بجهوده في نشر الفكر الوسطي.
*الشيخ أحمد الطيب (مواليد 1946) – شيخ الأزهر الحالي، يُعتبر من أبرز العلماء الأشاعرة في العصر الحديث.
*الشيخ سعيد فودة (مواليد 1967) – عالم في العقيدة الإسلامية، له مؤلفات في الدفاع عن العقيدة الأشعرية.
هل كان النووي وابن حجر أشعريين؟
أقوال الإمام النووي التي تثبت أنه كان أشعريًا مع المصادر:
الإمام النووي (ت 676هـ) كان من علماء الشافعية، وكان يتبع العقيدة الأشعرية، كما يظهر في شروحه للحديث وكتبه في العقيدة. وفيما يلي بعض أقواله التي تؤكد ذلك:
إثباته لعقيدة الأشاعرة صراحةً:
قال في مقدمة شرحه لصحيح مسلم:
“مذهب أهل الحق إثبات صفات الله تعالى، من العلم، والقدرة، والإرادة، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، وأنها صفات أزلية قائمة بذاته تعالى، وليست بجوارح، ولا أعضاء، ولا أجزاء، وليست مخلوقة، ولا حادثة، بل هي صفات أزلية” [المنهاج في شرح صحيح مسلم، ج1، ص 120]
هذا التعريف مطابق تمامًا لعقيدة الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبعة فقط، وينفون الصفات الخبرية كاليد والاستواء.
تأويله للاستواء بأنه “الاستيلاء” على طريقة الأشاعرة:
قال في شرح حديث النزول في صحيح مسلم:
“هذا الحديث من أحاديث الصفات، وقد سبق مرات بيان تأويلها، وأنها تُمر كما جاءت، ويؤمن بها، وأن مذهب السلف والإجماع منع الخوض في تفسيرها، مع اعتقاد أن ظواهرها غير مرادة، فيجب تأويلها على ما يليق بالله تعالى” [شرح صحيح مسلم، ج6، ص 36]
نفي ظاهر الصفات الخبرية مثل النزول والاستواء، ويقول إن ظواهرها غير مرادة، مما يوافق مذهب الأشاعرة في التأويل.
عبارة “ويجب تأويلها” صريحة في أنه كان على مذهب التأويل الكلامي للأشاعرة.
تأويله لحديث “ينزل الله إلى السماء الدنيا”:
قال في شرح حديث النزول:
“هذا الحديث من أحاديث الصفات، وقد سبق القول في مثل ذلك مرارًا، وأن منها ما يؤول، ومنها ما يفوض. وأما من أولّه، فحمله على لطف الله بعباده، واستجابته دعاءهم، ونحوه، وليس في ذلك ما يقتضي نزولًا وانتقالًا وتحولًا، فإن ذلك من صفات الأجسام” [شرح صحيح مسلم، ج6، ص 37]
نفي النزول الحقيقي، ويؤول الحديث على أنه لطف الله وليس نزولًا حقيقيًا، وهو عين مذهب الأشاعرة.
عبارة “ليس في ذلك ما يقتضي انتقالًا وتحولًا” هي رد على أهل الحديث الذين يثبتون النزول الحقيقي.
تفسيره لـ “اليد” بأنها النعمة أو القدرة:
قال في شرحه لحديث “يد الله ملأى لا تغيضها نفقة”: “هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه تأويلان: أحدهما، إجراء لفظه على ما جاء، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن الجارحة. والثاني، أنه يُتأوَّل على القدرة، أو النعمة” [شرح صحيح مسلم، ج6، ص 39]
الأشاعرة يؤولون “يد الله” بأنها القدرة أو النعمة بدل إثباتها كصفة حقيقية كما هو عند أهل الحديث والسلف.
تصريح النووي نفسه بأنه على مذهب الأشاعرة:
قال في كتابه “شرح المهذب”:
“والمختار الذي عليه المحققون من أئمتنا أن مذهب أهل الحق هو مذهب أهل السنة، وهم الأشاعرة، لأنهم أعلم الناس بالتوحيد” [شرح المهذب، ج1، ص 96]
هذا تصريح صريح جدًا بأن النووي كان على مذهب الأشاعرة، حيث يقول بوضوح أن مذهب الحق هو مذهب الأشاعرة.
وصفه للأشاعرة بأنهم “أهل السنة والجماعة”
قال في “المجموع شرح المهذب”:
“أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة وأتباعهم، الذين تمسكوا بالنقل والعقل معًا” [المجموع شرح المهذب، ج1، ص 97]
أكد أن الأشاعرة هم الفرقة الناجية وأهل السنة، مما يدل على أنه كان أشعري العقيدة بالكامل.
الإمام ابن حجر العسقلاني:
الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) كان من أشهر المحدثين والشراح، وكان يتبع المذهب الأشعري في العقيدة، خاصة في مسائل الصفات الإلهية والتأويل، كما يظهر في شروحه للحديث وكتبه في العقيدة. وفيما يلي بعض أقواله التي تثبت ذلك:
تصريحه بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة:
قال في كتابه “فتح الباري شرح صحيح البخاري”:
“وأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، وهما الطائفتان الناجيتان من الفرق الضالة” [فتح الباري، ج1، ص 293]
اعتبر أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وهو تصريح صريح بانتمائه إليهم.
تأويله لحديث النزول وفق مذهب الأشاعرة:
قال في شرح حديث “ينزل الله إلى السماء الدنيا”:
“اختلف العلماء في معنى النزول على أقوال؛ فمنهم من حمله على ظاهره وهم المشبهة، ومنهم من أنكره أصلًا وهم المعتزلة، ومنهم من أوّله على وجه يليق بجلال الله وهم جمهور أهل السنة، والأولى تفويض معناه إلى الله” [فتح الباري، ج3، ص 30]
نفي إثبات النزول الحقيقي، ويقول إنه يؤول بما يليق بجلال الله، وهو منهج الأشاعرة في تأويل الصفات.
كما أنه يذكر أن أهل السنة هم الذين يفوضون المعنى، وهو مفهوم أشعري معروف.
تأويله للاستواء على العرش بأنه “الاستيلاء”:
قال في شرح قوله تعالى: {الرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ}:
“الاستواء ليس بمعنى الجلوس أو الاستقرار، بل هو بمعنى الاستيلاء والقهر، وهو مذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم” [فتح الباري، ج13، ص 406]
تفسير الاستواء بـ “الاستيلاء” هو أحد تأويلات الأشاعرة.
أهل الحديث والسلفية يثبتون الاستواء بلا كيف، بينما الأشاعرة يؤولونه بالاستيلاء والسيطرة.
تأويله لحديث “يد الله ملأى لا تغيضها نفقة”:
قال: “واليد في هذا الحديث يؤولها أهل السنة على معنى القدرة أو النعمة، ولا يجوز حملها على الجارحة” [فتح الباري، ج13، ص 395]
يثبت أهل الحديث أن لله يدًا تليق بجلاله دون تشبيه، بينما الأشاعرة يؤولون اليد إلى النعمة أو القدرة، وهو ما فعله ابن حجر هنا.
نفيه أن يكون الله في جهة، وفق منهج الأشاعرة:
قال في شرح قوله ﷺ: “أين الله؟”:
“أحاديث الجهة يجب تأويلها بما يليق بجلال الله، لأنه تعالى منزه عن الحدود والجهات” [فتح الباري، ج6، ص 158]
الأشاعرة ينفون أن يكون الله في جهة، بينما أهل الحديث يثبتون أن الله فوق العرش بلا كيف.
تأكيده على التنزيه المطلق هو من مفاهيم الأشاعرة.
وصفه للأشاعرة بأنهم أهل الحق:
قال:
“الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين حملوا لواء العقيدة الصحيحة في مواجهة الفرق الضالة” [فتح الباري، ج1، ص 293]
صرح بوضوح أن الأشاعرة هم الفرقة الناجية، مما يدل على تبنيه لمذهبهم في العقيدة.
علماء أشاعرة تراجعوا عن مذهبهم وتابوا في آخر أيامهم:
يوجد علماء أشاعرة بارزين تراجعوا عن بعض آرائهم الكلامية وعادوا إلى منهج أهل السنة والسلف الصالح في إثبات الصفات لله كما جاءت في النصوص، بدون تأويل ولا تعطيل.
ومن أبرزهم:
1️. الإمام الجويني (ت 478هـ) – إمام الحرمين:
كان الجويني من كبار علماء الأشاعرة في عصره، وكان أحد منظّري علم الكلام.
لكنه في آخر حياته أدرك ضعف علم الكلام في إثبات العقيدة، واعترف بأنه لم يجد اليقين في الجدل الكلامي.
قال “لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه. واليوم إن لم يتداركني ربي برحمته، فأنا أموت على عقيدة أمي!”.
فرجع إلى عقيدة السلف البسيطة التي كان عليها أهل الحديث والتفسير.
له قول مشهور: “يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ، ما اشتغلت به” (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج18، ص 470)
2️. الإمام الغزالي (ت 505هـ):
كان من أكبر المتكلمين الأشاعرة، لكنه مر بأزمة شكّ كبرى جعلته يعتزل الناس.
ترك بغداد وسافر إلى الشام بحثًا عن اليقين، وبدأ يميل إلى التصوف.
في كتابه “إلجام العوام عن علم الكلام”، قال بوضوح:
“الخوض في علم الكلام يورث الحيرة والشك”
فلم يترك الأشعرية تمامًا، لكنه ابتعد عن الفلسفة وعلم الكلام، وفضّل البساطة الإيمانية.
اعترف بأن الكلام لا يجلب اليقين، بل الفطرة السليمة.
قول مشهور له:
“وجدتُ طريق التصوف هو الحق، فنبذتُ علم الكلام وراء ظهري”
هل رجع الإمام الغزالي عن علم الكلام والتصوف؟
الإجابة باختصار:
لم يترك التصوف نهائيًا، لكنه ابتعد عن علم الكلام الفلسفي في آخر حياته، وأصبح يميل إلى عقيدة السلف في البساطة الإيمانية، بدلاً من التعقيدات الفلسفية.
لم يعد إلى الفقه المجرد أو العقيدة السلفية بشكل كامل، لكنه أدرك ضعف الفلسفة وعلم الكلام في تحقيق اليقين، واتجه إلى الإيمان القلبي المباشر.
أقواله المشهورة عند التوبة:
“لقد علمتُ يقينًا أن الفلاسفة في ضلال، وأن طريق النجاة هو طريق القرآن” (المُنقذ من الضلال، ص 130)
“أكثر الناس شكًّا عند الموت هم علماء الكلام” (إحياء علوم الدين، ج1، ص 30)
إذن كان من أكبر المتكلمين والفلاسفة في عصره، لكنه في آخر حياته أدرك أن علم الكلام لا يجلب اليقين، وأن أفضل طريقة للإيمان هي منهج القرآن والتصديق المباشر.
كتب كتابه الشهير “تهافت الفلاسفة”، الذي هاجم فيه الفلاسفة أمثال ابن سينا والفارابي، وبيّن تناقضهم في مسائل العقيدة.
في كتابه “إلجام العوام عن علم الكلام”، نصح الناس بعدم الخوض في الجدل الكلامي، وقال إنه يضر الإيمان أكثر مما ينفعه.
النتيجة:
نعم، الغزالي ترك الجدل الفلسفي والكلامي، وأصبح أقرب إلى إيمان العوام والبسطاء. لكنه لم يصبح سلفيًا بالكامل، بل ظل متأثرًا ببعض أفكار الأشاعرة.
هل تراجع الغزالي عن التصوف؟
لم يترك التصوف نهائيًا، لكنه أصبح أكثر اعتدالًا، وترك الطرق الصوفية المنحرفة.
بعد رحلته الطويلة في البحث عن الحقيقة، قال:
“لم أجد الطمأنينة إلا في التصوف الحقيقي، لا في التصوف الفاسد” (المُنقذ من الضلال، ص 134)
ماذا يعني “التصوف الحقيقي” عند الغزالي؟
الغزالي لم يكن صوفيًا على الطريقة الفلسفية مثل ابن عربي، لكنه كان يؤمن بالزهد والتقرب إلى الله.
كان يرفض المبالغات الصوفية في الاتحاد والحلول، لكنه كان يميل إلى تزكية النفس والبُعد عن الدنيا.
النتيجة:
لم يترك التصوف، لكنه نقد الطرق الصوفية المنحرفة التي تعتمد على الشعوذة والدجل.
أصبح أقرب إلى التصوف العملي القائم على الزهد والعبادة، وليس التصوف النظري الذي يعتمد على الفلسفة.
ماذا كانت عقيدته في آخر حياته؟
في آخر حياته، اعتزل الغزالي التدريس والجدل الكلامي، وعاش في خراسان يدرس القرآن والسنة.
آخر كتاباته كانت أكثر ميلًا إلى العقيدة السلفية البسيطة، لكنه لم يصرّح بترك الأشعرية نهائيًا.
قال في رسالته الأخيرة:
“عليكم بالقرآن والسنة، وإياكم والكلام، فإن الكلام ظلمات، والسنة نور” (إلجام العوام عن علم الكلام، ص 98)
دلالة هذه الأقوال:
أصبح أقرب إلى منهج أهل الحديث والسلف في إثبات العقيدة بدون فلسفة. لكنه لم يُصرّح بترك التصوف، بل فضّل التصوف المعتدل البعيد عن الغلو.
3️. الإمام الفخر الرازي (ت 606هـ) – متكلم الأشاعرة الأكبر:
كان من أعظم المتكلمين الأشاعرة، وكان بارعًا في الجدل والمناظرات.
لكنه في آخر حياته ندم على انشغاله بعلم الكلام، واعترف أن أقوى حجة في العقيدة هي القرآن، وليس الفلسفة.
قال:
“نهاية إقدام العقول عقالُ … وغاية سعي العالمين ضلالُ”
أدرك الفخر الرازي أن التعمق في الفلسفة والكلام لا يجلب الإيمان الحقيقي. واقترب من منهج السلف الصالح، لكنه لم يُصرّح بترك الأشعرية كليًا.
له قول مشهور:
“لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي غليلًا، وأقرب الطرق طريقة القرآن” (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج21، ص 501)
4️. القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ) – المدافع عن الأشعرية:
كان من أقوى المدافعين عن الأشعرية، لكنه في آخر حياته تراجع عن بعض التأويلات الكلامية.
قال: “أهل الحديث على حق، فإياكم والكلام فإنه يورث الشك”
لكنه لم يعلن ترك الأشعرية بالكامل، لكنه اقترب من منهج أهل الحديث.
مثل غيره من المتكلمين، أدرك في النهاية أن البساطة العقدية أقوى من الجدل الكلامي.
قول مشهور له:
“رجعتُ إلى قول السلف، وأسلمتُ من علم الكلام”
خلاصة:
كثير من علماء الأشاعرة بدأوا حياتهم في الفلسفة وعلم الكلام، لكنهم أدركوا في النهاية أن اليقين في عقيدة السلف البسيطة.
اعترافهم بأن علم الكلام لا يروي العطش الروحي هو أكبر دليل على ضعف المنهج الأشعري المتكلم.
أهل السنة والجماعة اعتمدوا على الإيمان الفطري والتمسك بالقرآن والسنة، وهو ما عاد إليه كثير من الأشاعرة في النهاية.
علاقة الأشاعرة والمعتزلة
موقف المعتزلة من الصفات الإلهية (ما عدا الكلام):
أنكر المعتزلة جميع الصفات الذاتية لله مثل العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، وقالوا إن الله لا يُوصف بصفات زائدة عن ذاته، بل هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، وليس بصفة قائمة بذاته.
أقوال المعتزلة في الصفات:
الجبائي (أبو علي وأبو هاشم): قال إن الله ليس له صفات زائدة على الذات، لأن ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء.
القاضي عبد الجبار (ت 415هـ): قال في كتابه “شرح الأصول الخمسة”: “إن الله عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وحي بلا حياة.”
أي أن هذه الصفات ليست قائمة بالله، بل هي مجرد تعبير عن أفعاله.
الزمخشري (ت 538هـ): قال في تفسيره للكثير من الآيات إن الله ليس له صفات قائمة بذاته، بل هي مجرد تعبير عن أفعاله.
لماذا أنكروا الصفات؟
لأنهم يرون أن إثبات الصفات يقتضي وجود ذوات قديمة متعددة، وهو عندهم شرك.
قالوا إن الصفات إما أن تكون عين الذات، أو غيرها، وإن كانت غيرها، فهذا يعني أن هناك أشياء قديمة مع الله، وهو عندهم باطل.
موقف الأشاعرة من الصفات (ومقارنته بالمعتزلة):
خالف الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات، لكنهم تأثروا بهم في بعض الجوانب.
ما أثبته الأشاعرة من الصفات:
أثبتوا سبع صفات فقط لله، وهي:
الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، والكلام (لكنهم قالوا إنه نفسي لا بحروف وأصوات).
قالوا إن هذه الصفات قائمة بذات الله أزليًا، وليست مجرد أفعال، على عكس المعتزلة.
ما نفاه الأشاعرة من الصفات (وتأثرهم بالمعتزلة):
الصفات الفعلية: مثل الغضب، الرضا، المحبة، الاستواء، النزول، الضحك، اليد، الوجه.
قالوا إن هذه الصفات تؤول إلى معانٍ أخرى، ولا تثبت على ظاهرها، وهذا تأثر واضح بالمعتزلة.
فمثلاً:
قالوا إن الاستواء يعني السيطرة وليس العلو.
إن الغضب والرضا هما إرادة الثواب أو العقاب وليس لهما حقيقة.
أبرز العلماء الذين كانوا من المعتزلة:
المعتزلة كان لهم تأثير واسع في الفكر الإسلامي، واشتهر منهم عدد من العلماء الذين تبنوا منهجهم في نفي الصفات والاعتماد على العقل في تقرير العقائد. ومن أبرز هؤلاء:
1. واصل بن عطاء (ت 131هـ)
هو المؤسس الحقيقي لفرقة المعتزلة بعد أن اعتزل مجلس الحسن البصري، بسبب قوله إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين.
وضع الأسس الأولى للمذهب المعتزلي، وخاصة في نفي الصفات وقضية القدر.
قال مقولته الشهيرة حول مرتكب الكبيرة، وهي: “هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر.”
هذه المقولة أصبحت من أصول المعتزلة الخمسة، وهي السبب في تسميتهم بـ”المعتزلة” لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصري بعد قوله هذا.
2. عمرو بن عبيد (ت 144هـ)
أحد التلاميذ المقربين من واصل بن عطاء.
اشتهر بتشدده في القدر، وكان يرى أن الإنسان مسؤول عن أفعاله بالكامل، وهو من رموز المعتزلة في عصره.
3. أبو الهذيل العلاف (ت 235هـ)
من أوائل منظّري المعتزلة، وكان متأثرًا بالفلسفة اليونانية.
قال إن الله لا يمكن أن يُرى في الآخرة، ونفى جميع الصفات الذاتية لله.
أول من قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس الأصوات، مما أثّر لاحقًا على الأشاعرة في نظريتهم عن الكلام النفسي.
يُنسب إليه قوله: “الله لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها، بل يعلمها عند وقوعها.”
هذه المقولة تسببت في جدل كبير لأنها تعني نفي علم الله المسبق بكل شيء، وهو من الأصول الفاسدة التي أنكرها أهل السنة بشدة.
4. النظّام (ت 231هـ)
من أكثر المعتزلة تطرفًا في الاعتماد على العقل.
قال إن القرآن ليس معجزًا بذاته، بل بالإعجاز الصرفي.
كان يرى أن الله لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها، مما جعله أقرب إلى الفكر الفلسفي المجرد.
يُقال إنه كان شاعرًا وفيلسوفًا معتزليًا، وله بيت شعر يعكس ميل المعتزلة للعقلانية:
العقل قبل النقل حكمُ ذوي النهى … فانظر بعقلك ما تقول وتفعلُ
هذا البيت يعكس فكرة تقديم العقل على النقل التي كانت سائدة عندهم.
5. الجاحظ (ت 255هـ)
أديب ومفكر، لكنّه كان من أتباع المعتزلة، وخاصة في مسألة نفي الصفات.
نشر الفكر المعتزلي عبر مؤلفاته، مثل “الحيوان” و”البخلاء”، وكان يميل إلى الفكر العقلاني بقوة.
كان الجاحظ، وهو من أعلام المعتزلة، معروفًا بقبح شكله لكنه اشتهر ببلاغته وذكائه الحاد.
6. القاضي عبد الجبار (ت 415هـ)
أبرز متأخري المعتزلة، وكان من أشهر القضاة في الدولة البويهية.
ألف كتاب “شرح الأصول الخمسة”، الذي يعتبر المصدر الأهم للعقيدة المعتزلية.
قال إن الله عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، مما يعني أنه ينفي الصفات ويجعلها مجرد تعبيرات لفظية.
وهو من كبار علماء المعتزلة في عهد البويهيين، وكان صاحب نفوذ قوي في بغداد.
يُحكى أنه كان يرد على أهل السنة قائلًا: “إن قولنا هو قول العقل، ومن خالفنا فقد خالف العقل!”
وهذا يعكس استعلاء المعتزلة على مخالفيهم واعتبارهم أنهم وحدهم أهل الفكر الصحيح.
7. الزمخشري (ت 538هـ)
اشتهر بتفسيره “الكشاف”، وهو تفسير اعتزالي يؤوّل الصفات ويؤكد على حرية الإرادة البشرية.
كان من دعاة مذهب المعتزلة في العصر العباسي المتأخر.
ومن أشهر قصص المعتزلة إجبارهم الناس على القول بخلق القرآن، وخاصة في عهد المأمون والمعتصم.
وعندما رفض الإمام أحمد بن حنبل هذا القول، تعرض للضرب والتعذيب، لكنه صمد حتى تراجع الخلفاء عن دعم المعتزلة.
هذه القصة كانت نهاية النفوذ السياسي للمعتزلة، وأصبحت علامة على تعصبهم رغم ادعائهم أنهم أهل العقل والمنطق.
أبرز الدول الإسلامية التي تأثرت بالمعتزلة:
المعتزلة لم يكونوا مجرد فرقة فكرية، بل كان لهم نفوذ سياسي في بعض الفترات، خاصة خلال حكم بعض الدول الإسلامية، ومنها:
1. الدولة العباسية (خصوصًا في عهد المأمون والمعتصم والواثق)
في عهد الخليفة المأمون (198-218هـ)، تبنى فكر المعتزلة رسميًا، وفرض محنة خلق القرآن، التي تعرّض فيها العلماء للاضطهاد، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل.
استمر دعم المعتزلة في عهد المعتصم (218-227هـ) والواثق (227-232هـ)، حيث استمر فرض مذهبهم بالقوة.
في عهد المتوكل (232هـ)، تم إلغاء دعم المعتزلة رسميًا، وأعيدت العقيدة السنية.
2. الدولة البويهية (334-447هـ)
كانت هذه الدولة تدعم الفِكر المعتزلي والأشعري على حساب الفِكر السلفي.
القاضي عبد الجبار كان قاضي القضاة في الدولة، ونشر الفكر الاعتزالي بقوة.
ساد الاعتزال بين العلماء والقضاة، لكن بعد سقوط البويهيين، عاد النفوذ السني.
3. الدولة الفاطمية (909-1171م)
الفاطميون كانوا إسماعيلية، لكنهم تأثروا أيضًا ببعض الأفكار المعتزلية، خاصة في تفسيرهم للقرآن.
نشروا الفكر العقلي بقوة، خصوصًا في عهد الحاكم بأمر الله.
4. بعض سلاطين الأندلس والمغرب
في بعض الفترات، كان للفكر المعتزلي تأثير محدود في الأندلس والمغرب، خصوصًا عبر الزمخشري وأتباعه، لكن لم يكن للمعتزلة سلطة سياسية مباشرة كما في بغداد.
هل هناك علماء معاصرون اشتهروا بالاعتزال بين 1900م والآن؟
نعم، هناك عدد من المفكرين والعلماء الذين تأثروا بالمذهب الاعتزالي أو تبنوا بعض أفكاره في العصر الحديث، خاصة في مصر وبعض الدول العربية، رغم أن المعتزلة كمذهب لم تعد لهم فرقة رسمية كما كان الحال في العصور الإسلامية المبكرة.
أشهر الشخصيات التي تأثرت بالاعتزال أو تبنته بين 1900م والآن:
1. محمد عبده (1849-1905م) – مصر
كان من رواد الإصلاح الديني في الأزهر، وتأثر بفكر المعتزلة في تقديم العقل على النقل.
دعا إلى تفسير النصوص الدينية وفقًا للعقل الحديث، وهو ما يشبه طريقة المعتزلة.
قال بتأويل بعض الصفات الإلهية، مما جعله قريبًا من المنهج الاعتزالي.
2. أحمد أمين (1886-1954م) – مصر
ألف كتاب “ضحى الإسلام”، وفيه أبدى إعجابه بالمعتزلة وأفكارهم العقلانية.
كان يرى أن المعتزلة قدموا فهمًا عقلانيًا للإسلام يناسب العصر الحديث.
3️.محمود شلتوت (1893-1963م) – مصر
شيخ الأزهر، كان متأثرًا بفكر محمد عبده، ودعا إلى التفسير العقلاني للنصوص.
بعض مواقفه تتشابه مع الفكر المعتزلي في اعتماد التأويل والتأكيد على دور العقل.
4️. طه حسين (1889-1973م) – مصر
كان متأثرًا بالفكر الفلسفي الغربي وبالمعتزلة من ناحية تقديم العقل على النقل.
كتابه “في الشعر الجاهلي” فيه نقد للنصوص الدينية والتاريخية، بطريقة مشابهة لنهج المعتزلة في التشكيك والتفسير العقلي.
5️. حسن حنفي (1935-2021م) – مصر
أحد رواد اليسار الإسلامي، وكان يدعو إلى عقلنة الدين والتفسير العقلاني.
اعتبر أن المعتزلة نموذج يمكن البناء عليه لتطوير الفكر الإسلامي الحديث.
تأثر بالفكر الغربي الفلسفي، مثل هيغل والماركسية، مما جعله قريبًا من المعتزلة في فكرة رفض التقليد الديني.
6️. محمد أركون (1928-2010م) – الجزائر
كان من دعاة إعادة قراءة الإسلام بمنهج نقدي عقلاني.
تبنى منهجًا قريبًا من المعتزلة في التشكيك في الروايات التقليدية وإخضاعها للنقد التاريخي.
7️. نصر حامد أبو زيد (1943-2010م) – مصر
قال إن القرآن منتج ثقافي يجب تحليله بطريقة تاريخية، وهو منهج قريب من المعتزلة في نفي الصفات.
انتقد فهم النصوص الدينية حرفيًا، ودعا إلى قراءتها بطريقة تأويلية.
اعتُبر خارجًا عن الإسلام من قبل الأزهر بسبب آرائه الجريئة، واضطر إلى مغادرة مصر.
8️. محمد شحرور (1938-2019م) – سوريا
اشتهر بتفسيره التجديدي للقرآن، وكان متأثرًا بالمنهج العقلاني.
دعا إلى قراءة جديدة للأحكام الشرعية بعيدًا عن التقليد الفقهي.
بعض أفكاره تتشابه مع المعتزلة في رفض الحديث الظني والتفسير المجازي للنصوص.
مدى اقتراب كلام الأشعرية عن القرآن من قول المعتزلة بأنه مخلوق؟
1. موقف المعتزلة من القرآن:
المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، وهذا بناءً على أصلهم العقدي الذي ينفي قيام الصفات بذات الله. وكان استدلالهم قائمًا على النقاط التالية:
نفيهم للصفات الذاتية: قالوا إن الله لا تقوم به الصفات الحقيقية، واعتبروا أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، وهو عندهم شرك. فأنكروا الصفات الذاتية لله، مثل العلم والقدرة والكلام، بحجة أن إثباتها يعني وجود ذوات قديمة متعددة إلى جانب ذات الله. أي أنهم اعتبروا كل صفة كيانا مستقلا قائما بنفسه، مما يؤدي – وفق منطقهم – إلى تعدد “القدماء”، أي وجود أكثر من شيء أزلي غير مخلوق، وهذا عندهم شرك في التوحيد. لذلك قالوا إن الله يُعرف بذاته فقط، وأن الصفات ليست سوى أسماء لأفعاله، فمثلاً “العليم” يعني “الذي يخلق العلم في المخلوقات”، وليس أن له صفة العلم. في المقابل.
أما أهل السنة والجماعة فيرون أن هذه مغالطة، لأن الصفات قائمة بذات الله وليست كيانات مستقلة، بل هي صفات لازمة لوجوده، لا تنفصل عنه ولا تقتضي تعدد القدماء.
والكلام عند المعتزلة محدث ومخلوق: يرون أن الكلام صفة حادثة، وبالتالي لا يمكن أن يكون قائمًا بذات الله، بل هو مخلوق مثل سائر المخلوقات.
أي أنهم يرون أن الكلام صفة حادثة، أي أنه لم يكن موجودًا أزلًا مع الله، بل وجد في وقت معين. وبما أنهم ينفون قيام الصفات بذات الله، فإنهم لا يعتقدون أن الله يتكلم حقيقةً، بل يقولون إن الكلام مخلوق، أي أن الله خلقه في مخلوقاته كاللوح المحفوظ أو جبريل، ثم بلّغه للأنبياء. وبناءً على هذا، قالوا إن القرآن مخلوق، لأنه – في نظرهم – لا يمكن أن يكون كلام الله قائمًا بذاته، وإلا لكان قديمًا مثل الله، وهذا عندهم يؤدي إلى تعدد القدماء، وهو ما يرفضونه.
لكن هذا القول يخالف النصوص الشرعية التي تثبت أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، كما قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} (التوبة: 6)، مما يدل على أن الله يتكلم حقيقةً وليس مجرد مخلوق يُبلَّغ عنه.
وقد أدى هذا القول إلى محنة خلق القرآن التي فرضها المعتزلة على العلماء في زمن المأمون، والتي صمد فيها الإمام أحمد بن حنبل.
2. موقف الأشاعرة من القرآن
الأشاعرة رفضوا القول بأن القرآن مخلوق، لكنهم قدّموا تفسيرًا آخر، وهو أن القرآن كلام الله النفسي وليس حروفًا وأصواتًا. وقد بنوا موقفهم على التالي:
التمييز بين نوعين من الكلام:
الكلام النفسي: وهو المعنى القائم بذات الله، وهو أزلي غير مخلوق.
الكلام اللفظي: وهو المسموع من جبريل أو المكتوب في المصاحف، وهذا تعبير عن الكلام النفسي.
إذن خالفوا المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق، لكنهم لم يثبتوا أن الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة كما هو مذهب أهل السنة. وبدلًا من ذلك، قالوا إن القرآن هو كلام الله النفسي، أي أنه معنى قائم في ذات الله أزلًا، لا يتغير ولا يتجدد، وليس بحروف ولا أصوات.
ووفقًا لهذا الرأي، فإن ما نسمعه من تلاوة القرآن أو ما هو مكتوب في المصاحف ليس كلام الله نفسه، بل هو تعبير عنه أو ترجمة له إلى لغة البشر. أي أن جبريل لم يسمع كلام الله بحروفه وأصواته، وإنما فهم المعنى القائم بذات الله، ثم عبر عنه بألفاظ عربية.
لكن هذا القول يخالف ما جاء في النصوص الشرعية، حيث وصف الله القرآن بأنه كلامه المسموع المتلو بالحروف والأصوات، كما في قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} (التوبة: 6)، مما يدل على أن القرآن كلام لفظي مسموع وليس مجرد معنى نفسي قائم في الذات.
عدم جعل الحروف والأصوات قديمة:
قال الأشاعرة إن الحروف التي نقرؤها في القرآن محدثة مخلوقة، لكنها ليست عين كلام الله، بل تعبير عنه.
استدلالهم على ذلك: قالوا إن الكلام لا يكون إلا بمعنى، والمعنى لا يحتاج إلى حروف وأصوات، ولذلك يكون كلام الله أزليًا في نفسه، لكن الحروف المكتوبة أو الملفوظة هي فقط وسيلة للتعبير عنه.
إذن:
الأشاعرة يعتقدون أن كلام الله أزلي قائم بذاته، لكنه ليس حروفًا ولا أصواتًا، بل معنى نفسي. ولذلك، قالوا إن الحروف التي نقرؤها في القرآن أو نسمعها عند تلاوته ليست عين كلام الله الحقيقي، بل هي تعبير عنه أو ترجمة له بلغة البشر.
بمعنى آخر، عندما نقرأ القرآن أو نسمعه، فنحن لا نسمع كلام الله نفسه كما هو في ذاته، بل نسمع تعبيرًا مخلوقًا عن كلامه الأزلي، سواء كان ذلك بواسطة جبريل أو النبي ﷺ أو ما هو مكتوب في المصاحف.
وهذا يختلف عن قول أهل السنة، الذين يؤمنون بأن القرآن كلام الله لفظًا ومعنى، تكلم الله به بحروفه وأصواته، وسمعه جبريل من الله مباشرةً، ثم بلّغه للنبي ﷺ. وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} (التوبة: 6)، مما يدل على أن كلام الله يُسمع ويُتلى، وليس مجرد معنى نفسي يُعبَّر عنه.
3. موقف أهل السنة والجماعة (السلفية) من هذه الأقوال:
أهل السنة والجماعة يرفضون كلا القولين، قول المعتزلة وقول الأشاعرة، ويعتقدون أن:
القرآن كلام الله حقيقي بحروفه ومعناه، غير مخلوق.
الله تكلم به حقيقةً بصوت وحروف، سمعه جبريل، ونقله إلى النبي ﷺ.
الكلام صفة ذاتية وفعلية، فهو قائم بالله أزلًا وأبديًا، لكنه أيضًا يتكلم متى شاء وكيف شاء.
أدلتهم على ذلك:
قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} (التوبة: 6)، وهذا يدل على أن كلام الله مسموع.
حديث النبي ﷺ: “إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان” (رواه البخاري)، وهو صريح في أن كلام الله يُسمع.
كيف يزعم الاشاعرة أنهم من تصدوا للمعتزلة وهم مثلهم فلاسفة؟
لأنهم تكلموا في الصفات، وتكلموا مثل المعتزلة في صفة الكلام وخلق القرآن؟
هل الأشاعرة تصدّوا للمعتزلة حقًا، أم أنهم تأثروا بهم؟
1. ادعاء الأشاعرة أنهم تصدّوا للمعتزلة:
الأشاعرة يعتبرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة، ويزعمون أنهم تصدّوا لفكر المعتزلة، خاصةً في مسألة نفي الصفات، حيث خالفوهم وأثبتوا بعض الصفات، لكنهم تأثروا بالمعتزلة في تأويل الصفات الخبرية والفعلية، مثل الاستواء، النزول، الغضب، الرضا، فجعلوها معانٍ مجازية وليست صفات حقيقية.
إذن، الأشاعرة لم يردّوا على المعتزلة ردًا سلفيًا خالصًا، وإنما اختاروا طريقًا وسطًا، وهذا يجعلهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات كما جاءت في النصوص.
ويجعلهم أيضا من أهل الكلام في الصفات.
2. الأشاعرة والمعتزلة في مسألة “الكلام” و”خلق القرآن”
في قضية الكلام الإلهي وخلق القرآن، تأثر الأشاعرة بالمعتزلة بشكل كبير، رغم أنهم لم يصلوا إلى نفس النتيجة النهائية.
أوجه التشابه بين الأشاعرة والمعتزلة:
كلاهما أنكر أن يكون كلام الله بحروف وأصوات:
المعتزلة: قالوا إن الكلام مخلوق ولا يقوم بالله.
الأشاعرة: قالوا إن الكلام معنى نفسي قائم بالله، والحروف التي نسمعها مخلوقة.
كلاهما ميّز بين “كلام الله الذاتي” و”القرآن المسموع”:
المعتزلة قالوا: “القرآن كلام الله لكنه مخلوق”.
الأشاعرة قالوا: “القرآن تعبير عن كلام الله النفسي، والحروف مخلوقة”.
إذن، الفرق بينهما ليس جوهريًا، بل في التعبير، لأن كلاهما لا يعتقد أن الله تكلم بحروف وصوت يسمع.
3. هل الأشاعرة فلاسفة مثل المعتزلة؟
نعم، الأشاعرة تأثروا بالفلسفة الكلامية مثل المعتزلة، لأنهم استخدموا علم الكلام والمنطق اليوناني في تقرير العقائد، بدلًا من الاقتصار على النصوص الشرعية كما فعل السلف الصالح.
أوجه التشابه الفلسفي بين الأشاعرة والمعتزلة:
الاعتماد على العقل في مسائل الصفات:
المعتزلة جعلوا العقل هو المرجع الأساسي ونفوا كل ما رأوه غير معقول.
الأشاعرة جعلوا العقل حاكمًا على النقل عند التعارض، وإن كانوا لا ينكرون النصوص كليًا مثل المعتزلة.
التأويل الفلسفي للصفات الخبرية:
كلاهما لجأ إلى التأويل المجازي للصفات مثل اليد والاستواء.
كلاهما قال إن الله لا يتكلم بصوت وحروف.
النظرية الفلسفية في أفعال الله:
المعتزلة قالوا بوجوب فعل الأصلح على الله.
الأشاعرة قالوا إن الله يفعل بلا حكمة وفق نظريتهم في الجبر.
إذن، الأشاعرة لم يكونوا مجرد خصوم للمعتزلة، بل كانوا فرعًا منهم مع تعديلات.
4. هل الأشاعرة ردوا على المعتزلة فعلًا؟ أم نافسوهم؟
الأشاعرة لم يردّوا على المعتزلة ردًا كاملاً مثل ردود السلف الصالح، بل ناقشوهم في بعض المسائل، وفي النهاية اقتربوا منهم في النتائج، خاصةً في الصفات والكلام.
في الحقيقة، كان الأشاعرة في بعض العصور امتدادًا للمعتزلة بطريقة أخرى، لكنهم حاولوا أن يكونوا أقل تطرفًا منهم كي لا يخرجوا تمامًا عن نطاق “أهل السنة والجماعة”.
النتيجة: الأشاعرة لم يكونوا خصومًا حقيقيين للمعتزلة، بل كانوا أقرب إلى كونهم نسخة معدلة عنهم، ولهذا وقعوا في بعض الإشكالات نفسها، خاصةً في تأويل الصفات ومسألة الكلام الإلهي.
كلام الأشعرية في الصفات وغيرها
الصفات التي أنكرها الأشاعرة:
ينكر الأشاعرة أو يؤولون صفات الله الذاتية والفعلية، مثل العلو، الوجه، اليدين، العينين، الكلام، المحبة، النزول، الضحك، الغضب، والرضا.
أما السلفية فيردون بإثبات هذه الصفات كما وردت في النصوص الشرعية دون تعطيل أو تشبيه، مؤكدين أن هذه الصفات تليق بجلال الله ولا تشبه صفات المخلوقين.
والأشاعرة ينكرونها بناءً على فهمهم الظاهر للنصوص الشرعية.
في تقديم العقل على النقل:
موقف الأشاعرة هو: تقديم العقل على ظاهر النصوص إذا ظنوا بعقولهم التعارض.
الرد المفحم:
النقل مقدم لأنه وحي معصوم:
قال الله تعالى: “وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ” (النجم: 3-4).
كذلك العقل تابع للنقل:
فالعقل محدود، والنصوص تُكمل نقصه. وتقديم العقل يُفضي إلى تحريف النصوص الشرعية.
ويوجد تناقض بين العقلانيين: فإذا كان العقل هو المرجع، فلماذا يختلف المتكلمون أنفسهم في قضايا أساسية؟ هذا يدل على أن العقل وحده غير كافٍ.
تأويل الأشاعرة صفات الله كاليد، الوجه، والاستواء بمعانٍ مجازية مثل القدرة أو السيطرة. يتضمن تناقضا:
فنقول لماذا تُؤولون اليد والوجه وتثبتون صفات كالسمع والبصر؟
إذا كان التأويل منهجًا، فلماذا لا تُؤولون الصفات كلها؟ هذا تناقض واضح.
في نفي الحكمة والتعليل:
موقف الأشاعرة: أفعال الله لا تُعلل بحكمة.
الرد المفحم:
النصوص تثبت الحكمة:
قوله تعالى: “وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا” (ص: 27) يثبت أن أفعال الله لها حكمة.
نفي الحكمة يُفضي إلى العبث:
إذا كانت أفعال الله بلا حكمة، فهذا يُناقض وصفه بالحكمة في القرآن.
الفطرة تُثبت الحكمة:
كل إنسان عاقل يدرك أن الحكمة وراء الفعل تدل على كمال الفاعل، ونفيها نقص.
فيما يلي أبرز الصفات الواضحة التي ينكرها الأشاعرة، مع أمثلة من النصوص الشرعية وردود السلفية على إنكارها:
1. إنكارهم لصفة العلو (الاستواء على العرش)
موقف الأشاعرة:
ينكرون العلو المكاني ويقولون إن الله موجود “بلا جهة”، ويؤولون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء أو السيطرة.
من النصوص الشرعية التي تثبت العلو:
قوله تعالى: “الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى” (طه: 5). وقوله تعالى: “إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ” (فاطر: 10).
رد السلفية:
العلو والاستواء صفتان مثبتتان لله على ما يليق بجلاله دون تشبيه أو تمثيل.
الاستيلاء يفهم منه نقص سابق، وهذا لا يليق بالله.
النصوص الشرعية صريحة:
قوله تعالى: “الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى” (طه: 5) يثبت الاستواء صراحة. تفسيره بـ“الاستيلاء” يُفضي إلى نقص سابق، وهذا لا يليق بالله (العرش لم يكن خارجا عن سيطرته ليستولي عليه).
منهج السلف:
الإمام مالك قال عن الاستواء: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة”.
معنى “معلوم” في قول مالك: “الاستواء معلوم”
1. السياق والمقصد من قول مالك: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة”.
هذا القول جاء في سياق الحديث عن صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن الكريم، مثل صفة الاستواء على العرش. كان الإمام مالك يُؤكد أن صفات الله تُؤخذ كما وردت في الكتاب والسنة، مع نفي التمثيل والتكييف.
2. تفسير “معلوم”:
“معلوم” هنا تعني أن المعنى اللغوي أو الأساسي للصفة واضح ومفهوم بحسب الظاهر، وهو أن الله تعالى استوى على العرش كما قال في القرآن: “الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ” (طه: 5).
المعنى معلوم يعني أن هذه الصفة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير مجازي، فهي مفهومة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى.
أما “الكيف مجهول”، فيعني أننا لا نعلم كيفية الاستواء (كيفيته) لأنه لا يُقاس على خلق الله.
شرح وتوضيح المعنى:
معنى “معلوم” في هذه المقولة هو: أن الله تعالى استوى على العرش كما ورد في الآية الكريمة، لكننا لا نعلم كيف حدث هذا الاستواء.
و“المعنى” الذي يقصده الإمام مالك هو الاستواء الحقيقي الذي ورد في القرآن دون الخوض في تفاصيل أو كيفية هذا الاستواء.
أراد الإمام مالك توضيح أن الصفة ثابتة في النصوص، وعلينا الإيمان بها كما وردت دون التفسير الغامض فقوله “معلوم” هو إقرار بوجود صفة حقيقية لله تعالى، حيث يُفهم المعنى الظاهر دون الحاجة للبحث عن تفصيلات لا نعلمها، مثل كيفية الاستواء.
ف“الكيف مجهول”، هي دعوة لعدم الدخول في مسائل التشبيه أو التكييف، حيث لا يمكننا أن نتصور كيفيته أو نشبهه بأي شيء مخلوق.
و“السؤال عنه بدعة” تشير إلى أنه لا يجوز الخوض في كيفية الصفة أو محاولة التفسير بما يتعارض مع النصوص.
الخلاصة هي أن الاستواء مفهوم وواضح كما ورد في القرآن والسنة. وأنه يجب الإيمان به دون التوسع في كيفية وقوعه أو محاولة تمثيله (أي إخراج العقول من هذا، فهو لا يعنيها، سواء حاولت تنزيهه سبحانه أو أيدت الثابت. عليك الرد برد مالك وفقط، أي بدون فلسفة).
ذكر الله سبحانه وتعالى استوائه على عرشه في 7 مواضع من القرآن:
يقال للأشعري وأمثاله: قد وصف الله نفسه بالاستواء على عرشه في سبع مواضع من القرآن، فهل أنت أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى؟”.
قال الله تعالى: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} (آل عمران: 105)
فالرد على الشبهات يكون بالبينات الواضحة وليس بالتعقيد الفلسفي.
ذُكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وهي:
1️⃣ سورة الأعراف (54):
{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۢ بِأَمْرِهِ}.
2️⃣ سورة يونس (3):
{إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِ}.
3️⃣ سورة الرعد (2):
{ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى}.
4️⃣ سورة طه (5):
{ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ}.
5️⃣ سورة الفرقان (59):
{ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًۭا}.
6️⃣ سورة السجدة (4):
{ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا شَفِيعٍۢ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ}.
7️⃣ سورة الحديد (4):
{هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}.
📌 🔹 النتيجة:
الاستواء على العرش ثابت في سبع آيات من القرآن الكريم، وكلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى.
أهل السنة يثبتونه بلا تأويل ولا تشبيه، كما قال الإمام مالك: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول”.
أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الاستواء هو الجلوس، ولا يصفون الله بأنه جسم:
الاستواء عندهم معلوم المعنى (وهو العلو والارتفاع)، والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك.
فلا يثبتون لله الجلوس؛ لأن ذلك لم يرد في النصوص الصحيحة.
ولا يصفون الله بأنه جسم، لأن التجسيم محدث، وغير وارد في القرآن والسنة، ولأن الله ليس كمثله شيء (الشورى: 11).
النتيجة: أهل السنة يثبتون الاستواء بلا تأويل ولا تمثيل، وينفون الجلوس والتجسيم (وخصومهم الأشاعرة تصوروا بما أوصلتهم إليه عقولهم أن أهل السنة مجسمة. يعني ردوا عليهم بذلك تفلسفا فقط بعد أن أفحموهم بالبساطة السنية التي لا تستخدم علم الكلام الذي يقدسون).
مصادر غير شات جيبيتي:
ساق اللالكائي بإسناده إلى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي قال: “سمعت محمد ابن الحسن يقول: “اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء”. (انظر أصول اعتقاد أهل السنة 2/417، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4/4، 5، ومختصر العلو للذهبي ص159).
ومراد السلف هنا في نهيهم عن تفسير صفات الله هو عدم الخوض والبحث عن معرفة كنهها وحقيقتها، فإن هذا لا علم لأحد به، أما الإيمان بها وبمعناها وبما دلت عليه فهم يعرفونه، ومن هنا قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: “الاستواء معلوم والكيف مجهول…” (انظر: أصول اعتقاد أهل السنة 2/379).
وتمامها {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
ولقد اتفق أهل السنة والجماعة على معنى هذه الآية، وآمنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحداً من خلقه.
قال أبو حنيفة: “لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية”. (انظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص15) .
وقال الطحاوي: “ولا شيء مثله”. وعلق شارحه على ذلك بقوله: “اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله…”. (شرح الطحاوي ص38) .
ولقد ضل فريقان في هذا الباب أحدهما: الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. الذين شبهوا الله بخلقه، وأطلق عليهم الأشعري اسم المجسمة، وذكر أن أقوالهم بلغت ست عشرة مقالة. (انظر: مقالات الإسلاميين 1/281، والفرق بين الفرق ص216، ولوامع الأنوار البهية 1/91) .
ولقد سار في هذا الطريق أيضاً مقاتل بن سليمان وهشام بن الحكم. قال ابن رجب: “وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقول، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره”. (انظر فضل علم السلف على الخلف ص8) .
والفريق الثاني: الجهمية النافون للأسماء والصفات ومن شاكلهم كالمعتزلة، وذلك لما قام في قلوبهم من رجس التشبيه.
قال الإمام أحمد عنهم: “إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى: {ليس كمثله شيء} ما تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش لا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان…”. (انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص 28) .
وكلا الفريقين السابقين في بعد عن الصواب، أما سلف هذه الأمة فقالوا: “إن الله موصوف بصفات الجلال والكمال، كما وصف نفسه، وأنه مع اتصافه بهذه الصفات لا يشبه شيئاً من المخلوقات”، فكانوا في ذلك وسطاً بين المشبهة والمعطلة. (انظر: في ذلك شرح الطحاوية ص39، 58، 466، 447، وشرح العقيدة الواسطية ص49) .
وفي مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة معلقا على كلام للمعتزلة:
“انظر – رعاك الله – خفاء مسالك المبتدعة، في صرف الحق وأَن لهم عبارات، وأَلفاظاً، وحيلاً، يُقََلِّبون فيها الأُمور” (محذرا من الفلسفة والكلام المزوق).
الإمام أبو زيد القيرواني (ت 386هـ)، توفي قبل ظهور دولة المرابطين بحوالي 60 عامًا، لكنه أثّر في الفقه المالكي الذي تبنته دولتهم لاحقًا.
كان من علماء العهد العبيدي الفاطمي في المغرب، لكنه لم يكن على مذهبهم، بل كان سلفيًا في العقيدة ومالكيًا في الفقه.
لم يكن الأشعرية قد انتشروا في بلاد المغرب في عصره، وكان السائد هو منهج السلف.
وفي كتابه “الرسالة” لم يذكر تأويل الصفات، بل أثبتها كما وردت في النصوص، وهذا يخالف منهج الأشاعرة.
كان على مذهب الإمام مالك، ومعلوم أن مذهب مالك في الصفات هو الإثبات بلا تأويل.
قال في “الرسالة” (باب الاعتقاد): “وأن الله على عرشه كما قال: {ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ}”.
فأثبت الاستواء كما جاء في القرآن، ولم يقل إنه استيلاء أو مجاز كما يقول الأشاعرة.
ولم ينقل عنه تأويل الصفات، وهذا دليل على أنه كان على منهج السلف لا على مذهب الأشاعرة.
من مصادر خارج الذكاء الصناعي
ما يؤمن به أهل السنة:
جاء في “الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار” للعمراني:
“ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول وغيره إيمانا مجملا ولا نفسرها بل نُمرُّها كما جاءت، وأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة بعيون رؤوسهم ولا يراه الكفار، وأن الله خلق أفعال العباد وأقوالهم ونياتهم وخطراتهم في الطاعة والمعصية، وأنه أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية وأراد منهم وقوع ما هم عليه، وأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، وأن عذاب القبر حق، وأن مسألة منكر ونكير في القبر حق. وأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء في يقظة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اطلع في الجنة والنار وبلغ سدرة المنتهى، فأوحى الله إليه ما أوحى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فمنهم من قال: رآه بعيني رأسه، وقالت عائشة رضي الله عنها: “ما رآه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه”. وأن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في أهل الكبائر من أمته، وكذلك لغيره من العلماء والصالحين، وأن الله سبحانه يغفر الكبائر من الذنوب غير الشرك لمن يشاء من عباده، وله أن يعذب على الصغائر، وأن معرفة الله وجبت بالشرع لا بالعقل، وأن بعث الله للرسل وتكليف الله للخلق أمر جائز غير واجب عليه، وأن الله سبحانه بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونسخ بشريعته جميع الشرائع وختم به النبوة فلا نبي بعده، وأن مراتب الخلافة في الصحابة رضي الله عنهم كما وقعت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وأن الخلافة ثلاثون سنة ثم بعده ملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة، ووردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل آحاد الصحابة وجماعتهم لا تتنافى، فيفضل الصحابة رضي الله عنهم بما ورد فيهم من الأخبار، وبما جرى لهم من السابقة، ونمسك عن ذكر ما جرى بينهم، ونحمل ذلك على أمور دينية كانوا بها متأولين ويغفر الله لهم ما وقع بينهم فيها من القتل بسابقتهم. ولا ننكر كرامات الأولياء. ونصب الإمام في وقتنا حق واجب فمن وجدت فيه شروط الإمامة وظهرت شوكته وقوي أمره وجبت طاعته ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل، سواء كانت إمامته بعقد أهل الحل والعقد له، أو باستخلاف إمام حق قبله له أو بغلبته بالسيف”.
الأصول:
جاء في “الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار” للعمراني:
“والأصول التي بنى أصحاب الحديث عليها أقوالهم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الكتاب: هو قول الله تعالى وهو القرآن… فأصحاب الحديث هم القائلون بأن القرآن كلام الله حقيقة، وهم المستدلون به على أقوالهم ومذاهبهم وعليه عمدة أمرهم وأساس بنائهم. فأما المعتزلة والقدرية فلا يصح تعلقهم ولا استدلالهم به لأنهم يقولون: إن الله لا يجوز أن يكون متكلما، ولا قائلا، وإن هذا القرآن المتلو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق لله يقدرون على الإتيان بمثله…الأصل الثاني الذي بنى عليه أصحاب الحديث أقوالهم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله العباد بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}. قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}. وقوله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}. وقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
وأولى الناس بالعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وإقراره هم الصحابة جميعهم رضي الله عنهم، شهد الله ورسوله لهم بالنزاهة مما رمتهم به القدرية وغيرهم من أهل البدع وطعنوا عليهم به. وقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} الآية. وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم”. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر”. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة، قالوا: يا رسول الله من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي”. ولو علم الله قرنا أطهر وأطيب منهم لبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن بلغتهم وعلموا سبب نزوله ومواضع النزول، وأخذوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بينهم وبينه، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من علماء التابعين وأخذوا منهم كأخذ كف عن كف، كابن المسيب وعروة بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين. ثم نقل التابعون ما أخذوه عن الصحابة إلى من بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم”. وأيد الله الدين بأئمة جمعوا السنن ودونوها وصنفوا كتباً في أسماء الرواة وأنسابهم ومساكنهم ونخّلوا عن طرائقهم في الدين، فميزوا العدل عن غير العدل عناية منهم في الدين لا للانتقاض بل لميزوا النقل الصحيح عن غيره فكان أصحاب الحديث هم أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”. وقال عبد الله بن عمر: “من خالف السنة كفر”. قال ابن عباس في قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ} قال: “أهل السنة والجماعة”، و{فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} قال: “هم أهل البدع والضلالة”.
وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: “لزوم السنة والجماعة”. فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث مبتدع زائغ لا يستحق أن يصغى إليه.
فالمعتزلة والقدرية عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل لوجوه:
أحدها: أنهم يطعنون على الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وينسبونهم إلى الظلم لعلي رضي الله عنه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم جميعاً والأخذ عنهم… وهم الواسطة بيننا وبين نبينا ولم يتصل إلينا القرآن الذي هو أصل السنة إلا منهم.
والثالث: أن السنة فرع للقرآن لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبتت بثبوت معجزته، ولا معجزة له فينا باقية إلى يوم القيامة إلا القرآن الذي هو كلام الله…
الأصل الثالث: الإجماع. وهو إجماع علماء العصر على حكم الحادثة. وهو حجة في الأحكام الشرعية، وقال بعض المعتزلة: الإجماع ليس بحجة. والدليل عليه قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}. وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ}. وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تجتمع أمتي على خطأ”. والأدلة في ذلك كثيرة. فالقائلون بهذا الأصل هم أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار. كلما ذهب قرن أيد الله الذين بعدهم بقوم على صفتهم بذلك…
الأصل الرابع: هو القياس. وهو أدلة العقل. وهو أصل من أصول الأدلة عندنا في العقليات والسمعيات، ولكنه غير موجب بنفسه بل الموجب والمحسن والمقبح هو الشرع.
والعقل آلة للتمييز بين الصحيح والباطل، ولم يكلف الله المعرفة به إلا من له عقل ولكنه تابع للشرع، ولم يلتزم القدرية بشيء من الأصول الأربعة إلا بالعقل إلا أنهم غلوا فيه وجعلوه عمدة أمرهم وأساس بنيانهم، وركبوا فيه طرقا وعرة، وجعلوا ما ورد في الكتاب والسنة تابعا لما في عقولهم فإن وافقهم وإلا رموا به. وهذا خلاف قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} وغير ذلك من الآيات.
الصفاتية:
جاء في “الملل والنحل” للشهرستاني: “الفصل الثالث: الصفاتية
اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون الله تعالى صفاته أزلية من العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة والسمع، والبصر، والكلام، والجلال، والإكرام، والجود، والإنعام، والعزة، والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحدا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين، والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع، فنسميها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون، سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة. فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر؛ فافترقوا فرقتين: فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك.
ومنهم من توقف في التأويل، وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبه شيء منها، وقطعنا بذلك؛ إلا أن لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 1 ومثل قوله: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} 2 ومثل قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ} 3 إلى غير ذلك. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقينا.
الأشاعرة أولوا بعض الصفات:
قال أبو حامد الغزالي في كتابه قواعد العقائد (وكان أشعريا متأثرا بالكلام):
“وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى الإقتصاد وفتحوا بَاب التَّأْوِيل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِصِفَات الله سُبْحَانَهُ وَتركُوا مَا يتَعَلَّق بِالآخِرَة على ظواهرها وَمنعُوا التَّأْوِيل فِيهِ وهم الأشعرية. وَزَاد الْمُعْتَزلَة عَلَيْهِم حَتَّى أولُوا من صِفَاته تَعَالَى الرُّؤْيَة وَأولُوا كَونه سميعا بَصيرًا وَأولُوا الْمِعْرَاج وَزَعَمُوا أَنه لم يكن بالجسد وَأولُوا عَذَاب الْقَبْر وَالْمِيزَان والصراط وَجُمْلَة من أَحْكَام الْآخِرَة وَلَكِن أقرُّوا بحشر الأجساد وبالجنة”.
كلام الأشاعرة في الصفات
يتبع…