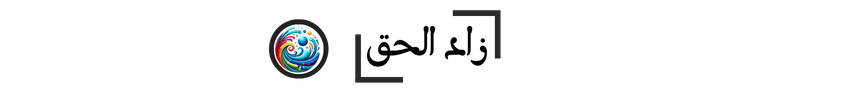أحكام الصلاة وأركانها في الفقه الإسلامي

أحكام الصلاة وأركانها في الفقه الإسلامي: مختصر من أحد الدروس التي ألقاها أحد المشايخ السعوديين، بهدف تحري الدليل (الراجح).
يتضمن الموضوع:
1. تعريف الصلاة وبعض المسائل
2. الأذان
3. شروط الصلاة
ملاحظة:
أحيانا أستعين بمصدر خارجي لتوضيح كلام الشيخ، لأنه كما تعلمون الدرس الملقى ليس كالكتاب المنظم، فقد يحدث فيه سهو أو خطأ أو قلة وضوح، فاستعين ببعض المصادر الخارجية لتوضيح بعض المسائل، وأشير إلى ذلك بكتابة “من مصدر آخر CG” قبل إدراج النص الجديد، وأختمه بعبارة “انتهي المصدر الخارجي”.
واكتب المختصر (CG) إشارة إلى أن المصدر هو الذكاء الصناعي، وقد ضبطته على إعطاء نتائج ذات مراجع تفاديا لشطحاته، وهو يأتي بالعجائب في هذه الأيام، ومعظم أجوبته دقيقة أو قريبة من الدقة، فإذا اعتمدته فليس إقرارا بنتائجه، بل للبحث فيها من أجل توسعة المدارك والإنطلاق من أساس جيد وهو النقاط المتفرقة التي يعطي، وقد لا يعطيها الكتاب المتخصص الواحد. فمثلا: يعطي أقوال الأئمة الأربعة في المسألة، ومختلف الخلافات فيها، وهذا لا تجده في الكتاب المتخصص.
وكلام الشيخ يكفي غالبا، ويعتمد على الدليل الراجح بعد عرض أقوال المذاهب الأربعة وغيرها في المسألة.
1. كتاب الصلاة
باب الصلاة:
تعريف الصلاة – متى فُرِضت الصلاةُ؟ – على من تجب الصلوات الخمس، والصبي المميز؟ – ما هي الأدلة على أن الصلاة مفروضة؟ – ماذا عن النائم إن فاتته؟ – ماذا عن المُغمى عليه؟ – ماذا عن تأخير الصلاة عن وقتها المختار؟ – ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟ – ما حكم ترك الصّلاة تهاونا وكسلا وحكم تارك الصلاة؟ – من نام عن ا لصّلاة ثم استيقظ، هل تكون الصّلاةُ في حقِّه قضاء أو يكون كمن صلّاها في وقتها؟
إذا كان يُلهِيك حرُّ المصِيفِ ** ويُبسُ الخريفِ وبردُ الشتاءِ
ويُلهِيك حُسنُ زمانِ الرّبيعِ ** فأخذُك لِلعِلمِ قُل لِي متى
تعريف الصلاة:
من المعلوم أنّ أهل العلم في تأليفهم لكُتُبِهم يبدؤون بالطّهارة، ثم بعد ذلك بالصّلاة؛ لأنّ الصّلاة لا تصِحُّ إلا بأداء شرط من شُرُوطها وهو الطّهارة (راجع موضوع الطهارة هنا)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصّحيحين من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه: «إِنّ الله لا يقبلُ صلاة أحدِكُم إِذا أحدث حتّى يتوضّأ». ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند التِّرمِذِيّ وأحمد من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مِفتاحُ الصّلاةِ الطُّهُورُ». والطُّهُور هو الطّهارة، أي يرفع الواحد الحدث، والحدثُ وصفٌ قائِمٌ بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها.
والصّلاة في اللُّغة: هي الدُّعاء، كما قال الله تعالى: ﴿وصلِّ عليهِم إِنّ صلاتك سكنٌ لّهُم﴾ [التوبة: 103]، أي: ادعُ لهم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصّدقة من أصحابه يدعو لهم، كما جاء ذلك في الصّحيح من حديث عبد الله ابن أبي أوفى أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اللّهُمّ صلِّ على آلِ أبِي أوفى». فهذا يدلُّ على أنّ الصلاة هي الدُّعاءُ، وسُمِّيت الصلاةُ دعاء لاشتمالها على الدُّعاء؛ لأنّ الدُّعاء نوعان: دُعاء عبادة ودُعاء مسألة.
فأمّا دُعاء العبادة فهو مثل أن تُسبِّح الله سبحانه وتعالى حال رُكوعك، أو تُسبِّحه حال سجودك، أو أن تحمده حال رُكوعك، أو أن تحمده حال قيامك بأن تقرأ القرآن، فإنّ قراءة القرآن من الذّكر، وهو أحبُّ العبادة، وأحبُّ الذِّكر هو قراءة القرآن، وهو دعاءٌ، لأنّ دعاء العبادة هو أن تُثني على الله بما هو أهلُه، وتُسبِّحُه وتحمده وتُهلِّله وتُكبِّرُه؛ ومعنى فعلك لذلك هو أنّك تطلب به الأجر، وتطلب رفع الدرجات في الجِنان والابتعاد عن النِّيران، فصار دعاءُ المسألة مُتضمِّنا لدُعاء العبادة.
الثاني: دُعاء المسألة. وهو أن يسأل العبدُ ربّه مُباشرة بأن يقول: ربِّ اغفر لي، أو رب ارحمني، أو اللّهُمّ تُب عليّ، أو يسأل ربّه من خيري الدُّنيا والآخرة في سجوده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هُريرة: «أقربُ ما يكُونُ العبدُ مِن ربِّهِ وهُو ساجِدٌ، فأكثِرُوا الدُّعاء، فقَمِنٌ أن يُستجاب لكُم».
فأكثر أقوال أهل العلم على أنّ الصلاة إنّما سُمِّيت صلاة لاشتِمالِها على الدُّعاء، المُتضمِّن دعاء العبادة، ودُعاء المسألة.
والصّلاة في الاصطلاح: هي التّعبُّد لله تعالى بفعل أقوال وأفعال مخصوصة، مُفتتحة بالتّكبير ومُختتمة بالتّسليم.
فدلّ ذلك على أنّه ليس كلُّ ذكر يُسمّى صلاة شرعِيّة، بل لابُدّ فيها من ذكر مخصوص، وقول مخصوص مُفتتح بالتّكبير مُختتم بالتّسليم.
متى فُرِضت الصلاةُ؟
فرضت الصلاة في ليلة الإسراء كما جاء في الصّحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما أُسرِي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «ففرض اللهُ عَليّ خمسِين صلاة، ثُمّ رجعتُ فلقِينِي مُوسى، فقال: كم فرض اللهُ عليك؟ قُلتُ: خمسِين صلاة. قال: إِنِّي قد خَبِرْتُ بنِي إِسرائِيل، فارجِع إِلى ربِّك فاسألهُ التّخفِيف. قال: فرجعتُ إِلى ربِّي، فحطّ عنِّي عشرة، فرجعتُ إِلى مُوسى، فقال: ارجِع إِلى ربِّك فاسألهُ التّخفِيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أُراجِعُ بين ربِّي وبين مُوسى حتى قال اللهُ: يا مُحمّدُ هِي خمسُ صلوات فِي اليومِ واللّيلةِ والحسنةُ بِعشرِ أمثالِها، وهِي خمسُون فِي المِيزانِ”.
فدلّ ذلك على أنّ فرضِيّة الصلاة كانت في ليلة الإسراء، وهو أمرٌ مُتّفقٌ عليه.
إلا أنّ أهل العلم اختلفوا متى كانت ليلة الإسراء؟
على أقوال كثيرة ذكرها الحافظُ ابنُ حجر في كتابه العظيمِ “فتح الباري”، ولا دليل صحيح يُصار إليه.
فمن العلماء من قال أنّها ليلةُ السّابع والعشرين من ربيع الأول، كما هو رأي إبراهيم الحربِي. وقال بعضُهم: بل في ليلة السّابع والعشرين من رجب. وقد أنكر ابنُ حزم هذا القول، وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العامّة وبعض أهل الطّوائف، ولأجل هذا شرعوا عبادات في رجب لم يشرعها اللهُ ولا رسولُه، ظانِّين أنّ ذلك لأنّ ليلة الإسراء في رجب.
والصّحيح أنه ليس لها تحديدٌ ثابتٌ، وإن كانت قبل الهجرةِ بثلاث سنين على المشهور، أمّا في أيِّ يوم أو أيِّ شهر، فإنّ الرّاجح أنّه لم يثبت في ذلك أي شيء صحيح يُصار إليه.
على من تجب الصلوات الخمس، والصبي المميز؟
نقول: “تجب الصّلواتُ الخمسُ على كلِّ مُكلّف، لا حائضا، ولا نُفَسَاءَ. والمُكلّفُ هو المسلمُ البالغُ العاقِلُ”.
فقولنا: (المسلم) يدخل فيه الذّكرُ والأنثى، ويخرج بذلك الكافر، فإنّ الكافر غيرُ مُخاطب بأداء الصّلاة، وإن كان مُخاطبا خطاب تكليف، والفرق بينهما أنّ الكافر مُخاطبٌ من حيث العُقوبة على تركها، وأمّا من حيث أداء العبادة فإنّه غيرُ مُخاطب؛ لأنّه لو أدّاها لم تصحّ منه، فصار ذلك بمثابة أنّه مُخاطبٌ بمعنى أنّه يُعاقب على تركها، كما قال الله تعالى: ﴿ما سلككُم فِي سقر * قالُوا لم نكُ مِن المُصلِّين * ولم نكُ نُطعِمُ المِسكِين * وكُنّا نخُوضُ مع الخائِضِين﴾ [المدثر: 42- 45] الآية. فدلّ ذلك على أنّ الكُفّار مُخاطبون بفروع الشّريعة، بمعنى أنّهم يُعاقبون على تركها، وهذا أحد معاني التّكليف. أي أنه من معاني التّكليف أداؤها، وهم غيرُ مُخاطبِين بذلك، ولكنهم مُخاطبون خطاب تكليف، بمعنى العذاب والعُقوبة.
وقولنا: (العاقل) يُخرج بذلك المجنون، فإنّ المجنون لا تصِحُّ منه الصّلاةُ ولو كان بالغا؛ لِما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث عليِّ بن أبي طالب، ورُوي أيضا من حديث عائشة: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: المجنُونِ حتّى يفِيق، والصّغِيرِ حتّى يبلُغ، والنّائِمِ حتّى يستيقِظ».
وجه الدِّلالة: أنّ المجنون لا نِيّة له، ومن شروط الصّلاة النِّيّةُ؛ لأجل أن يُميِّز العبدُ بين الفرض والفرض الآخر، وبين الفرض والنّفل، وهذا لا يتأتّى من المجنون.
وذكر أهلُ العلم أنّ الصبيّ غيرُ المُمَيِّزِ – وهو من لا يفهم الخطاب ولا يرُدُّ الجواب – لا تصحُّ منه الصّلاةُ، أمّا المُمَيِّز – وهو الذي يفهم الخطاب ويرُدُّ الجواب وهو من بلغ سبع سنين- فتصِحُّ منه الصلاةُ كما سيأتي بيانُه.
وذكر العلماءُ أنّ الصبيّ غير المُميِّز لا تصِحُّ مُصافّتُه، لماذا؟
لأنّه كالمجنون، فصار بمثابة الجماد، ولهذا كره أهلُ العلم في الصّبي غيرِ المُميِّز أن يُؤتى به إلى المسجد فيكون له مكانٌ في الصّفِّ؛ لأنّ وجوده في الصّفِّ بمثابة الفُرجة، وأمّا الصّبيُّ المُميِّز فإنّه تصِحُّ صلاتُه، بمعنى أنّه يُثابُ عليها، لا أنّها تصِحُّ صِحّة فرض.
وقولنا: (أنّه يُثاب عليها)؛ لما جاء عند أهل السُّنن وأحمد من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مُرُوا أبناءكُم بِالصّلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سِنِين، واضرِبُوهُم عليها وهُم أبناءُ عشرِ سِنِين».
وجه الدِّلالة: أنّ الشارع لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحةٌ، فأمر الصبيِّ، وتحديد ذلك بالسّبع دليلٌ على أنّ ذلك ينفعه.
وهل ثواب صلاته ثوابٌ له أم ثوابٌ لولِيِّه؟
الصّواب: أنّها ثوابٌ له؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿من جاء بِالحسنةِ فلهُ خيرٌ مِّنها﴾ [النمل: 89]، وإن كان ولِيُّه يُؤجر من حيث الأمرُ بها.
أمّا الحجُّ فقال أهلُ العلم: إنّ الحجّ مُستثنى بمعنى أنّه صحيحٌ، وأنّ الصبيّ المميز وغير المُميِّز يُؤجر عليه؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لقِي ركبا بالرّوحاءِ، فقال: “مَنِ القومُ؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسُولُ اللهِ. فرفعت إليه امرأةٌ صبيّا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ”. ولا يُقال أنّه كان مُميِّزا أو لم يكن؛ لأنّ ترك الإستفصال في مقام الاحتمال يُنزّل منزلة العمومِ في المقال، ولو كان لا يصِحُّ لذكره لأنه لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة.
وعلى هذا فنِيّته إنّما هي نِيّة ولِيِّه، فولِيُّه هو الذي ينوي عنه، فيُلبِّي عنه؛ لأنّ الصّبيّ ليس له نِيّةٌ.
وأمّا الصلاة فإن الصبيُّ المُميِّز يُثاب عليها، ولكنّها لا تصِحُّ منه صِحّة الفرض.
وماذا لو بلغ الصبيُّ أثناء الصلاة، أو بلغ بعد أدائها وقبل خروج الوقت، فهل يُؤمر بإعادتها؟
قالوا: لأنّه لو بلغ أثناء الصّلاة، وهذا على افتراض القول بأن بلوغه يكون بخمس عشرة سنة، فلو أنّه وُلِد في ساعة مُعيّنة، ثم صلى الظُّهر فكان له خمس عشرة سنة، وهذا على افتراض.
وأمّا بعد أداء الصّلاة وقبل خروج وقتها فمتصوّر، مثل ما لو نام فاحتلم فعلمنا أنّه قد بلغ.
هذه المسألة اختلف فيها أهلُ العلم: هل يُؤمر بالإعادة؛ لأنّه افتتح الصلاة على اعتبار أنّها نافِلةٌ، والأصل أنّ الصلاة لا تتجزأ نِيّتُها، فافتتحها بالتّكبير الذي هو نافلةٌ في حقِّه، فلمّا بلغ في أثنائها أُمِر أن يُعِيدها على اعتبار أنّها تكبير فرض، هذا هو مذهب الحنابلة.
وذهب بعضُ أهل العلم – وهو روايةٌ عند الإمام أحمد اختارها ابن تيميّة – إلى أنّ الصبيّ لا يُؤمر بالإعادة، سواء بلغ أثناء العبادة أو بعد أدائها وقبل خروج الوقت، قالوا: لأنّه أدّاها بنِيّة الأجر والثّواب، فليس مثل ما لو صلى على اعتبار التّعليم، فهو قد نواها ففعل كما أمره اللهُ بنِيّته، فهي تكفي فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نُصلِّي صلاة مرّتين.
وهذا القول قويٌّ، إلا أنّ الاحتياط والأولى أن يُعِيد الصّلاة. لماذا؟
لأننا نقول: أنّه ما زال مأمورا بأدائها أداء وجوب، وهو قد افتتحها أو أنهاها على أنّها أداء سُنّة، وبين السُّنة والفرض مفاِوز، كما قال الله تعالى: «وما تقرّب إِليّ عبدِي بِشيء أحبّ إِليّ مِمّا افترضتُهُ عليهِ». فهو قد نواها، ومن المعلوم أنّ النِّيّة لا يجوز أن تتجزّأ أثناء الصّلاة، فلو صلّى شخصٌ على اعتبار أنّه يُريد أن يتطوّع للظُّهر، ثم قال: أُرِيدُ أن أقلبها إلى فرض، فلا تصح بالإجماع، قالوا: فكذلك لا تصِحُّ من الصبيِّ أثناء الصّلاة، ولا تصِحُّ منه بعدها؛ لأنّه أدّاها على اعتبار أنّها نافِلةٌ، وهذا القول أحوطُ، والله أعلم .
وقولنا: (لا حائضا ولا نُفساء)؛ لأنّ الحائض والنُّفساء لا تصِحُّ منهما الصّلاةُ، وهذا محلُّ إجماع من أهل العلم، وقد حكى الإجماع الإمامُ ابنُ المُنذِر وابنُ حزم، وكذلك ابنُ هُبيرة في كتاب “الإفصاح”.
ومما يدلُّ على ذلك ما جاء في الصّحيحين أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في حقِّ الحائض: «أليست إِذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم؟»، ولما جاء في الصّحيحين من حديث مُعاذة العدويّة أنّها قالت لعائشة رضي الله عنها: “ما بالُ الحائِضِ تقضِي الصّوم ولا تقضِي الصّلاة؟” فقالت عائشةُ مُستفسِرة: “أحرُورِيّةٌ أنتِ؟”، أي هل أنتِ من الحرُورِيّة وهم الخوارج الذين يُخالفون السُّنة ولا يعملون بها؟ فقالت: “لا، ولكنِّي أسألُ”. فقالت عائشةُ رضي الله عنها: “كُنّا يُصِيبُنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصّوم ولا نُؤمر بقضاء الصّلاة”.
فيجب الانقياد وقول: سمعنا وأطعنا لأوامر الشرع، هذا هو الواجب في حقِّ كلِّ مسلم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأُنثاهم، وإن كان أهلُ العلم يتفاضلُون بمعرفة الحِكم والتّشريعات السّماويّة وأسبابها وحِكمها، فذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء.
ما هي الأدلة على أن الصلاة مفروضة؟
فرضيّة الصّلاة ثابتةٌ بالكتاب والسُّنّة، وإجماع أهل العلم. فأمّا في الكتاب فقول الله تعالى: ﴿إِنّ الصّلاة كانت على المُؤمِنِين كِتابا مّوقُوتا﴾ [النساء: 103]، أي مفروضا.
وأما في السنة: فلِما جاء في الصّحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذا إلى اليمن، فقال له: “إِنّك تأتِي قوما أهل كِتاب، فليكُن أوّل ما تدعُوهُم إِليهِ: شهادةُ أن لا إِله إِلّا اللهُ، وأنّ مُحمّدا رسُولُ اللهِ، فإِن هُم أجابُوك لِذلِك فأخبِرهُم أنّ الله افترض عليهِم خمس صلوات فِي اليومِ واللّيلةِ” الحديث.
ومن الأحاديث أيضا ما جاء في الصّحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “بُنِي الإِسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إِله إِلّا اللهُ، وأنّ مُحمّدا رسُولُ اللهِ، وإِقامِ الصّلاةِ، وإِيتاءِ الزّكاةِ، وصِيامِ رمضان، والحجِّ”. وفي رواية: “والحجِّ، وصِيامِ رمضان”. وهذا يدلُّ على وجوب الصّلوات الخمس على كلِّ مُسلم مُكلّف بالِغ، لا حائضا ولا نُفساء.
ماذا عن النائم إن فاتته؟
النّائم وإن كان غير مُدرِك للوقت ولا للأذان، فإنّه مأمورٌ إذا استيقظ أن يُصلِّيها، وهذا محلُّ إجماع من أهل العلم؛ لما جاء في الصّحيح من حديث أنس رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “من نام عن صلاة أو نسِيها فليُصلِّها إِذا ذكرها، لا كفّارة لها إِلّا ذلِك”. وقرأ: ﴿وأقِمِ الصّلاة لِذِكرِي﴾ [طه: 14].
ماذا عن المُغمى عليه؟
هل يأخذ حكم النائم فيجب عليه القضاءُ أم يأخذ حكم المجنونِ فلا يجب عليه القضاءُ؟
الجواب: اختلف العلماءُ في ذلك على أقوال، أصحُّها وأرجحُها هو مذهب مالك والشّافعيِّ ورواية عند الإمام أحمد: أنّ المجنون إذا أفاق أو المُغمى عليه، لا يجب عليه شيءٌ من الصّلاة إلا الصّلاة التي أفاق ووقتها ما زال قائما، أي الصّلاة التي أفاق وهو فيها، إذن لا يقضي الصّلوات التي لم يكن في وعيه فيها، ويصلي التي هو في وقتها قبل أن يخرج وقتها.
إلا أنّ أهل العلم قالوا: لو أفاق في وقت يُجمع لها مع غيرها في وقت العُذر، كما لو أفاق في وقت العصر، أو أفاق في وقت العشاء، فإنّ العشاء والمغرب وقتهما وقتا واحدا حال العذر، وكذلك الظهر والعصر وقتهما وقتا واحدا حال العُذر، فقالوا: يُصلِّي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، هذا هو مذهب جمهور السلف، ونُقل عن ابن عبّاس وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة، ولا يصِحُّ عنهما حديثٌ أو أثرٌ صحيحٌ، إلا أنّ أكثر أهل العلم عليه.
وقد ذهب مالكٌ رحمه الله وهو قولٌ عن الشافعيِّ وروايةٌ عن الإمام أحمد: إلى أنّه لا يجب عليه إلا أن يُصلِّي الصلاة التي أفاق فيها؛ لأنّه لم يصِحّ في ذلك حديثٌ. وأقول: إنّ قول مالك قويٌّ، أي لا يُصلِّي إلا العصر، أو لا يُصلِّي إلا العشاء، إلا أنّ الأحوط أن يُصلِّي الظهر والعصر (ليضمن دخول الصلاة التي قبلها احتياطا).
وكذلك يُقال في حقِّ الحائض والنُّفساء إذا طهُرتا في وقت الثّانية، أي: في العصر، فإنّ المشروع في حقِّها أن تُصلِّي الظهر والعصر، وإن أفاقت بعد العشاء وقبل الفجر فإنّ المشروع أن تُصلِّي المغرب والعشاء، فإن صلّت العشاء فقط، أو صلّت العصر فقط، فإنّ الراجح أنّه يجوز لها ذلك؛ لأنّ التّكليف لا يكون إلا بدليل ولا دليل.
ماذا عن تأخير الصلاة عن وقتها المختار؟
يحرُم تأخيرُ الصّلاة عن وقتها المختار. والصّلاة التي لها وقتان على الرّاجح هي صلاة العصر وحدها، فإنّ لها وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. فأمّا وقت الاختيار فإلى اصفرار الشمس، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “ووقتُ العصرِ ما لم تصفرّ الشّمس”.
وأمّا وقت الضّرورة فمن اصفرار الشّمس إلى غُروبها، ومما يدلُّ على أنّ “إلى غروبها” هو وقتها ما جاء في الصّحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “من أدرك ركعة مِن العصرِ قبل غُرُوبِ الشّمسِ فقد أدرك الصّلاة”، فهذا يدلُّ على أنّه وقتُها، إلا أنّه لا يجوز للمسلم أن يُصلِّيها في وقت الضّرورة من غير عذر، فإنّه حينئذ يأثم، ومما يدلُّ على الإثم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “تِلك صلاةُ المُنافِقِ، يجلِسُ يرقُبُ الشّمس حتّى إِذا كانت بين قرني الشّيطانِ قام فنقرها أربعا لا يذكُرُ الله تعالى فِيها إِلّا قلِيلا”.
فهذا يدلُّ على أنّ تأخير الصّلاة عن وقتها له أحوالٌ:
الحالة الأولى: أن يُؤخِّرها عن وقتها الاختياري إلى وقتها الضّروري من غير عذر، فإنّه يأثم.
الحالة الثانية: أن يُؤخِّرها عن وقتها المُستحبِّ إلى آخر وقتها وليس عن ضرورة، مثل صلاة الظهر، فإنّه يمكن أن تصلى في أول وقتها، ويمكن أن تصلى أواخر وقتها قبل دخول وقت العصر، إلا أنّ السُّنّة أن تُصلّى الصّلوات في أول وقتها، هذا في الأصل، والدّليلُ على ذلك ما جاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: “الصّلاةُ على وقتِها”. وفي رواية: “الصّلاةُ لِوقتِها”. وعند الحاكم: “الصّلاةُ فِي أوّلِ وقتِها”. وهذا يدلُّ على أنّ الصلاة في أول الوقتِ يُثاب صاحبُها أكثر من إثابته على صلاتها في آخره؛ لأنّ الصلاة في آخره مدعاةٌ إلى جعل الواحد يُؤخِّرها وربما خرج وقتُها، وقد حذر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة الظهر إلى شرقِ الموتى، أي إلى العصر، فقال: “كيف أنتُم إِذا كان عليكُم أُمراءُ يُؤخِّرُون الصّلاة عن مِيقاتِها ويخنُقونها إِلى شرقِ الموتى؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلُّوا الصّلاة لِوقتِها، فإِن أدركتُمُوها معهُم فصلُّوها تكُن لكُم نافِلة”.
وهذا جعل بعض أهل العلم يقول: إنّ المُداومة على الصّلاة في آخر الوقت ولو لم يكن فيها وقت ضرورة، فيه ذمٌّ. وهذا القول فيه وجاهةٌ، إلا إذا كان التّأخيرُ لمصلحة شرعيّة.
ومن المصلحة الشّرعيّة: إذا كان في صلاة الظهر، فإنّ الراجح أنّها إذا كانت في وقت الحرِّ فالأفضل فيها الإِبرادُ، والإِبراد هو تأخيرها قبل خروج وقتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “إِذا اشتدّ الحرُّ فأبرِدُوا بِالصّلاةِ، فإِنّ شِدّة الحرِّ مِن فيحِ جهنّم”. والحديث في الصّحيحين جاء من طريق أبي سعيد، ومن طريق أبي ذرّ وغيرهما.
وكذلك العشاء، فإنّ الأفضل في حقِّها أن تُؤخّر إذا لم يكن على الناس حرجٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما أعتم الناسُ عن صلاة العشاء حتى نام الصّحابة، فخرج صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامّةُ الليل، فقال: “إِنّهُ لوقتُها لولا أن أشُقّ على أُمّتِي”. وهذا الحديثُ في الصّحيحين من حديث عائشة.
فهذا يدلُّ على أنّ المشروع في حقِّ المسلم، وحقِّ المرأة خاصّة، أن تُؤخِّر العشاء، فإن خشيت أن تأخيرها مدعاةٌ إلى نسيانها أو النوم عنها فلا يجوز.
ما معنى لا يجوز؟ لأنّ الواجب أن يخرج الواحد من عُهدة الطّلب بيقين، فإن كان مُتيقِّنا أو يغلب على ظنِّه فهو مأجورٌ على هذا ولا إثم.
الحالة الثالثة: تأخيرُها عن وقتها المفروض بأن يُصلِّيها خارج الوقت، وهذا لا يجوز، وهو آثمٌ بإجماع أهل العلم، وقد فسّر ابنُ مسعود كما روى ابنُ جرير في تفسيره في قول الله عز وجلّ: ﴿فخلف مِن بعدِهِم خلفٌ أضاعُوا الصّلاة واتّبعُوا الشّهواتِ فسوف يلقون غيّا﴾ [مريم: 59] قال: “يتركونها”، يصلونها في خارج وقتها، فقال القاسمُ بن عبد الرحمن: “والله يا أبا عبد الرحمن ما كُنّا نرى إلا أنّهم يتركونها”. أي لا يُصلُّونها، فقال: “ذاك الكفر”. أي أنّ الذي يتركها ذاك كافر.
وعلى هذا فمن ترك الصلاة حتى خرج وقتُها فإنّه آثمٌ بإجماع أهل العلم، ويزيد الإثمُ إذا صلّى صلاة النّهار باللّيل، وصلاة الليل بالنّهار، فلو صلى صلاة الظهر في وقت العصر فهو آثمٌ، ولو صلى الظهر أو العصر في الليلِ فالإثم يزداد، وكذلك المغرب والعشاء، وهو مع الإثمِ مأمورٌ أن يقضِيها ولو كان مُتعمِّدا، وهذا قول عامّة أهل العلم، هذا قول الأئمّة الأربعة، وقد حكى بعضُهم إجماع أهل العلم عليه.
وفي الواقع ليس في المسألة إجماعٌ، فقد خالف في ذلك الحسنُ البصريُّ، وذهب إليه ابن تيميّة فقالوا: إنّ من ترك الصلاة حتى خرج وقتُها مُتعمِّدا فإنّه لا ينفعه قضاؤُها، بل الواجب عليه التّوبة.
والذي يظهر والله أعلم أنّ قول عامّة السّلف أظهرُ؛ وذلك لأنّ القضاء يحكي الأداء، ومما يدلُّ على ذلك أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: “ومن لم يُحافِظ عليها لم تكُن لهُ نُورا ولا نجاة ولا بُرهانا لهُ يوم القِيامةِ، وإِن شاء عذّبهُ وإِن شاء غفر لهُ”. فوجه الدِّلالة أنّ الذي لا يُحافظ عليها ليس المقصودُ أن يتركها؛ لأنّ الترك على الرّاجح كفرٌ. فهو إنّما لا يُحافظ عليها بمعنى: يتركها عن وقتها، فيكون آثما ولو أدّاها، وأمّا لو تركها فهذا لا يُعدُّ مُحافظا عليها ولا يُعدُّ فاعلا لها، ولا يُقال أنّه محافظٌ؛ لأنّ المحافظ هو الذي يفعل الشيء في وقته، وأمّا غيرُ المحافظ فهو الذي يفعل الشيء في غير وقته، وأمّا الذي لا يفعل الشيء حتى في وقته فهذا لا يُعدُّ فاعلا، بل يُعدُّ تاركا، وهذا هو الرّاجح، والله أعلم .
ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟
إذا ثبت هذا أيُّها الإخوة، فقد أجمع أهلُ العلم على أنّ من قال إنّ الصلاة ليست بواجبة، وكان مثلُه لا يجهل ذلك، فإنّه كافرٌ، فكلُّ من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، وهذا محلُّ إجماع من أهل العلم في القديمِ والحديثِ، وهذا لا يُحتاج معه إلى دليل؛ لأنّ الله أوجب على الأُمّة الصلاة، وقد ذكرنا فرضِيّتها بالكتاب والسُّنة.
ما حكم ترك الصّلاة تهاونا وكسلا وحكم تارك الصلاة؟
ومعنى ترك الصلاة تهاونا وكسلا هو أنّه لا يُصلِّيها وإن كان مؤمنا بوجوبها عليه، لكنّه يتركها تهاونا وكسلا، والعياذ بالله، فهذا يكفر، وقد كان ذلك محلّ إجماع عند المتقدِّمين من الصّحابة ومن جاء بعدهم، فقد روى محمدُ بن نصر المروزِيُّ في كتابه الفذِّ العظيم “تعظيم قدر الصّلاة”، قال: “عن أيُّوب السّختِيانِي قال: ترك الصلاة كفرٌ لا يختلفون فيه”.
وقد صحّ عن ابن مسعود، وإن كان في سنده المسعُودِي، لكن عبد الرحمن المسعودي تُقبل روايته إذا لم يأتِ بما يُنكَر، فقد روى المسعوديُّ عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنّه قال في ترك الصلاة مُطلقا: “ذاك الكُفرُ”. ولا يُقال: كفرٌ دون كفر؛ لأنّه جعل فيها “الـ” التي تُفيد الإستِغراق.
وقد قال إسحاقُ بن راهُويه: “كان رأيُ أهل العلم من لدُن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنّ تارك الصلاةِ عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافرٌ”.
ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما صحّ عند التِّرمِذِيّ من حديث عبد الله بن شقِيق التّابعيِّ المعروف أنّه قال: “كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركُه كُفرٌ غير الصلاة”. وهذا الحديث حاول بعضُهم أن يطعن في إسناده، ولكن الرّاجح والله أعلم أنّ إسناده جيدٌ. وقد روى الحاكمُ في “المستدرك” أنّه من قول أبي هريرة، ولكن الحديث فيه ضعفٌ.
وذكر ابنُ حزم أنّه قد رُوي عن عمر وأنس وابن مسعود وجملة من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّهم يرون أنّ تارك الصلاة كافرٌ. ولكن الراجح أنّه لا يصِحُّ إلا عن ابن مسعود: “ذاك تركُها كُفرٌ”.
ومما يدلُّ على ذلك من السُّنة: ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «بين الرّجُلِ وبين الشِّركِ أوِ الكُفرِ: تركُ الصّلاةِ». وما جاء في حديث بُريدة عند الإمام أحمد: «العهدُ الّذِي بيننا وبينهُمُ الصّلاةُ، فمن تركها فقد كفر».
وهذا هو قول جمهور السلف، وإن كان الشافعيُّ رحمه الله لا يرى تركها كفرا، وقولٌ عند المالكيّة، وأمّا مالكٌ فلم يُحفظ له قولٌ في هذا، كما ذكر ذلك ابنُ خُويص من المالكيّة، وكذلك أبو عمر ابن عبد البرِّ في كتابه “التّمهيد” قال: “لا يُحفظ لمالك قولٌ في هذه المسألة”.
وإذا قلنا أنّ تارك الصلاة كافرٌ، وهو الراجح، فإننا نقصد بذلك أمورا:
الأمر الأول: أنّه لا يُعدُّ كافرا إذا كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا، وإنّما المقصود بالتّرك هو التّرك المُطلق، فهو لو تركها التّرك المُطلق، ونوى التّرك المطلق، فإنّه يكفر. وأمّا لو فعلها أحيانا، فإنّه لا يُعدُّ كافرا؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “ومن لم يُحافِظ عليهِنّ لم تكُن لهُ نُورا، ولا نجاة، ولا بُرهانا يوم القِيامةِ، فإِن شاء عذّبهُ، وإِن شاء غفر لهُ”. وجه الدِّلالة: أنّ المشيئة لا تكون مع فعل الكبائر لا فعل الكفر لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنّ الله لا يغفِرُ أن يُشرك به ويغفِرُ ما دُون ذلِك لِمن يشاءُ﴾ [النساء: 48].
وأمّا الأحكام المُتعلِّقة بالدُّنيا، فإننا نقول: لا يكفر، ولا تجري عليه أحكامُ الكفر حتى يدعوه السُّلطانُ أو نائبُه فيُبيِّن له وجوبها، فإن أصرّ على التّرك بحيث لو عُرض عليه السّيفُ قال: أنا لا أصلي، فإنّه يكفر، يقول ابنُ تيميّة: “ولا يمكن أن يُقال أنّه مسلمٌ، ومن قال أنّه مسلمٌ فقد دخل عليه شُبهة الإرجاء”. ومعنى شُبهة الإرجاء في العقيدة: الذين يُرجِئون العمل عن مُسمّى الإيمان.
على هذا أيُّها الإخوة، فإننا نقول: أنّ تارك الصلاة كافرٌ إذا تركها التّرك المُطلق، فمن كان يُصلِّي أحيانا مثل الجُمعِ، أو إذا ذهب إلى العمل، أما إذا ذهب إلى بيته لا يُصلِّي، فهذا على خطر عظيم، ولكنّه لا يُعدُّ كافرا.
يقول ابنُ تيمية رحمه الله: “وأمّا إذا كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا؛ فهذا غالب المسلمين اليوم”. الله المستعان! قال هذا في القرن الثامن، فكيف بزماننا؟ والعياذ بالله!
فالصلاة هي صِلةٌ بين العبد وربِّه، وقد كانت المساجد بالأمس تمتلئ، ولا يُفرِّقون بين فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واليوم تجد أنّ عدد من يُصلِّي الفجر في بعض مساجد المسلمين قليل جدّا، فهُجِرت المساجدُ – والعياذ بالله، وهذا مُؤذِنٌ بسخطِ الله عز وجلّ كما قال عبدُ الله بن مسعود: “ولو أنّكم تركتم سُنّة نبيكم لضللتم، وإنّ من سُنن الهُدى الصّلاة في المسجد الذي تُقام فيه”.
ما حكم من يصلي صلاة العيدين فقط؟
الجواب: إذا كان كذلك، فإن من ترك الصلاة مطلقا فإنّه كافرٌ،لكن نُفرِّق بين التّكفير المُعيّن والتّكفير الوصفِي، فنقول: تارك الصلاة كافرٌ، لكن فلان لا يُعدُّ كافرا حتى تُقام عليه الحُجّةُ، لأنّ هذه المسألة اختلف العلماءُ فيها، فالشافعي نصّ في “الأُمِّ” على أنّه ليس بكافر، فإذا كان الإمامُ الشافعيُّ لا يعُدُّه كافرا، فكيف يحكم عليه بالكفر من هو دونه في الفقه؟
إذن حتى تُقام عليه الحُجّةُ، أي يأتي أهلُ العلم أو القُضاةُ.
والواجب كما قال ابنُ تيمية رحمه الله أنه: “لا يجوز تأخيرُ الصّلاة عن وقتها لا لحصد ولا لزرع ولا لصيد”.
يقول البعض: نحن مضطرون بسبب العمل أو غيره إلى تأخير الصلاة عن وقتها؟
الجواب: إذا كانوا يُؤخِّرون الصّلاة حتى يخرج وقتُها بحيث تكون صلاةُ النهار في الليل، فهم آثمون في ذلك، فيجب عليهم أن يصلوا حتى ولو كانوا في السّيارة؛ لأنّ وقت الصلاة مُحترمٌ، ولا يجوز أن يستهين به الواحد.
والله سبحانه وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلاة حتى في وقت الجهاد الذي فيه القتل، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فإِن خِفتُم فرِجالا أو رُكبانا﴾ [البقرة: 239]. فهذا كله دليلٌ على وجوب المحافظة على الصّلاة.
ولما أخّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمسُ؛ نزل قولُ الله تعالى: ﴿حافِظُوا على الصّلواتِ والصّلاةِ الوُسطى وقُومُوا لِلّهِ قانِتِين * فإِن خِفتُم فرِجالا أو رُكبانا﴾ [البقرة: 238، 239]، فتأثّر صلى الله عليه وسلم وقال: «شغلُونا عنِ الصّلاةِ الوُسطى، حشا اللهُ قُبُورهُم وأجوافهُم نارا»، والله أعلم.
من نام عن ا لصّلاة ثم استيقظ، هل تكون الصّلاةُ في حقِّه قضاء أو يكون كمن صلّاها في وقتها؟
الجواب: هو معذورٌ بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِع القلمُ عن ثلاث». ومعنى معذور: أنّه قد هيّأ أسباب القيام ثم لم يقُم، وأمّا من لم يُهيِّئ أسباب القيام فيُعدُّ مُفرِّطا، فيأتي إلى الفراش وهو مُنهكٌ فينام، ولا يأمر أحدا بإيقاظه، ولا يضع شيئا من المُنبِّهات التي تُوقظه، فهذا لا يُعدُّ مُهتمّا، ونقول له: هب أنّ لديك موعدا في الطّائرة، فهل ستقول: إن قمتُ قمت وإلا فلا، أم ستطلب من الجميع إيقاظك حتى الجار، وتضع المنبه؟ فهذا يدلُّ على قِلّة الاهتمامِ بالصّلاة، وقد كان سلفُ هذه الأُمّة يهتمون بها، ويرون أنّ من كان مُهتمّا بها فهو دليلٌ على صِحّة إيمانه وصدق تقواه، وأمّا من لم يُحافظ عليها، فقال إبراهيمُ بن أدهم: “فاغسل يدك منه”، والله المُستعان.
2. الأذان
الأذان:
تعريف الأذان – متى شُرِع الأذان؟ – أيهما أفضل الأذان أم الإمامة؟ – حكم الأذان والإقامة – ما هي السنة عند المالكية وهل تختلف عنها عند غيرهم؟ – حكم الإجارة على الأذان؟ – ما الذي يستحب في المؤذن؟ – إن تَشَاحّ شخصان كل منهما يقول: أريد أن أؤذن أيهما نختار؟ – ما هي جُمَل الأذان؟ – أيهما أفضل أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟ – أيهما أفضل في الأذان أن يقول الله أكبر جملة جملة أم جملتين جملتين؟ – ما الذي يستحب عند الأذان؟ – ما هي شروط صحة الأذان؟ – من جمع لصلاتين أو لفوائت، فما يصنع؟ – ما الذي يستحب لمن سمع المؤذن؟ – لو أن إنسانا في الخلاء فسمع المؤذن، فهل يقول معه أم لا؟ – هل لو صلى متطوعا فسمع المؤذن، هل يقول مثلما يقول؟
تعريف الأذان:
يفيد الأذان الإعلام بدخول الوقت، وفي الحديث “فأمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول: قد طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم” الحديث.
فهذا يفيد أن الأذان يكون للإعلام بدخول وقت الصلاة.
وهو أيضا الدعاء والنداء إلى الصلاةِ؛ ذلك أن من الأذان ما يكون لأجل صلاة فائتة، ومن المعلوم أن الأذان للصلاة الفائتة ليس إخبارا بدخول الوقت، وإنما هو دعاء ونداء إلى الصلاة، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته، فقال: من يكلأُ لنا الليل؟ فقال بلال بن رباح: أنا يا رسول الله، قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام الصحابة ونام بلال، فلم يستيقظوا إلا والشمس على ظُهورهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “ما هذا يا بلال؟ قال بلال: أخذ بنومي الذي أخذ بنومِك يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنّ هذا مكانٌ حضرنا فيه شيطانٌ، ثم انتقل، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الفجر”.
إذن الأذان يفيد الإعلام بدخول وقت الصلاة، وأيضا هو الدعاء والنداء للصلاة.
إذن الأذان هو الإعلامُ، كما قال الله تعالى: ﴿ وأذانٌ مِّن اللّهِ ورسُولِهِ إِلى النّاسِ يوم الحجِّ الأكبرِ ﴾ [التوبة: 3]؛ أي: إعلام من الله ورسوله.
ويُطلق الأذان على الاستماعِ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «ما أذِن اللهُ لشيء أذِنهُ لنبيّ حسن الصوت يتغنى بالقرآنِ»، يعني ما استمع الله.
وأما في الاصطلاح: فإن الذي يظهر والله أعلم أن الأذان في الجملة هو الدعاء والنداء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، ذلك أنّ الواحد يُؤذن إما بدخول الوقت، وإما بعد دخول الوقت، والهدف من أذانه هو مناداة الآخرين للصلاة.
وأما الإقامةُ فهي من باب أقام، أي إذا استُنهِض من قُعود، وأما في الاصطلاح: فهي الإعلامُ بالقيام إلى الصلاة.
ومؤذنو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: بلال وأبو محذُورة وسعد القرظ.
والمشهور اثنان: بلال، وهو الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. وأبو محذورة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في فتح مكة لما رأى أنه حسن الصوت.
متى شُرِع الأذان؟
اختلف العلماء في متى شُرع، والذي يظهر أنه ليس هناك شيء ثابت في هذه المسألة، وإنما الثابتُ أنّ الأذان لم يكن في مكة بل كان في المدينةِ.
الأمر الثاني: أنه كان في أولِ الإسلامِ ولم يكن في آخرِه، ولهذا اختلف العلماءُ في أي سنة فُرض، والأكثر أنه فُرض في السنة الأولىِ، وقيل الثانية، والذي يظهر أنه فُرض في السنة الأولى.
وكانوا قبل أن يشرع يتحيّنُون للصلاة، والتحيُّن هو حساب فترة بين كل صلاة وصلاة، يقيسون ذلك إما بقراءةِ عددِ الآيات أو غير ذلك، ويتحينون: أي يترقبون ويتربصون. فشقّ ذلك على المسلمين، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا.. الحديث.
ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: “كان الناس يجتمعون للصلاة ويتحينون لها، وليس يُنادَى لها، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وقال بعضهم: اتخذوا بُوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا يُنادِي بالصلاةِ، فقال رسول الله: قُم يا بلال فنادِ بالصلاة”.
ويفيد هذا الحديث أن الذي رأى الأذان هو عمرُ، والذي يظهر أن عبد الله بن عمر إنما قال على حسبِ عِلمه، وإلا فإن أبا داود وأحمد وغيرهما رووا عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، أنه رأى رؤيا، قال: “بينما أنا نائم إذ جاءني ملك عليه ثوبان أخضران، فدخل المسجد ثم صعد فأذّن”، فأذن مثل أذان بلال”.
كم في أذان بلال من جملة؟ خمس عشرة جملة، هي:
“الله أكبر، الله أكبر – الله أكبر، الله أكبر – أشهد أن لا إله إلا الله – أشهد أن لا إله إلا الله – أشهد أن محمدا رسول الله – أشهد أن محمدا رسول الله – حي على الصلاة – حي على الصلاة – حي على الفلاح – حي على الفلاح – الله أكبر، الله أكبر – لا إله إلا الله”.
قال عبد الله بن زيد: “ثم استأخر عني، ثم قعد، ثم قام فأقام، فقال: الله أكبر، الله أكبر – أشهد أن لا إله إلا الله – أشهد أن محمدا رسول الله – حي على الصلاة – حي على الفلاح – قد قامت الصلاة – قد قامت الصلاة – الله أكبر، الله أكبر – لا إله إلا الله”.
قال عبد الله بن زيد: “فقلت له: ما هذا؟ قال: إن هذا أذان، قال: فقلت: ألا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم”. ثم قام من نومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الرؤيا، فسُرّ صلى الله عليه وسلم بهذه الرُّؤيا، وقال: “إنها رُؤيا حق، قم يا عبد الله، فألقه على بلال؛ فإنه كان أندى صوتا منك”.
وأندى تشتمل معنيين: أرفع وأغض؛ فهو أكثر رفعا، وفيه من الحسن.
قال: فجعل بلال يؤذن، فخرج عمر رضي الله عنه، يجر إزاره، يعني كان نائما، فسمع الأذان، فخرج يجر إزاره، وهو ينادي: “يا رسول الله، والله لقد رأيتُ الذي رأى”، وهذا يدل على أن عُمر مُلهمٌ، حينما سمع ذلك علم أن هذا لا يتأتى إلا من رؤيا، فقال: رأيت الذي رأى، وهذا يدل على أنّ الرُّؤى إذا تواطأت، وفيها من الوحدانية لله وإثبات رُبوبيته وجبروته وقيُّوميّته، فإنها صادقة، ولهذا من تأمل ألفاظ الأذان، أو ألفاظ الإقامة، يجد فيها من الوحدانية وإفراد العبودية وكمال القيُّوميّة وكمال القوة والقهر لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى.
إذن الأذان شُرع برُؤيا.
تنبيه: نقول: هو رؤيا لكن حينما أمر بها صلى الله عليه وسلم كان التشريعُ من النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وموافقته، لا من الرؤيا.
وعلى هذا فليس بمستساغ أن يستدل الرّاؤون على الأحكامِ الشرعيّة بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه بدعوى أنها رؤيا حق، فنقول: من أخبركم أنها رُؤيا حق، أما رسول الله؛ فإنه أعلم الناس وقوله يصدُرُ من الوحيِ، كما قال صلى الله عليه وسلم: “لا أُلفينّ أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرتُ به، أو نهيتُ عنه، ويقول: لا ندري! بيننا وبينكم كتابُ الله، ألا وإني أُوتيتُ القرآن ومثله معه” الحديث رواه أبو داود، والإمام أحمد بإسناد صحيح.
إذن الرؤيا الحق لا يلزمُ منها التشريع، فلربما تكون رؤيا حق يُستأنس بها فقط، وهي ليست تشريعا إلا بأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وما آتاكُمُ الرّسُولُ فخُذُوهُ وما نهاكُم عنهُ فانتهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وقال تعالى: ﴿فإِن تنازعتُم فِي شيء فرُدُّوهُ إِلى اللّهِ والرّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُون بِاللّهِ واليومِ الآخِرِ﴾ [النساء: 59].
أيهما أفضل الأذان أم الإمامة؟
جدل قائم في كُتب الفقهاءِ والحديث، فقال بعضهم: إن الأذان أفضل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة”، قالوا: وهذا مزيّة شرف وفضل لم تتأتى للإمام.
وقالوا أيضا: ولأنّ المؤذن يشهد له كل من سمِعه من حجر ومدر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أن أبا سعيد الخُدري رضي الله عنه، قال: “إذا كنت في غنمك وباديتك فحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر؛ إلا شهد له يوم القيامة”.
القول الثاني في المسألة: هو مذهب الحنِيفية والمالكية، قالوا: إن الإمامة أفضل من الأذان، قالوا: فإن الإمام هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأما ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فإن الحديث ضعيف، ولو صح، فإن معناه أن النبي أمر بالأذان، كما تقول: بنى الخليفة قصرا، فالخليفة لا يبني إنما يُبنى بأمره، والله أعلم.
وقال بعضُ المحققين: الإمامة أو الأذان أفضل على حسبِ حال الشخص، فلربما كان الأذان في حال بعض الناس أفضل له من الإمامة، وكان بعض الناس الإمامة أفضل له، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية.
مثال: أيهما أفضل الصلاة أم الصوم؟!
هذا يختلف، فبعض الناس أفضل في حقه الصلاة من حيث التطوعُ، وبعض الناس أفضل في حقه الصوم، نحن نقول هذا خارج من محل النزاع، هذا من حيث المتعلّقُ، لكن من حيث هو، فإن الصلاة أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضُوع”، والله أعلم.
إذن، الذي يظهر هو أن الإمامة في الجملة أفضل، وذلك لأمور:
الأول: أن الإمامة فيها تحمُّلُ المصلين وتعليمهم أمر دينهم والاقتداء بهم، فكان لا يتقدمها إلا أفضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «يؤُمُّ القومُ أقرؤهم لكتاب الله»، فدل ذلك على أنّ هذه المِيزة لا تتأتى لكلِّ أحد، وأيضا جاء في الحديث أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «وليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤُمُّكُم أكثركم قُرآنا»، وهذا يدلُّ على الأفضلية من هذا الوجهِ.
ثم إن بعض المعاني الشرعية ربما يرد فيها فضائل، فليس معنى ذلك أنّ غيرها مما لم يرد فيه أقل منزلة، فإن ذلك ليس بظاهر، فإن بعض الصحابة قد يرد له فضل، وهو ليس أفضل من العشرة المبشرين بالجنة ولا من غيرهم، فورود فضيلة شيء، لا يدلُّ على أنه أفضل من غيره مما لم يذكر فيه إلا بإعتبار آخر، والله أعلم.
حكم الأذان والإقامة:
اختلف أهل العلم في حُكم الأذانِ والإقامة، فالذي يظهرُ “أن الأذان فرضُ كفاية على الرجال المجتمعين لأداء الصلاةِ”.
وقولنا “فرض كفاية” يخرِج به فرض العينِ، فإن صلاتهم بلا أذان صحيحة.
ثم إن قولنا “على الرجال” يخرج به النساء، فإن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن هل يشرع لهن؟
الجواب: رُوي عن بعض السلف كابن عمر أنه يُشرع لهن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مباح، وهذا رواية عند الحنابلة، وقال بعضهم: لا يشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه أمر نساءه ولا الصحابيات بالأذان ولا الإقامة. ذلك أنّ الأذان إنما مشروعيته للمناداة إلى الصلاة، والمرأة ليس مشروعا في حقها الجماعة فهي تُصلي وحدها، فلا معنى أن تؤذن وهي تُصلي وحدها، وهذا هو الظاهرُ.
فالظاهر هو أن الأذان في حق المرأة جائز غير مشروع، يعني ليس من السنة،والله أعلم.
وقولنا جائز: لفعل السلف، أي لفعل بعض الصحابة، فإن الصحابة إذا فعلوا أمرا لا يقال إنه بدعة، ولم نقل باستحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولم يُفعل في عهده صلى الله عليه وسلم.
وقولنا “المجتمعين لأداء الصلاة” هل يخرج بذلك الصلاة المقضية؟
نقول: إن كان هُم هُم الذين فاتتهم الصلاة هم المخاطبين في هذا البلد، يعني ليس فيه غيرهم، فإنهم مأمورون بالأذان، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، حينما ناموا عن الصلاة حتى خرجت عن وقتها، فقال: «ما هذا يا بلال»، قال: أخذ بنومي الذي أخذ بنومك يا رسول الله، قال: «إن هذا مكانٌ حضرنا فيه شيطان»، فتقدموا وأذن بلال وأقام، لأنهم هم الكفاية الذين يحصل بهم هذا الأمر، وأما لو أنهم ناموا في الحضر، وقد أذن للصلاة، ثم قاموا فلا يجب عليهم الأذان، لأنه قد حصلت الكفاية بأذان غيرهم، والله أعلم.
ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: «إذا سافرتما»، يعني بذلك مالك بن الحويرث «فأذنا وأقيما وليؤمكم أكبركم».
أما الفرد، يعني الشخص الواحد، فيُستحبُّ له الأذان ولا يجبُ.
وأما قولنا: ولا يجب، لأن الأذان في حقه مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَعْجَبُ ربك من راعي غنم على شظِيّةِ جبل، يؤذنُ ويُصلي – يؤذن بالصلاة ويصلي – فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة”، وهذا الحديث رواه أهل السنن، وهو صحيح، فهذا يدل على استحباب الأذان في حق الفرد.
ولم نقل بوجوبه فرضا كفائيّا؛ لأن الأذان إنما هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، والفرد وحده.
ومما يدل على ذلك أيضا، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل عليه الأسود وعلقمة، فقال: أصليتما العصر، فقالا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: قوموا فأصلي بكم، قال: فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا وقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، والله أعلم.
أما الإقامة، فإننا نقول: هي فرض كفاية على الرجال المجتمعين للصلاة، وقال بعضهم – وهذا مذهب الحنابلة –: إن الإقامة فرضُ عين على الرجال المجتمعين للصلاة، وذلك لأنه لم يُعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة إلا بإقامةِ، سواءٌ كانت مقضية أم مُؤداة، مجتمعة مع غيرها أم بوقتها، فقد صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وصلّى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وصلى الظهر وحدها بأذان وإقامة، وصلى العصر وحدها بأذان وإقامة، وصلى الفجر في وقتها بأذان وإقامة، وصلى الفجر في غير وقتها بأذان وإقامة، مما يدل على أن الإقامة فرض عين على الرجال المجتمعين، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها بعض المحققين، وأظنه ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول ظاهر، والله أعلم.
أما النساء: فقال بعضهم: يجوز للمرأة أن تقيم ويستحب لها ذلك، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تقيم للصلاة، وقال بعضهم: إنما هو مباح.
والظاهر أن ابن تيمية يرى أن الإقامة فرض كِفاية، وعلى كل حال فإن القول بأنها فرض عين على الرجال المجتمعين قول قوي وهو الأظهر، لأنه لم يُعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها، وأما فعل بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود حينما كان هو وعلقمة والأسود، فصلى بغير أذان ولا إقامة، فهذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، خالفه غيره من الصحابة، والله أعلم.
وعلى كل فإذا لم يوجد إلا قول عبد الله بن مسعود، دل على أنه فرض كفاية، والله أعلم.
ما هي السنة عند المالكية وهل تختلف عنها عند غيرهم؟
ومن المهم جدا معرفة مصطلحات الأئمة: فإن بعض أهل العلم أطلق على الأذان والإقامة أنه سنة، فالمالكية يُطلقون على فرض الكفاية بأنه سُنة، بمعنى أن المالكية رتبوا الأمور والواجبات والمأمورات على: الفرض، ثم الواجب، ثم السنة، ثم الرّغِيبة، ثم النافلة، وهلُمّ جرّا.
فالسنة عند المالكية: أنه لا يأثم إذا تركها مرة واحدة، لكن إذا تركها مُطلقا فإنه يأثمُ، كما ذكر ذلك غير واحد من المالكية، وقد أشار صاحب “مراقِي السّعُود” إلى أن السنة عند المالكية أنه إذا تركها فإنه يأثم.
ولماذا جعلوها سنة؟ قالوا: لأن النبي داوم عليها، ولكن الأمر بها بدليل ظني.
وعلى هذا يخطئ بعضُ الباحثين حينما يجدُ المالكية ينُصُّون على السُّنِّيّةِ، فيظن أنها السُّنة في المصطلح المعروف عند غيرهم من أصحاب المذاهب: أي أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا ليس بصحيح، أرأيتم في الحج، فإن الحنابلة والشافعية ينصون على بعض الأعمال بأنها واجبة، وعلى بعض الأعمال بأنها سنة، ويقولون في السنة: إنه لا يجب لمن تركها جبره بدم، أما المالكية: فيجعلون الواجب وهو ما ثبت بدليل قطعي، يُجبرُ بدم، والسنة أيضا يُجبرُ بدم، أما المستحب عندهم فإنه لا يجبر بدم كما في طواف الوداع في حق الحاج عند مالك رحمه الله وابن المُنذِر.
فعلى هذا: فإذا قرأتم أيضا في صلاة الجماعة عند المالكية قولهم سنة: قصدهم بذلك ليس مثل قصد من ظن أنه يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، ولهذا قال ابن تيمية: “أنه من ترك صلاة الجماعة مطلقا فإنه يأثم بإتفاقِهم”، أو كلمة نحوها. والله أعلم.
حكم الإجارة على الأذان؟
الأذن إما أن يكون رزقا من بيت المال، وإما أن يكون تعاقدا بين الواحد وبين جهة معينة عقد إجارة.
أما إن كان الأمرُ رزقا من بيت المال، فإنه حينئذ يكون جائزا باتفاقهم، نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم، كالبُهُوتِي في “كشّافِ القِناع” وغيره من كتب الحنابلة. قالوا: لأن الرّزق إنما هو فيءٌ من مصالح المسلمين العامة، وقد كان أبو بكر يأخذ رزقا حين ولايته، وينبغي أن تعلم أن الرّزق المقصود به أنه يُعطى من بيت المال على أنه نوع من النفقة، لا علاقة له بشخصيته ولا علاقة له بشهادته ولا علاقة له بجاهه ومركزه؛ إنما يعطى لأجل أنه تفرّغ، فيُعطى مقدار معيشته، ولهذا اجتمع عمر رضي الله عنه مع عليّ حينما رأيا أبا بكر وهو خليفة المسلمين يذهب إلى السوقِ، فقالوا: يا خليفة رسول اللهِ، لا تذهب، قال: فاتفقوا على أن يُعطوه نِصف شاة، إما كل أسبوع أو كل شهر. لأنهما رأيا أن ذلك نفقته، هذا من غير ماله الذي يكتسبه ويتاجر فيه.
وهذا يدلُّ على أن هذا هو الرّزق، وأما الذي في النظام عندنا الآن، فالذي يظهر لي أن الرواتب التي يُعطاها المؤذنون عن طريق وزارة الشئون الإسلامية أو وزارة الأوقاف أو الوزارات؛ ليست من باب الرّزق، لأن الرّزق إنما هو نوع من النفقة، وأما هذه فإنها على فئات، فئة أ، وفئة ب، وفئة ج، وهي تختلف على حسب الأحياء وقربها من المدن الكبيرة والصغيرة.
الثاني: أن لها مخصصات، فلو أن إنسان تقاعد وتركها فيستطيع أن يطالب بالبقية التي اختُزِلت له، ولو كانت رزقا؛ لما جاز له أن يُطالب.
وفي بعض الدول يكون المؤذن موظفا مثله مثل الموظف في وزارة الخدمة المدنية، فهذا عقد إيجار، لكن مع من؟ لأن الدولة أصبحت في مجتمع مدني تتعاقد مثلما يتعاقد الأفراد والشركات؛ لإعتبارِ الجهة الشخصية، وعلى هذا فمدرس الدروس الدينية الآن، تعاقده مع الجامعات إنما هو عقد إجارة، لا يُقال إنه رزق؛ لأن الأوقات اختلفت.
ولهذا أقول: إن عقد الإجارة في الأذان الراجح جوازُه، والله أعلم.
وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وأكثر الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد خلافا للمشهور عند الحنابلة وأبي حنيفة، فإنهم منعوا الإجارة في كل ما هو قُربة، واستدلوا على ذلك بما رواه أهل السنن كأبي داوود وابن ماجة والتِّرمِذِيّ، عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واتخِذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»، وجه الدلالة أن النبي حثّ عثمان على ألا يأخذ الواحد على أذانه أجرا.
فالجواب على هذا أن يقال: المقصود بالأجر هو المال سواء كان بِعِوَض أو ليس بعوض، وليس المقصود الأجر الذي هو مُعاوضة. ثانيا: أن هذا ليس فيه ما يدل على النهي أي أن من أخذ فإنه يأثم، ولكن فيه أن المؤذن الذي يحتسب الأجر على الله أفضل من المؤذن الذي يأخذ على ذلك أجرا.
ومما يدل على جواز ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره ومن حديث أبي سعيد في قصة اللّدِيغ الذي لُدِغ فجاء أحد الصحابة فتعاقدوا معهم على إنهم إن رقوه فشفي فلهم قطيع من الغنم، فرقاه أحدهم بالفاتحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه: «وما يدريك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم». يعني خذوا القطيع لأنه شُفي بإذن الله بسبب رقية هذا الصحابي. وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بجوازِ الأخذِ بسبب القُربة وهي الطاعة، وهي القراءة، فدل ذلك على جواز أخذ المال على القُرَبِ.
وأما من قال من الفقهاء إن ثمة فرق بين الجِعالةِ والإجارة، فالجواب: نعم هي جِعالةِ، ولكن الجامع هو أنه أخذ شيئا من المال لأجل قربته، سواء أخذها عن طريق الإجارة أو أخذها عن طريق الجعالة، لأن كلاهما من باب عقود المعاوضات، والله أعلم.
إذن لا بأس أن يأخذ الواحد الأجر على الأذان، ذلك جائز، لكن الأفضل منه أن يحتسب الأجر على الله.
وهل ينقص أجره إذا أخذ أجرا؟
الجواب: الناس مراتب، فقد قال صلى الله عليه وسلم «ما من غازيّة أو سرِيّة تغزو فتُصابُ إلا قد تمّ لهم أجُورهُم، وما من غازية تغنم إلا قد تعجلوا ثُلُثي أُجُورِهِم». فدل ذلك على أن الواحد الذي يأخذ من مغانمه بسبب خيراته، فإن ذلك يُنقص أجره، ولكن لا يدل على ضعف إخلاصه، وإن كان الواحد ينبغي له أن يراقب الله في هذا الأمر، وألا يكون همه هو المال دون الطاعة، بل يكون المال وسيلة لإعانته على الطاعة، ولهذا ما أجمل ما قال ابن تيمية: “من حجّ ليأخُذ غير من أخذ ليحُج”. يعني: من أخذ ليحج يكون قصده الطاعة، ويكون المال بذلك معونة له على ذلك، أما من حج ليأخذ فلو يُسِّرَ له الحج من غير عِوض لما حج، فهو جعل الحج للعِوض، قال: فهذا لا خلاق له في الآخرة. فهنالك فرق كبير بين الأمرين، والله أعلم.
ما الذي يستحب في المؤذن؟
يستحب في المؤذن أمور منها:
أولا: أن لا يأخذ أجرا على أذانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»، فهذا على سبيل الاستحباب والأفضلية.
الثاني: أن يكون أمينا عدلا، لأن الناس ائتمنوه على دخول وقت الصلوات، وإذا لم يكن أمينا؛ فإنه ربما يؤذن قبل الوقت فيجعل الناس يفطرون مثلا قبل الوقت، فه مؤتمن في هذا الأمر.
الثالث: أن يكون عالما بالوقت، فأما من لا يحسن الوقت وفيه عجلة وطيش، فهذا لا يصلح أن يكون مؤذنا.
الرابع: أن يكون رفِيع الصوت، لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أن أبا سعيد الخدري قال له: «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالأذان»، فارفع صوتك بالأذان. رواه البخاري.
الخامس: أن يكون صوته ندِيـّا، يعني فيه نوع من الجمال، فيه نوع من الطلاوة والحزن والجمال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «قم فألقه على بلال فإنه كان أندى صوتا منك».
إن تَشَاحّ شخصان كل منهما يقول: أريد أن أؤذن أيهما نختار؟
قُدِّم أحسنهما صوتا ومواظبة وأكثرهما تميزا في غيرها من الصفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه للأذان، لم يقل: قم فألقه لأبي بكر أو لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، ولم يذكر كبار الصحابة، ولا العشرة المبشرين بالجنة، بل اختار بلال وهو الأنفع له، فقال: “فإنه كان أندى صوتا منك”.
فإن تساويا؛ يعني كل واحد حسن الصوت، فقال بعضهم: على ما يختاره الجيران، قالوا: لأنه هو الذي يناديهم إلى الصلاة، فإذا كانوا يحبونه ويرتاحون لصوته، فإن ذلك مدعاة إلى أن يتعجلوا الخروج إلى الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية، وهذا القول قوي.
وقال بعضهم: لا، بل يُقرعُ بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهِمُوا عليه – يعني يقترعوا بينهم – لأستهموا عليه»، والذي يظهر أن القُرعة إنما تُشرع حال عدم الترجيح، أما إذا كان ثمة ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر فهو المقدم، والله أعلم.
ما هي جُمَل الأذان؟
هنالك فرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، وأبو محذورة هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح، وكان شابا صغيرا حسن الصوت، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسن صوته، علّمه الأذان وأمره به، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة.
وقد علمه أذانا غير أذان بلال، وبلال كان يؤذن قبل الفتح وبعد الفتح أيضا، ولأجل هذا اختلف أهل العلم، أي الأذان أفضل أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟
فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن أذان بلال أفضل.
وذهب الشافعي رحمه الله، إلى أن أذان أبي محذورة أفضل.
أما مالك رحمه الله فله أذان خاص، حيث أنه يرى أذان بلال لكنه لا يرى التكبير إلا مرتين، وأما أذان بلال فهو خمس عشرة جملة، وإذا حذفنا التكبيرين من الأول والتكبيرين من الأخير فيكون الأذان الذي يرى مالك: أحد عشر جملة، وهذا هو اختيار مالك في الأذان. وهو (أذان المالكية):
الله أكبر، الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلا الله
وعلى هذا فإن مالك رحمه الله بسبب أن رواية أحد الرواة وهو إسحاق إبراهيم، أشارت إلى أن التكبير مرتين، واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه، قال: “أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”، فقال: وشفعُ الأذان بأن يقول التكبير مرتين، وأما إذا قال مرتين مرتين، فليس بشفع.
والذي يظهر أن هذا الحديث إنما ذكر على سبيل الإجمال، وإلا فإن الصحابي الذي رأى الأذان وعلّمه بلالا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: «إنها رؤيا حق»، علمه أن يقول الأذان الذي من 15 جملة (وهو أذان بلال ومقداره 15 جملة):
الله أكبر .. الله أكبر
الله أكبر .. الله أكبر
أشهد ألا إله إلا الله
أشهد ألا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
الله أكبر .. الله أكبر
لا إله إلا الله
وأما الشافعي رحمه الله فإنه يرى أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة هو مثل أذان بلال، إلا أنه يقول بعد التكبيرات الأربع، يقول ويُسمع ما بينه وبين من بجانبه والقريب ومن حوله: أشهد ألا إله إلا الله.. أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.. أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يَرجعُ أي يُعيد، فيقول بصوت عال مثلما يقول في الأذان المعتاد: أشهد ألا إله إلا الله .. أشهد ألا إله إلا الله.
وهذا يسمى التّرجِيع، إذن الترجيع هو أن يقول الشهادتين مرة بصوت منخفض بحيث يُسمع نفسه ويسمع من بجانبه، يقولهما مرتين مرتين، ثم يقوم ويرفع صوته ويقول: أشهد ألا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يقول: حي على الصلاة .. حي على الصلاة.. حي على الفلاح .. حي على الفلاح.. الله أكبر .. الله أكبر.. لا إله إلا الله.
فإذا كان كذلك فكم تكون جمل أذان أبي محذورة؟
تسع عشرة جملة، وهذا هو الذي ثبت عند أهل السنن وصححه التِّرمِذِيّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان تسع عشرة جملة.
وأما الإقامة، فقد علّمه سبع عشرة جملة، وهو نفس إقامة بلال إلا أنه زيد فيه الإقامة:
قد قامت الصلاة .. قد قامت الصلاة.
ولأجل هذا نقول: اختلف العلماء في أي الإقامة أفضل؟
فذهب الشافعي ومالك وأحمد في الجملة إلى أن الأفضل إقامة بلال بأن يقول (11 جملة):
الله أكبر .. الله أكبر
أشهد ألا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة
الله أكبر .. الله أكبر
لا إله إلا الله
وذهب أبو حنيفة إلى أن إقامة أبي محذورة أفضل، وعلى هذا تكون إقامة أبي محذورة سبع عشرة جملة.
ومالك رحمه الله وإن كان يختار إقامة بلال، إلا أنه يرى في الإقامة أن التكبير مرة واحدة، لقول أنس: “أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”، فيقول: الله أكبر مرة، فإقامة مالك (تسع جمل)، وهي:
الله أكبر
أشهد ألا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة
الله أكبر
لا إله إلا الله
والذي يظهر والله أعلم أن هذا فهمٌ من بعض الرواة في الاختصار، والراجح أن إقامة بلال هي أحد عشر جملة، وهذا هو الراجح والله أعلم .
أيهما أفضل أذان بلال أم أذان أبي محذورة؟
الذي يظهر أن كل ذلك من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علّم بلالا الأذان بالوحي، وقال: «إنها رؤيا حق»، وعلّم أبا محذورة الأذان كذلك، وكله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأذان بلال فضيلة وكذلك أذان أبي محذورة فضيلة، وإن كانت الفضائل تتفاوت كما قال تعالى ﴿الّذِين يستمِعُون القول فيتّبِعُون أحسنهُ﴾ [الزمر: 18]، فيكون أذان بلال هو الدائم وهو الغالب، لأنه هو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وقد تكلم فيها الإمام الحافظ ابن رجب في كتاب “القواعد”، وهي:
أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، اختلف العلماء فيها، والأفضل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله هو أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ولا بأس إن كان الغالب على فعله أحد هذه الأشياء، لكن لا بد أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة.
لماذا؟
قالوا: لإحياء السنن، فإننا إن فعلنا هذا مرة وهذا مرة، نكون قد فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع المداومة على أحدها في الغالب.
والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح يقول هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الغالب عليه من فعله حينما سأله أبو هريرة: ما هذا السكوت الذي تسكت بين التكبير والقراءة؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي»، وإن قال: «سبحانك اللهم..» كما رُوي عن عمر وصح عنه، وقاله على محضر من الصحابة، فسواء قال هذا أو قال هذا، كله جائز.
وقد قال ابن تيمية: ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وإن كان لو فعل واحدا في الغالبِ الأكثر، لا حرج، يقول: لأننا بذلك نكون قد فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ولأن الفعل الواحد المداوم عليه ربما يقوله الواحد على سبيل العادة، لكنه إذا قال هذا مرة وهذا مرة، فيكون فيه من الاستحضار القلبي والخشوع في النفس ما لا يكون في الاعتياد على دعاء واحد.
والمسألة مسألة خلافية، لكن ومع قولنا بأن كلاهما جائز، فإننا نقول: ينبغي للمؤذنين ألا يخالفوا الأذان المعتاد في البلد؛ لأن بعض الناس وبعض العامة ربما لا يُدرك مغزى هذه المسائل، ومغزى هذا الخلاف، لكننا نخبر الناس ونبين للناس حتى إذا ذهبوا من بلد إسلامي إلى آخر، لا يستغربوا، وليعلموا أن هذا مسألة خلافية، فلو أننا ذهبنا مثلا إلى بلاد المغرب الإسلامي ووجدنا أنهم يؤذنون بأذان مالك، وأراد أحدنا أن يؤذن، وطُلب منه أن يؤذن، فليس من الحكمة أن يؤذن بالأذان المعتاد لأن الناس ربما يظنون أنه قد أخطأ، لأنهم تربوا على ذلك.
ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله بيّن أنه أحيانا الذي تربى على أمر معين يصعب عليه تركه، لكن أهل العلم وكبار العلماء وطلبة العلم الذين لهم حظوة وقبول عند الناس، ينبغي أن يبينوا للناس بين الفينة والأخرى ما هو السنة، حتى ينتشلوا الناس من الأمر المفضول إلى الأمر الفاضل، وكل على خير إن شاء الله، فهذه من المسائل التي اختلف أهل العلم، وكل واحد منهم له قول فيها.
وعلى هذا فإذا كانوا شباب وجماعة ذهبوا في رحلة، وأحب أحدهم أن يؤذن بأذان أبي محذورة إذا كان البلد اعتاد أن يؤذن أهله على أذان بلال، فلا حرج، فقد طبّق السنة، فيخبرهم بطريقة الأذان، وكذلك بإقامة أبي محذورة، ولا حرج إن شاء الله.
أما أن يأتي الأمر غلابا في مخالفة ما كان الناس قد اعتادوا عليه، فهذا ليس من الحكمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر، لبنيت الكعبة على بابين» الحديث. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد ترك السنة لأجل ألا يشغِب على قلوب الناس، وهم حديثو عهد بكفر، فربما قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم لا يعظم البيت.
أيهما أفضل في الأذان أن يقول الله أكبر جملة جملة أم جملتين جملتين؟
أي أن يقول جملة جملة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (الفاصلة تعني يصمت قليلا)، أم يقول جملتين جملتين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر؟
هذا من باب الفضيلة، بعضهم استدل بأنه يقول: الله أكبر مرة، جملة جملة، واستدلوا بما جاء عند عبدِ الرّزّاقِ أن إبراهيم النّخعِي، قال: كانوا يستحبون التكبير جَزْمُ، ومعنى جزم: يعني يُسكِّن ولا يُحرِّك، لأنه إذا حرك، قال: الله أكبرُ الله أكبر، فإذا كان التكبير جزم قال: الله أكبرْ وسكت. فهذا استدل به بعض أهل العلم ورُوي عن ابن عمر رضي الله عنه، ومعنى جزم أن لا يمده ولا يُعرِب آخره كما يقول شُراح الحديث كالبغوِي، وغيـره.
والقول الثاني في المسألة: قالوا الأفضل أن يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني جملتين، جملتين، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم، من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله، قال: أشهد ألا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله… من قلبه دخل الجنة». فقالوا أن هذا دليل على أن الأذان جملتين جملتين.
والذي يظهر أن عندنا قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع لنا أمرا مسنونا، ولم يبين لنا صفته، دل على أن كل صفة يُفعل بها جائزة. وعلى هذا فسواء أذن المؤذن الله مرة، أو جمع بينهما، الكلٌّ جائز.
ما الذي يستحب عند الأذان؟
يستحب فيه أمور:
الأول: حال الأذان، أن يرتله، وأما في الإقامة فإنه يَحْدُر.
أما الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، كما عند أهل السنن: «اذهب فألقه على بلال، فإنه أندى صوتا منك»، وهذا يدل على أن بلالا كان ندي الصوت، ويقوله مُترسِّلا.
وأما الإقامة، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يحدُر الإقامة، وليس ثمة شيء مشروع أو ثابت في السنة إلا ما رواه أحد الرواة عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا أراد أن يقيم يحذِم الإقامة، ومعنى يحذم يعني يُسرع في الإقامة، يعني لا يترسل فيها، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب.
الثاني: يستحب للمؤذن أن يكون قائما، وهذا السنة، واستدل أهل العلم على ذلك بأن قالوا: إن المَلَك الذي علم عبد الله بن عبد ربه الأذان قام في المسجد ثم جلس بعد الأذان، ثم قام ومشى بعد الإقامة، قالوا: فهذا يدل على أن المؤذن إنما يؤذن حال القيام.
واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قم فألقه على بلال».
ومن الأدلة أيضا، أن أهل السنن رووا أن بلالا كان يرقى بيتا لبني النجار ويؤذن، وهذا يدل على أنه كان قائما، وهذا هو السنة؛ لأن الأذان المقصود به إعلام الناس بالأذان، وتطبيق السنة في الغالب أن يكون قائما، فإن أذن قاعدا فلا حرج، لكن السنة هي القيام.
الثالث: أن يكون متطهرا، فبعض الناس ربما يؤذن على غير طهارة.
فنقول: إذا كان المؤذن سوف يؤذن في المسجد، فلا بد أن يكون طاهرا طهارة من الحدث الأكبر، لأنه سوف يدخل المسجد.
وأما إذا كان مُحدثا حدثا أكبر، وليس داخل المسجد، كأن يكون هنالك ميكروفون عنده في بيته، فإذا أذن في الفجر فلا حرج لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله أو أحيانه.
وأما إذا كان حدثا أصغر، فلا حرج أن يؤذن، وإن كان الأفضل أن يؤذن على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر» كما جاء في حديث أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، وكما رُوي عن ابن عمر أيضا عند أهل السنن وأحمد.
الرابع: يستحب للمؤذن إذا أذن أن يستقبل القبلة، وليس فيه حديث صحيح صريح.
وأما حديث بلال، فإن في سنده الحجاج بن أرطأة، قال: «فقام مستقبل القبلة»، ففي سنده بعض الضعف، لكن أصح شيء في الباب أن المَلَك الذي قام يؤذن ليُعلم بذلك عبد الله بن عبد ربه، كان مستقبل القبلة، كما جاء ذلك عند أهل السنن وأحمد.
الخامس: أن يجعل يديه على أذنيه، وبعضهم قال: أن يدخل أصبعيه في أذنيه.
والذي يظهر هو أن رواية أن يدخل أصابعه في أذنيه فيها نكارة وضعف، أما الضعف فلأن عون بن أبي جُحيفة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من النبي، وأما الأذان المعروف فرواه عون بن أبي جُحيفة عن أبيه. الثاني: أن فيه علة الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، ولا يصح.
وأما وضع اليدين، فالذي يظهر أنها رواية ثابتة، وهو قوله: «ويداه في أذنيه»، وقد ضعفها بعض أهل العلم، والأقرب أنها رواية صحيحة.
وبعض أهل العلم قال: يضع يدا واحدة. وهذا ليس معروفا عن الصحابة، وإنما رُوي عن محمد بن سِيرين وغيره.
والذي يظهر أن وضع اليدين على الأذنين سنة، لأن وضعهما يجعل النّفس ترفع الصوت بالأذان، وهذا أمر مجرب معروف، فيزيد بذلك في الصوت.
وقال بعضهم: أن هذا بما أنه لحكمة، وهي رفع الصوت، فإذا كان عنده ميكروفون، فهو منتفي.
ولكن نقول: وضع الأذنين ولو لم يسمعه الناس يُعلم منه أنه قد أذن، والحكمة في هذا معلومة.
وعلى كل المسألة مسألة استحباب، فسواء وضع أو لم يضع، فإن أذانه صحيح.
إذن: على هذا، فالسنة في حق المؤذن أن يضع يديه على أذنيه.
السادس: استحبوا أن يلتفت في الأذان في الحيعلتين، وأما الاستدارة مثل ما يفعله بعض المؤذنين فلا.
يعني السنة أن يقول مثلا حي على الصلاة، مرة من هنا، ويقولها مرة من هنا، يُدِيرُ رأسه. أو يقول حي على الصلاة مرتين من هنا، وحي على الفلاح مرتين من هنا، كل ذلك جائز.
وأما أن يقول: حي على الصلاة، هكذا، فإن الحديث الوارد فيه «فأدار على صدره» ضعيف، في سنده رجل يقال له الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس. وعلى كل حال هذا على سبيل الإستحباب.
وقد يُقال يفعل هذا إذا كان الناس ذات اليمين وذات الشمال، لأن الراوي حينما ذكر أذان بلال، لم يذكره حال المسجد وإنما ذكره في حال سفره، ومن المعلوم أن السفر ربما يكون بعض الصحابة عن يمينه وبعضهم عن يساره.
وأما في الميكروفون، فأرى ألا يلتفت، لأن الالتفات سوف يقلل من الصوت.
وعلى هذا فإذا كان في فضاء؛ فإنه يلتفت لأجل الإسماع، فالمقصود من الحكمة من ذلك هو الإسماع وليس التعبد، وعلى هذا فإذا كان أمامه ميكروفون فإنه لا يلتفت.
وقال بعض الفضلاء: يلتفت ويبتعد عن الميكروفون بحيث يحصل على فضيلتين.
ولكن هذا إنما كان لأجل الإسماع، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا بذلك، فالمعروف أن بلالا كان يفعله، وهذا تقرير، والتقرير يدل على الجواز، ولا يدل على الاستحباب المطلق.
فالذي يظهر أن وضع اليدين على الأذنين والإلتفات وغير ذلك، كله إما أن يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بفعله هو وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدل على الجواز.
كما أن بلال لم يكن من عادته أنه كان يصنع ذلك، ولذلك لم يرو هذا الالتفات بإسناد صحيح إلا رواية عون بن أبي جحيفة عن أبيه، فدل ذلك – وهو في غزوة أو سفر- على أن الواحد إن فعله أو لم يفعله، فكل ذلك جائز، والله أعلم.
السابع: ويستحب له أن يقول في الفجر “الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم”.
وقد أجمع أهل العلم على أن جملة “الصلاة خير من النوم”، لا تقال إلا في أذان الفجر، وهذا يسميه أهل العلم بالتّثوِيبِ.
وهناك شيء يسمى التثويب غير الصلاة خير من النوم ما هو؟
«إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله ضُراطٌ حتى إذا قُضِي التأذين أقبل حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر»، فالتثويب يسمى أيضا إقامة، ويسمى أيضا “الصلاة خير من النوم”.
وجماهير أهل العلم من المالكية والحنيفية والحنابلة والشافعية في القديم من قوليه، أنه يستحب أن يقول ذلك في أذان الفجر.
واختلف أهل العلم في أي الأذانين يقولها؟
فمن المعلوم أن صلاة الفجر يؤذن بأذانين، أذان قبل الوقت وأذان بعد الوقت، فهل يقول: “الصلاة خير من النوم” في الأذان الأول الذي هو قبل الوقت أم يقولها في الأذان الثاني؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والراجح هو أنه يقولها في الأذان الثاني، وذلك لعدة أدلة:
أولا: لأنه روى البيهقي وصححه من حديث أنس أنه قال: “من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم”، ومن المعلوم أن أذان الفجر الأصل فيه هو الأذان الثاني، الذي هو أذان دخول الوقت.
ثانيا: ما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي محذورة، أنه قال: «فإذا كانت صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم»، ومن المعلوم أن الأذان قبل الفجر لا يسمى صبحا، وإنما الصبح هو الفجر الثاني، هذا هو الظاهر، والله أعلم.
وأما رواية «فإذا أذنت الأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم»، فقالوا: أذنت الأول من الصبح، هو الأذان الأول. والصحيح أن الأول من الصبح يُقصد به الأذان الأول لأن الإقامة مع الأذان تسمى أذانا، فهذا هو المقصود، والله أعلم.
ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت»، فهذا يدل على أنها تُقال في الثاني، وهو الصبح، والله أعلم.
وعلى هذا فالسنة في قول: “الصلاة خير من النوم” أن يكون في الأذان الثاني.
ثم اعلم كما هو معلوم أن التثويب في غير الفجر غير مشروع، بل نص بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك من البدع، وقد روى مجاهد عن ابن عمر أن رجلا أذن فلما رأى الناس قد تأخروا نادى بالصلاة قبل الإقامة، فخرج ابن عمر من المسجد يقول: “أخرجتني البدعة أخرجتني البدعة”.
وهذا يدل على أنه لا يشرع للمؤذن إذا رأى الناس قد تأخروا أن يأخذ الميكروفون ويقول: “أيها الناس تعالوا إلى الصلاة، ولا تتأخروا، أو اتركوا النوم، أو أيها الوالي، أو أيها السلطان.. إلخ”، فكل هذا ليس بمشروع، لأنه نوع من الفعل الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المُقتضِي والسبب في ذلك، فلما لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضِي لذلك دل على أنه غير مشروع.
ما هي شروط صحة الأذان؟
الأول: أن يؤذن مؤذن واحدٌ مُرّتّبا، فلو أذن بعض الناس في أول الأذان وجاء الآخر فأكمله فهذا لا يصح.
فلو قال واحد: أنا أؤذن إلى الشهادتين وأنت تؤذن الباقي، فهذا لا يصح. بل نقل بعضهم كالمِرداوِي، قال: “بغير خلاف أعلمه عن أحد” أو كما قال رحمه الله.
وأيضا أن يؤذن مرتبا، فلو قال: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح… فهذا لم يؤذن مرتبا.
فالصحيح والله أعلم أن هذا الأذان الغر مرتب لا يصح، لأنه صار من جملة الأذكار، فهو مثل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
وقد عَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بهذا الترتيب، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه كان يؤذن من غير ترتيب.
الثاني: أن يؤذن عدل، فلا يؤذن فاسق أو شارب خمر.
والمقصود بأن يؤذن عدل، الأذان الواجب الذي به تُرفع الكلفة عن الناس، ولهذا قال ابن تيمية: “لا ينبغي أن يُوّلى على الأذان فاسق”. والفسق هو على حسب كل بلد، فإنه ربما يكون في بلد فاسق وفي بلد آخر ليس بفاسق عندهم، وإن كان هو محرم.
ومن المعلوم أن الأذان أمر شرعي، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الإقامة ولا الأذان للفاسق، والذي يظهر أن كل من صحت إمامته صح أذانه، فإن الإمامة أعظم، فإذا صحت إمامة الفاسق، فأذان الفاسق من باب أولى. فالصحيح والله أعلم، أن أذان الفاسق صحيح إذا كان يعلم الوقت، خلافا لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله.
الثالث: يجب أن لا يتكلم بكلام كثير بينهما، ولا بكلام محرم ولو قل.
فلا يجوز أن يؤذن كلمتين ثم يغتاب، فإن بعض أهل العلم قال: يبطل أذانه لأنه قال محرما بين الأذانين.
وأما إذا تكلم وأكثر من الكلام، فيقولون: يبطل، أما الكلام اليسير الذي يُسمِعُ من بجانبه لحاجة، مثل أن يقول: افتح المكيف أو اقفل الباب بهدوء، بحيث يسمعُهُ من بجانبه، فإذا كان ذلك لحاجة فلا حرج، ومع ذلك فإنه يُكره أن يتكلم ولو كان يسيرا.
أما الكلام الكثير الذي بحيث إذا سمعه الآخرون لم يروا ذلك أذانا كأن يقول جملة من الأذان وجملة من كلام الناس، وهكذا؛ فإن هذا لا يُعد أذانا، وعلى هذا فإن الكلام الكثير يُبطل الأذان، وأما الكلام اليسير فإنه معفو عنه، وإن كان الأفضل عدمه، أما الكلام المحرم فيبطله ولو كان قليلا، والله أعلم.
الرابع: أن يؤذن في الوقت.
أجمع أهل العلم على أنه لا يصح للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت إلا في الفجر خاصة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت»، فهذا يدل على أن بلالا كان يؤذن قبل الوقت.
وأما غير الفجر من الصلوات الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن ذلك لا يصح ولا يجوز.
وأما لو تأخر عن الوقت، يعني دخل الوقت ولم يؤذن، فإذا كان ذلك لحاجة مثل أن يكون الناس مجتمعين وأحبوا أن يجمعوا الظهر مع العصر في وقت العصر، أو أحبوا أن يُبردوا بالصلاة مثل شدة الحر في الصيف، فإنه لا بأس إذا كانوا جماعة أن يؤذنوا في وقت ليس في أول دخول الوقت، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، قال: “كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد أبرد إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة”. قال أبو ذر: “حتى رأينا فيء التلول”، وهذا يدل على أنه لا بأس بتأخير الأذان إذا كانوا جماعة ويريدون فعل السنة في تأخير صلاة الظهر للإبراد.
وأما في مساجد المسلمين وفي الأمصار وفي المدن، فإنه ينبغي أن يؤذن في الوقت؛ لأجل أنه ربما تكون ثمة امرأة في بيتها تنتظر الأذان، وغير ذلك إذ تختلف طبيعة حياتنا اليومية عن حياة السلف التي كانت بسيطة بلا تعقيد.
ويجب العلم بأن الأذان الأول لصلاة الفجر لا ينبغي الإقتصار عليه، وأنه إنما يسوغ إذا كان سوف يؤذن أذانا ثانيا، والحنابلة في أحد أقوالهم يقولون: لا بأس بالأذان الأول ولو اكتُفي به.
والراجح أن بلالا إنما كان يؤذن قبل الفجر؛ لأنه كان يؤذن بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلال يؤذن ليُرجع قائِمكُم وينبه نائمكم»، وأما الاقتصار على الأذان قبل الفجر فقط فهذا ليس بمشروع، فإن السنة أن يؤذن أذانين أو يؤذن أذانا واحدا بعد دخول الوقت، أما أن يؤذن أذانا واحدا قبل دخول الوقت فهذا ليس بمشروع.
ثم اعلموا أن الأذانين يستحب ألا يكون الفاصل بينهما طويلا فإن بعض الناس ربما يؤذن بعد منتصف الليل، فبعض الحنابلة وهو المذهب، قالوا: يؤذن بعد نصف الليل.
والذي يظهر هو أن يكون الأذان بينهما يسيرا، إما ساعة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، خمس وأربعين دقيقة أو أقل أو أكثر، يعني أكثر من ربع ساعة، أما أن يكون بينهما ثلاث ساعات؛ فالظاهر أن هذا ليس من السنة، وذلك لأمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال: «إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم»، يعني يُرجع القائم، يقول: انتبه سيؤذن الفجر، يعني أوتر، فالقائم لقيام الليل حينما يسمع أذان بلال يعلم أن دخول الوقت قد أزف واقترب، فبذلك يستعد للوتر.
ولو قلنا بأنه يؤذن بعد منتصف الليل، فإنه لم يُشرع بعدُ الأفضلية في قيام الليل أنه عند ثلث الليل الأخير، فكيف يقول: «يرجع قائمكم وينبه نائمكم»؟
الثاني: أن ابن مسعود، الراوي لهذا الحديث، قال: “ولم يكن بينهما – يعني بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم-، إلا أن يرقى هذا، إلا أن يصعد هذا وينزل هذا” يعني يصعد ابن أم مكتوم وينزل بلال.
فالوقت بينهما يسير، ربع، أو ثلث، أو نصف ساعة تقريبا، والله أعلم.
إذن السنة أن يؤذن في أول الوقت، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال: “كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس” يعني للظهر.
من مصدر آخر (CG):
ما الحكمة من تشريع أذانين لصلاة الفجر؟
وردت السنة النبوية بتشريع أذانين لصلاة الفجر، أحدهما قبل دخول الوقت، والثاني عند دخول الوقت، والحكمة من ذلك كما جاءت في الأحاديث وكلام الفقهاء تتلخص في الأمور التالية:
تمييز وقت السحور وتنبيه الصائمين:
ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم” (رواه البخاري ومسلم). وفي الحديث دلالة على أن الأذان الأول للفجر كان قبل دخول الوقت، وحكمته إعلام الناس بقرب الفجر ليتهيؤوا للصلاة والصيام.
تنبيه النائمين للاستعداد للصلاة:
جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم” (رواه مسلم). أي أن الأذان الأول ينبه النائمين ليستعدوا لصلاة الفجر، بينما الأذان الثاني يؤذن عند دخول الوقت.
اعلام من يتهجد – صلاة القيام – بأن وقت صلاة الفجر قد اقترب:
قال بعض العلماء إن الأذان الأول لينبه من يريد قيام الليل أنه قد بقي من الليل قليلا فليوتر ويتهيأ لصلاة الفجر، أما الأذان الثاني فهو لإعلام بدخول الوقت الحقيقي للصلاة.
أقوال الفقهاء في الأذانين لصلاة الفجر:
1- المذهب المالكي:
قال الإمام ابن عبد البر في “الاستذكار” (2/69): “الأذان الأول للفجر مستحب لإيقاظ النائم وتنبيه الساهي وإعلام القائم بقرب الفجر”. أي أن المالكية يرون استحباب الأذان الأول لهذا الغرض، لكنه ليس واجبًا، فالمهم هو الأذان عند دخول الوقت.
2- المذهب الحنفي:
جاء في الفتاوى الهندية (1/51): “الأذان الأول للفجر سنّة مستحبّة، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويُؤذَّن به في غير وقت الصلاة لتنبيه من يريد الصيام أو القيام”. أي أن الحنفية يرون أنه ليس أذانًا للصلاة بل هو إعلامي فقط.
3- المذهب الشافعي:
قال الإمام النووي في “المجموع” (3/111): “يستحب أن يكون للفجر أذانان، أحدهما قبل الفجر، والآخر عند طلوع الفجر الصادق، كما ثبت في الحديث الصحيح”. فالشافعية يعتبرونه سنّة مستحبّة ومقصده التنبيه للصيام والصلاة.
4- المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة في “المغني” (1/423): “يستحب الأذان الأول للفجر، لما ورد في السنة أن بلالًا كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الوقت”. فالحنابلة يرون أنه مستحبّ لكنه ليس واجبًا، ومعمول به في كثير من البلدان. انتهى المصدر الخارجي.
من جمع لصلاتين أو لفوائت، فما يصنع؟
يعني من فاتته فوائت، فإن السنة في حقه أن يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة أذانه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: “فأمر بلالا فأذن ثم أقام للظهر وأقام للعصر ولم يؤذن”، فأمر بلالا أن يؤذن مرة ويقيم مرتين، وهذا هو السنة والله أعلم.
وأما رواية ابن عمر كما عند مسلم أنه “أقام مرة وأذن مرة”، فهذا فهم من ابن عمر، لعله لم يسمع الإقامة الثانية، وإلا فإن الظاهر أنه يقيم لكل صلاة. وقد قلنا في المسألة أن الإقامة للجماعة الصحيح والأقرب أنها فرض عين، وأما للشخص فإنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الإقامة في كل صلاة صلاها مع أصحابه، والله أعلم.
ما الذي يستحب لمن سمع المؤذن؟
يستحب لمن سمع المؤذن أمور:
أولا: أن يقول مثلما يقول.
فإذا قال الإمام “الله اكبر الله أكبر” قال المستمع: “الله أكبر الله أكبر”، وعلى هذا فقس، إلا في الحيعلتين، يعني “حي على الصلاة حي على الفلاح”، فإنه يقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر، أنه قال: “قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: حي على الفلاح، قال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله”.
والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم.
ثانيا: أن يقول عند سماعه للأذان، أو عند الشهادتين: “وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا”، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا».
وجاء في رواية أبي عوانة أنه يقول ذلك عند الشهادتين، ولكن فيها بعض الضعف.
والذي يظهر أنه يقوله إما حين يسمع المؤذن وإما عند الشهادتين وإما بعد انتهاء المؤذن، لأن هذا كله يصدق عليه حين يسمع المؤذن، وإن كان إدراكه عند الشهادتين أقرب للسنة، والله أعلم.
ثالثا: يستحب له أيضا أن يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي».
وهذا هو السنة. أول شيء: يقول مثل ما يقول المؤذن. ويقول في الحيعلتين. ثم يقول: وأنا أشهد ألا إله إلا الله. ثم يقول: اللهم صل على محمد. ثم يقول: “اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته”، هكذا يقول. وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر، وأما زيادة “إنك لا تخلف الميعاد” فقد رواها البيهقي، وفي بعض نسخ البخاري، وهي رواية الكُشمِيهنِي، والصحيح أنها لا تصح في رواية البخاري، وأن الرواية أيضا لا تصح، فإن في سندها رجل يُقال له علي بن يزيد البارِقِي، وقد وهِم في هذه الزيادة، والصحيح أنها ليست من السنة. فإن قالها أحيانا فلا حرج، لكن لا ينبغي الاعتياد على أنها من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اعلم أنه في الصلاة على النبي، إما أن يقول: “اللهم صل على محمد”، وإما أن يقول: “اللهم صل وسلم على رسول الله”، وإما أن يقول الصلاة الإبراهيمية بأن يقول: “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد”، والأفضل في الصلاة على النبي أن يُصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية، والله أعلم.
رابعا: ثم بعد ذلك يدعو.
ولكن الدعاء جاء في حديث عند التِّرمِذِيّ وغيره: «ثم سلوا العفو والعافية»، ولكنه حديث ضعيف.
ومما يدل على جواز الدعاء ما جاء من بعض الروايات: «الدعاء لا يُرد عند الأذان أو ما بين الأذان والإقامة»، وحديث سهل بن سعد السّاعِدِي أنه قال: «ساعتان تُفتح فيهما أبواب السماء ويُستجاب فيهما الدعاء، عند الأذان للصلاة، وعند الصف في سبيل الله»، وهذا الحديث صححه ابن حِبّان، وهو حديث قريب التحسِين، فإن دعا الواحد بعد انتهاء الأذان فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
لو أن إنسانا في الخلاء فسمع المؤذن، فهل يقول معه أم لا؟
اختلف العلماء في ذكر الله في الخلاء – دورة المياه – على قولين: فذهب الحنابلة إلى أنه لا يقول. والقول الثاني: أنه يقول، لماذا؟ لأنه تعارض مكروه وهو ذكر الله في الخلاء، ومستحب وهو الترديد.
القاعدة: إذا تعارض مكروه ومستحب فيُقدم المستحب، وإذا تعارض واجب ومحرم فيُقدم الواجب، لأن المأمور أعظم من اجتناب المحظور، وهذا إذا كانت مرتبتهما واحدة، وأما لو تعارضت سنة بمحرم، فالمُقدم هو المحرم، لأن مرتبتهما ليست سواء، والله أعلم.
(أحيانا يشطح بنا الخيال، فقد ذهب بي أول مرة إلى أن ذكر الله في خلاء قد يكون مكروها، وأن المقصود من سمع الأذان وهو في مكان خال بعيد شيئا ما عن البنيان، وهذا يحدث، وهذا يدلك على أن الخطأ قريب لذا يجب الحرص والتأكد والبحث بتوسع لمعرفة الحقيقة، أما ذكر الله في خلاء فلا شيء فيه بل هو مستحب).
هل لو صلى متطوعا فسمع المؤذن، هل يقول مثلما يقول؟
جماهير أهل العلم قالوا: لا يقول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الصلاة لشغلا» كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وذهب ابن حزم وهو اختيار ابن تيمية إلى أنه يقول ولو كان في الصلاة، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، قالوا: والأذكار الواردة في الأذان هي من التسبيح والأذكار.
ولكن الأقرب والله أعلم، أنه لو قال فلا حرج، لكن الأفضل أن لا يقول إلا عند الحيعلتين، فإنه إذا قال المؤذن: “حي على الصلاة”، قال: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، قال بعضهم: إن هذا مخاطبة لبني آدم، والذي يظهر والله أعلم، أن كلمة: “لا حول ولا قوة إلا بالله” ذكر خاص، وليس مخاطبة لبني آدم. فلو قال: السلام عليكم أو يرحمك الله، هذا مخاطبة، أما أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يظهر أنها لا تبطل، ولكن الأفضل ترك ذلك، والله أعلم.
3. شروط الصلاة
شروط الصلاة:
تعريف الشرط – شروط الصلاة كاملة على سبيل الإجمال – الشرط الأول من شروط الصلاة: دخول الوقت – أنواع الصلوات – وقت صلاة الظهر – أيهما أفضل: تعجيل صلاة الظهر أم تأخيرها؟ – وقت صلاة العصر – ويُستحبُّ تعجيل صلاة العصر في أول الوقت – هل يُستحب تعجيل صلاة الجمعة، وهل تؤخر لشدة الحر أم لا؟ – صلاة العصر هي الصلاة الوُسطى – وقت صلاة المغرب – واختلفوا، ما معنى الشفق؟ – ويُستحبُّ تعجيل صلاة المغرب في أول وقتِها – وقت صلاة العشاء – هل لوقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة؟ – هل يستحب تقديم صلاة العشاء أو تأخيرها؟ – وقت صلاة الفجر – الشرط الثاني من شروط الصلاة: الطهارة من الحدث – الشرط الثالث من شروط الصلاة: الطهارة من الخبث – الشرط الرابع من شروط الصلاة: ستر العورة – الشرط الخامس من شروط الصلاة: استقبال القبلة – الشرط السادس من شروط الصلاة: النية – اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسة، وأراد الصّلاة، فماذا يفعل؟ – ما حكم القيء؟ – هل من الواجب فركُ الملابس التي فيها نجاسة قبل وضعها في الغسالة؟ – ما حُكم تشبيك أصابع اليد أثناء غسل اليدين أول الوضوء وأثناء الصلاة؟
تعريف الشرط:
الشرط في اللغة يُطلق على العلامة كما قال الله تعالى: ﴿فقد جاء أشراطُها﴾ [محمد: 18] أي علاماتها. والشرط أيضا هو الإلزام، فإذا التزم الواحد بشيء، قال: شرطته عليّ أو على نفسي.
واصطلاحا هو: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من وجوده وجوده ولا يلزم من عدمه عدمه.
فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، فوجودها لا يلزم منه وجود الصلاة، لكن عدمها يلزم منه عدم الصلاة، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة.
وقد عدّ بعض أهل العلم شروط الصلاة فجعلها ستة، وبعضهم جعلها خمس، وبعضهم تسع، وأدخل فيها الإسلام والتمييز والعقل. وتعدادها تسع محل نظر، وذلك لأن الإسلام والتمييز والعقل هذه شروط في كل عبادة، ولا تختص بالصلاة. كذلك هذه الشروط إنما هي شروط للنية التي هي شرط من شروط الصلاة، وليست شروط ابتدائية، وعلى هذا فالإسلام والتمييز والعقل إنما هي شروط لشرط الصلاة وليست شرطا للصلاة نفسها، فإنما هي شرط لأحد شروط الصلاة وهي النية، والله أعلم.
ونحن سوف نتحدث عن هذه الشروط الستة التي تحدث عنها أهل العلم ونبين دليل كل قول، والخلاف في هذا الأمر على سبيل الاختصار، والله أعلم.
شروط الصلاة كاملة على سبيل الإجمال:
الشرط الأول: دخول الوقت
الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
الشرط الثالث: الطهارة من الخبث، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء باجتناب النجاسة
الشرط الرابع: ستر العورة، وبعضهم يضيف مع ستر العورة ستر المنكبين
الشرط الخامس: استقبال القبلة
الشرط السادس: النية. والنية قد تختلف عن هذه الشروط، وذلك لأن الشرط الأصل فيه هو وجوده قبل الماهية، مثلا الوضوء أي الطهارة، وجوده قبل الصلاة، أما النية فتوجد مع الصلاة وهو الأفضل، وتوجد أيضا قبل الصلاة من حيث استحضارها، وهو يؤجر عليها، وإنما سموها شرطا لأنها توجد أحيانا قبل الصلاة، والله أعلم، ولأنها خارج الماهية.
الشرط الأول من شروط الصلاة: دخول الوقت
ومعنى دخول الوقت إنما هو لأداء الصلوات المكتوبات، وقد قال الله تعالى ﴿أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ إِلى غسقِ اللّيلِ﴾ [الإسراء: 78]، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، فلو أن سجينا سُجِن، ولم يعلم هل دخل الوقت أم لا، فغلب على ظنه دخوله فصلى، فتبين له بعد ذلك أن صلاته كانت قبل الوقت، فيجب عليه أن يعيد.
وقولنا دخول الوقت، إنما هو لأجل الصلوات المكتوبة، وأما غير الصلاة المكتوبة فهي على أنواع، فمن الصلوات ما يصح فعلها في كل وقت، وذلك مثل ركعتي الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: «يا بني عبدِ مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»، وهذا الحديث إسناده صحيح، فقد رواه أهل السنن من حديث جُبير بن مُطعِم.
القسم الثاني من الصلوات ما لا تُفعل إلا لسبب، مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف، فلا يُشرع فعلها إلا لسبب الاستسقاء وطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، أو لأجل خسوف أو كسوف الشمس، على خلاف عند أهل العلم هل تُصلى صلاة الخسوف والكسوف في غير خسوف الشمس وكسوفها؟ يعني لوجود آية؟ على خلاف عند أهل العلم.
فذهب ابن عباس وهو قول ابن حزم واختيار ابن تيمية إلى جواز ذلك. وذهب عامة العلم إلى عدم الفعل، والله أعلم.
أنواع الصلوات:
من الصلوات أيضا ما لا تفعل في أوقات النهي كالنوافل المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلُع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، يقول عقبة بن عامر «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبُر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائِمُ الظهيرة، وحين تضيّفُ الشمس للغروب حتى تغرب»، يعني بعد طلوع الفجر، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق، وقبل غروب الشمس بنصف ساعة، وهو بعد اصفرار الشمس، فإن ذلك وقت ضرورة، لا يجوز التطوع فيه.
ومن الصلاة ما لا تشرع إلا في وقتها المحدد، مثل صلاة الضحى، كذلك لا يشرع له أن يُوتِر في الضحى، على خلاف هل يوتر أم يصلي ركعتين ركعتين، كذلك لا ينبغي له أن يوتر المغرب، فإن هذا من الصلوات التي لا تشرع إلا في وقتها المعتاد.
ومن الصلاة ما يشرع فعلها في كل وقت، وهذا كما قلنا في ركعتي الطواف والصلوات الفوائت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ ﴿وأقِمِ الصّلاة لِذِكرِي﴾ [طه: 14]» والحديث صحيح رواه أنس بنُ مالِك رضي الله عنه.
وأما دليل أنه لا يصح أن يصلي الواحد خارج الوقت ولا قبل الوقت، فما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم “فسأله عن الوقت، فلم يجبه، ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول: قد طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم، ثم أمره أن يؤذن الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فأذن العصر حينما كان ظل الرجل كطوله”، الحديث. ثم بعد ذلك أمره أن يؤذن قبل طلوع الشمس، ثم قال له في آخر الحديث: “الوقت بين هذين”. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، ولا يجوز له أن يصلي بعد الوقت إلا لعذر كالذي يريد أن يجمع الصلاة.
ولهذا قال أبو بكر لعمر: “واعلم يا عمر أن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وعبادة في الليل لا يقبلها في النهار”.
وذكر ابن تيمية إجماع أهل العلم على أن صلاة النهار لا يجوز فعلها في الليل، وصلاة الليل لا يجوز فعلها في النهار، والله أعلم.
إذن دخول الوقت محل إجماع عند أهل العلم.
وقت صلاة الظهر:
يبدأ دخول وقت الظهر من زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس هو: من ميلانها إلى جهة الغروب بعد وقوعها في كبد السماء، وذلك لأن الشمس تخرج في صبيحة كل يوم من جهة المشرق، فلا تزال ترتفع، وكلما ارتفعت كلما تقلّص الظل، أي نقص، فإن الشمس إذا خرجت من جهة المشرق، يكون ظل كُلُّ شاخِص طويل جدا، ثم ترتفع الشمس إلى الأعلى متجهة إلى الغرب،
وأنتم تعلمون أن الشمس في المشرق، كم عندنا من مشرق؟ عندنا مشرق واحد أم لا؟ طيب ماذا نقول في قول الله تعالى: ﴿ربُّ المشرِقينِ وربُّ المغرِبينِ﴾ [الرحمن: 17]؟ ماذا نقول في قوله تعالى ﴿فلا أُقسِمُ بِربِّ المشارِقِ والمغارِبِ﴾ [المعارج: 40]؟
الجواب على هذا: المشرق من حيثُ جهته هو مشرق واحد، والمغرب من جهته هو مغرب واحد، لكن الشمس لها إشراق من جهة الشمال أعلى شيء، ولها إشراق من جهة الجنوب أعلى شيء، فهذا هو قوله تعالى: ﴿ربُّ المشرِقينِ وربُّ المغرِبينِ﴾ [الرحمن: 17]، فالشمس لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف، فهذا هو قوله تعالى: ﴿ربُّ المشرِقينِ وربُّ المغرِبينِ﴾ [الرحمن: 17]. وكذلك في الصيف والشتاء في الغروب.
وأما: ﴿بربِّ المشارِقِ والمغارِبِ﴾ [المعارج: 40] فالشمس إذا كان لها مشرق في الشتاء، فالشتاء كلما ذهب إلى جهة الصيف، الشمس تتحول شيئا فشيئا إلى أعلى جهة لها في الصيف، فصار هذا ﴿بِربِّ المشارِقِ﴾.
وهذا يدل على أن الشمس إنما تشرق بعلم الله وإرادته وقدرته، ولهذا قال تعالى: ﴿والشّمسُ تجرِي لِمُستقرّ لّها﴾ [يس: 38]، وقال تعالى في سورة الرحمن: ﴿الشّمسُ والقمرُ بِحُسبان﴾ [الرحمن: 5]، فهذا يدل على أن كل شيء قد وضع في حسبة دقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها.
إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الشمس تخرج من جهة المشرق متجهة إلى جهة الغروب، فلا يزال كل ظل يتقلص عن ما كان في أول المشرق، ثم يتقلص شيئا فشيئا حتى تكون الشمس في كبد السماء، فيكون الظل قد توقف، فلا ينقص أكثر من هذا.
ومن المعلوم أن الظل إذا كان في كبد السماء طوله ربما في الشتاء غير طوله في الصيف، فإذا زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب بدأ الظل يطول، فإذا بدأ الظل يطول بدأ أذان الظهر.
فيبدأ وقت الظهر من زوال الشمس حينما تزول الشمس إلى جهة المغرب ومن بعد زوال الشمس غير الفيء الذي قبل الزوال، لا يُحسب هذا من ظل الظهر.
إذا ثبت هذا فإننا نقول: إذا شرعت الشمس في الزوال إلى جهة الغروب، فإن أذان الظهر يبدأ، فيبدأ الظل بالزيادة، فإذا صار ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال، فإنه يخرج وقت الظهر.
إذن لا بد أن نعلم أن قول العلماء، كما جاء في الحديث: «إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» هو غير فيء الزوال (شرحي: عندما تصل الشمس القادمة من المشرق إلى كبد السماء لا ينعدم الظل تماما بل يكون للشاخص ظلا قصيرا هذا الظل هو فيئ الزوال ولا يحسب من الظهر. إذن: يخرج الظهر إذا كان ظل الشاخص كطوله + طول فيئ الزوال. وهو معنى “غير” فيئ الزوال، لأن فيء الزوال لا يحسب من الظهر لأنه وقت منع، وبالتالي يجب تعويضه فإذا صار ظل الشيء مثله لا يخرج الظهر إلا بعد أن نضيف إليه فيء الزوال الذي لم يحسب سابقا من الظهر).
الآن كانت الشمس في كبد السماء، وكان الظل توقف (شرحي: هذا التوقف وقت ونهي حتى يشرع الظل في الزيادة)، ثم شرع الظل بعد ذلك في الزيادة، فيبدأ وقت الظهر.
يقول العلماء، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ووقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يكن ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر»، إذا كان ظل الرجل كطوله فإنه يأذن العصر، لكن ما هو طوله؟ ليس ينظر الواحد الظل، يقول هذا ظلي، هذا شخصي وهذا ظلي، إذن خرج وقت …، لا .. لا ليس هذا.
نقول: كم طول الظل حينما كانت الشمس في كبد السماء؟ قال: طوله مثلا، نفترض أن طوله 15سم، طيب، ثم أصبح طوله – طول الواحد – 170سم، فهل خرج وقت الظهر؟
نقول: لا، بقي 15 سم حتى يخرج الظهر، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وهو ألا يُحسب فيء الزوال، وقد جاء في ذلك حديث: «حتى رأينا فيء التُّلُولِ»، قال أهل العلم: «حتى رأينا فيء التلول» دليل على كما جاء في الحديث «وليس للحيطان ظل يستظل به»، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن هذا – وهو الظل الذي من قبل الزوال – لا يحسب من وقت الظهر، والله أعلم.
ذكرنا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وقلنا: إنّ هذا هو قول عامة أهل العلم، بل حكى ابن المُنذِر الإجماع على ذلك، نعم يوجد خلاف يسير في هذا؛ لكن أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس؛ لقول الله تعالى: ﴿ أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ إِلى غسقِ اللّيلِ ﴾ [الإسراء: 78]، ودلوك الشمس هو زوالها، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»، والحديث رواه مسلم في صحيحه.
أما خُروج وقت الظهر؛ فذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنِيفية، وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن خروج وقت الظهر هو إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال؛ لِما روى البخاريُّ من حديث أبي ذرّ، قال: كُنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أحد أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أبرد أبرد؛ إنّ شدة الحر من فيح جهنم»، قال: فإذا أراد أن يؤذن قال: «أبرد أبرد»، قال أبو ذر: حتى ساوى الظل التلول ثم أذن، ومعنى حتى ساوى الظل التلول: يعني صار ظل كل شيء مثله، ومع ذلك أمره أن يؤذن لصلاة الظهر، دليل على أنه بقي شيء يسير وهو: فيء الزوال، وهذا ما استدل به أهل العلم، والله أعلم.
وذهب الحنيفية إلى أن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل الرجل مثليه غير فيء الزوال، والراجح هو مذهب عامة أهل العلم؛ لِما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطولِه ما لم يحضرِ العصرُ»، وهذا دليل على أنه ليس ثمة وقت فاصل بين الظهر وبين العصر، فبُمجرد انتهاء وقتِ الظهر يبدأ وقت العصر، وهذا قولُ عامةِ أهل العلم، إلا أنّ الحنفية قالوا: ينتهي إذا كان ظلُّ الرجل مثليه، والراجح هو أنّ خروج وقت الظهر ما لم يحضرِ العصر وكان ظِلُّ الرجلِ كطوله غير فيء الزوال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم.
أيهما أفضل: تعجيل صلاة الظهر أم تأخيرها؟
الراجح أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر، ما لم يكن هناك شدة حرّ. وأما دلالةُ التّعجيل، فلما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبيّ صلى الله عليه وسلم «سُئل: أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أيُّ؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله»، وقد روى الحديث الحاكمُ من طريق شُعبة عن الوليد بن العيزار عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: حينما سُئل أي الصلاة أفضل، قال: «الصلاة في أول وقتها». وهذا صريح على المراد؛ إلا أنّ هذه الرواية شاذةٌ، والصحيح هو رواية ابن مسعود «الصلاة على وقتها». قال أهل العلم تفيد على أنها أول الوقت، وأما إذا اشتد الحر، فإن السنة هي الإبراد، ومعنى الإبراد هو: التأخير حتى تنكسر شدة الحر.
وذهب جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن رجب إلى أن شدة الحر يستحب التأخير فيها سواء كان ذلك في المناطق الباردة أو المناطق الحارة، وسواء كان ذلك منفردا أو كان جماعة، فإنه يُستحب الإبراد؛ لِما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»، والحديث له ألفاظ متنوعة وهذا لفظ أبي سعيد.
قال أهل العلم: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم علّل سبب التأخيرِ، وهو أنّ شدة الحرِّ من فيح جهنم، فلا فرق في ذلك بين أن تكون المناطق باردة أو حارة، إلا أنه إذا كان هناك مساجد مُنتظمة ويتوافدها أناس يختلفون، كما يوجدُ الآن في البلاد الإسلامية، ولها إدارة مستقلة، فالأولى أن تنضبط على ما عليه الوزارات التي تسيرها؛ لأنّ هذا هو ما يضبط الناس، ومما يدل عليه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الصحابةُ، فبكّر بالصلاة مع شدة الحرِّ، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال: “كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فيضع أحدنا كُمّه فيسجد عليه – وكانت أكمامهم طويلة“، وهذا يدل على وجود شدة الحر في التراب، ومع ذلك كان يُعجِّل لأجل حاجة الناس، وإلا فإذا كان هناك شخص وحده فهو معذور، أو امرأة في بيتها؛ فالأفضل في حقها في شدة الحر أن تؤخر، يعني أن تصلي قبل أذانِ العصر بساعة مثلا، أو نصف ساعة على حسب.
ومما يدلُّ على هذا ما جاء في صحيحِ مسلم من حديث خبّاب بن الأرتِّ أنه قال: “شكونا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر، فلم يُشكِنا”، يعني لم يلتفت لشكوانا؛ فكان صلى الله عليه وسلم يراعى أكثر الناس، أما في سفره فقد أبرد، وكذلك يجوز ويستحب إذا كان غير مسافر؛ لأنّ العلة ظاهرة وواضحة.
وقت صلاة العصر:
ووقت صلاة العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم.
أما وقت الاختيار؛ فالراجح هو أنه إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال، كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنيفية، إلى خروج وقته، فإن للعصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة.
أما وقت الاختيار، فالراجح أنه ما لم تصفر الشمس أو ما لم ترتفع الشمس، وهذا يتأتّى في الغالب قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع، على حسب اختلاف الشتاء والصيف، فإذا اصفرت الشمس دخلنا في وقت الضرورة؛ فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة بعد ذلك.
وأما قبل ذلك؛ فلا حرج، لكن السُّنة أن يصلي العصر في أول وقتها، والراجح فيه وهو مذهب الجمهور: أنه يبدأ إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيءِ الزوالِ بعد انتهاء صلاة الظهر.
ومما يدلُّ عليه: ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس»، وفي حديث أبي موسى في قصةِ الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المواقيت، قال: «فصلِّ معنا»، وفي رواية: «فلم يُجبه»، فأمر بلالا فأذن في أول الأوقات ثم أذن في آخر الأوقات، ثم قال: “ثم أمره، فأذن العصر، فصلى والشمس مرتفعة”، وهذا هو مُراد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو «والشمس صفراء» يعني ما لم تصفر الشمس، هذا هو وقت الاختيار.
أما وقت الضرورة فمن اصفرار الشمس إلى غروبها، وهو وقت أداء وليس وقت قضاء، يعني أنه يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا لها، فالقضاء كأن يصلي بعد الغرول أو بعد المغرب، فهذا يسمى أداء قضاء.
ومما يدل على أنه وقت أداء، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك العصر»، وهذا يدلُّ على أن الإدراك إدراكُ أداء وليس إدراك قضاء.
وتأخير الصلاة من اصفرار الشمس إلى غُروب الشمس لا يجوزُ إلا لعذر، والعذر مثل امرأة حائض طهُرت، أو مريض يشق عليه القيام، أو نائم استيقظ، وأما القائم النشيط؛ فلا يسوغُ له أن يُؤخرها.
ومما يدلُّ على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلسُ يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرنيِ الشيطانِ، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا». فالمنافق يؤخرُها.
ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ويخنقونها إلى شرقِ الموتى»، يعني يُؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت، وهذا يدلُّ على أنهم فعلوا محرما، قالوا: يا رسول الله، فكيف تأمرنا، قال: «صلُّوا الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصلِّ تكن لك نافلة»، فهذا يدلُّ على أنه لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس.
وأما بعض أهل العلم وهم الحنابلة، فقد رأوا أن وقت الاختيار: إذا كان ظل الرجل مثليه، وهذا هو مذهب الحنابلة، والراجح هو أن وقت الاختيار ينتهي ببداية إصفرار الشمس.
ما دليل الحنابلة في هذا؟ دليلهم ما رواه التِّرمِذِيّ وغيره من حديث جابِر بن عبدِ اللهِ: “أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمّهُ جبريل في أوّل الإسلام فصلى الصلوات في أول الوقت وصلى الصلوات في آخر الوقت”، وفي الحديث عن صلاة العصر: «ثم أمره فأذن فصلى العصر حينما كان ظل الرجل مثليه»، فكيف نجمع بينهما؟
أولا: حديث جابر حديث صحيح، قال البخاري عنه: “أصحُّ شيء في أحاديث المواقيت حديثُ جابر”. ولا عبرة بمن ضعفه كابن القطّانِ، بحجة أنّ جابرا لم يُشاهد هذا الحدث؛ لأن جابر من الأنصار وهذه كانت في مكة، فالجواب على هذا: أن مراسيل الصحابة مقبولة.
لكنّ أهل العلم قالوا: إن ذلك يدلُّ على أن حديث جابر كان في أول الإسلام، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «ما لم تصفر الشمس»، وحديث أبي موسى: «والشمس مرتفعة»، وحديث بُريدة: «والشمس بيضاء نقية» كلها تدلُّ على أنّ وقت الاختيار ينتهي إلى هذا الوقت (أي بداية الإصفرار )، هذا جواب.
الجواب الثاني: قالوا: إنّ هذا يدلُّ على أن وقت الاختيار قريب، هذا وهذا، مثل حديث أنه صلى العشاء إلى ثلثِ الليل الآخر، وفي حديث آخر: «إلى منتصف الليل»، فدل ذلك على أنّ هذا وقت الاختيار يقترب بعضه بعضا، وهذا ربما يكون أيضا قريب، وهذا الحديثُ يدلُّ على ضعف قول أبي حنيفة، أنه يقول: أن وقت العصر يبدأ إذا كان ظل الرجل مثليه، والحديث إنما ذكره في آخر وقت العصر، فكيف يكون آخر وقت العصر هو أول وقته، فلا يمكن، وهذا قول قوي، والله أعلم.
وفي كلام سابق للشيخ قال:
وأما الحنيفية فإنهم ذهبوا إلى أن وقت صلاة العصر يمتدُّ من بداية إذا كان ظل الرجل مثليه، وإنما استدلوا على ذلك بالمفهوم، ولم يستدلوا بدلالة صريحة. واستدلوا بالمفهوم قالوا كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ بقاءكم في الأمم كبقاء من سبقكم»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أُوتي أهل التوارة التوارة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا فيه حتى إذا كان العصر عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، فأوتينا القرآن، فعملنا به حتى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، قال: فقال أهل الكتاب: يا رب، أعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا، فقال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء».
وجه الدلالة: قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر؛ لأنه جعل اليهود والنصارى وقتهما واحد، فمن الفجر إلى منتصف النهار، ومن منتصف النهار إلى العصر دليل على أنه سواء، وأما من العصر إلى غروب الشمس فإنه يدل على وقت يسير، ولهذا كان فضل الله يؤتيه من يشاء.
وهذا استدلال بالمفهوم، والقاعدة الأصولية عندنا “أنه لا يُعولُ على المفهوم في وجود منطُوق صريح»، والمنطوق الصريح هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس»، أما الدليلُ على البداية هو ما قبل هذا، وهو: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر»، فهذا يدل على أن وقت العصر إذا كان ظل الرجل كطوله، وهذا كما قلت مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.
ويُستحبُّ تعجيل صلاة العصر في أول الوقت:
ومما يدلُّ على ذلك: ما ثبت في الصحيحِ من حديث رافِع بن خدِيج، قال: “كنا نُصلي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العصر فننحر الجزُور، فنقسِمُها عشرا، فنطبخ، فنأكل لحما طبيخا، ولم تغب الشمس بعدُ”، والشمس لم تغب. فهذا يدلُّ على أنهم كانوا يُبكِّرُون بالصلاة، والله أعلم.
هل يُستحب تعجيل صلاة الجمعة، وهل تؤخر لشدة الحر أم لا؟
الراجحُ هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعية، وهو أن صلاة الجمعة يُستحب فيها التعجيل ولو اشتد الحر؛ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ: «كنا لا نُقِيل إلا بعد الجمعة»، دليل على أن الجمعة يُبكّرُ فيها. وفي حديث آخر: “كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج إلى حِيطانِنا، وليس للحيطان ظل يُستظل به”، دليل على أنه قريب من الزوال، والله أعلم.
صلاة العصر هي الصلاة الوُسطى:
وهذا أرجح الأقوال؛ لما جاء في الصحيحِ من حديث عليِّ بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا»، ثم أنزل الله: ﴿ حافِظُوا على الصّلواتِ والصّلاةِ الوُسطى وقُومُوا لِلّهِ قانِتِين ﴾ [البقرة: 238].
وقد ذكر الحافظ ابن حجر عشرين قولا في أي الصلوات هي الصلاة الوسطى.
وقد يقول قائل: إذا كنتم تقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلماذا ابتدأتم المواقيت بصلاة الظهر، لماذا لم تبدؤوها بصلاة الفجر، حتى تكون العصر هي الصلاة الوسطى؟ وإذا بدأتم بصلاة الظهرِ، فإنكم تخالفون أمرين: خالفتم أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وخالفتم أن تكون صلاةُ المغرب هي وِترُ النهار، ولا تكون وتر النهار إلا إذا ابتدأ بالفجر.
الجواب: هذا إيرادٌ قوي؛ إلا أننا لم نبتدئ ولم نشأ أن نبتدئ بصلاة الفجر لأمور:
الأول: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بصلاة الظهر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
الثاني: لأنّ أكثر الفقهاء من الحنابلةِ والشافعية والمالكية يبتدئون بصلاة الظهرِ، وإلا فإنّ الأظهر أن يُبتدأ بصلاة الفجر؛ لِما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوقت، قال: فلم يُجبه، ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول: قد طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم. وهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل كثيرة جدّا.
وقت صلاة المغرب:
يبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن المُنذِر في كتاب الإجماع على أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب”.
وأما آخر وقت المغرب، فقد أجمع أهل العلم على أن وقت المغرب ينتهي حين مغيب الشفق، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ووقتُ صلاة المغربِ ما لم يغِبِ الشّفقُ»، هذا أمر أجمعوا عليه.
واختلفوا، ما معنى الشفق؟
فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفق هو الحُمرة، لما روى الدّارقُطنيّ والبّيهقي من حديث ابن عمر أنه قال: “الشفق الحُمرة”، ورُوي مرفوعا ولا يصحُّ فالصواب وقفه على ابن عمر كما ذكر الحافظ الدّارقُطنيّ.
وقد جاءت أحاديثُ تُبين أنّ الشفق الحُمرة، كما رواه ابن خزيمة «ما لم يغب حُمرةُ الشفق»، وإن كان ابن خُزيمة صححه، ولكن في أسانيده بعض الكلام.
وأصح شيء في الباب هو حديث ابن عمر، وابن عمر هو مُفسِّر لِما حضره من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقد عاين التنزيل، وأدرك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما أبو حنيفة فيرى أن الشفق هو: البياضُ المُعترِض.
والصحيحُ أنّ الشفق يُطلق في اللغة على هذا وذاك، فهو من الألفاظ المشتركة، أما إطلاق الشرع له في المواقيت فعلى الحُمرة. ومن المعلوم أنه إذا ختلفت الحقيقة اللُّغوية والحقيقة الشرعية فيُعوّلُ على الحقيقة الشرعية، والله أعلم.
إذن أبو حنيفة يرى أن الشفق هو البياض المعترض، وأما جمهور أهل العلم فيرون أن الشفق هو الحُمرة.
ويُستحبُّ تعجيل صلاة المغرب في أول وقتِها:
ومما يدلُّ على ذلك ما جاء في الصحيحِ من حديث أنس أنه قال: “كانوا إذا أذن المغربُ ابتدروا السّوارِي قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وهذا يدلُّ على أنهم كانوا يتعجّلُون في التطوع قبل صلاة المغرب؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء»، فكانوا يبتدرون السواري، وهي الأعمدة، فهذا يدل على أنهم كانوا يتعجلون قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يُستحب تأخير صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
وقت صلاة العشاء:
يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، وهذا محل إجماع، فقد أجمعوا على أنّ وقتها يبدأ من مغيبِ الشفقِ، إلا أنهم اختلفوا ما هو الشفقُ، فأبو حنيفة يرى أن الشفق هو البياض المعترض، فيرى أنّ وقت العشاء يبدأ من البياض المعترض، وهو الشفق عنده، وأما جمهور أهل العلم فيرون أن الشفق هو: الحُمرة.
هل لوقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة؟
مثل العصر، أم هو وقت واحد كالمغرب والظهر؟
ذهب عامة السلف والخلف – وتأملوا هذه المسألة جيدا – إلى أنّ وقت العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة.
فأما وقت الاختيار؛ فإنهم قالوا إلى منتصف الليل؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليلِ».
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ وقت الاختيار ينتهي إلى ثلث الليل الآخر؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشُقّ على أمتى؛ لأمرتهم بالصلاة عند ثلثِ الليلِ الآخر».
والّذي يظهر أن وقت الاختيار ينتهي إلى منتصف الليل؛ ذلك أن حديث جابر كما مر معنا كان في أول الإسلام، وأما حديث الصحيحين: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالصلاةِ عند ثُلثِ الليل الآخر»، فهذا يدلُّ على أفضلية تأخير العشاء، لا على أنه هو آخر وقته، وهذا هو الراجح.
أما وقت الضرورة: فهو إلى طلوعِ الفجر الصادق.
يعني إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك ابنُ حزم ورواية عند الإمام أحمد، فقال: إن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، واستدل بدليلين:
الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ووقت العشاء إلى منتصف الليل» قالوا وهنا «إلى» غائِيّة، ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها.
واستدل أيضا بقول الله تعالى: ﴿ أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ إِلى غسقِ اللّيلِ ﴾ [الإسراء: 78]، قال: وغسقُ الليلِ هو منتصفه، وقال: ﴿ وقُرآن الفجرِ إِنّ قُرآن الفجرِ كان مشهُودا ﴾ [الإسراء: 78]، ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى قرآن الفجر، بل فصل بين العشاء وصلاة الفجر.
والجوابُ على هذا أن يقال: إن آية ﴿ أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ إِلى غسقِ اللّيلِ ﴾ هو وقت الاختيار، ولا يجوزُ لمسلم أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد ذلك، وأما إذا كان ثمة ضرورة مثل حائض طهرت، أو شخص في باص كما في الحج فتأخر، فهو يزيد قليلا.
ومما يدلُّ على جوازِ ذلك أمور:
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامّةُ الليل”، وفي رواية: “حتى ذهب شطرُ الليل”، فقام عُمر: فقال يا رسول الله نام الناس، فخرج قال: «إنه لوقتها لولا أن أشقّ على أمتي».
انظر استدلال الإمام ابن المُنذِر، فقد قال: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد شطر الليل، حينما قال “حتى ذهب عامة الليل”، قال: فدل ذلك على أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد منتصف الليل، فإذا كان النبي صلى عامة الليل أي بعد منتصف الليل، فهو دليل على أنّ ما بعده من وقتها، فيمتد إلى الفجر بالإجماع، وهذا القول قوي.
ومما يدل على ذلك فهم الصحابة لذلك، فقد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى ابن المُنذِر، أن أَسْلَمْ مولى عمر قال: “كتب عمرُ إلى الأمصار أن وقت العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تصلوها بعد ذلك إلا من شُغل”.
وجه الدلالة أنه قال: “ولا تصلوها بعد ذلك إلا من شغل”، فدل ذلك على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر إذا كان هناك ثمة شغل وضرورة.
ومما يدلُّ على ذلك: ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى»، فهذا يدل على أنه ليس بينهما فاصل.
هل يستحب تقديم صلاة العشاء أو تأخيرها؟
الجواب: أن ذلك على حسب الجماعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأفضل التأخير، لولا يشُقُّ على أمته، فقال: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالعشاء عند ثلث الليل الآخر»، وفي رواية «إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي».
وأما إذا كان ذلك يشُق، فإنه يُقدّم الصلاة، ومما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال الناس في ذلك. قال جابر: «وأما العشاء فكان أحيانا يؤخرها، وأحيانا يُعجِّل، كان إذا رآهم أبطؤوا أخّر، وإذا رآهم عجّلُوا صلّى»، أي كان صلى الله عليه وسلم يراعي حال الناس.
وعلى هذا فإذا رأتِ الجهات المنظمة لمساجد الناس أن الصلاة تكون في وقت تحدده مراعاة لحال الأعمّ فلا حرج في ذلك.
ومما يدل على أن مراعاة حال الناس ولو خالف السنة يجوز أمور كثيرة:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العشاء متأخرا رِفقا بالناس، وقال: «إنه لوقتُها لولا أن أشق على أمتي».
الثاني: ما جاء في حديث خبّاب بن الأرت في أحد المعنيين، أنه قال: “شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرِّ الرّمضاءِ فلم يُشكِنا”، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت مع أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالإبراد، على أحد التفسيرين.
وبعضهم وهم الشافعية رأوا أن تعجيل الصلاة أفضل حتى وقت الإبراد، والصحيح خلاف ذلك، إلا في المناطق الحارة.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة مراعاة لحال الناس، قال أنس: قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأدخُلُ الصلاة وأنا أريد أن أُطِيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفِّفُ مخافة الشفقة على أمه»، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس،
ومن المعلوم أن الناس، خاصة في ظل كثرة التنازع لا بد لهم من ضابط يضبطهم، وهذا لا يتأتّى إلا من الجهات التي تضبط الناس، وإلا لو جُعل لكل واحد سلطة لوقع الخلاف في المسجد، لأن كل واحد سيغضب إذا خولف ما يرر، فربما لو عجّل المؤذن في الإقامة يغضب الإمام، أو ربما يقيم الإمام في حال تأخر المؤذن فيغضب الأخير، والناس لهم قصص معروفة في هذا، والله أعلم.
وقت صلاة الفجر:
يبدأ من طلوع الفجر الصادق.
والفجر الصادق هو: البياضُ المُعترِضُ من الشمال إلى الجنوب.
وأما البياض المعترض من الشرق إلى الغرب فهذا يسمى “ذنبُ السِّرحانِ”، ولا عِبرة به لأنه تعقُبُه ظلمة.
ولم يبين الشارع وقت صلاة الفجر بيانا قاطعا مثل الأوقات الأخرى، فإن الأوقات الأخر يدركها الواحد ﴿ أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمسِ ﴾ [الإسراء: 78]، ما لم يحضر العصر، ما لم يغب الشفق، ما لم تغب الشمس، كل ذلك أمره مضبوط، يدركه الناس ولا يقع إشكال.
أما وقت الفجر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: “وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”. قال: حتى يتبيّن ولم يقل: يُبَين، فهذه لأمر قاطع، لكن قال: حتى يتبين لكم، فجعل الشارع دخول وقت الفجر على حسب الناس، وهذا يدل على أن الناس تختلف فيه، فليس البياض الذي يأتي من الشمال إلى الجنوب أمر قاطع، فبعضهم يقول: قد طلع الفجر، وبعضهم يقول: لم يطلع.
ومما يدل على أن هذا أمر يُختلفُ فيه، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول: قد طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم منهم».
وإذا كان الصحابة الذي عايشوا الأمر في قوته وظهوره قد اختلفوا في طلوع الفجر مع علمهم بأنه يبدأ من البياض، فما بالك بلجنة متخرجة ربما لم يدرك أصحابها كامل الإدراك في هذا الأمر.
فهذا مما تختلف فيه الأنظار، وليس أمرا قاطعا في دخوله، وعلى أتمنى عدم المبالغة في الإنكار على الناس، فلهم أن يجتهدوا فيما بينهم، أما أن يشككوا الناس في صلواتهم فهذا أمر ليس بمحمود.
ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا كان بِغلس، أليس كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين الستين إلى المئة، كما في حديث أبي برزة الأسلمِي، وأنا أطالب الإخوة الذين يقولون الوقت بين فجر أم القرى والصحيح ثلث ساعة أو ربع ساعة كما يقولون؛ نحن نطالبهم إذا أذن بعد وقت أذان وقت أم القرى يجلسون ثلث ساعة ثم يؤذن المؤذن، ثم يصلي، يتطوع الواحد، ويضطجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد الفجر، فتقول عائشة: “فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا يضطجع، وكان إذا اضطجع نفخ”، ويجلس تقريبا ربع ساعة أو عشر دقائق، هذا أقل تقدير، لأن هذا هو الأمر العام، ما عدا العشر الأواخر، لأن هذا له حديث آخر، ثم نقول لهم: اقرؤوا ما بين الستين إلى المئة، هل يخرجون بغلس؟ ما يخرجون بغلس.
يقول أبو برزة: “وإن أحدنا ليعرف جليسه”، وتقول عائشة: “كن نساء المؤمنات يخرجن أو يشهدن صلاة الفجر وهن مُتلفِّعاتٌ بمُرُوطِهن ما يعرفهن أحد من الغلس”، وقد قال جابر كما في الصحيحين: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس”، فهذا يدل على أن الوقت فيه متسع وفيه سماحة.
ومما يدل على ذلك، أن عبد الله بن أم مكتوم كان ينادي في الفجر الثاني، ويقول عبد الله بن مسعود: “وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت”، يعني كان يؤذن في آخر وقت الفجر، وبعض الصحابة يقول: ترى أذن الفجر، فيقول: اصبر. مع أن منهم من كان يأكل قبل أذان ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن هذا الوقت اليسير الخمس والثلاث والدقيقتين أمر معفو عنه، وإن كان توقيت أم القرى أرى أنه لا حرج، فلو صلى الواحد بعد الفجر مباشرة فإن صلاته صحيحة، نعم له أن يؤخر من باب الخروج من الخلاف، أما أن نقول صلاته باطلة، أو أن صلاة الحرم المكي أو الحرم النبوي في رمضان لأن الوقت بينهما عشر دقائق صلاتهم باطلة، فلا ينبغي إبطال صلاة الناس.
والأصل إذا أذن للفجر أن يصلي، وقد صلى صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، واستحب أهل العلم أن يصلي الفجر مبكرا، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه الذي قال: يستحب التأخير، استدلالا بما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر»، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، والأقرب أنه إسناده جيد، ولكن معناه: أن «أسفروا بالفجر» يعني لا تصلوا حتى تتأكدوا من دخول الوقت، والمعنى الثاني: أن تصلوا إذا عرف بعضكم بعضا، لما جاء في حديث أبي برزة: “وإن أحدنا ليعرف جليسه”، وإلا فإن المُعوّلُ ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي موسى وغير ذلك مما ذكرناه في الأول.
الشرط الثاني من شروط الصلاة: الطهارة من الحدث.
والحدث هو: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وعلى هذا ذهب أهل العلم إلى أن الطهارة شرط، وهذا محل إجماع، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة من غير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول».
الشرط الثالث من شروط الصلاة: الطهارة من الخبث.
ويُقصد بها: اجتناب النجاسة. والخبث أو النجاسة هي: عين خبيثة تمنع من الصلاة.
والطهارة من الخبث تكون في ثلاثة مواطن:
طهارة من الخبث في البدن، وفي الثوب، وفي البقعة أي الأرض التي تصلى فيها.
أما طهارة البدن: فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين يعذبان فقال: «أما أنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزِهُ من بوله». وقد جاء في الحديث «استنزهوا من البول فإن عامّة عذابِ القبرِ منه»، وهذا الحديث رواه البزّارُ واستنكره أبو حاتم، ورأى أنه ضعيف.
وهذا يدل على شرطية الطاهرة في البدن.
ولا تخلو النجاسة على البدن من حالين:
أن تكون نجاسة في السبيلين: فإن الراجح عدم صحة الصلاة.
أو أن تكون في غير السبيلين، فإن كان الواحد جاهلا، فالراجح وهو مذهب مالك أن الصلاة صحيحة، وأما مع العلم والتعمد فإنه لا يصح؛ لأنه خالف المأمور، والمأمور هو قوله صلى الله عليه وسلم «تحتُّه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه»، وهذا يدل على أنها لا تصلي حتى تزيله، وذلك مع العلم، وأما مع الجهل فقد جاء حديث أبي سعيد الخدري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو لم يعلم ولم يستأنف الصلاة حينما علم أن في نعليه أذى وقذر، والله أعلم.
أما طهارة الثوب: فاستدل بعض أهل العلم على ذلك بما جاء في قول الله تعالى في سورة المدثر ﴿يا أيُّها المُدّثِّرُ * قُم فأنذِر *وربّك فكبِّر *وثِيابك فطهِّر﴾ [المدثر: 1-4]|.
فذهب بعض أهل العلم كابن جرير الطبري وقوّاه الشّوكانِيّ، إلى أن المقصود بالثياب هي الثياب المعروفة المعتادة، فإن الواحد مأمور ألا يوقع النجاسة على ثيابه.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالثياب هنا هو طهارة القلب؛ لأن الطهارة لم تكن قد شُرعت لأن هذه الآية هي ثاني آية تنزل من القرآن.
والذي يظهر أن المقصود هو طهارة الثياب من باب لازِمِ الآية، وإن كان ظاهر دلالة التضمن والمطابقة هي طهارة القلب من الشرك والغل وغير ذلك.
ومما يدل على طهارة الثياب، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في ثوب الحيض: «حُتِّيهِ ثم اقرُصِيهِ بالماء ثم انضحِيهِ ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلِّي فيه»، وهذه الزيادة رواية التِّرمِذِيّ.
ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث ابن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: «ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى»، وهذا ثابت؟
هل خلع النعال التي فيها أذى شرط في صحة الطهارة أم أم لا إذا كان جاهلا بذلك؟
محل خلاف عند أهل العلم.
فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه شرط. والراجح أن كون الطهارة من الخبث شرط محل نظر، وذلك لأن الشرط لا يُعذر صاحبه بجهل ولا نسيان، فلو صلى قبل الوقت جاهلا لا تُقبل صلاته، ولو تبوّل وهو جاهل أن الضُّراط يفسد الطهارة، فإن طهارته لا تصح بالإجماع لأنه لا يعذر بجهل ولا نسيان، لذلك فإن أهل العلم على الراجح أنه لو لبس ثوبا نجسا فصلى فيه وهو لم يعلم فإن صلاته صحيحة كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فيهما قذرٌ، ومع ذلك لم يستأنف الصلاة من جديد، ولكن عندما تذكر ذلك أو أخبره به جبريل خلع نعليه ولم يُعد الصلاة.
ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الطهارة من الخبث، واجتناب النجاسة واجبة، تسقط مع النسيان، قال: لأن الشارع دلّ على وجوبها، ولم يدل دليل على عدم صحتها حال فقدِها، بخلاف دخول الوقت، وهذا هو الراجح، وهو أن اجتناب النجاسة واجب، ويُعذر الواحد بالنسيان، وأما إذا قلنا بأنها شرط، فلا يُعذر بنسيانها.
أما طهارة المكان: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر» وهذا ثابت في الصحيحين في قصة الرجل الذي تبوّل في المسجد، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر.
وهذا يدل على أنه يجب على الواحد حال الصلاة أن يتنظف في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته.
الشرط الرابع من شروط الصلاة: ستر العورة.
العورة: هي ما حرّم الله سبحانه وتعالى كشفهُ أمام من لا يحل نظره إليه، ومن العورة أيضا السّوءتان، وتطلق العورة على كل ما يشين سماعه أو رؤيته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «من ستر على مسلم عورته، ستره الله في الدنيا والآخرة»، والعورة مما يجب ألا يظهر، والله أعلم.
ودليل ستر العورة: قوله تعالى ﴿يا بنِي آدم خُذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِد﴾ [الأعراف: 31]، والزينة زينتان: زينة واجبة وزينة مستحبة. فالزينة الواجبة هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كما هو مذهب أبي حنيفة.
ويخطئ من يسمع كلام الفقهاء “المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها”، ويظن أن هذا في حال النظر، فهذا إنما هو في حال الصلاة، فحال النظر والخروج إلى الرجال شيء وحال الصلاة شيء آخر.
فالمقصود “المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها” كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك قدميها كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهذا هو الذي يظهر.
ومما يدل على ستر العورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يطوف في الناس في السنة التاسعة «ألا يطوف بالبيت عُريانٌ». وقد أجمع أهل العلم كما نقل ذلك أبو عمر ابن عبد البر، و ابن تيمية أن الواحد إذا صلى وقد بدت عورتُهُ فإن صلاته باطلة بالإجماع إذا كان من غير عذر، فدل ذلك على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأما إذا كان لا يجد مثل صلاة العريان، فإن هذا سوف نتحدث عن إن شاء الله.
الشرط الخامس من شروط الصلاة: استقبال القبلة.
استقبال القبلة واجب بدليل قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلُّب وجهِك فِي السّماءِ فلنُولِّينّك قِبلة ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجِدِ الحرامِ﴾ [البقرة: 144]، الشاهد قوله تعالى: ﴿فولِّ وجهك شطر المسجِدِ الحرامِ﴾. فهذا أمر.
ومما يدل على ذلك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في جوف الكعبة ثم خرج واستقبل الكعبة وقال: «هذه القبلة»، وهذا يدل على أن استقبال القبلة واجب، فلو صلى من غير القبلة، فهل تصح صلاته أم لا؟
فرق جماهير أهل العلم بين الحضر والسفر، فقالوا في الحضر إذا اجتهد ثم صلى فبان خِلاف القبلة، فإن صلاته صحيحة؛ لأنه اجتهد وفعل ما أمر الله به، واستدلوا بما جاء عند التِّرمِذِيّ من حديث ربيعة بن عامر، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فأصابنا غيمٌ فلم ندري ما القبلة، فصلينا ثم طلعت الشمس بعد، فصلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله قوله تعالى ﴿ولِلّهِ المشرِقُ والمغرِبُ فأينما تُولُّوا فثمّ وجهُ اللّهِ﴾ [البقرة: 115]، وهذا الحديث في سنده ضعف، فقد قال التِّرمِذِيّ: هذا حديث حسن غريب، والتِّرمِذِيّ إذا قال في حديث حسن غريب أو حديث غريب أو حديثُ حسن، فإن ذلك إشارة إلى ضعفه لا تحسينه، إلا إذا قال: حديث صحيح أو حسن صحيح، وهذا كلام معروف في مصطلح الحديث.
الشرط السادس من شروط الصلاة: النية.
النية في اللغة: هي القصد. وأما في الاصطلاح فهي: العزم على فعل الشيء.
وعليه فلا يصح للواحد أن يصلى على أنها تطوع ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر، فيقول هذه بدل عن الظهر، وذلك لأنه لم ينوِ الظهر من أول الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند التِّرمِذِيّ وأحمد من حديث علي بن أبي طالب: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير»، والتكبير من النية، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، ونقله ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، على أنه لا يصح أن يقلب النية من نفل إلى فرض، فلو صلى مثلا على أنها سنة الفجر فأحس بأن الوقت قد اقترب، فقلبها إلى فجر، فلا يصح بالإجماع، أو قلبها من فرض إلى فرض، مثل أن يكبر على أنه يريد أن يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال: أصلي الظهر، فلا تصح ظهرا ولا عصرا، لا تصح ظهرا لأنه لم ينوها من أول الصلاة، ولا تصح عصرا لأنه غيّر النية ولو رجع؛ لأن جزءا من الصلاة قد تُركت فيه النية.
ودليل النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرِئ ما نوى».
ويستحب له في النية أن يُقارِنها مع التكبير، ولو لم يتذكر فلا حرج في ذلك؛ لأنه من حين خروجه من منزله هو ناو أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، وأما الوسوسةُ في ذلك أو قراءة بعض كتب المتأخرين الذين ربما استفصلُوا في هذا الأمر حتى يقع الواحد في الحرج، فلا فائدة فيه، حتى أنك ربما ترى بعض الناس يتأخر في التكبير، فيقول: نويت أم لم أنوِ؟ نقول: أنت من حين خروجك وأنت تريد أن تصلي الظهر، فلا ينبغي للواحد أن يوسوس في هذا وربما توقف وقرأ الإمام الفاتحة وهو لم يكبر، فهذا والعياذ بالله ينبغي أن يعيد حساباته، هذا شيء.
الشيء الثاني: أنه لا يشرع له أن يتلفظ بشيء قبل التكبير، فلا يشرع أن يقول: اللهم إني نويتُ أن أُصلِيّ الظهر أربع ركعات، أو اللهم إني نويت أن أصلي العصر أو غير ذلك، فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما جاز ذلك في الحج خاصة، كما صحّ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لعروة قل: “اللهم الحجّ أردتُ ولك عمدتُ، فإنك كان الحج فاللهم، وإلا فمحِلِّي حيث حبستنِي”، وأما في غير ذلك من العبادات فلا يشرع للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت.
وأما الجهر بها فلم يقل واحد من أهل العلم به، لم يقل أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد أنه يجهر بحيث يُسمع الناس ما ينويه، فهذا كله من البدع المحدثة.
وأما أن يقوله بينه وبين نفسه، فإن الشافعي رحمه الله قد صحّ عنه أنه كان يقول ذلك، وابن تيمية يقول: لم يصح عن الشافعي في هذا شيء. والصحيح: أنه صحّ عن الشافعي، فقد رواه ابن الأعرابي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن الربيع بن سليمان مؤذن الشافعي أن الشافعي كان يقول: “اللهم إني نويت”، وهذا بينه وبين نفسه، وإلا فإن السنة والمشروعية أفضل، وعلى هذا فإنه لا يُشرع للواحد أن يقول شيئا من ذلك؛ لأننا متعبدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو فعل الصحابة بدليل الجواز، وأما إذا لم يقل أحد منهم ذلك ولم يستحب أحد منهم ذلك ولم يفعل أحد منهم ذلك، فلا شك أن الصلاة من أعظم عماد الدين، فإذا زيد فيها شيء من أفعال الناس أو اجتهادات العلماء مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، فإن الأفضل والأتقى والأسلم ألا يقول الواحد شيئا أو يفعل شيئا من ذلك، والله أعلم.
اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسة، وأراد الصّلاة، فماذا يفعل؟
قال بعضُ العلماء: “إذا كان يعلم عدد النّجِسِ؛ فإنّه يُصلِّي عدد الثِّياب النّجسة وزيادة واحد”. فلو كان عنده مئة ثوب نجس، وعنده ثوبين طاهرين، واختلط الجميع ، قالوا لابُدّ أن يُصلِّي، لذا ليلبس ثوبا ويُصلِّي، ثم يلبس الثاني ويصلي، ثم يكمل مئة وواحد، قالوا: “لأنّنا نعلم حينئذ أنّه قد صلّى في واحد طاهر؛ لأنّه صلى عدد النّجِس وزيادة”. وهذا فيه كُلفةٌ، وقد قال الله تعالى: ﴿وما جعل عليكُم فِي الدِّينِ مِن حرج﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لا يُكلِّفُ اللّهُ نفسا إِلّا وُسعها﴾ [البقرة: 286]، وهذا من التّكليف بما لا يُطاق، والله أعلم.
والجواب على هذا أن نقول: القاعدة التّحرِّي، فيتحرى أيُّ الثيابِ الطّاهرة، فيأخذ واحدا ويُصلِّي ولا حرج عليه. ونقول: صلاتُه صحيحةٌ؛ لأنّه اجتهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِذا حكم الحاكِمُ فأصاب فلهُ أجرانِ، وإِنِ اجتهد فأخطأ فلهُ أجرٌ واحِدٌ». لكنّه لو أُخبِر بعد ذلك أنّه صلى في ثوب نجس، فالرّاجح والله أعلم أنّه لا حرج عليه ولا تلزمُه الإعادةُ؛ لما جاء عند أهل السُّنن أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخُدرِي: صلى وفي نعليه نجاسةٌ – أذى – فلما أخبره جبريلُ خلعهما. وجه الدِّلالة: أنّه لو كانت النّجاسةُ في الثّوب إذا كان جاهلا أو ناسيا تُبطلها لبطلت من أول الصّلاة، فلمّا أكمل صلى الله عليه وسلم دلّ على أن النّاسِي وجود نجاسة في ثوبِه لا حرج عليه ولا بأس بذلك، والله أعلم.
ما حكم القيء؟
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن القيء نجس، وقد ذكر ابن المُنذِر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك، والقول الثاني في المسألة وهو قولٌ لبعض المالكية اختاره أشهبُ من المالكية وابن رشد على أنه ليس بنجس، وهذا القول قوي، لكن الأحوط أن يغسله، ولا فرق بين قيءِ الصبي وقيء الكبيرِ، كل ذلك ينبغي أن يُتوقّى منه.
هل ينقض القيءُ والدّمُ الخارج من الجُرح الوضوء؟
أمّا القيء فنجسٌ، وأمّا أنّه ينقض الوضوء أو خروج الدم ينقض الوضوء، فالصّحيح هو مذهب الشافعي ومالك، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو الرّاجح: أنّ القيء لا ينقض الوضوء، وأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإن كان القيءُ عند الجمهور نجسا هو والدم نجسا.
هل من الواجب فركُ الملابس التي فيها نجاسة قبل وضعها في الغسالة؟
إذا كانت النجاسة الموجودة لها جُرم (حجم)؛ فينبغي إزالتها أولا لكي لا تُنجِّس الماء، فربما يكون الماء قليلا فتغيره، فينبغي أن يُغسل ثم بعد ذلك يوضع في الغسالة، أما إذا كان الماء يتناوب عليه فلا حرج في تركه، والله أعلم.
هل تنشيف الأعضاء خلال الوضوء يجوز، وهل يجوز حمل الطفل وهو يلبس الحفّاظّات؟
الجواب: أن مسح الوضوء الراجح والله أعلم أنه جائز، تقول ميمونة: «فأتيته بالمنديلِ، فردّه، وجعل ينفضُ الماء بيديه».
والجواب: أن الرسول إنما رده ليس لأجلِ أنه لا يُريد أن يتمسح، بدليل أنه جعل ينفض الماء بيده، ويقول ابن القيم: “كل حديث فيه تنشيفُ الأعضاء أو عدم تنشيفه فهو حديث ضعيف، إلا حديث ميمونة”، فحديث ميمونة ليس فيه أنّ الرسول أمر بتنشيف الأعضاءِ أو نهى، فكل حديث فيه الأمر بتنشيف الأعضاء أو النهي عن تنشيف الأعضاء فإنه حديث ضعيف؛ والله أعلم .
ثم السؤال الآخر: هل يجوز حمل الطفل وهو يلبس الحفاظات؟
لا حرج أن يُحمل الطفل ولو كان فيه شيء إذا كان في غير الصلاة، ولأنه لم ينجس، وأما إذا كان فيه بلل؛ فإنك تغسلين المكان الذي وقع فيه البلل، والله أعلم .
ما حُكم تشبيك أصابع اليد أثناء غسل اليدين أول الوضوء وأثناء الصلاة؟
الراجح أن تشبيك الأصابع ليس فيه بأس، إلا في حال الصلاة، ففي حالة الصلاة السنة وضع الأصابع في المكان المأمور به، فيضع حال القيام يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويضع حال الركوع يديه على ركبتيه، وأما حال الرفع فإما أن يُسدل وإما أن يضع، كل ذلك جائزٌ، والأولى أن يضع، وأما السجود فكذلك هو وما بين السجدتين والتشهد.
أما التشبيك فإنه ترك للسنةِ، ولهذا نقول: مكروه.
أما إذا كان ينتظر الصلاة أو خرج إلى الصلاة؛ فإن الراجح أنّ الأحاديث الواردة في هذا أحاديث ضعيفة، حديث كعب بن عُجرة، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخُدرِي، كلها أحاديث ضعيفة، أشار إلى ضعفها الإمام البخاري وابن رجب، والله أعلم.