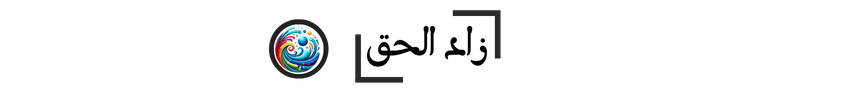أحكام الطهارة: باب الطهارة في الفقه الإسلامي

أحكام الطهارة: باب الطهارة في الفقه الإسلامي. مختصر من أحد الدروس التي ألقاها أحد المشايخ السعوديين، بهدف تحري الدليل (الراجح).
يتضمن الموضوع:
1- المياه والآنية
2. آداب قضاء الحاجة
3. السّواكُ
4. سنن الوضوء
5. أركان الوضوء وواجباته
6. شروط الوضوء
7. مستحبات الوضوء
8. باب المسح على الخُفّين
9. نواقض الوضوء
10. الغسل من الجنابة
11. التيمم
12. الحيض
13. النفاس
ملاحظة:
أحيانا أستعين بمصدر خارجي لتوضيح كلام الشيخ، لأنه كما تعلمون الدرس الملقى ليس كالكتاب المنظم، فقد يحدث فيه سهو أو خطأ أو قلة وضوح، فاستعين ببعض المصادر الخارجية لتوضيح بعض المسائل، وأشير إلى ذلك بكتابة “من مصدر آخر CG” قبل إدراج النص الجديد، وأختمه بعبارة “انتهي المصدر الخارجي”.
واكتب المختصر (CG) إشارة إلى أن المصدر هو الذكاء الصناعي، وقد ضبطته على إعطاء نتائج ذات مراجع تفاديا لشطحاته، وهو يأتي بالعجائب في هذه الأيام، ومعظم أجوبته دقيقة أو قريبة من الدقة، فإذا اعتمدته فليس إقرارا بنتائجه، بل للبحث فيها من أجل توسعة المدارك والإنطلاق من أساس جيد وهو النقاط المتفرقة التي يعطي، وقد لا يعطيها الكتاب المتخصص الواحد. فمثلا: يعطي أقوال الأئمة الأربعة في المسألة، ومختلف الخلافات فيها، وهذا لا تجده في الكتاب المتخصص.
وكلام الشيخ يكفي غالبا، ويعتمد على الدليل الراجح بعد عرض أقوال المذاهب الأربعة وغيرها في المسألة.
المذاهب الفقهية
قال ابن الجوزي رحمه الله: “إن الفقه من أشرف العلوم، وإذا أردتَ أن تعرف فضل أمرٍ، فانظر إلى ثمرته، وثمرة علم الفقه واضحةٌ، فحينما تتفقه في دين الله عزَّ وجلَّ فإنك تعبد الله على بينةٍ وبرهانٍ، وعلى بصيرةٍ، وتسير في حياتك على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم”.
والمذاهب الأربعة ليست الوحيدة، بل كانت توجد مذاهب أخرى غيرها، لكن لم يكتب لها الاستمرار، وبقيت هي، وتلقتها الأمة بالقبول، وأكثر عمل أهل السنة والجماعة اليوم، على المذاهب الأربعة.
ولا يجب التعصب في المذهبية، وقد حصل في مرحلةٍ من مراحل تاريخ المسلمين أن حدثت نزاعاتٌ وخلافاتٌ شديدةٌ وكبيرةٌ بين المذاهب الأربعة، ووصل الأمر إلى أنَّ أناسًا من متعصبة الحنفية قالوا: “إذا كان قول الإمام يخالف السنة، فالسنة إما منسوخةٌ أو مؤولةٌ”، يعني جعلوا الأصل كلام الإمام أبو حنيفة! وهذا خطأ.
كذلك بعض الشافعية كان يسأل: “هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته من الحنفية، أو نحو ذلك”.
وفي المملكة العربية السعودية قبل توحيدها كان في الحرم المكي أربعة محاريب، لكل مذهب من المذاهب الأربعة محرابٌ، ثم بعد ذلك جمعهم الملك عبد العزيز على إمامٍ واحدٍ، لأن جمع الناس في الصلاة أولى من تفرقهم.
فتكن أفعالنا مثل ما كان بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، فقد كان الإمام الشافعي كثير الثناء على الإمام أحمد، وكان يقول: “يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني حتى أعمل به”.
وكان الإمام أحمد يقول لتلاميذه: “الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن”.
ويذكرون عن الإمام أحمد أنه استضاف يومًا الشافعي في منزله، فقدم له الطعام، فأكل الإمام الشافعي كثيرا، ثم نام في الليل، فأخذ أبناء الإمام أحمد الإبريق ووضعوه عند غرفته حتى يقوم للوضوء لصلاة الليل، فلم يقم، ثم بعد ذلك خرج لصلاة الفجر ولم يتوضأ، فلم يستطع أبناء تلاميذ الإمام أحمد أن يصبروا على ذلك، فقالوا: يا إمام أنت تقول “الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن”، التهم طعامنا، ولم يصلِّ الليل، وصلى الفجر بدون وضوء. فسأله الإمام أحمد عن ذلك، فقال: أما الطعام، فلا والله لا أعلم أحدًا أكثر ورعًا منك، وأعلم أن هذا الطعام الذي قُدم لي خالص الحل، فأردت أن آكل منه، وأما صلاة الليل فأنا لم أصلِّ الليل لأني كنت أتدارس العلم، وقد استنبطت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا عمير ما فعل النقير، كذا وكذا من الفوائد»، وطلب العلم خير من النافلة، قال: وأما صلاة الفجر فلا زلت على وضوئي من صلاة العشاء”. فأثنى عليه الإمام أحمد وذكره بخير.
كذلك يرى الإمام الشافعي القنوت في صلاة الفجر، في حين أن الإمام أحمد لا يرى ذلك، فصلى الإمام أحمد خلف الشافعي، فقنت الشافعي وأمن الإمام أحمد – مع أنه يرى عدم جوازه – فسألوه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». يعني لا يجوز الإنصراف من الصلاة لمجرد رؤية رأي فقهي مغاير.
ولد الإمام أحمد بن حنبل في بغداد سنة 164، وتوفي سنة 241، فعاش رحمه الله سبعة وسبعين سنة، ومذهبه آخر المذاهب، استوعب المذاهب السابقة لأنه أتى متأخرا، فكان لديه علم الفقه وعلم الحديث، فاستدرك ما فات العلماء من قبله، لكن لا يعني هذا أن كل المسائل التي ذكرها الإمام أحمد في مذهبه هو الراجح فيها.
ومن أصوله في مذهبه، أخذه بالقرآن، وأخذه بالسنة، وعدم التفريق بين المتواتر والآحاد فيها، بل ما صح فهو مذهبه، كما يأخذ بأقوال الصحابة، وبالمراسيل (أي الأحاديث المرسلة).
وقد ظُلم مذهبه في فترةٍ من فترات التاريخ، حتى أن الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- في حديثه عن الخلافيات، لم يذكر الإمام أحمد – أي لم يذكر المذهب الحنبلي -، ولما سُأل عن ذلك قال: “أحمد إمامٌ في الحديث وليس بإمامٍ في الفقه”، وهذا لا شك أنه قولٌ غير صحيحٍ، فالإمام أحمد من علماء المسلمين فقهًا وحديثًا، وإمامته في الفقه لا شك فيها، وعنايته الشديدة بعلم الحديث لا تعنى عدم إدراكه لعلم الفقه.
وانتشار مذهب الإمام أحمد أقل من انتشار غيره من المذاهب، ويعيد العلماء ذلك إلى عدة أمورٍ، ذكر ابن خلدون أن بعضهم يذكر أن من أسباب ذلك: “الشدة التي في مذهب الإمام أحمد”، وهذا غير صحيحٍ، ففي المذاهب الفقهية الأخرى من الشدة ما ليس في مذهب الإمام أحمد، حتى تجد في بعض الدول إذا رأوك تعمل بالسنة، يقولون أنت حنبليٌّ على سبيل السخرية والاستهزاء، وهذا غير صحيحٍ، والذي جعل مذهبه لا ينتشر كالمذاهب الأخرى هو ما ذكره ابن بدران، وهو: “أن علماء هذا المذهب يميلون إلى التخفي والورع والعبادة مما أسهم في عدم انتشاره بشكلٍ واسعٍ كغيره من المذاهب”.
لن نلتفت في هذا الدرس إلى المذهبية بل سنأخذ الأقوال الراجحة لأن الهدف هو ما عليه الدليل، وقد قال الإمام مالك بن أنس: “كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر”. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الدليل هو مبتغانا.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: “إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد”.
ولم يسلم أحد من العلماء من الخطأ، فقد خفيت عليه السنة في بعض المواضع.
قال عمر بن عبد العزيز: “أحب أنّ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتفقوا؛ لأنهم لو اتفقوا؛ رأيت أن مخالفهم على ضلال، فأما وقد اختلفوا، أرى أن الناس في سعة”.
وجاء رجل إلى الإمام أحمد، وقد ألف كتاب اختلاف الفقهاء ليريه أقوال أهل العلم في الأمصار، فقال أحمد: “لا، سمِّه كتاب السّعة”؛ لأن كل واحد ينشد في هذه المسائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والأئمة لم يأتوا من فراغ، فأبي حنيفة تربى على مدرسة ابن مسعود (أخذ عن حماد بن أبي سليمان)، ومالك أخذ علمه من مدرسة عبد الله بن عمر (أخذ عن الزهري)، والشافعي أخذ عن سفيان بن عيينة في مكة، ثم عن مالك في المدينة (وهو ابن ستة عشر سنة)، ثم أخذ من محمد بن الحسن. وأحمد بن حنبل أخذ بعلم أهل الحديث وفقه التابعين كالفقهاء السبعة وعطاء بن رباح وسعيد بن المسيب، وكلهم على حق.
سُئل الإمام أحمد بن حنبل: “ما ترى في لحم الجزور؟ هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم ينقض الوضوء، فقالوا: يا أبا عبد الله، هل نصلي خلف مالك بن أنس وسعيد بن المسيب؟ فقال: “أتُرانِي أقول: لا تُصلِّ خلف مالك بن أنس، أو لا تُصلي خلف سعيد بن المسيب؟!”. يعني أن هؤلاء لهم اجتهادهم إن أخطأ الواحد منهم فله أجر لأنهم أصلا ينشدون السنة لم يأتوا بذنب.
والناس كُثر لكنّ الفقهاء قلة، وأهل العلم في حفظ سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- متفقون، ويختلفون في فهمهم لها في بعض الأحيان، قال -صلى الله عليه وسلم عن فقيه الأمة معاذ بن جبل: «يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة وقد سبق العلماء بخطوة»، وهذا يدل على أنهم تتفاوت منازلهم، وكل اجتهد في الحق وطلبه، فهو على هُدى وصراط مستقيم.
فخطأ العلماء ليس لهوى في النفس، أو لترك الحق، بل لأنهم بشر، بعضهم لم يصله الدليل. فأبي حنيفة يعتب عليه من يعتب لتركه الدليل، لأنه عاش في الكوفة؛ وأهل الحديث في ذلك الوقت قلة فيها، فاعتمد على النصوص العامّة، واستدل. قال ابن تيمية عن أبي حنيفة “انه يترك القياس والقاعدة لأجلِ أثر رواه عبد الله بن مسعود، أي يترك القياس بقول صحابيّ، فما بالك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟!”. يعني أن العلماء إذا وجدوا الدليل يتمسكون به ولا يحيدون عنه لأي سبب من الأسباب.
ذكر الخطيب البغدادي في كتاب “الفقيه والمتفقه” أن أبو حنيفة النعمان كان عند الأعمش سليمان بن مهران، الإمام المحدث القارئ، فسأل الأعمش سائل، فقال: ما تقول يا سليمان في هذه المسألة؟ فطأطأ الأعمش رأسه ثم رفعه، فقال: ما تقول يا نعمان في هذه المسألة؟ فقال أبو حنيفة: “أقول فيها كيت وكيت”، فسكت الأعمش ثم رفع رأسه، وقال: من أين لك هذا؟ (سموا لنا رجالكم لأن العالم يُوقِّع عن رب العالمين، فلا بد من أن يأتي بدليل على ما يقول). فقال النعمان: “أو لم تحدثنا، قلت: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا؟! فهذا منك”، فضحك الأعمش وقال: “يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة”.
في أهمية طلب العلم:
نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم؛ فإنّ طلب العلم من أعظم القُرُبات لمن صلُحت نيّتُه، كما يقول الإمامُ أحمد، فمن تعلّم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين والمسلمات، فإنّ ذلك من أعظم القُرُبات.
ولهذا روى الإمامُ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه “جامعُ بيانِ العلمِ وفضلهِ” رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: “لأن أتعلّم مسألة ربما احتاج الخلقُ إليها، أحبُّ إليّ من أن أقوم شهرا وأصوم شهرا”.
وهذا يدل على أن تعلم العلم من أعظم القُرُبات؛ لأنّ العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا على علم، ولهذا أمر اللهُ نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يعلم معنى “لا إله إلا الله”، وأن يستغفر لذنبه، فقال تعالى: ﴿فاعلم أنّهُ لا إِله إِلّا اللّهُ واستغفِر لِذنبِك﴾ [محمد: 19]، وهذا يدل على أنّ العالِم الذي يستغفر الله بعلم أفضل من العابِد الذي يستغفر بلا علم، فلربما استغفر عن بعض المسائل التي ربما يكون فعلها هو الصحيح، أو ربما لا يستغفر عن بعض المسائل التي يكون فعلها غير صحيح (مثالهما: المتبع للسنة فهذا يعبد الله بعلم، والصوفي المتبع لشرع شيخه المُتَلَقى من الشياطين بدليل عدم ثبوته ولا معرفة أهب الإسلام من الصحابة به ! فهذا يعبد ربه بعدوان في كثير من الأحيان).
ولهذا ذكر أهلُ العلم أن العبد أحيانا يُؤتى من قِبلِه، ولا يُؤتى من قِبلِ أهل العلم، ولهذا جاء في الصّحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار، حتى كأنّه كالفرخِ، فقال له صلى الله عليه وسلم: «هل كُنت تدعُو بِدُعاء؟» قال: كنتُ أقول: “اللّهُمّ إن كنت مُعذِّبي في الآخرة، فعجِّل لي العقوبة في الدُّنيا”. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سُبحان الله! سُبحان الله! لا تُطِيقُهُ، هلّا قُلت: ربّنا آتِنا فِي الدُّنيا حسنة وفِي الآخِرةِ حسنة وقِنا عذاب النّارِ». فالواحد أحيانا يُؤتى من حيثُ جهله، ولكن أهل العلم هم أهل الدِّراية:
دِينُ النّبيِّ محمّد أخبارُ …. نِعم المطِيّة للفتى الآثارُ
لا ترغبنّ عن الحدِيثِ وأهلِهِ …. فالرّأيُ ليلٌ والحدِيثُ نهارُ
ولرُبّما نسِي الفتى أثر الهُدى …. والشّمسُ طالِعةٌ لها أنوارُ
واعلموا أن طلبة العلم إذا تأصّلوا في معرفة الدليل في أصول المسائل؛ فإنّهم بإذن الله يستطيعوا البحث في كتب أهل العلم عن المسائل الأخرى، فيبنُوا الأصول الجديدة على الأصول التي بنوها بمعرفة الدليل وكيفية وطريقة الاستدلال ومناقشة الأدلة، فإن هذه المعالم وهذه المعارف من أهم مُهِمّات طالب العلم؛ لأنّ طالب العلم إذا عرف كيف يستدل، وعرف كيف يُناقش، وعرف كيف يُرجِّح؛ فإن هذا هو أساس العلم.
ولهذا يحسن بأهل العلم والمشايخ أن يُركِّزوا لطلاب العلم على معرفة الخلاف، وكذلك يركزوا على رفع الملامِ عن الأئمّة الأعلام، ويُبيِّنوا لماذا اختلف الأئمّةُ.
كذلك ينبغي أن يُركِّزوا على طريقة فهم الدّليل، فليس فهم الدليل مبنيّا على عقول بعض الناس، ولهذا ربما تجد الرجل من عباقرة الناس، ولكنّه ليس بفقيه بالفقه الشرعي، ولربما رأيت رجلا يُجيدُ علم الكلام وعلم المنطق لكن فتاويه ليست مبنيّة على التّأصيل الشرعي.
ولهذا ليس الفقهُ دلالة على العبقرية، فربما يكون الرجل عبقريّا وليس بفقيه، فكل من أخذ العلم من أهله وعرف طريقة الاستدلال؛ فإنّه بإذن الله سينجح ويُفلح أشد الفلاح.
ولهذا كان من أهم المُهِمّات أن يتعلّم طالبُ العلم كيف يستدل وكيف يُناقش وكيف يُرجِّح؛ لأنّ المناقشة أحيانا تكون من غير علم، والذي يُناقش من غير علم ربما يُخطئ أو يتكلّف المناقشة ويُخرج النّصّ الشّرعي عن مدلوله الظاهر.
ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: “ينبغي أن يُحمل كلامُ الله وكلامُ رسوله على ما أراده اللهُ وأراده رسولُه، لا على ما أراده المجتهدُ في نفس الأمر”.
فربما يأتي بعضُ الناس إلى دليل فيُؤوِّله ليسلم قولُه، وهذا ليس من الحكمة وليس من الفقه وليس من العقل، وأذكر مثالا على هذا: وهو ما ذكره بعضُ أهل العلم حينما جاء إلى حديث: «غُسلُ يومِ الجُمُعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحتلِم، وسِواكٌ، ويمسُّ مِن الطِّيبِ ما قدر عليهِ» الحديث متّفقٌ عليه، وكان يُرجِّح أن غسل الجمعة مُستحبٌّ، فقيل له: ما معنى «غُسلُ يومِ الجُمُعةِ واجِبٌ»؟ قال: واجب تأتي في اللغة بمعنى الساقط، كما قال تعالى: ﴿والبُدن جعلناها لكُم مِّن شعائِرِ اللّهِ﴾ [الحج: 36]، ثم قال تعالى: ﴿فإِذا وجبت جُنُوبُها﴾ [الحج: 36] أي سقطت على جنوبها، قال: فالواجب هنا بمعنى الساقط، فهذا الحديث دليلٌ على أنّه ليس بواجب. إذن غُسلُ يوم الجمعة ساقِطٌ عن كلِّ مُحتلِم. كما أشار إلى ذلك بعض فقهاء الحنفية، وهذا من التّكلُّف الذي لا ينبغي؛ لأن هذا يُخرجه عن النص الشرعي (واليوم نرى في التيكتوك وغيره مجتهدون يتبعون هذه الطريقة، يريدون رد الثوابت ببعض التفاهات التي يرونها من عقولهم الفارغة).
والواقع أنّ الواجب في لغة الشرع يأتي بمعنى الحتم، والأهمية واللزوم، واللزوم لا يلزمُ منه الوجوبُ التّكلِيفِي الذي عرفهُ الفقهاء من مُصطلحاتهم وعِلمِ الأصولِ، والله أعلم.
وبإذن الله، إذا درس الواحد معنا هذا المنهج فعرف كيف نستدل، وعرف كيف نناقش، وعرف كيف نُرجِّح، والغالب أن الراجح لا يكاد يخرج عن قول جمهور أهل العلم، كما قال الإمامُ الذهبي: “الحق لا يكاد يخرج عن مذهب جمهور أهل العلم، أنا لا أقول أنّه إجماعٌ، ولكني أقول: أنّه لا يكاد يخرج الحقُّ عن مذهب جمهور أهل العلم” انتهى.
وذلك لأنّهم أخذوا العلم عن مدارس الصحابة، فإذا اجتمعت هذه المدارس على معنى أو على راجح أو على قول، فإنّه لا يكاد يخرج عن هذا إلا قول مبنيٌّ على غير أصول الأئمة، ودائما تجدون أنّ الراجح أو الدليل لابد أن يبني أصوله على قواعد ومقدمات، فهذه من المُهِمّات بمكان.
وصل الشيخ معنا في هذا الدرس إلى “صلاة الجمعة”، وكان بهدف البحث عن الدليل أي الراجح من الأقوال مع عرض أقوال المذاهب وغيرها في المسالة، فجزاءه الله خيرا.
هل يُعذر المخالف في المسائلِ الفقهية إذا خالف نصّا صريحا جليّا؟
الجواب: إذا اجتهد الواحد وأخطأ في المسائل العملية؛ فإنه يُعذر، ودليلُ ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخُدرِي أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم صلّيا بالتيمم، فلما جاء الماء، أعاد أحدهما الوضوء والصلاة، أما الآخر فلم يُعِدِ الصلاة وأعاد الوضوء، فلما جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد الوضوء والصلاة: «لك الأجر مرتين»، وقال للذي أعاد الوضوء ولم يُعد الصلاة: «أصبت السُّنة»، فهذا دلالة على أنّ الواحد معذور باجتهاده؛ لأنه خفِيت عليه السنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قُريظة»، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصلِّ، ومع ذلك لم يُعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اجتهدوا.
نريد اسم الكتاب المقرر؟
الجواب: ليس هناك كتابٌ مقررٌ؛ ذلك أننا سوف نذكر المسائل ونتتبع الأقوال فيها؛ لأننا إذا شرحنا كتابا واحدا فربما لا يجده البعض أو ربما يكونوا متتلمذين على مذهب معين، فلأجل الجمع بين الكلمة سنأخذ المسائل ونذكر أحكامها الشرعية طلبا للدليل.
ما معنى فقه؟ وما معنى مصطلح الحديث؟
الفقه في اللغة: الفهم «من يُرد الله به خيرا؛ يفقه في الدين»؛ يعني يُفهمه فيه.
والفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها العملية المستنبطة من الأحكام الشرعية.
وأما المصطلح: فمصطلح الحديث هو العلم الذي يُعرف به تصحيح الحديث من تضعيفه من وجود علة فيه أم لا.
هل يجوز إتباع مذهب واحد؟
بالنسبة للمقلد الذي لا يعرف البحث في الأدلة، لا بأس أن يأخذ قول إمام، أما طالب العلم، أو من يتعلم بحيث يبحث في أقوال أهل العلم، فعليه البحث عن الدليل، والله أعلم.
1- باب المياه والآنية
باب المياه
تعريف الطهارة – صفة الماء الصالح للطهارة – أقسام الماء – ما هو ضابط «إذا بلغ الماءُ قُلّتينِ»؟ – ما حكم الماء الذي سقطت فيه أصباغ ملونة ظاهرة غيرت لونه ولم تغير طعمه، هل يصح الوضوء منه؟ – الوضوء بماء البحر الذي خالطه تراب الشاطئ – الوضوء بالماء الذي له مدة – ما حكم الماء الذي سقط فيه فأر حيّ ثم خرج؟ – ما حكم الماء المُشمّس؟ – ما حكم الماء الذي خالطه الصّابون فغلب عليه؟ – هل الماء الطّهور إذا أُضيف إلى النّجس يجعله طاهرا؟ – عنده إناء فيه ماء فشك هل هو نجس أو طاهر، فماذا يصنع؟
تعريف الطهارة:
الطهارة في اللغة والإصطلاح: الطهارة في اللغة هي “النظافةُ والنزاهة من الأقذارِ”.
وفي الاصطلاح الفقهي هي “ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث”.
والطهارة من حيث المعنى الشرعيُّ هي “التعبد لله تعالى باستعمال الماء أو بدله التيمم، على وجه مخصوص، وفي صفة مخصوصة”.
ولابد في الطهارة الشرعية من وجود النية: لأن الطهارة الشرعية من التعبُّد. فلو جئتُ بماء، وأردت أن أعلمكم طريقة الوضوء، فهذا الوضوء حينما لم أنوِ ارتفاع الحدث ليس طهارة شرعية. وعلى هذا لو أن شخصا دخل في بِركة وهو محدِثٌ حدثا أصغر، فلما انتهى من سباحتِهِ، قال: أنا طاهر، لا ينفعه؛ لأنه لم ينوِ الطهارة، وكذلك لم يرتب الوضوء، لأن ترتيبه ضروري في حالة الحدث الأصغر، وهو مذهب جماهير العلم كما سيأتي.
الحدث: هو “وصف معنوي قائم بالبدن، يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات”، فهو ليس شيئا يُشار إليه بالبنانِ.
وما في معنى رفع الحدث: يسميه العلماء تجديد الوضوء، كالغسلة الثانية، وغسل الميت. فهذا لا يرفع الحدث، ولكنه في معنى ارتفاعه.
زوال الخبث: معناه إزالة النجاسة. والنجاسة إما أن تكون نجاسة عينِيّة أو حُكمِيّة.
فالعينية كروثِ الحمار وعُذرةِ بني آدم وبوله، فهذه لا يمكن أن تطهُر بنفسها.
والحكمية أي ما في حكمها، فكوقوع تلك النجاسة في شيء كثوب أو أرض، فهذا يسمى مُتنجّس، ولا بد من إزالة نجاسته ليطهر. فالحكمية هي الشيء الطاهر الذي وقعت فيه نجاسة.
تعريف المياه:
صفة الماء الصالح للطهارة: لابد في الطهارة الشرعية من نية، ولا بد فيها مما يُتطهر به، والذي يُتطهر به أمران: الماء أو بدله وهو والتيمم.
وللماء المستخدم للطهارة الشرعية صفة، فلا بد أن يوصف بأنه ماء مطلقٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا ﴾ [النساء: 43]. فإذا خرج اسم الماء إلى وصف آخر؛ فإنه لا يصحُّ الوضوء به، لأنه لم يعد ماء، كالعصير الذي سلب الماء المغمور فيه خاصية الماء.
أما بدل الماء فهو التيمم، قال تعالى: ﴿ فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا ﴾ [النساء: 43]، وليس كل تيمم يصحُّ، لابد من الصعيد.
واستعمال الماء أو بدله، يكون على وجه مخصوص، فغسل اليدين قبل الأكل يسمى من حيث اللغةُ وضوءً، لكنه ليس كذلك من حيث الشرع.
ومعنى على وجه مخصوص، أن تبتدئ بالوجه مع المضمضة والاستنشاق، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك تمسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين.
ومعنى بصفة مخصوصة، اليد صفتها أن تغسل إلى المرفق، والرأس أن تُعمّم، إلخ.
هذه هي الطهارة الشرعية.
أقسام الماء:
قسمين:
القسم الأول: الطّهُور.
القسم الثاني: النّجِس.
وبعض أهل العلم جعل المياه ثلاثة أقسام، وهم الشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية، وبعض المالكية، قالوا بأنه ثلاثة أقسام:
الأول: طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره.
الثاني: الطاهر: وهو الطاهر في نفسه، غير المطهر لغيره. يعني أنه لو سُكب في ثياب؛ فإنه لا يُنجسها، لكنك لو أردت أن تتوضأ به؛ فإنه لا يرفع الحدث. فقالوا: هناك طاهر، مُطهِّر في نفسه، ولكنه غير مطهر لغيره.
الثالث: النجس، وهو كل ما وقعت فيه نجاسة، فغيرت أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه.
والصحيح والراجح أن الماء قسمان فقط. القسم الأول: الطهور. والقسم الثاني: النجس.
ذلك أن الله ورسوله لم يذكرا لنا إلا أمرين، طهورا ونجسا، ولم يذكرا شيئا آخر؛ لأن الطاهر لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يتغير وصفُ الماء فيه. الثانية: أن لا يتغير وصف الماء فيه.
فلو وقعت فيه تمرة فإن وصف الماء يبقى موجودا فيه، فنقول: هذا لا يضر، وجود الطاهر فيه في هذه الحالة لا يضر؛ لأن مُسمى الماء ما زال موجودا، فهو إذن يُطهِّر، ولهذا قال – صلى الله عليه وسلم – كما روى الخمسة أحمد وأبو داود والتِّرمِذِيّ والنّسائِي وابن ماجه، ومالك بن أنس وغيرهم، من حديث أبي هريرة: «هو الطّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ ميتتُهُ»؛ يعني بذلك ماء البحر.
فماء البحر له وصف الماء إذا رأيته، لكن إذا تذوقته تجد فيه طعم الملوحة الزائدة، ومع ذلك وجود هذا الملح لم يُخرجه من مُسمى الماء والطُهُورِيّةِ.
ولا فرق أن يكون هذا الماء خِلقة كماء البحر، أو بوضع طاهر فيه.
ومن الفقهاء من قال إنه إن كان خلقة؛ فيجوز، وإن كان قد وُضع فيه مِلحا؛ فإنه لا يجوز.
والصحيح أنه لا فرق، لأن هذا تفريق قياسي ليس له مستند شرعي.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: «هو الطّهور ماؤه الحِلُّ ميتته»، وقال في حديث سعيد الخُدرِي الذي رواه أهل السنن: «إن الماء لا ينجُس». يعني أن الماء الكثير لا ينجسه وقوع نجاسة فيه ما لم يتغير.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهُور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه». وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وفي سنده ضعف، بل حكى الشافعيُّ رحمه الله اتفاق أهل المعرفة بالحديث أن هذا الحديث ضعيف، ولكنه إجماع من أهل العلم على أنّ الماء إذا وقعت فيه نجاسة تُغير لونه أو تغير طعمه أو تغير رائحته؛ فإنه يكون حينئذ نجسا.
لكن كان سكبت عصيرا في كوب ماء فغيّره، أي غير لونه؛ فهل أقول: هذا ماء، أم أقول: هذا عصير؟ أقول: هذا عصير، وبالتالي: لا يجوز الوضوء به لأنه لم يعد ماء.
قال الإمام أبو حامد الغزالي في شرح كتاب الوسيط (وهو في مذهب الشافعي)، ومذهب الشافعي يُقسِّمُ الماء إلى ثلاثة أقسام، قال: “ودِدت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في تقسيم المياه إلى قسمين”.
ومالك له قولان في هذه المسألة، والراجح أن الماء قسمان: طهور، ونجس.
ما هو ضابط «إذا بلغ الماءُ قُلّتينِ»؟
جاء حديث ابن عمر «إذا بلغ الماءُ قلتين» من أربع طرق كلها صحيحة، وقد صححه الإمام أحمد وابن خُزيمة وابن حجر وابن تيميّة وغير واحد من أهل العلم.
فالصحيح أن «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»، معنى قلتان هي القلة من قِلالِ هَجَرْ، وهي تَسعُ خمسة أرطال، فإذا كان هناك خمسة أرطال ثم سقطت فيه نجاسة، فالغالب أن النجاسة اليسيرة لا تُغير الماء الكثير، فأما إن غيرته بلون أو طعم أو رائحة؛ فإنه ينجسُ كائنا ما كان، والله أعلم.
وأما قوله: الخبث، فالمقصود به خبث النجاسة، والله أعلم.
ما حكم الماء الذي سقطت فيه أصباغ ملونة ظاهرة غيرت لونه ولم تغير طعمه، هل يصح الوضوء منه؟
إن كان هذا الصبغُ قد غيّر لونه مثل ما لو سقط حِبرُ على ماء فغير لونه تماما، بحيث يكون لونه أزرق، فإننا نقول: لا يتوضأ منه، لأنه سلبه مُسمى المائية، والله أعلم.
الوضوء بماء البحر الذي خالطه تراب الشاطئ:
إذا ذهبت إلى الشاطئ، فأخذت ماء، فتعكر بتراب الشاطئ، فهل يجوز الوضوء به؟
نعم يجوز، لأن وصف المائية ما زال فيه.
ومما يدل على هذا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أم هانئ أنها قالت: “أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وقد سُتِر بثوب، فاغتسل من جفنة فيها أثرُ العجِينِ”.
العجين طاهر، فوجود هذا العجين في هذا الإناء، قد يُغير الماء، لكن هل غيره إلى وصف جديد أم ما زالت المائية فيه؟
فلما توضأ صلى الله عليه وسلم بهذا الإناء؛ علمنا أن أثر العجين وإن غيّر بعض رائحتِه أو بعض لونه، لم يسلبه مسمى المائية، فعلى هذا توضأ صلى الله عليه وسلم من هذا الطّهُور.
ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند عبد الرزاق أمر قيس بن عمرو حينما أسلم أن يغتسل بماء وسِدر، وأنتم تعلمون أن ورق شجر السِّدر، إذا وُضِع في الماء يغيره أحيانا، ومع ذلك لا بأس.
الوضوء بالماء الذي له مدة:
وأحيانا تجد ماء آسنا، له مدة في البركة، وفيه طحالب، وأحيانا تُغير لونه وطعمه، فإذا لم تخرج وصفية الماء منه، فإنه يجوز الوضوء به، فإن خرجت؛ قلنا: لا يصح الوضوء به، والله أعلم.
قد يقول قائل: لكن هناك أحاديث ربما تُخالف ما تقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري».
قالوا: إن نهي النبي عن الاغتسال في الماء الدائم دليل على أن المجنب إذا وقع في ذلك الماء فإنه وإن لم ينجسه، فإنه قد قلبه إلى معنى آخر غير الطهور، وغير النجس، إذن هو الطاهر.
فالجواب على هذا: نقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل استقذار الناس له، فلو علموا أن هذا الماء المستجمع الصغير قد وقع فيه شخص مجنب واغتسل منه، لتقززت النفوسُ منه، وهذا يمنع من استعماله، فيكون في ذلك إسراف، أي يبقي لا يستعمل، والشارع الحكيم يكره الإسراف لأنه من عمل الشيطان، ولأجل هذا نهى المجنب أن يقع فيه.
قالوا: ما تقولون في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمِس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
ما حكم الناء الذي سقط فيه فأر حيّ ثم خرج؟
من المعلوم أنّ الفأر الحيّ الراجح فيه والله أعلم، أنّه في حكم الطّاهر، وذلك لأنّه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند أهل السُّنن في الهِرّة: «إِنّها ليست بنجس، إِنّها من الطّوّافِين عليكُم والطّوّافاتِ». فكذلك الفأرةُ، فالأصل أنّ سُؤر الفأرةِ طاهرٌ، وعرقها طاهرٌ، ولأنّه يشُقُّ التّحرُّزُ منه، إلا إذا وُجِد شيءٌ من نجاستها على الماء؛ فالأصل أنّه إن كان قد غيّر شيئا من أوصافه؛ فإنّه يكون نجسا، وإن لم يُغيِّر فالأصل فيه الطّهُوريّة.
ما حكم الماء المُشمّس؟
فإنّ بعض الشّافعيّة يقولوا بأنّه لا يجوز استعمال الماء المُسخّن بالشّمس؟
أولا: الشّافعيّةُ لا يقولون بعدم جواز استعماله، بل يقولون – وهو مذهب الحنابلة -: يُكره استعمال الماء المُشمّس.
وقد جاء في ذلك أحاديثُ وهي ضعيفةٌ: أنّه يُورِثُ البرص. والصّحيح أنّ استعمال الماء المُشمّس لا حرج فيه؛ لأنّ هذه المسائل تحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك – والله أعلم.
ما حكم الماء الذي خالطه الصّابون فغلب عليه؟
الماء الذي خالطه الصّابون: إذا كان ماء موجودا فلا حرج في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته حينما ماتت: «اغسِلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، واجعلن في الماء كافورا أو شيئا من كافور». ومن المعلوم أنّ الكافور ربّما إذا كان مطحونا غيّر، فلا حرج في ذلك، فقوله: (غلب عليها الصّابون) لا يُؤثِّر في الماء في الغالب – والله أعلم.
هل الماء الطّهور إذا أُضيف إلى النّجس يجعله طاهرا؟
الجواب نعم إذا أضِيف إليه ماء طهورا بحيث يكون كثيرا ويُزيل النّجاسة، فهذا يُطهِّره. وينبغي أن يكون الماء الطهور كثيرا؛ فيكون وقوعُ نجاسة فيه غير مؤثِّر عليه، والله أعلم.
عنده إناء فيه ماء فشك هل هو نجس أو طاهر، فماذا يصنع؟
الجواب: يبني على اليقين، فيقول: ما هو حال الماء قبل وجود هذا الشك؟
فمثلا وقوع شيء من الأشياء لا يعلم عنها كروثة، فهي إما أن تكون روثة ما يُؤكل لحمه، أو روثة مما لا يُؤكل لحمه كالحمار، فوُجودها مما يُؤكل لحمه في هذا الإناء لا يسلبه الطهورية، لكن وجود روثة ما لا يؤكل لحمه كالحمارِ في هذا الإناء يسلبه الطهورية؛ لأنها نجس.
إذن إذا شك ينظر إلى الماء قبل وجود هذا الشيء، فحكمه أنه طهور؛ فعلى هذا يجوز الوضوء به؛ لأن الأصل هو الطهورية، واليقين لا يزولُ بالشك، واليقين هو أن عنده ماء طهور.
أما إذا كان الأصلُ فيه أنه نجس، فوجد أنّ شخصا قد سكب عليه بعض الماء، أي زاد الماء الموجود في الإناء، فربما هذا الماء يُزيل النجاسة أو لا يزيلها.
فنقول: ننظر إلى الأصل في هذا الماء قبل ورود هذا عليه، فهو كان نجس، فيبقى على نجاسته.
هذا هو مذهب الجمهورِ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان لم يتبين له شيء؛ فإنه يبني على الأصل وهو الطهورية. لكن إذا غلب على ظنِّه أن هذه الروثة روثة حمار مثلا، وعنده دراية في هذا، فإنه لا يبني على الأصل، ولكنه يبني على غلبة الظنِّ.
والراجح أنه إذا كان عنده غلبة ظن بنى على غلبة ظنه، فإن لم يكن معه غلبة ظن بنى على الأصلِ، وهو “أنّ اليقين لا يزول بالشك”، سواء كان اليقين هو الطهورية أو هو النجاسة، لا يُزيله الشك.
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا شكّ أحدكم؛ فليتحرّ الصواب وليبنِ عليه»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «فليتحرّ الصواب وليبنِ عليه»؛ يعني فليعمل بغلبة الظنِّ وهو تحرِّي الصواب، ولم يقل له ابنِ على اليقين، مما يدلُّ على أنّه إن كان عنده غلبة ظنّ فإنه يبني على غلبة ظنه، وإن لم يكن معه غلبة ظن فإنه يبني على اليقين.
الصورة الثانية: إذا اشتبه طهورٌ بنجس.
عندنا إناءان، أعلم أن أحدهما طهور وأعلم أن آخر نجس، لكنني لا أعلم أي الإناءين هو الطهور، ولا أي الإناءين هو النجس، فماذا أصنع؟
قال بعض أهل العلم: إذا كنت لا تعلمُ أيهما؛ فيحرم استعمال أحدهما ويتيمم.
وهل نقول: يبني على اليقينِ؟ لا؛ لأنه ليس عنده يقين، والأصل هو أنّ الطهارة لا تثبتُ إلا بماء طهور، ولا يعلمُ أي الطهورينِ هو.
وذهب بعضُ أهل العلم بناء على قاعدة البناء على غلبة الظن، فقال: إن كان يغلبُ على ظنه أن أحدهما هو الطهور؛ عمل بهذا الطهور، أو أن أحدهما النجس عمل بخلافِه وهو الطهورُ، ولا يجوزُ له أن يتيمم لأنه لم يُعدم الماء، وهذا القولُ أظهرُ، والله أعلم.
مثاله عندك إناءان فجاء الكلبُ فولغ في أحدهما، ومن المعلوم أنّ الكلب إذا ولغ في الإناء يُنجِّسُه، فقال لك الراعي: إن الكلب قد ولغ في أحدهما، وذهب ولم يخبرك أيهما، إذن إما أن تبني على اليقينِ وليس هناك يقين، وإما أن تبني على غلبة الظنِّ، فذهب بعض أهل العلمِ إلى أنك لا تبني على غلبة الظن، بل اليقين هو أن تتركهما جميعا وتتيمم. قالوا: لأنه لما عسر أن يعلم أحد الطهوريين؛ فيكون وجوده كعدمِه، فيتمم.
وقال بعضُ أهل العلمِ: لا، بل يبني على غلبةِ الظنِّ، فإن كان يغلبُ على ظنه أنّ الكلب قد ولغ في هذا وأحسّ فيه نوع تغيُّر، فإنه حينئذ يعملُ بالماء الآخر، وتكون صلاته صحيحة، وهذا هو الراجحُ، والله أعلم.
باب الآنية
كل إناء طاهر يُباح اتخاذه واستعماله؛ إلا آنية الذهب أو الفضة – الفرق بين الاتخاذ والاستعمال – حُكم الخاتم للرجال؟ – لبس الخاتم من الحديد – الإبريق من فضة؟ – هل يجوزُ الوضوء والتطهر من إناء من ذهب أو فضة؟ – لماذا لا نقول إن آنية الماس والياقوت محرمة – ما حُكم آنية الكفار؟ – الأواني من الجلود – لو أن إنسانا لبس فِراء من نمِر، هل يجوز؟ – ماذا عن ما نلبسه من أحزمة أو أحذية جلديّة؟ – أجزاء الميتة كلها نجس، إلا ما لا تدخلُه الحياة.
أحيانا يحتاج المتوضئ إلى إناء، فلا بد من ذكره، وقد كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الآنية بعد باب المياه.
كل إناء طاهر يُباح اتخاذه واستعماله؛ إلا آنية الذهب أو الفضة:
قولنا: كل إناء طاهر، فالأصلُ في الأواني الطهورية، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والحِلُّ؛ كما قال الله تعالى: ﴿ هُو الّذِي خلق لكُم مّا فِي الأرضِ جمِيعا ﴾ [البقرة: 29]؛ خلق الله لنا كل ما في الأرض لأجل أن نتنعّم به في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيما يُعين على ذلك.
ومن الأدلةِ على ذلك ما جاء في البخاريِّ من حديث عبد الله بن زيد، قال: “أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور، فتوضأ به” (التّورِ إناء من نُحاس)، فدلّ ذلك على أن كلّ إناء طاهر يُباح اتخاذه واستعماله.
إذن الأصلُ أن كلّ شيء يُباح اتخاذه واستعماله، ولو كان غالي الثمن، ولو كان هذا الإناء من الماس أو الزُّبُرُّدِ أو من الجواهرِ وغير ذلك، إلا آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لورود النصِّ الشرعيِّ فيهما.
وهو ما جاء في الصحيحين من حديث حُذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافِهِما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
فنهانا الشارع أن نتخذ أو أن نستعمل الذهب والفضة نصّا.
وقد جاء في مسلم من حديث أم سلمة: «الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجرجِرُ في بطنه نار جهنّم»، والعياذ بالله.
قال أهل العلم: فإذا مُنع الإنسانُ من شُرب الإناء الذي فيه فضة؛ دلّ ذلك على أن الذهب من باب أولى وأحرى. هذا هو سبب المنع في آنية الذهب والفضة. فأما الذهبُ والفضة؛ فلا يجوز استعمالهما.
الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:
الاتخاذ: هو أن يُقتنى للزينة، كتحفة تضعها في زاوية من البيت، هذا يُسمى اقتناء، أو أن تستعملها أحيانا للحاجة؛ مثل أن تضع جُلجُلا – قارُورة صغيرة – نضع فيه بعض الأشياء، فهذا استخدام للحاجة.
أما الاستعمالُ فهو التلبُّس بالشيء كاللباس، والاغتسال به، والوضوء به، وغير ذلك.
الاستعمال هو التلبس للانتفاع؛ مثل أن يلبس ما فيه ذهب، أو أن يلبس ساعة من ذهب، أو أن يضع شيئا من ثياب أو قُرُط أو غير ذلك.
فآنية الذهب والفضة لا يجوز على مذهب جمهور أهل العلم لا اتخاذٌ ولا الإستعمالٌ وغيره، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
وذلك أنه قد جاءت أحاديث من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث أبي موسى الأشعري، وإن كان فيها بعض الانقطاع، إلا أنه يدل على أن لها أصلا؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رفع حريرا وذهبا، وقال: «هذانِ حرامٌ على ذكورِ أمتي حِلٌّ لإناثها»، فدل ذلك على أنّ استعمال الذهب والفضة ينقسمُ إلى أقسام:
القسم الأول: الأكل والشرب فيهما.
فإذا أكل الإنسان أو شرب في آنية الذهب والفضة فحكم ذلك أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، وكلُّ عقوبة توعّد الشارعُ فيها بلعنة أو غضب أو نار؛ فهي في كبيرة، فإذا كان هذا في الشرب في الفضة، فالذهب من باب أولى، ولحديث حذيفة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافهما». هذا في الأكل والشرب.
القسم الثاني: اللباس.
اللباس للنساء حلال، فيجوز للمرأة أن تضع ما شاءت من قرط أو ساعة إلخ؛ لقول الله تعالى: ﴿ أومن يُنشّأُ فِي الحِليةِ وهُو فِي الخِصامِ غيرُ مُبِين ﴾ [الزخرف: 18]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر النساء، تصدقن ولو من حُليِّكُنّ»، فدل ذلك على أنّ النساء تصنعُ الحليّ وتلبسُهُ، فدل ذلك على أنّ الحلي للنساء جائز ذهبا أو فضة.
أما الرجالُ؛ فيحرم الذهب للرجال، ولا يجوز استعمالُ الذهب للرجالِ إلا لضرورة، أو إذا كان مغمورا لا أثر له. ومعنى المغمور بحيث يكون لو عُرض على النار لم يبق منه شيء، مثل “المشالح” التي فيها “زري”، يقولون إن فيها عشرة جرامات، فلو عرضت هذه “الزري” على النار لذاب ولم يبق فيه شيء، فدل ذلك على أنه إنما قُصد لإبقاء اللمعة واللون، فإذا كان قد بقي شيءٌ منه كثيرٌ؛ فإنه يحرُم.
أما النوع الأول وهو للضرورة، فقد جاء عند أبي داود وعند البيهقِي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعرفجة حينما قُطِع أنفُه في معركة ذاتِ الكُلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل ذلك على أنه لضرورة فلا حرج.
واليوم نجد بعض النساء أو بعض الرجال يضعون سِنّا من ذهب، فما حُكم ذلك؟
أما الرجال فإنه لا يجوز، لأنه يوجد بديلٌ، بل بديل أفضل أحيانا، أما إذا كان لضرورة فيجوزُ، مثل أن يكون في بلد لا توجدُ فيه الأنواع الأخرى، فإذا كانت موجودة وتؤدِّي الغرض؛ فلا يجوز استخدامه للرجال.
وأما النساء فالأصل فيها الجواز، وتركه أولى خوفا من أن يكون داخلا في مجال الأكل والشرب، وإن كان بعضهم يرى أنه نوع من اللباس، والله أعلم.
حُكم الخاتم للرجال؟
الخاتم للرجال من الذهب لا يجوز. وكذلك القلم من الذهب والساعة من الذهب، لا يجوز؛ لأنها ظاهرة.
أما الفضة للرجال؛ فيجوز استخدام خاتم من فضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كما في الصحيحين من حديث ابن عُمر وغيره.
أما استخدام شيء من الفضة غير الخاتم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك الشيء المستعمل إن كان بمقدار حجمِ الخاتم؛ فلا حرج؛ لأن الشارع حينما أباح لبس الخاتم من الفضة للرجال، دل ذلك على أنه يباح هذا من باب التخفيفِ، فهذا تقريبا 150-200 جرام، أي لا يزيد عن 250 تقريبا، فدل ذلك على أن 150 جراما تقريبا يجوز وضعها في “الكبك” للرجال، هذا على رأي ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول للحنفية.
وكذلك يجوز وضع الأزِرّة بمقدار لا يزيد عن 150 جراما، وأما ما زاد على ذلك فلا ينبغي؛ لأنه في حُكم النهي عن الذهب والفضة.
فالأولى ألا يزاد لبس الفضة بمقدار ما يُلبس من الخاتم، أي 150 جراما يوضع في ساعة أو في “الكبك”، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية، ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول لبعض الحنفية، واستدلوا بما عند أبي داود: «وأما الفضةُ، فالعبوا فيهما» ولكن الحديث فيه ضعف. إذن: نحن قسمنا هذا الأمر.
سؤال: نودُّ من فضيلتكم شيئا من التّفصيل في حكم لبس الخاتم من غير الذّهب للرجال، وأقوال الفقهاء في ذلك؟
مسألة الخاتم اختلف فيها العلماء في غير الذهب: فقال بعضُ أهل العلم: يُستحبُّ الخاتم من الفضة، وأمّا إذا كان من الذّهب فإننا نقول مُحرّمٌ. وهذا قول عامة أهل العلم، بل قد حكى بعضُهم الإجماع. وقالوا: ما ورد في حديث ابن عمر عند البخاريِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتّخذ ذهبا، هي زيادة منكرة، أو أنّه منسوخٌ، وعلى هذا فلبس الخاتم الذهب للرجال مُحرّمٌ كما جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة ذلك.
أمّا من الفضة فقد قال بعضُ أهل العلم أنّ لبس الخاتم من الفضة مستحبٌّ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم اتّخذ، فاتّخذ الناس، وهذا مذهب الجمهور.
وقال بعضُهم: إنّ لبس الخاتم إنّما يُستحبُّ إذا كان يُلبس لأجل أن ينتفع به في الختم؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتّخذ خاتما إلا حينما أراد أن يكتب إلى الناس، فقالوا: “إنّهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم”. فاتّخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم بعد.
فدلّ ذلك على أنّ الإستحباب هو أن يكون على هيئةِ وحالةِ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول إنّما لبس الخاتم حينما احتاج إليه.
ويدل على الجواز أنّ الناس لبسوا الخاتم لما لبسه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ففعل الناس دليلٌ على الجواز، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة دليلٌ على الإستحباب، ولعلّ هذا القول الثاني أظهر وأقوى، والله أعلم.
لبس الخاتم من الحديد:
فإنّ بعض أهل العلم حرّم ذلك؛ لأجل أنّها حِليةُ أهل النار، والرّاجح والله أعلم أنّ كلّ حديث يدلُّ على أنّ الحديد حِليةُ أهل النار فهو حديثٌ ضعيفٌ، كما أشار إلى ذلك الحافظُ ابن رجب وغيره، ولكن الراجح جوازه لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال كما في الصّحيحين من حديث سهل بن سعد السّاعِدِي: «اتّخِذ ولو خاتما مِن حدِيد»، فهذا يدلُّ على أنهم كانوا يلبسون الخاتم من الحديد، وهذا نوعٌ من التقرير الفعلي.
القسم الثالث: استعماله واتخاذه للرجال والنساء.
الأصل أنه يُمنع؛ لأنه لا حاجة في ذلك، وبعضهم يقول: إذا جاز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة، فما الفرق بين اللباس وبين الاتخاذ؟
الجواب أنّ الاتخاذ ليس فيه حاجة، وأما المرأة في لباسها؛ فإنها تحتاج، والأولى ألا يُتخذ الذهب والفضة من حيث الاتخاذ.
الإبريق من فضة؟
وقد يُشتهر في بعض بلاد المغرب الإسلامي وغيره، يضعون إبريقا من فضة، أو بعض اللذين يأكلون يأكلون بملاعق من فضة، فما حُكم ذلك؟
هذا لا يجوز، وأما إذا كان نوعا من إبقاء اللون، بحيث لو عُرض على النار لم يبق شيئا فلا بأس به (أي فيه شيئا قليلا من فضة)، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
هل يجوزُ الوضوء والتطهر من إناء من ذهب أو فضة؟
فائدة: الطهارة بإناء من ذهب أو فضة تصحُّ مع الإثمِ.
الطهارة بالإناء الذي فيه ذهب وفضة تصحُّ مع التحريم، فلو توضأ إنسان بإناء من ذهب أو فضة فإن طهارته صحيحة، هذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.. قالوا: لأن النهي عن استعمال الذهب والفضة لا علاقة له بفساد عبادة الطهارة؛ لأن الماء طهور، وهذه نوع من الآلات أي إناء مستعمل خارج عن ماهية العبادة، وهذا هو الراجحُ.
فالطهارة صحيحة، لكنها مع المنع والإثم، فالأفضل ألا يستخدمه البتة، والله أعلم.
لماذا لا نقول إن آنية الماس والياقوت محرمة قياسا على الذهب والفضة لأنها غالية مثلها؟
السبب في منع الذهب والفضة هو ورود نص فيها، مثل: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»، لا غلائها أو كسر قلوب الفقراء لأن الإنسان أحيانا يستخدمها دون سر لقلوبهم، فدل ذلك على أنها آنية أهل الجنة، فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يستعملوها، فتكون لهم خالصة يوم القيامة، ولا تكون للكفار، وعلى هذا فالنهي ليس لأجل الغلاء، ولكن لأجل خصوصية الذهب والفضة، والعلة قاصرة فيه.
ما حُكم آنية الكفار؟
القاعدةُ هي أن كلُّ إناء طاهر يُباح اتخاذُه واستعمالُه، فكذلك آنية الكفار يباح استعمالها ما لم يُعلم نجاستُها، فإن عُلم نجاستها فيحرم استعمالهما، وأما إذا لم يُعلم فالأصل أن الإناء طاهرٌ.
والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حُصين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادةِ مُشركة، والمزادة نوع من القِربة الصغيرة، وأعطى رجلا من أصحابه أن يغتسل حينما أجنب؛ قال: «خذ هذا، فأفرغه عليك»، وفي رواية: «أفرغه على جسدك». فدل ذلك على أن استعمال آنية الكفار لا بأس به، ولا حرج.
ما تقولون فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخُشنِي رضي الله عنه، أنه قال: “يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكلُ في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إِلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها”.
نقول: يا إخوان، هذه فائدة لنا جميعا: أحيانا نقرأ الأحاديث، فيجب العلم بأنّ ظاهر الحديث لا يؤخذ به على الإطلاق، فأحيانا يكون الراوي أو المصنِّف قد كتب هذا الحديث مختصرا، ولم يجمع جميع طرق الحديث؛ لأنّ تتبع الطرق وجمع الروايات يُظهر فيها معنى غير المعنى الذي اختُصِر في ذلك الحديث.
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تأكلوا فيها” خوفا من أن يكون قد علق فيها شيء من لحم الخنزيرِ الذي هو رِجس بالإجماع، أو شيء من الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: «إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها». فدل ذلك على أن هذا الحديث لم يكن منعا على الإطلاق، وإنما قُصد به حالةٌ خاصة لأنه جواب من النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال، وعندنا قاعدة أصولية وهي:
قاعدة: السؤال مُعادٌ فيه الجوابُ
أي إن إجابة النبيِّ صلى الله عليه وسلم إنما كانت لأجل معنى من المعاني سئل عنه صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا: إن كانت فيها خمر أو لحم خنزير؛ فلا يجوزُ الأكل فيها إلا أن تُغسل، ومعنى النهي «لا تأكلوا فيها» من باب التّوقِّي والورع، أما إذا كانت طاهرة؛ فلا حرج أن يستعملها، فيكون منع النبي ابتداء إنما هو من بابِ التوقِّي والورع والابتعاد عن سائر النجاسات، والله أعلم.
الأواني من الجلود:
وقد توضّأ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من مزادةِ مُشركة، والمزادةُ هي جِلد قد دُبغ.
ومن المعلوم أنّ الحيوان الذي يكونُ مأكول اللحم إذا ذُكي فإنه طاهر، فبالتالي جلده جلده طاهر.
لكن أحيانا تكون ميتة، فإذا دُبغ جلدها هل يطهُر أم لا؟
اختلف العلماءُ في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وأرجح هذه الأقوال أنّ هذا الحيوان الميت لا يخلو أن يكون طاهرا في الحياة مما يؤكل لحمه، أو ليس طاهرا ولا يُؤكل لحمه.
فإن كان طاهرا ولا يُؤكل لحمه كالهرِّ، فإنه لا ينفع فيه الدبغ، وإن كان نجسا ولا يُؤكل لحمه فلا ينفع فيه الدبغ.
أما إن كان طاهرا في الحياة، ومما يؤكل لحمه فينفع فيه الدبغ، فيكون الدبغ بمنزلة الذكاة. والدليل هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قوم يجرون شاة ميتة، فقال: «أفلا انتفعتم بإِهابِها؟»؛ أي بجلدها، قالوا: إنها ميتة، لأنه معلوم عندهم أن الميتة محرمة، ففي الآية: «إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما حَرُم أكلها».
فالشاة ينفع فيها التذكية، والدبغ بمنزلة الذكاة.
قالوا: هذا يخالف حديث ابن عباس، «إذا دبغ الإهابُ فقد طهُر» وقد رواه مسلم، قالوا: ولم يكن هناك فرق بين إهاب وإهاب.
قلنا: هذا حديث عام، خُصِّص فيما يؤكل لحمُه، ودليله ما جاء عند الإمام أحمد وغيره والدّارقُطنيّ وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دِباغها ذكاتها»، وفي رواية «دباغها طهورها»، وفي حديث سلمة بن المُحبِّقِ: «دِباغُ جلودِ الميتة ذكاتها»، والحديث بمجموع طرقه يدلُّ على أن له أصلا، وأحسن شيء في الباب حديثُ عائشة: «دِباغها طهُورها».
وجه الدلالة: قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «دباغها ذكاتها»، فإننا ننظر، فإن الأسد لو ذُكي هل يطهر؟ لا، فلم يكن هذه الذكاة تنفع النجس، فدل ذلك على أن الدبغ بمنزلة التّذكِية، والتذكية لا تُطهِّرُ إلا ما يُؤكلُ لحمُهُ، وهذا القول أظهر وأحوط.
لو أن إنسانا لبس فِراء من نمِر، هل يجوز؟
نقول: أولا: إن كان قد دُبغ؛ فلا يجوز الصلاةُ فيه. ثانيا: أن جلود السباع جاء فيها نهي خاص، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع؛ لأنها من فعل المجوس، فعل الفرس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث المقداد بن معدي كرب وفي حديث معاوية بن أبي سفيان، وأما في غير السباع، مما لا يُؤكل لحمه؛ فإنهم قالوا: يجوزُ استعماله في اليابسات، ولكن لا يُصلى فيه، ولا يُوضع في إناء رطب؛ لأنه سوف يُنجِّسُه.
والذي يظهر لي أن الغالب أن يكون ذلك في الحيةِ، لأنّ الحية ليست من السباع، ومع ذلك فهي نجسة، فإذا دبغت فإنها تستخدم في اليابسات؛ مثل أن تعلق في السيارة، أما أن تستخدم في الرطب؛ فهذا ينجسها، والله أعلم.
ماذا عن ما نلبسه من أحزمة أو أحذية جلديّة؟
يعلم ذلك بسؤال صاحب الأحذية في الغالب، فإذا قال إنّها من جلد ما يُؤكل لحمُه من البقر أو الغنم أو غير ذلك؛ فيكتفي، وأمّا إذا قال: هو من جلود السِّباع؛ فإن لبسه في اليابس جائزٌ، وأمّا إذا كان رطبا فإنّه يجب عليه إذا لبسه أن يغسل رجليه؛ لأنّه لا ينبغي ذلك؛ لأنّه من النّجس، والله أعلم.
أجزاء الميتة كلها نجس، إلا ما لا تدخلُه الحياة:
قالوا: كل جزء من أجزاءِ الميتة إذا كان فيه دمٌ فالدم تدخله الحياة، فهو إذا ماتت نجس؛ أما ما لا تدخله الحياة، فهو طاهر، مثل: الصوف، والشعر.
وقد كان الصحابة يجزون الصوف من بهيمة الحيوانِ.
وما أُبِين من حيِّ فهو كميتتِه، فإذا قطعت يد حيوان وهو حي، فهذه اليد ميتة.
فهذا الجز من الصوف استخدمه الصحابة، فلو كان هذا من غيرِه من أعضائه؛ لما جاز استعماله؛ لأنه سوف يكون نجسا، وقد أُبين من حيّ، فلما جاز استعمالُه؛ صار مستثنى من أعضاء الحيوانِ؛ فدلّ ذلك على أن الصوف والشعر لا بأس به، وهذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وتوجد أعضاء مِن الميتة اختلف العلماء فيها، مثل العظم والقرن والسِّن. فذهب الجمهور – المالكية، والشافعية، والحنابلة – إلى أن السِّنّ والقرن والظُّلف نجسٌ.
والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أن السنّ والقرن والظلف طاهر؛ لأن حياته حياةٌ نباتية وليست حياة حيوانية. أي أن نموه مثل الحياة النباتية ليس فيه دم، فدل ذلك على أنه طاهرٌ، وهذا هو ظاهر كلام البخاريِّ، فإنّ البخاريّ ذكر حديثا معلقا بصيغة الجزم أن محمد بن سيرين سُئل عن العاجِ وهو سِنُّ الفيلِ، فقال لا بأس بالتمشُّطِ به لأنه في حكم الطاهر، والله أعلم.
أما العظم فالذي يظهر أنه إذا فُتح ففيه دم، فدل ذلك على أن عظم الميتة نجس، ولو كان مما يؤكل لحمه، والله أعلم.
2. باب آداب قضاء الحاجة
آداب قضاء الحاجة:
تعريف – ماذا يقول عند دخول الخلاء؟ – ماذا يقول عند خروجه من الخلاء؟ – ما الحِكمةُ من قوله «غُفرانك»؟ – ماذا لو دخل الإنسانُ الخلاء وقد نسي أن يقول الذكر؟ – تقديم الرجل اليسرى عند الدخول – هل يُكره دخولُ شيء فيه ذكرُ الله في الخلاء؟ – وإذا أراد الإنسانُ أن يقضي حاجته ابتعد – ويُستحبُّ للإنسانِ عند قضاء الحاجة ألا يتكلّم – حديث ضعيف في رؤية عورة الآخر – حكم استقبال القبلة واستدبارها – حكم الإِستِنجاء بالماء، أو الإستِجمار بالحجر، أو بهما معا – طريقة وأحكام الإستِجمار – حكم الإِستِنجاء أو الإستِجمار باليمين – وإذا قضى الإنسانُ حاجته فكيف يتمسّح بيمينه؟ – استحباب ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض – ولا ينبغي له أن يكشف عورته إلا إذا أراد أن يقضي الحاجة – المواضع التي يُنهى عن التّخلِّي فيها.
تعريف:
من المعلوم أنّ الفقهاء رحمهم الله يذكرون آداب قضاء الحاجة بهذا العنوان، وأحيانا يذكرونها في باب الإِستِنجاء.
ومن المعلومِ أنّ الإِستِنجاء هو: إزالةُ الخارج من السّبِيلين بالماء أو بغيره كالإستِجمار.
وكلمة ( آداب) يُقصد بها الأشياءُ التي تُفعل عند قضاء الحاجة مما هو: واجبٌ، أو مُستحبٌّ، أو مُحرّمٌ، أو منعُ استعمالِهِ كمُحرّم أو مكروه، أو أنّ ذلك مُباحٌ، والله أعلم.
حينما نتحدثُ عن آداب قضاء الحاجة فمن المعلوم أنّ المسلم لا يدخل لقضاء الحاجة إلا في مكان، وهذا المكانُ إمّا أن يكون قد خُصِّص لذلك، كالحُشِّ ونحوه، أو يكون في فضاء. فإذا أراد أن يقضي حاجته في مكان ما: فإنّ هذا المكان الذي سيقضي فيه حاجته يكون في حُكمِ دخولِه للحُشِّ.
والخلاء: هو المكان الذي يُقضى فيه الحاجة (كدورات المياه)، فلو كان في صحراء فوجد مكانا يريد أن يقضي فيه حاجته؛ فإنّه حينئذ يكون هذا المكان في حكم قضاء الحاجة.
ماذا يقول عند دخول الخلاء؟
يُستحبُّ له إذا أراد أن يأتي مكان قضاء حاجته أن يقول دعاء دخول الخلاء كما في الصّحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللّهُمّ إنِّي أعوذُ بك مِن الخُبُثِ -أو مِن الخُبُثِ والخبائِث». والحديث متّفقٌ عليه.
وفيه فائدةٌ: وهي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قبل الدخول (أي عند دخول الخلاء)؛ وعلى هذا فإذا أراد الإنسانُ أن يدخل الخلاء، فإنّه قبل أن يدخل يقول هذا.
وإذا كان في فضاء ورأى أنّه مكان يحسُن أن يقضي حاجته فيه فإنّه يقول: “اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث”.
وقد اختلف أهل العلم في مسألة النُّطق: هل هي الخُبْث بضم الخاء وسكون الباء، أم هي الخُبُث بضم الخاء وضم الباء؟
بعضُ أهل العلم – وهو قول أكثر المُحدِّثين – يقول إنّ الأصحّ التّسكين. وبعضُهم يقول إنّ الأصح هو الضم.
وكل طرف له وجهة نظر، والذي يظهر والله أعلم أنّ الأشهر هو: الخُبُث بالضم، وإن كان يجوز التّسكينُ من باب التّخفيف عند علماء اللُّغة، كما تقول: رُسُل ورُسْل، كُتُب وكُتْب. كلُّ ذلك جائزٌ، فالأصل هو كُتُب بالضم، ولكن يجوز أن تقول: كُتْب.
وعلى هذا إذا قلت: الخُبْث أو الخُبُث. فكلُّ ذلك جائزٌ.
معنى الخُبُث؟
قال بعضُهم: إنّه بالضّمِّ ذُكران الشّياطين، والخبائث إناثُ الشّياطين.
وقال بعضُهم: إنّه بالتّسكين يكون المقصودُ به الشّرّ، فالخُبْث هو الشّرُّ، والخبائث هي الذّوات الشِّريرة. إذن فالأول بالتّسكين الشّر، والخبائث المقصود بها الشريرة.
والذي يظهر والله أعلم أنّنا إذا قلنا (الخُبُث والخبائث) فالمقصود به ذُكران الشّياطين والشّر نفسه، والخبائث إناثُ الشّياطين والأنفس الشِّريرة كلها، وهذا هو الأظهر، والله أعلم.
ومن المعلوم أنّ الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنّه لابدّ له من ذِكر؛ لأنّه بحاجة إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى.
وبعضُ الناس يقول: بسم الله؟
فأقول: إنّه لو قال (بسم الله اللّهُمّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) فجائزٌ، ولكنّ كلّ الأحاديث الواردة بالبسملة أحاديث ضعيفةٌ.
فإذا لم يقل (بسم الله) فهذا هو الّذي جاءت به السُّنة، فإن قالها فلا حرج – شرِيطة ألا يظنّ أنّها سُنّةٌ أو يُداوِم عليها، والله أعلم.
ما سبب هذا الذِّكر؟
الجواب: التعوّذ بالله من الذي ينظر إلى عورته، ولهذا قال – صلى الله عليه وسلم: «إِنّ هذِهِ الحُشُوش مُحتضرةٌ، فإِذا أتى أحدُكم الغائِط فليقُل: اللّهُمّ إنِّي أعوذُ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ». فلأجل أنّها مُحتضرةٌ يعني حاضِرةٌ، فإنه ينبغي له أن يتعوّذ بالله من شرِّها، والله أعلم.
ماذا يقول عند خروجه من الخلاء؟
يقول: ( غُفرانك)، كما ثبت عند أهل السُّنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج من الخلاءِ قال: «غُفرانك». وهذا الحديثُ صحّحه ابنُ خُزيمة وابنُ حِبّان والنّوويُّ وغيرُ واحد من أهل العلم.
ولو قال: (الحمدُ لله الذي أذهب عني الأذى وعافانِي)، فهذا رواه ابنُ ماجه، فلا حرج، لكن فيه ضعفٌ والله أعلم. والصّحيحُ أنّه من قول أبي ذرّ كما ذكر الدّارقُطنيّ، فإن قاله أحيانا فلا حرج، ولو لازمه لأنّه قولُ صحابيّ فلا حرج إن شاء الله، لكنّ السُّنة أن يقول: «غُفرانك».
ما الحِكمةُ من قوله «غُفرانك»؟
أنّه لمّا يسّر اللهُ له إزالة ما في بطنه فهو يسأل ربّه أن يُزِيل ما علِق من الذُّنوب، فلمّا زال ما علِق من الأوساخ الحِسِّيّة ناسب أن يسأل ربّه أن يُزيل عنه الأوساخ المعنويّة، وهذا ظاهرٌ، والله أعلم.
ماذا لو دخل الإنسانُ الخلاء وقد نسي أن يقول الذكر؟
لا حرج أن يقول: (اللّهُمّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) وهو يقضي حاجته.
وسوف نتحدّث عن مسألة ذكر الله في الخلاء، وأنّ ذلك مكروهٌ، فذكر الله العامّ مكروهٌ في الخلاء، وقول: (اللّهُمّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) مُستحبٌّ، والقاعدة تقول:
وهذا غير ما لو جاء مُباحٌ ومُحرّمٌ فيُقدّم المُحرّم.
إذن مُبِيحٌ وحاظِرٌ، فيُقدّم الحاظِرُ. أمّا الواجبُ فيُقدّم على المُحرّم، والمُستحبُّ يُقدّم على المكرُوه.
وعلى هذا فلو قال: (اللّهُمّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) وهو في دورة المياه فلا حرج في ذلك؛ لأنّ المُستحبّ أقوى من المكروه، والله أعلم.
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول:
ويُستحبُّ له قبل أن يدخل الخلاء أن يُقدِّم رِجله اليُسرى، وإذا أراد أن يخرج قدّم رِجله اليُمنى، وذلك لما جاء في الصّحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: “كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجِبُه التّيمُّن في تنعُّلِه إذا انتعل، وفي ترجُّلِه إذا ترجّل”. وفي رواية: “وفي شأنه كلِّه”. فدلّ ذلك على أنّ كلّ ما كان فيه إكرامٌ لليمين قُدِّمت اليُمنى، وكلّ ما فيه عدمُ إكرام لليمين قُدِّمت اليُسرى.
وقُل مِثل ذلك في دخول المسجد، فدُخول المسجدِ إكرامٌ لليمين؛ فيُقدِّم اليُمنى، وعند الخروجِ بقاءُ الرِّجلِ في المسجد أبركُ من بقاءها خارج المسجد؛ فيُقدِّم اليُسرى، والله أعلم.
هل يُكره دخولُ شيء فيه ذكرُ الله في الخلاء؟
لا يخلو هذا الشيء من أمرين: أولا: المصحف: فما حُكم دخول الخلاء بالمُصحف؟
الجواب: لا يجوز، بل قال بعضُ أهل العلم: “ولا أظنُّ عاقلا يُخالف في ذلك”، كما قال المِرداوِي صاحب “الإنصاف”.
فلا يجوز لأنّ المصحف مأمورٌ فيه بالإكرام، ودخول الخلاء فيه الإهانة، إلا إذا كان ذلك خوفا عليه، فيصبح ضرورة فلا حرج، مثل أن يكون في دورات مياه غير أهل الإسلام، أو يكون مصحفُه يخاف عليه من سرقة ونحوها، فيجعله داخل الجيبِ، ومع ذلك يجب توقّى ألا يُدخله، والله أعلم.
الثاني: دخول شيء فيه ذكرُ الله، كصحيفة فيها اسم الله:
أولا: لم يرد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ صحيحٌ في هذا الباب، واستدلّ بعضُ أهل العلم على الكراهة، فقالوا: “لِما جاء من حديث أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع خاتمه، وكان نقشُه: محمدٌ رسولُ الله”. فقالوا: كلمةُ “الله” ذكرٌ لله، فكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يخلع خاتمه لأجل ألا يدخل به الخلاء.
والجواب على هذا: أنّ هذا الحديث لا يصِحُّ مرفوعا، فقد ضعّفه النّسائِي وأبو داود وقال: مُنكرٌ. وهذه هي طريقةُ أهل العلم من المُتقدِّمين، وصحّحه بعضُ أهلِ العلم من المُتأخِّرين، والصّحيح أنّ الحديث موقوفٌ على أنس.
فإن دخل بشيء فيه ذكرُ الله فلا حرج إن شاء الله، والأفضل ألا يُدخِل شيئا فيه ذكرُ الله الخلاء، إلا إذا كان قد وضعه في جيبه، فلا حرج في ذلك؛ لأنّه في حكم ما في قلبك، وقلبك في حكم الصُّندوق، فكذلك دخولك به.
وقُل مثل ذلك في دخول الأجهزة الإلكترونيّة كالجوال والآيفون وغير ذلك، التي فيها مصاحف، فإذا كانت مُقفلة وهي داخله فهذه حكمها مثل حكم ما لو دخل الإنسانُ وفي قلبه القرآنُ كاملا، فلا حرج في ذلك، لكن إذا كان سيُظهره أو يقرأ فيه؛ فلا ينبغي له ذلك، والله أعلم .
وإذا أراد الإنسانُ أن يقضي حاجته ابتعد:
وهذا كما جاء في الصّحيح من حديث المُغِيرة بن شُعبة رضي الله عنه أنّه قال: “حتّى توارى – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- عنِّي في سوادِ اللّيلِ”. فهذا يدلُّ على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ابتعد.
إذن الابتعادُ غير الإستتار، فأنت ربما تقضي حاجتك وقد استترت من زُملائك وأصحابك، لكنّك لم تبتعد، فالسُّنة أن تبتعد، وقد جاء في ذلك حديث: “أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد”، ولكن الحديث ضعيفٌ، وأحسن شيء هو حديث المُغِيرة بن شُعبة رضي الله عنه، إذن يُستحب للإنسان أن يبتعد.
الثاني: الإستتار:
والاستتار نوعان: استتارٌ عن كشف العورة، فهذا واجبٌ أن يستتر، فبعض الناسُ أحيانا لا يُبالي فيقضي حاجته في دورات المياه والناس ينظرون إلى عورته، وهذا لا يجوز؛ لما جاء عند أهل السُّنن أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُئل وقال له الصحابةُ: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: «احفظ عورتك إلا من زوجِك أو ما ملكت يمِينُك». قالوا: يا رسول الله، يكون أحدُنا وحده! قال: «فاللهُ أحقُّ أن يُستحيى منه». فدلّ ذلك على أنّ الإنسان إذا كان مع إخوانه فيجب أن يحفظ عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه.
الثاني: الاستتار بمعنى ألا يراه أصحابُه حال قضاء الحاجة؛ يعني يختفي، فعندنا ابتعادٌ، والثاني أي الإستتار اختفاءٌ.
فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتِر؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحبّ ما استتر لحاجته هدفٌ أو حائِشُ نخل، والهدف هو الشيء المُعترِض، مثل: تلّ صغير أو شجرة ليس لها ظلٌّ يُنتفع به، فيقضي حاجته، بحيث لا يراه أحدٌ ولو كان قريبا. فهذا هو الأفضل، وينبغي أن يكون عليه المسلم.
فإذا لم يجد مكانا فلا حرج إن شاء الله، شريطة ألا يظهر منه شيءٌ من العورة، وقد قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصّحيحين: «فأتى – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – سُباطة قوم فبال قائما وأنا خلف عقِبِهِ». يعني أنه قريبٌ منه، فإذا كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
ويُستحبُّ للإنسانِ عند قضاء الحاجة ألا يتكلّم:
لأنّ بعض أهل العلم يرى أنّ الكلام ممقوتٌ، واستدلُّوا على ذلك بما جاء من حديث ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فجاء رجلٌ فسلّم عليه، فلم يرد عليه السلام، ثم قال: «إنِّي كرِهتُ أن أذكُر اللهِ وأنا على غيرِ طُهر». فقالوا يُكره لذلك.
والصّحيحُ أنّ هذا الحديث ليس فيه دلالةٌ على أنّه يُكره الكلامُ حال قضاء الحاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما كره ذلك لأجل أنّه يقول: (وعليكم السلام)، ففيه ذكرٌ لله وهو غيرُ طاهر. فدلّ ذلك على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما امتنع لأجل عدم الطُّهر.
ومما يدلُّ على أنّ الكلام لا بأس به إن كان لحاجة؛ ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنّه صلى الله عليه وسلم قال له: «ائتِنِي بثلاثةِ أحجار». قال: “فأتيتُه وهو يقضي حاجته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الرّوثة، وقال: «إِنّها رِجسٌ»”. وفي رواية عند ابن خُزيمة: «ائتِنِي بغيرِها». فدلّ ذلك على أنّه إذا احتاج إلى الكلام فلا حرج، فإذا كان الإنسانُ في دورات المياه وطُرِق عليه البابُ فلا حرج أن يتنحنح، أو يقول: أنا فيه. أو يُنادى به فيُقال: يا فلان. فيقول: نعم. بحيث يُخبر السائل.
حديث ضعيف في رؤية عورة الآخر:
أمّا الحديثُ الواردُ من أنّ الله يمقُتُ الرّجلين يخرجان قد ظهرت عوراتُهما يتغوّطان، فإنّ الله يمقُتُ من ذلك. فهذا الحديثُ ضعيفٌ، ولو صحّ فإنّ النّهي إنّما هو لأجل أن الرّجل يرى عورة أخيه، والرّجل الآخر يرى عورة صاحبه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
حكم استقبال القبلة واستدبارها:
ما حكم استقبال بيت المقدس؟
الجواب: ننظر استقبال بيت المقدس يلزم منه ماذا؟ فإذا كان في “المدينة المنورة” فاستقبل بيت المقدس فإنّه يستدبر مكّة، هذا في المدينة خاصّة. فنقول الصّحيح: أنّ استقبال بيت المقدس ليس فيه نهيٌ.
ما حكم استقبال النّيِّرينِ (الشّمس والقمر)؟
الجواب: جائزٌ ولا حرج، وبعضُ الفقهاء يرى أنّه يُكرهُ، والصّحيح أنّه جائزٌ؛ لأنّه إذا مُنِع الإنسانُ من أن يستقبل القبلة ومن أن يستدبرها فماذا يصنع؟ الشّمسُ إمّا أن تكون في الجهة الثانية أو يكون القمر فيها. فالرّاجِحُ والله أعلم أنّ ذلك جائزٌ ولا حرج.
حكم استقبال القبلة؟
الرّاجح أنّه لا يجوز حال قضاء الحاجة، ولا فرق في ذلك في البُنيان أو الصّحراء؛ لأنّ الإنسان حال البُنيان وإن كان بينه وبين القبلة جُدُرٌ، فكذلك الصّحراء بينه وبين القبلة مفاوز وجبال ورمل وغير ذلك، فعلى هذا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة لا يجوز، والدّليل ما جاء في الصّحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أنّه قال: “قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبِلُوا القِبلة ولا تستدبِرُوها بغائِط أو بول، ولكِن شرِّقُوا أو غرِّبُوا»”. قال أبو أيوب: “فذهبنا الشّأم – يعني الشام – فوجدنا مراحِيض قد بُنِيت قِبل القِبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله”.
ولم يأتِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه استقبل القِبلة، لا في البُنيان ولا في الصّحراء؛ فدلّ ذلك على أنّه محفوظٌ، فلا يجوز هذا الاستقبال.
اما حكم استِدبارُ القبلة؟
الرّاجح أنّه جائز حال قضاء الحاجة، وإن كان الأفضل عدمه، ودليل ذلك ما جاء في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنّه قال: “ولقد رقيتُ على ظهر بيت لحفصة فرأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبِنتينِ مُستقبل بيت المقدس”. فإذا كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مُستقبل بيت المقدس؛ إذن فهو مُستدبر الكعبة.
وجه الدِّلالة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبِلُوا القِبلة ولا تستدبِرُوها». وجاءنا حديثُ عبد الله بن عمر، وهو أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم مُستدبِر القِبلة، فدلّ ذلك على أنّ هذا فعلٌ يدلُّ على الجواز، وذلك نهيٌ، فكان النّهيُ في الاستدبار أخفّ من النّهي في الاستقبال، ولا فرق بين البُنيان وغيره، ولكن الأفضل ألا يستدبر، وأمّا الإستقبالُ فلا يجوز.
وعلى هذا، فحكم استقبالُ القِبلة مُحرّمٌ، وليس مكروها. أما حكم استدبار القِبلة فجائز، والأفضل التّرك، والله أعلم.
ينبغي للإنسانِ إذا كان يريد أن يبني منزلا أن لا يجعل مكان الحُشِّ وقضاء الحاجة مُستقبل القبلة ولا مُستدبرها؛ لأنّ القبلة ينبغي أن تكون مُعظّمة، وقد قال الله تعالى: ﴿قد نرى تقلُّب وجهِك فِي السّماءِ فلنُولِّينّك قِبلة ترضاها﴾ [البقرة: 144]، فهذه القبلةُ التي رضيها الله لنبيه، ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لا ينبغي أن تُهان باستقبال أو استدبار، والله أعلم.
سؤال:
“لقد ذكرت أنّ استقبال القبلة عند قضاء الحاجة مُحرّمٌ، فأريد شيخنا معرفة صحّة هذا الحديث: أنّ مروان الأصفر قال: رأيتُ ابن عمر أناخ راحلته مُستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن ذلك؟! قال: إنّما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك فلا بأس”؟الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود، وقد علّقه البخاريُّ بصيغة الجزم. وقد اختلف الصّحابةُ في هذا الأمر: فذهب أبو أيوب رضي الله عنه إلى حُرمة أن يستقبل الإنسانُ القبلة أو يستدبرها، وقيل انه قول لعائشة، وذهب ابن عمر إلى جواز ذلك إذا كان بينه وبين البنيان شيءٌ.
فإذا اختلف الصّحابةُ فإنّنا نختار ما هو أقرب إلى السُّنة، فابن عمر هذا هو رأيه رضي الله عنه، وأمّا القول الثاني فإنّه يمنع، وهو قول أبي أيوب، وقد قال العلماءُ: إذا اختلف الصّحابةُ فإننا نختار من أقوالهم ما هو أقرب إلى السنة، والله أعلم.
حكم الإِستِنجاء بالماء، أو الإستِجمار بالحجر، أو بهما معا:
الإِستِنجاء هو إزالةُ الخارجِ من السّبِيلين بالماء. والإستِجمار هو إزالةُ الخارجِ من السّبِيلين بغير الماء، كحجر، أو خِرقة، أو شيء مُباح.
وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماءِ عند قضاء الحاجة، وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه، وقد نقل الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم كابن قُدامة وغيره، وذلك لِما جاء في الصّحيحين من حديث أنس بن مالك أنّه قال: “كنتُ أنا وغلامٌ نحوي نحمل إِداوة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فإذا قضى حاجته أعطيناهُ إيّاها”. فكان ذلك دلالة على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته يُعطى هذه الإِداوة ليستنجي بها، ولهذا جاء في الصّحيحين من حديث المغيرة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى ويستنجي أخذ إِداوة من ماء لأجل أن يستنجي بالماء، والله أعلم.
الحالة الثانية: الإستِجمار، وهو إزالةُ الخارج من السّبِيلين بغير الماء كالمناديل، والخِرقة، والحجر، والتُّراب، ونحو ذلك: فيجوز للإنسانِ أن يُزيل الخارج من السّبِيلين بهذه الأحجار، أو بهذه المناديل، ولو كان الماءُ موجودا عنده، وإن كان الأفضلُ أن يستخدم الماء، لكنّ يجوز الإستِجمار ولو كان عنده ماءٌ، والله أعلم.
فعلى هذا يجوز للإنسانِ في البرِّ أو في البيت أن يتمسّح من الخلاء بمنديل أو بخِرقة.
الحالة الثالثة: أن يستخدم الاثنين، فيغسل السّبيلين بالماء، ثم يتمسّح بالمناديل، أو يتمسّح بالمناديل ويستخدم الماء. وهذا أيضا جائزٌ، ولكن لم يرد فيه حديثٌ صحيحٌ بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وإنّما جاءت أحاديثُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قُباء في قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّون أن يتطهّرُوا واللّهُ يُحِبُّ المُطّهِّرِين﴾ [التوبة: 108]، قال: «أنّكُم تُتبِعُون الحِجارة الماء». وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة وعائشة وآخرون، ولا يصحُّ في الباب حديثٌ، والله أعلم.
ولكن إذا جاز الماءُ وجاز الإستِجمار؛ فالجمع بينهما جائزٌ، والله أعلم، وأحسن شيء قول عائشة، والله أعلم.
وعلى هذا فلو حمع بين الإستنجاء والإستجمار فلا حرج.
طريقة وأحكام الإستِجمار:
المسألة الأولى: لا يجوز الإستِجمار إلا بثلاثةِ أحجار، أو بثلاث مسحات مُنقِية، فلو مسح السّبيلين بحجرين وأنقى، فهل يُجزئ أم لا يُجزئ؟
لا يُجزئ حتى يكون ثلاثا، وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة، خلافا للمالكيّة والحنفِيّة، فإنّهم قالوا: يُجزئ، ولكن الأفضل الثّلاثُ.
والصّحيح أنّه لا يُجزئ إلا بثلاثةِ أحجار، ولو أنقى بواحد أو باثنين، ودليل ذلك: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال – كما عند الإمام أحمد وأهل السُّنن: «أيُّها النّاسُ، إنّما أنا لكُم بمنزِلةِ الوالِد، فإذا أراد أحدُكم أن يقضِي حاجته فإنّه يُجزئ من ذلك ثلاثةُ أحجار». فقوله: «يُجزئ» دليلٌ على أنّ غير الثلاثة لا يُجزئ والله أعلم. وهذا من باب المأمور، والقاعدة أنّ باب المأمور لا يجوز تركه، والله أعلم.
المسألة الثانية: أنّه لا يجوز أن يتطهّر أو يتمسّح بِروث أو عظم ولو كانا طاهِرين، فإذا أراد إنسانٌ أن يستجمِر بروثة، فهذه الرّوثةُ إمّا أن تكون روثة حمار، وإمّا أن تكون روثة ما يُؤكل لحمُه، فلا يجوز، لأنّه إذا كانت روثةُ حمار فإنّها نجِسةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاريِّ: «إِنّها رِجسٌ».
كذلك العظمُ لا يجوز، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستجمر بالرّوثِ والعظم إذا كانا يُؤكل لحمهما، قال: «لأنّهُ طعامُ إِخوانِكُم مِن الجِنِّ»، وحينما قالت اليهودُ: “قد علّمكم نبيُّكم كلّ شيء حتى الخِراءة” (يعني حتى قضاء الحاجة)، قال سلمانُ الفارسيُّ -رضي الله عنه: “أجل، نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القِبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثةِ أحجار، أو أن نستنجي برجِيع أو بعظم”.
فإذا كان الحبيبُ صلى الله عليه وسلم علّمنا كيف نقضي الحاجة، فهل يُعقل ألا يُخبرنا كيف نحكم؟ أو كيف نتقاضى؟ من باب أحرى وأولى.
وتأمل في جواب سلمان فهو لم يستشكل هذا الأمر، أو يرى حرجا في جوابهم به لأنه الحق (لا شيء مخفي عندنا، ولا نستحي من شيء، لذا ترى من أكبر الأدلة على باطل أهل البدع جميعا: وجود مسائل في مذهبهم الشيطاني مخفية لا يجرؤون على طرحها علنا على الناس، ويفضلون الحديث عنها في مجالسهم السرية المظلمة، وفي نفس الوقت يدعون الناس إلى باطلهم! فكيف؟ تأمل ذلك فيهم).
والسُّؤال:
إذا استنجى الإنسانُ برجيع أو عظم ومسح ثلاثة مرّات بالعظم، أو ثلاث مرّات بالرّوثةِ الطّاهرة، هل يكون طاهرا؟
اختلف العلماءُ في ذلك: فذهب الشّافعيُّ وأحمدُ إلى أنّه لا يكون طاهرا، فتجب عليه الإعادةُ، أي يأتي بحجر أو ثلاثةِ أحجار ويمسح، ولو كان المكانُ طاهرا، قالوا: لابُدّ أن يتمسّح بثلاثةِ أحجار، أو بثلاثةِ أشياء طاهرة مُنقِية، ولو تطهّر المكانُ.
وذهب أبو حنيفة، ومالك، واختيار ابن تيمية، أنّه لو تمسّح بروث أو عظم فإنّه آثمٌ، ولكنّه يكون طاهرا، قالوا: لأنّ النّهي إنّما هو من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يأثم صاحبُه، ولكن الفعل صحيحٌ، واستدلوا على ذلك بأنّ الحديث الوارد فيه وهو حديث أبي هريرة عند الدّارقُطنيّ: «إِنّهُما لا يُطهِّرانِ» حديثٌ ضعيفٌ، والله أعلم.
وأمّا حديثُ: «إِنّهُما لا يُطهِّرانِ» يعني الرّوث والعظم؛ فإنّه حديثٌ ضعيفٌ، ضعّفه غيرُ واحد من أهل العلم.
ثالثا: أن يستجمر بطاهر: فلو استجمر بنجِس فإنّه لا يزيد المكان إلا نجاسة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إِنّها رِجسٌ»، والله أعلم.
حكم الإِستِنجاء أو الإستِجمار باليمين:
علّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمة أنّ اليمين مُكرّمةٌ عند الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتمسّح من الخلاء بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يبول ويُمسِك ذكره بيمينه؛ لأنّ ذلك من باب إهانة اليمين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصّحيحين من حديث عائشة: “يُعجِبه التّيمُّن في تنعُّلِه إذا تنعّل، وفي ترجُّلِه إذا ترجّل، وفي طهورِه إذا تطهّر”. وكان إذا أراد أن يتطهر من باب إزالة ما علِق في جسده صلى الله عليه وسلم من أوساخ بدأ باليمين، وإذا أراد أن يُزِيل وصف الحدث القائم بنفسه بدأ بشِقِّه الأيمن، وأمّا ما دُون ذلك فإنّه يستخدم اليسار.
ولأجل هذا جاء في الحديث الذي رواه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُمسِكنّ أحدُكُم ذكرهُ بِيمِينِهِ وهُو يبُولُ، ولا يتمسّح مِن الخلاءِ بيمِينِهِ، ولا يتنفّس في الإِناءِ». والحديث مُتّفقٌ عليه.
والسُّؤال: هل الإِستِنجاء باليمين من باب التّحريم أم من باب الكراهة؟
اختلف العلماءُ في ذلك: فذهب الأئمّةُ الأربعةُ إلى أنّ النّهي إنّما هو للكراهةِ وليس للتّحريم، إذن النّهيُ عند الجمهور للكراهة.
ولماذا حملوا النّهي على الكراهة مع أنّ الأصل أنّ النّهي يقتضي التّحريم؟
نحن نعلم أنّ القاعدة الأُصوليّة تقول: أنّ النّهي يقتضي التّحريم، ولا يُصرفُ عن التّحريمِ إلا بقرينة، والقرينةُ لا يلزم أن تكون نصّا شرعيّا من كتاب أو سُنّة، فيُمكن أن تكون ظاهِر الكتابِ والسُّنة، ويمكن أن تكون قرائِن تُعرفُ بالأدلّة والقرائن، فذكر العلماءُ أنّ من الصّوارِفِ – كما أشار إلى ذلك النووي – قالوا: لأنّ هذا من باب الإرشاد والآداب، وليس من باب العبادات التي هي مُتوقِّفةٌ على التّوقيف. يعني لا يُعرف حكمتُها، فقالوا: إنّ النهي للكراهة.
وقالوا أيضا: ولأنّ في الحديث «ولا يتنفّس فِي الإِناءِ»، فإذا كان التّنفُّسُ في الإناء ليس من باب التّحريم؛ فكذلك التّمسُّح من الخلاء ليس للتّحريم.
وقالوا أيضا: ولأنّ اليمين أو اليسار إنّما هي بضعةٌ من جسد الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِنّما هُو بضعةٌ منك»، فإذا كان كذلك فإنّه يدلُّ على الكراهة.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنّ النّهي للتّحريم، وهذا مذهبُ داوود الظّاهِرِيّ وابن حزم، وهو روايةٌ عند الإمام أحمد، وقالوا: لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يُمسِكنّ أحدُكُم ذكرهُ بيمِينِهِ وهُو يبُولُ»؛ فدلّ ذلك على أنّ المقصود هو حالُ أداء قضاء الحاجة، فلربما وقع في يده اليمنى بعضُ النّجاسةِ، واليُمنى ينبغي أن تُكرّم، فلا ينبغي للإنسانِ أن يُخالف مأمور النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو أمره.
وعلى هذا فإنّنا نقول أنّ قول التّحريم قولٌ قوِيٌّ، ولكن لا نستطيع أن نترك مذهب جمهورِ أهل العلم، فنقول أنّه لا يدلُّ على التّحريم، لكن نقول مع ذلك أنّه وإن كان القولُ بالكراهة قولٌ قوِيٌّ، لكن لا ينبغي للناسِ أن يُخالفوا هذا الأمر؛ لأنّ القول بالتّحريم قولٌ قويٌّ.
فنقول الرّاجحُ أنّه للكراهة، لكن لا ينبغي للإنسانِ أن يتهاون في هذا الأمر، فإذا أراد أن يقضي حاجته لا يُمسِك ذكره بيمينه بل بيساره.
وأنا إذا قلت: (لا ينبغي) فليس فيه ما يدلُّ على التّحريم، إلا أنّ التّحريم قولٌ قويٌّ، هذه قاعدتنا، ولكن إذا قلنا للتّحريم، فهو للتّحريم، وإذا قلنا للكراهة فهو للكراهة.
وإذا قضى الإنسانُ حاجته فكيف يتمسّح بيمينه؟
انظر فقه العلماء، قالوا: إذا اضطر إلى استعمال اليمِين فإنّه يُمسِك ذكره بيمِينِه ويأخذ الحجر ويُحرِّكها بشماله؛ لتكون المُتحرِّكةُ هي اليسار وليست اليمين، كل ذلك لأجل ألا يُخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا شيءٌ يُربِّينا يا إخواني، فهذا الذي يظنُّه بعضُ الناس تكلُّفا، إنما هو لأجل ألا نُخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتبقى قلوبُنا مُعظِّمة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في قضاء الحاجة.
سؤال:
أحيانا يدخل الواحد إلى مرحاض عمومِيّ فيفاجأ أنه لا يوجد فيه ماء، فما العمل؟ هل يجوز له أن يستجمر على الحائط؟
الجواب: إذا دخل دورات المياه وقضى حاجته ولم يجد شيئا فلا حرج أن يستجمر بأيِّ شيء شريطة أن يستجمر ثلاث مرّات، فإذا كان حجرا فلابد أن يستجمر به من وجه ومن وجه ومن وجه، لا يستجمر من مكان واحد، فلابُدّ أن يستجمر من ثلاثِ شُعب على الأقل حتى يطهر، فإن تطهّر فالحمد لله، وإن لم يتطهّر وجب أن يزيد حتى يُزِيل النّجاسة، ويُستحبُّ أن يقطع الإستِجمار على وتر، والله أعلم.
استحباب ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض:
قال أهلُ العلم: ينبغي للواحد إذا أراد أن يقضي حاجته ألا يكشف عورته حتى يكون قريبا من الأرض. أي حتى يدنو من الأرض، وقد ذكر النّوويُّ استحباب ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض فلماذا؟
قالوا: لما جاء عند أهل السُّنن من حديث معاوية بن قُرّة رضي الله عنه قال: “يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إِلا مِن زوجتِك أو ما ملكت يمِينُك. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا كان أحدُنا وحده؟ قال: فاللهُ أحقُّ أن يُستحيى مِنهُ”.
يعني إذا كنت تستحي من أن تكشف عورتك أمام شخص أجنبي؛ فالله أحقُّ أن تستحي منه. فإذا كان مُحرّمٌ أن يكشف الإنسانُ عورته أمام صاحبه، فكذلك أن يكشف عورته بلا حاجة وحده؛ لأنّ الله أحقُّ أن يُستحيى منه.
وقد يقول قائلٌ: ما الدّليلُ على أنّ الإنسان يحرُمُ عليه أن يكشف عورته أمام صاحبه؟
قلنا: ما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدرِي رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُفضِي الرّجُلُ إلى الرّجُلِ في ثوب واحِد، ليس على عورتِهِما مِنهُ شيءٌ». فهذا يدلُّ على أنّه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمامه.
ولهذا أثنى اللهُ سبحانه وتعالى على موسى فقال: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تكُونُوا كالّذِين آذوا مُوسى فبرّأهُ اللّهُ مِمّا قالُوا﴾ [الأحزاب: 69]، فقد كان اليهودُ إذا أرادوا أن يغتسلوا كشفوا ثيابهم وعوراتهم رجالا ونساء، فكان موسى عليه السلام استحياء من الله لا يغتسل إلا وعليه شيءٌ، فكان اليهود يقولون: “والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنّه آدرُ”. يعني مجبوب الذّكرِ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يُظهر عور كلامِهم، فوضع موسى ثوبه على حجر، ثم اغتسل فجعل الحجرُ يهرب بأمر الله سبحانه وتعالى، فلمّا رأى موسى أنّ الحجر قد هرب بثيابه جعل يقول: “ثوبِي حجر، ثوبي حجر”. فجعلت اليهودُ تنظر إلى موسى وقالوا: “والله ما بموسى من بأس”. والحديث في صحيح مسلم.
ولا ينبغي له أن يكشف عورته إلا إذا أراد أن يقضي الحاجة:
من المُؤسِف أنّك تجد بعض الناس بمجرد دخولِه دورات المياه يكشف ثيابه، ورُبّما من غير حاجة، فإذا أراد أن يقُصّ شارِبه أو أن يصنع شيئا برأسه، أو تصنع المرأةُ شيئا برأسها؛ تجد أنّهم يكشفون ثيابهم، ولا شيء على عوراتهم وهم في دورات المياه. وهذا لا يجوز ولو كانوا وحدهم؛ لأنّ هذا الكشف ليس له حاجةٌ، فلأجل هذا فإنّ كشف العورة من غير حاجة الراجح أنّه مُحرّمٌ؛ لأنّه إذا استحيى المرءُ من الأجنبيِّ فالله أحقُّ أن يُستحيى منه.
أمّا حال إرادة قضاء الحاجة فإنّنا نقول يُستحبُّ له، ولكن مع ذلك نجد بعض الناس إذا انتهى من حاجته يمكث كاشفا عورته؛ وذلك مكروهٌ.
إذن عندنا ثلاث مراتب:
كشف العورة من غير حاجة، وحكمه أنه حرامٌ، والدليل: «فاللهُ أحقُّ أن يُستحيى مِنهُ».
وكشفها حين يريد أن يقضي حاجته، ويُستحبُّ له ألا يكشف ثيابه إلا إذا كان يريد قضاء الحاجة أو يدنو منها.
كشفها بعد قضاء حاجته، حكمه أنه مكروهٌ، بل بالغ بعضُهم فقال مُحرّمٌ، والرّاجح أنه مكروهٌ.
لهذا المُوسوِسون عندما يطيلون في دورات المياه كاشفي عوراتهم، وهم يعتقدون أن ذلك من باب التطّهر؛ قد أطاعوا إبليس من وجهين: الأول: أنّهم بالغوا في التّطهُّر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «سيكُونُ فِي آخِرِ الزّمانِ قومٌ يعتدُون فِي الطُّهُورِ والدُّعاءِ». الثاني: أنّهم كشفوا عوراتهم، وقد نهانا رسولُنا صلى الله عليه وسلم أن نكشف عوراتنا من غير حاجة.
المواضع التي يُنهى عن التّخلِّي فيها:
ليس كلُّ موضع يجوز للإنسانِ أن يقضي فيه حاجته، لدينا سيع مواضع لا يجوز له فعل ذلك فيها، وإذا أردنا أن نُجمِلها نقول: ست:
الموضع الأول: طريق الناس.
أي طريق الناس المسلوكة، فهذا المكانُ إذا قضى فيه حاجته فإنّ الناس تتأذّى بذلك. فقد يستقذرون المرور من ذلك الطريق، وقد تطأ أرجُلُ بعضِهم بعض تلك النّجاسة، أو تصيب ثيابهم؛ ولربما كان ذلك سببا في سبّ فاعله، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتّقُوا اللّعّانينِ». قالوا: يا رسول الله، وما اللّعّانانِ؟ قال: «الّذِي يتخلّى في طرِيقِ النّاسِ، أو فِي ظِلِّهِم». وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللّعّانينِ» مُحتمِلةٌ معنيين: المعنى الأول: الذي سبّب لنفسه اللّعن. المعنى الثاني: الملعون، يعني: اتّقوا الملعُونين، والله أعلم.
وقد روى الطبرانيُّ بإسناد حسّنه المُنذِريُّ أي بسند جيد: «من آذى المُسلِمِين فِي طُرُقِهم وجبت عليهِ لعنتُهُم». ومعنى لعنة الناس أي سِبابُهم.
أمّا الطريقُ التي تكون غير مسلُوكة أو مهجورة مثل الطُّرق التي تكون في البرارِي، فهذه ليس من عادة الناس السلوك فيها لأنّها مهجورة، فحينئذ نقول: لا حرج، لكن إذا كان الطريقُ مسلوكا وهو مُعتادٌ أن يسير الناسُ عليه؛ فإنّه يحرُمُ على الإنسان أن يقضي حاجته فيه.
الموضع الثاني: ظِلُّ الناس.
فلا يجوز قضاء الحاجة فيما يستظِلُّ فيه الناسُ، وكذلك في الأماكن التي يتشمّس فيها الناسُ في وقت البردِ، أو في الحدائق والمُتنزّهات؛ لا يجوز له أن يقضي حاجته فيه، لذلك من المؤسف أن تجد بعض الناس لا يُبالي في أيِّ مكان قضى حاجته، وقد نهى رسولُنا صلى الله عليه وسلم أن يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهم.
والمقصود بالظِّلُّ الأماكن التي يستظل الناس فيها، أمّا الظِّلُّ الذي لا يحتاجونه، فلا حرج، مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أنّه قال: “كان أحبُّ ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته: هدفٌ أو حائِشُ نخل”. ومن المعلوم أنّ الهدف فيه ظِلٌّ، لكن هذا الظِّلّ لا يُنتفعُ بالجلوس فيه، وكذلك “حائِشُ نخل” فحائش النخل ليس مكانا للظِّلِّ.
أمّا شجر الطّلحُ الذي يستظل الناسُ فيه فلا يجوز.
الموضع الثالث: موارد المياه.
التي يرد الناسُ إليها لسُقياهم أو لسُقيا مواشيهم كالآبار والوِديان؛ لا يجوز أن يقضي حاجته فيها، سواء كان ببول أو غائط، ولا يقل: لم أجد مكانا! فقد أعطاه اللهُ سبحانه وتعالى فُسحة في كل البرارِي، فقضاء حاجته في موارد المياه أذى للنّاس، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿والّذِين يُؤذُون المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ بِغيرِ ما اكتسبُوا فقدِ احتملُوا بُهتانا وإِثما مُّبِينا﴾ [الأحزاب: 58].
والمشكلة أنّ بعض الناس إذا قيل لهم: حرامٌ عليكم، رُبّما لا يبالون، لكن إذا قيل لأحدهم: سنأخذ عليك غرامة كذا؛ ربما يمتنع، فالفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الرّبانيّة التي أمر الله بها هي العلاقة بين العبد وربه.
لذلك حينما قالت المرأةُ لإبنتها: “يا بُنيّةُ، شُوبِي اللّبن بالماء”. قالت البنت: “إنّ عمر قد نهى عن ذلك!” فقالت الأم: “عمر اليوم لا يرانا!”، فقالت البنت: “إن لم يكن عمر يرانا فإنّ ربّ عمر يرانا”.
هذه هي المراقبة التي تكون بين العبد وربه، ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يعلم أنّ الله مُطّلِعٌ عليه.
يا من يرى ما فِي الضّمِير ويسمعُ *** أنت المُعدُّ لكُلِّ ما يُتوقّعُ
الموضع الرابع: نقعُ الماء.
أي مُجتمع الماء، فأحيانا يرتوي الناس ومواشيهم حينما تهطل الأمطار في وقت الشتاء من بعض الأماكن التي يسقط فيها الماء، فيقصدون هذا المكان فيشربون، فإذا استقذر الناسُ هذا المكان فإنّه لن يُنتفع من الماء الذي فيه بسبب قضاء حوائج الناس فيه، وربما نرى في وقت الشتاء أماكن يتمنى الناسُ أن يحضروها وأن يجلسوا أمامها لكي ينتفعوا، فيجدونها مُمتلئة بأذِيّة الناسِ من قضاء حوائجهم فيتركونها، وربما سبُّوا من فعل ذلك.
ومن المعلوم أنّ من آذى المسلمين وجبت عليه لعنتُهم كما جاء عند الطّبرانيِّ بسند جيد.
الموضع الخامس: تحت الشجر.
فإنّه يُمنع أن يقضي حاجته تحت الشّجر؛ لأنّ الشّجر إمّا أن يكون ظِلّا للناس، وإمّا أن يكون مُثمرا، فربما وقعت تلك الأثمارُ على الأوساخ، فربما ترك الناس الأكل من هذه الأطعمة، فلأجل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته تحت الأشجار المُثمرة.
الموضع السادس: جوانب الأنهار والبحار.
فإنّك تأسف أشدّ الأسف حينما تجد من يقضي حاجته على الشّواطئ التي هي مُرتدى الناس ومجيئهم، فلربما بحثوا عن أماكن أخرى بسبب وجود من يصنع هذا.
ومن المعلوم أنّ مجرد وجود هذه الأوساخ مُؤذِنٌ بأذِيّة، فلا ينبغي لأنّ الناس تتقذّر من ذلك المكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كان فِيمن كان قبلكُم رجُلٌ أزال شوكة عنِ الطّرِيقِ فغفر اللهُ لهُ»؛ حرصا على عدم أذية الناس.
الموضع السابع: بين القبور.
فيحرم على الإنسانِ أن يمشي بين القبور بنعليه أو يطأ القبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لأن يعمد أحدُكُم إلى جمرة فتخرِق ثِيابه أهونُ على اللهِ مِن أن يجلِس على قبر»، كما ثبت ذلك في الصّحيح؛ لأنّ هذا أذِيّةٌ للمسلم الميت، وحُرمةُ المسلم حيّا كحُرمتِه ميِّتا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد لبشير بن الخصاصِية عندما رآه يمشي بين القبور وهو على نِعالِه: «يا صاحِب السّبتتينِ اخلع سبتتيك». والحديث حسّنهُ الإمامُ أحمد.
فإذا نُهِي العبدُ أن يمشي بين القبور بنعليه خوفا من أذِيّة أهل القبور المسلمين؛ فقضاء الحاجة من باب أولى.
وقد جاء حديثٌ رواه ابن ماجه وأبو يعلى بسند صحيح، وقد صحّحه الحافظُ ابنُ حجر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن أمشِي على جمرة أو سيف أو أخصِف نعليّ بِرِجلِي أحبُّ إليّ من أن أمشِي على قبرِ مُسلِم، ولا أُبالِي أوسط القُبُورِ قضيتُ حاجتِي أو أوسط السُّوقِ»، فهذا يدلُّ على أن قضاء الحاجة وسط السُّوق ممنوعٌ ومُحرّمٌ؛ لأنّ هذا أذِيّةٌ، فهو جمع كلّ هذه الأشياء، فإذا كان قضاءُ الحاجة وسط السُّوق ممنوعا؛ فإنّ مثله مثل قضاء الحاجة بين القبور.
ولأجل هذا فإنّ قضاء الحاجة بين القبور مُحرّمٌ، والله أعلم.
سؤال: هل أذِيّةُ أهل القبور حِسيّة أو معنويّة؟
الذي يظهر والله أعلم أنّها أذِيّةٌ حسيّةٌ، لكن هذه الحِسّ لا نعلمه، فهو يتأذّى، لكن كيف يتأذى؟ الله أعلم.
وهذا هو معنى الأذيّة الحسية، فإنّه يتألم ويسمع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الميِّت ليُعذّب ببُكاءِ أهلِ الحيِّ عليه»، ومعنى (يُعذّب) يعني يتألم، وهذا الألم اللهُ أعلم بطريقته، لكنّه يتألم، والألم الذي يقع على الميت يقع على الروح وعلى الجسد، كما هو مذهب أهل السُّنة والجماعة كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية، وإن كان هذا الألمُ والنّعيمُ على الروح أكثر، وفي الدنيا يقع الألم والفرح على الروح وعلى الجسد، إلا أنّ وقوعه على الجسد أكثر، فالمسألة مسألةٌ مُغايرةٌ، والله أعلم.
سؤال: نشاهد الآن من يُهمِل الصّرف الصِّحي ويُطلقه في الشّوارع، فهل يدخل هذا في الوعيد؟
بعض الناس يكون الصّرفُ الصِّحيُّ عنده أو ما يُسمّى المجاري طافِحا في بيته، فلا ينبغي له أن يُؤذي إخوانه المسلمين بذلك، ينبغي أن يُخبرهم لأجل ألا يتأثّروا بذلك، فإذا كان قادرا على إزالة هذا الأمر فلا ينبغي له أن يتوانى في ذلك؛ لأنّ ذلك أذِيّة في طريق الناس أو في ظلهم، ومن المؤسف أنّك ربما تجد بعض الناس لا يُبالي بهذا الأمر، ولهذا ينبغي لنا أن نحتاط من هذا الأمر.
3. باب السّواكُ
السواك:
تعريف السواك وحكمه – هل معجون الأسنان يحلُّ محلّ السِّواك إذا لم يوجد السِّواك؟ – السِّواك سُنّةٌ عند عامة أهل العلم – المواضع التي يتأكد فيها السواك – طريقة التسوك – أيهما أفضل التسوك باليمينِ أم باليسار – سنن الفطرة .
تعريف السواك وحكمه:
من المعلوم أنّ الإنسان إذا أراد أن يتوضّأ فإنّه يُستحبُّ له أن يفعل أشياء قبل الوضوء، ومن ذلك السِّواك، فناسب ذلك أن يتحدث الفقهاءُ قبل الوضوء عن باب السِّواك وسُنن الوضوء.
فالسِّواك أيُّها الإخوة سُنّةٌ من سُنن المرسلين، وقيل إنّ أول من تسوّك هو إبراهيم عليه السلام وقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «عشرٌ مِن الفِطرةِ»، وذكر منها السِّواك.
وقد روى البخاريُّ في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثرتُ عليكُم فِي السِّواكِ»، وهذا حديثٌ عظيمٌ.
إذن فلا ينبغي أن تترك السِّواك؛ لأنّه سُنّةٌ، ولهذا ذكر العلماءُ أنّ السِّواك سُنّةٌ في جميع الأوقات، لكنّه يتأكّد في مواضع سنذكرها.
والسِّواك اسمٌ للعود الذي يُتسوّكُ به، وكذلك اسمٌ للفعل الذي يُزال به الأقذار العالِقة في الفم وعلى اللِّسان.
ويُستحبُّ أن يسُوكُ أسنانه، وكذلك لسانه، وهي سُنّةٌ تخفى على كثير من الناس، فأكثر الناس لا يسوك إلا أسنانه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسُوكُ لسانه ويسوك أسنانه، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنّه قال: “دخلتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يستاكُ على لسانه، ويقول: «أُوع، أُوع»”.
وقد ذكر الفقهاءُ والأطباءُ فوائد لإستخدام السِّواك، ولا داعي لأن نذكرها لأنّها موجودةٌ في كتب الآداب، وموجودةٌ في كتب الطب، وكذلك ذكرها ابنُ القيِّم في “زاد المعاد”، ولعلنا نذكر على عجل بعضها.
فمن فوائد استخدام السواك: أنّه يفيد اللّثة، ويفيد الأسنان ويقوِّيها، وكذلك يغيِّر رائحة الفمِ، ويقتل الجراثيم العالقة في الأسنان، وغير ذلك مما ذكره الفقهاء.
والحديث شاف وكاف، فقد روى الإمامُ أحمد والبخاريُّ مُعلّقا بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها قالت: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السِّواكُ مطهرةٌ للفمِ، مرضاةٌ للرّبِّ”.
يعني وأنت تُنظِّف لأجل ألا يستقذرك الآخرون فإنّك تطيع الربّ جل جلاله وتقدست أسماؤه.
ومن المعلوم أنّ السِّواك هو عودٌ أو نحوه، فإذا لم يوجد عودُ الأراكِ فإنّه يمكن أن تستاك بأيِّ عود بشرط ألا يُؤثِّر على اللّثة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضِرار».
وعلى هذا فينبغي لمن استخدم السواك أن يقضِمهُ كل يومين لأجل أن ينتفع به، وقد ذكر الأطباءُ أنّ السِّواك بحاجة إلى أن يُقضم، وقد روت عائشةُ كما في الصّحيحين أنّه حينما دخل عبدُ الرحمن بن أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى السِّواك وجعل ينظر إليه، قالت عائشة: “تشتهي أن تستاك به؟” فأشار برأسه أن نعم، قالت: “فأخذته فقضمته فبللته بريقي ثم أعطيته إياه”.
فهذا يدلُّ على أنّه ينبغي للإنسان أن يستاك بعُود رطب ليِّن حتى لا يُؤثِّر على لثتِه، فإذا لم يوجد فإنّه يستاك بأصبعه، لا لأنّ السِّواك بالأصبع سُنّةٌ، ولكن لأجل أنّ ما لا يتم المستحبُّ إلا به فهو مُستحبٌّ، ولهذا كان قد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه “الطهور” عن عثمان رضي الله عنه أنّه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه، وإسناد الحديث لا بأس به.
هل معجون الأسنان يحلُّ محلّ السِّواك إذا لم يوجد السِّواك؟
نعم معجون الأسنان يؤدي دور السِّواك من وجه، ولا يُؤدِّيه من وجه آخر: فيؤديه من حيث أنّ الواحد مأمورٌ بالتنظّف والتطيّب؛ لأنّ في السِّواك إزالة للأوساخ، وفُرشاة الأسنان تُؤدِّي هذا الغرض، لكنّ السِّواك مقصُودٌ لأنّه مرضاةٌ لِلربِّ، وأمّا الفُرشاةُ فإننا لا نستطيع أن نقول ذلك عنها إلا بنصّ شرعيّ، ولكن يُؤجر الإنسانُ إذا أراد إزالة الرائحة الكريهة.
السِّواك سُنّةٌ عند عامة أهل العلم:
لم يُخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهُويه وداود الظّاهِرِيّ فأوجبوا ذلك في الوضوء والصّلاة.
فالسواك مسنون في كل الأوقات، وذكر النوويُّ رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه سُنة ومشروعٌ، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاقُ بن راهُويه وداود الظّاهِرِيّ، والراجح والله أعلم أنه سُنة مؤكدة.
المواضع التي يتأكد فيها السواك:
مع أن السواك سنة، إلا أنه يتأكد في مواضع. والمواضع التي يتأكد فيها السواك:
أولها: الوضوء. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ؛ فإنه يشرع له أن يستاك، وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وكذلك ابن خُزيمة أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرت بالوضوء عند كل صلاة، طاهرا أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على أُمتي؛ أُمِرتُ بالسواك عند كلِّ وضوء»، فهذا يدل على أن السواك يُعطي الوضوء عبادة أزيد مما لو توضأ بلا سواك.
وهذا يدل على أن الوضوء بالسواك سُنة مؤكدة، وأن الصلاة بالسواكِ سُنة مؤكدة.
أما دليل استحباب السواك عند الوضوء؛ فلِما رواه مالك في موطئِه، وكذلك البخاري – معلقا بصيغة الجزم – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشُقّ أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، وهذا حديث إسناده صحيح، وهو من أحاديثِ بُلوغ المرام.
الموضع الثاني: الذي يُتأكد فيه السواك هو الصلاة، فيستحب للإنسان إذا شرع المؤذِّن في الإقامة أن يُخرج المسواك ويستاك، ويدعو. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، أي حينما يشرع المؤذن بالإقامة فإنه يستحب له أن يدعو، ويستاك كذلك بحيث يكون سواكه نهايته قبل التكبير، وهذا من السنن التي ينبغي أن تُشاع بين الناس.
ومما يدل على استحباب السواك عند كل صلاة: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، وحديث: «لولا أن أشق على أمتي» جاء من حديث: «مع كل وضوء»، وجاء «عند كل صلاة».
واستدل بعضُ أهل العلم على أنّ «مع كل وضوء» على أنّه لو تمضمض وتسوّك؛ فإنه يصدق عليه أنه تسوّك مع الوضوء، أما السِّواك في الصلاة؛ فإنه يستاك قبل أن يُكبر، أما إذا كبّر؛ فإنه لا ينشغل إلا بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاةِ لشُغلا»، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، فيضع السواك في جيبه ويصلي.
الموضع الثالث: عند الانتباهِ من النومِ. جاء في الصحيحين من حديث حُذيفة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشُوصُ فاه بالسواكِ. إذن: يُستحب للإنسان عند الانتباه من النوم أن يستاك، وكونه إذا قام من الليلِ فإن هذا إنما كان من غالِب فِعلِه صلى الله عليه وسلم، فلو قام من النهار فإنه له أن يستاك أيضا.
وينبغي لنا جميعا أن نضع مسواكا الجيب، وبهذا نستخدمه عند القيام من النوم تطبيقا للسُّنة، فإن من أُعطِي السنة فقد أُعطي خيرا كثيرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يُعِد الوضوء حينما جاء الماء وهو قد تيمم، قال له: «أصبت السنة»، وقال للذي لم يُصِب السنة: «لك الأجر مرتين»، مما يدل على أن إصابة السنة أعظم من الأجرين.
الموضع الرابع: عند دخول المنزل. روى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. وهذا يدلُّ على استحباب السواك عند دخول المنزل.
فكان عليه الصلاة والسلام إذا اقترب منه أحد لا يجد إلا شيئا طيبا، ورائحة طيبة، حتى إنّ عرقه صلى الله عليه وسلم كانت أمُّ سُليم تأخذه وتضعه في قارورة، فتقول: نُطيب به صبياننا، وكان من أحسن الطيب، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا نُهِي العبد أن يأكل الكُرّاث أو الثوم أو البصل لأجلِ ألا يؤذي عباد الله، بل ولأجل ألا يؤذي الملائكة، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»، مما يدل على أن الملائكة المقصود بها ملائكة المسجدِ، وإلا فإن الإنسان لو صلّى في بيته فإن ثمة ملائكة عن يمينه وعن شماله، ولكن هؤلاء الملائكة إنما المقصود بهم ملائكة المسجد، كما نصّ على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا دخل بيته اقترب من أهله، فكان يُقبِّلُ نسائه صلى الله عليه وسلم، كما أشارت عائشةُ إلى ذلك كما في الصحيحين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يتجمل لأهله مثلما كان الأهلُ يُحبون أن يتجملوا له، فكان هذا من ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾، فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع من يمُونُ، فما بالك به مع خُلطائه؟ فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي مع الآخرين ومع أهله، وكثيرون هم اللذين يتقون مع الآخرين ولا يتقون أهليهم، فربما لبس ثيابا رثّة في بيتِه، ولا يُبالي في رائحته، لكن إذا أراد أن يخرج إلى الناسِ، لبس أحسن الثيابِ، وتطيب بأحسن الطيب، فأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يُطبق السنن في كلِّ شيء حتى مع أهله، فكان إذا أراد أن يدخل المنزل بدأ بالسواك.
الموضع الخامس: عند تغير الرائحة. ذكر ذلك غيرُ واحد من أهل العلم – ذكره الحنابلة وذكره الشافعية وذكره غير واحد من أهل العلم –، وقد ذكر ابن دقيق العيد في كتابه “إحكام الأحكام” قال: “ولعله يستدل بذلك – يعني عند تغيّر رائحة الفم – قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأن من عادة من صمت ولا يتكلم فإن فمه يتغير.
الموضع السادس: من السننِ أيضا فعل ذلك عند قراءة القرآن، استدل الحنابلة وغيرهم وكذلك الشافعية وغيرهم على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتسوك، واستدلوا بما جاء عند الدِّمياطِي في “المتجرِ الرّابِحِ” أنه قال من حديث علي بن أبي طالب: “إن أحدكم إذا أراد أن يقرأ فليشُص فاه بالسواك فإن الملك ليضع فاه على موضع فيه، فما خرج من جوفه دخل في جوف الملك، ألا، فطيبوا أفواهكم بالقرآن”. والحديث في سنده بعض الضعف، إلا أن الدِّمياطِي حسنه، ومن المعلوم أن الحديث له طرق تدل على أن له أصلا، فيُستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يشُوص فاهُ بالسواك.
طريقة التسوك:
قال بعضُ أهل العلم: يُستحب التسوك عرضا (أي يحرك المسواك أفقيا من اليمين إلى اليسار مثلا)، قالوا: لِما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا، والحديث سنده ضعيف، فإن في سنده رجلين ضعيفين.
وذكر الأطباء أنه يستاك طولا، يقولون: لأنّ أغشية الأسنان تتأثر فيما لو استاك عرضا، أما اللسان فإنه يستاك طولا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو طرف السواك على لسانه وهو يقول: «أُع أُع».
إذن: الأقرب والله أعلم على أنه لم يرِد دليلٌ على أنه يستاك عرضا أو يستاك طولا، كل ذلك يدل على الجواز، ونحن ذكرنا قاعدة، أننا نقول: كل ما جاء الشرع بمشروعيته ولم يُبين لنا صِفته؛ دل على أن كلّ صفة تُؤدِّي فعل هذا المشروع تدلُّ على أنها جائزة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السواك ولم يُبين لنا كيفية أو طريقة التسوك، مما يدلُّ على أن أية طريقة تدل على الجواز، والله أعلم.
أيهما أفضل التسوك باليمينِ أم باليسار؟
بعض أهل العلم قال: يُستحب السواك باليمين، قال: لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُرِيتُ في المنام وأنا أتسوك بسواك، فجاءني رجلان فدفعت السواك الأصغر منها، فقيل لي: كبِّر كبِّر، فدفعتُه للأكبر». الدليل قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أريت في المنام وأنا أتسوك بسواك، فدفعت للأصغر منهما» قالوا: لو كان الرسول يستاك باليسار لقال: فأخذته باليمينِ فأعطيتُ، لأنه لا يُعطي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ إلا باليمين، فلما قال: «فدفعت»، والفاء تفيد التعقيب، قالوا: دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك باليمين، وهذا يُلتمس منه لكنه ليس صريحا في المقصود.
وقال بعضهم: إنه يستحب السواك باليسارِ، وذكر أبو العباس ابن تيميّة أنه مذهبُ جمهورِ أهل العلم، أنه يُستحب السواك باليسارِ؛ لأن السواك إنما هو مطهرة للفم، وما كان مطهرة للفمِ، فإن من المعلوم أن الإنسان يُريد أن يُزيل الأشياء العالقة في الفمِ، والأشياء العالقة في الفم إنما تُزال فيما دون اليمين؛ لقول عائشة كما في الصحيحين: «كان يحب التيمن في تنعله، وفي ترجله، وفي طُهوره»، وأما ما عدا ذلك فإنه يستاك باليسار، هذا قول.
وقال بعض أهل العلم إن كان يريد بسواكه التّنظُّف يستاكُ باليسارِ، وإن كان يُريد بسواكه تطبيق السنةِ ليس إلا، فيستاك باليمين.
والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب مالك، فإنه سئل رحمه الله فقال: “الأمر في هذا واسع”، ومعنى ذلك كما قلت، أنه صلى الله عليه وسلم بيّن استحباب السواك، ولم يقل بيمين أو يسار، مما يدل على أن كل أمر ثبتت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتابِ ربِّنا، ولم يرد إلينا شيءٌ في صفتِه دل على أن كلّ صفة تُؤدي فعل هذا المشروع فإنها جائزة، والله أعلم.
إذا ثبت هذا فإنه ثمة فرق بين أن يبدأ بشقه الأيمن أو الأيسر، فإن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: «كان يحب التيمن في شأنه كله» فهذا يدل على استحباب البدء باليمين، فالله أعلم، فيبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وكل ذلك جائز.
سنن الفطرة:
وهي سنن يشرع لنا تطبيقها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمسٌ من الفطرة: الخِتان، والإستِحداد، وقصُّ الشارب، وتقلِيمُ الأظافِر، ونتفُ الإبط»، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فتقليم الأظافر هو إزالة الشيء الطويل، وقد ذكر بعض الفقهاء صفة في تقليم الأظافر، يبدأ بالخِنصِر ثم الوُسطى ثم البِنصِر ثم الإبهام. ولكن لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبين كيفية تقليم الأظافر، فسواء بدأ بالإبهام أو غيره، كل ذلك جائز، إلا أنه يبدأ باليمين.
وقد كان ابنُ عمر إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة يُقلم أظفاره ويقصُّ شاربه، وقد جاء مرفوعا ولكن في سنده ضعفٌ، وهو ابن السِّموال، وبالتالي هو حديث ضعيف لا يصحُّ مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عُمر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وكذلك يُستحب قصُّ الشارب إذا احتاج إلى ذلك، مثل أن يطول الشعر إلى ما زاد عن الشفتينِ.
وطريقة قص الشارب إما أن يقص فقط ما زاد عن الشفتين، كما جاء في الحديث الذي رواه المُغِيرة بن شُعبة أنه وضع العود على أعلى شفتيه، ثم قال: جُزّ، أي إن ما زاد فإنه يأخذ منه.
وقال بعضهم: يستحب قص الشارب عامة، وهو لا يُسمى شاربا إلا بالعموم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين؛ جُزُّوا الشوارب، وأعفُوا اللِّحى»، والجزُّ هو العموم، والراجح والله أعلم أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن لا ينبغي أن يكون الشارب كثيرا.
وقص الشارب من السنن، وهذا مذهب عامة أهل العلم، وأخطأ ابن حزم رحمه الله فجعله فرضا، وذكرهُ إجماعا، والصحيح أنه ليس في المسألة إجماع، بل عامة الفقهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن قص الشارب سُنة.
أما حلق العانة فهو الإستِحداد الذي جاء في الحديثِ، فالإستحداد هو استعمال الحديدة التي بها يزول شعر العانة، وهو الشعر النابت فوق الذكر أو فوق قُبُلِ المرأة، فإنّه يُستحب للإنسان أن يحلقه لئلا تجتمع الأوساخ فيه.
كذلك يستحب نتف الإبط فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف إبطه، وأي شيء صُنِع في هذه الإزالة إما بوضع بعض الأدهان أو “النّورة” أو غير ذلك مما يعرفه الناس في عاداتهم، فإن ذلك جائز، إلا أنّ نتف الإبط أفضلُ، وحلق العانة أفضلُ، لأجل ألا يتضرر الإنسان ولا يتألم.
وإذا تأخر الإنسان عن أربعين يوما في نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة، فهل ذلك حرام؟
الجواب: جاء حديث عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «أمر النبيُّ» وفي رواية «أُمِر ألا يُزاد عن أربعين يوما في قصِّ الشارب»، أو «حدّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ألا نزيد على أربعين يوما»، فقال بعض أهل العلم: إن هذا ما زاد فهو مكروه، وهذا نسبه النووي رحمه الله إلى قول عامة أهل العلم، وقال بعضهم: إذا زاد عن الأربعين فهو محرم.
والذي يظهر لي والله أعلم أن ما زاد عن الأربعين فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه من الفطرة، والثاني لأن مثل هذه الأشياء إنما هي بالجِبِلّةِ فالإنسان مأمور بالفعل، والفعل مثل هذا يدل على الإستحباب، وأما إذا نهي عن الفعل فإنما يدل على التحريم، فحلق اللحية محرم لأنه أُمر بالترك، فإذا فعل فقد خالف، وأما قصُّ الشارب فهو مأمور بالفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فمنه الواجب ومنه المستحب، والمعلوم أن مثل هذه الأشياء ليست إلا من باب الإرشاد والتوجيه ولذلك كان مذهب عامة أهل العلم على أن ذلك على سبيل الإستحباب، والله أعلم.
إذا ثبت هذا أيها الإخوة فمن المعلوم أن الإنسان يقص أظفاره ويحلق شعره، فماذا يصنع بها؟
الجواب: جاء عند ابن أبي شيبة من حديث محمد بن سيرين والحسن أنهما كانا يدفنان الشعر والأظفار، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسائله أنه قال: كان ابن عمر يصنعُ ذلك، فهذا يدلُّ على أنّ الإنسان ينبغي له – لا أقول يستحب – إذا قص أظفاره أن يدفنها، فإن لم يدفنها بأن وضعها في منديل ثم وضعها في القمامة؛ فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأما السن، فإن من الناس إذا سقط أسنان أطفاله فإنه يدفنها، فهذا جاء كما قلت في الآثار لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن دفنها فحسن، وإن ألقاها في القمامة فحسن، كل ذلك جائز، لكنه ينبغي أن تزال عن مرأى الناس لأن ذلك مما يُستقذرُ، والله أعلم.
الختان:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة: الختان… إلخ».
الختان يكون للرجال والنساء، أما للرجال: فهو إزالة الحشفة التي في أصل الذكر، فإنه يجب على الرجل إذا وجبت عليه الصلاة والطهارة.
إذن حُكم الختان في حق الرجل واجب إذا وجبت عليه الطهارة والصلاة، وتجب عليه حين البلوغ، وأما من لم يبلغ فإنه يستحب له، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة لأن الإنسان إذا وجبت عليه الطهارة فإنه ربما يكون قد تعلق بعض النجاسات وبعض البول في تلك الحشفة، فربما وقعت في ثيابه بعدما تلتصقُ بجسده، فيقع في عدم التّنزُّهِ من البولِ، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين فرآهما يعذبان فقال صلى الله عليه وسلم: «أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير» كما جاء في بعض الروايات، «أمّا أحدهما فكان لا يستنزِه من البول»، وفي رواية «كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، فهذا يدل على أن الإنسان واجب عليه أن يستنزه من البول، ومن لم يختتن من الرجال فإنه لا يستتر ولا يتنزه من البول، ولهذا يجب عليه الختان إذا بلغ، وأما قبل ذلك فإنه مستحب أو جائز لأجل أن لا يتألم، أو ربما يشق عليه وقت الكبر.
وأما المرأةُ، فالراجحُ والله أعلم أن ذلك جائزٌ، وليس بواجب في حق المرأة.
وطريقة ختان المرأة هي إزالة الحشفة التي كأنها عُرفُ الديك، ومما يدلُّ على أن المرأة لها أن تختتن ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الغُسل: «ومسّ الختانُ الختان» إذا التقى الختانُ بالختانِ، فهذا يدل على أن المرأة تختتن والرجل يختتن، هذا هو الأقرب ولكنه ليس بسنة وليس بواجب، هذا الذي يظهر والله أعلم.
وعلى هذا فلو لم تختن المرأة أو كان من في البلد لا يعرفون ذلك، فكل ذلك جائز، ولا ينبغي أن نُستغلّ من قِبل المستشرقين أو من بعض الكُتاب الذين تأثروا بكتب المستشرقين حينما يتحدثون عن مثل هذه القضية، وأن الدين عذاب، وذلك غير صحيح، فالرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا أدرى بنا، وقد قال سبحانه وتعالى : ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾، فهو أعلم، وإن لم نُدرك ذلك. ولهذا قالوا إن من حكمة ذلك أنّ المرأة تقِلُّ غِلمتُها – أي شدة شهوتها –، والحكمة عند الله سبحانه وتعالى.
متى يختتن المسلم؟
الجواب: قال بعضُ أهل العلم انه يختتن قبل أن يُدرِك، يعني قبل أن يبلُغ، أي قريبا من البلوغ.
وقد روى البخاري من حديث سعيد بن جُبير أن ابن عباس سئل: مِثل من أنت حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمرك كم؟ قال: “وأنا يومئذ مختون”، وكانوا لا يختنون أطفالهم حتى يُدركوا، يعني أنه من عادة قُريش ألا تختِن إلا قبل البلوغ، يعني الصبي المراهق ابن عشر ابن إحدى عشرة ابن اثنتي عشرة.
وقال بعضهم: إنه يستحب في اليوم السابع، أو عمره سبع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك مكروه، لأنه من فِعل اليهود، وجاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام ختن ابنه إسحاق وعمره سبع.
وأقول والله أعلم: إنه حينما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم متى يختتن حال الصِّغرِ، فإن كل ذلك جائزٌ، فإن ختنوه بعد ولادته بثلاثين أو بعشرين يوما أو بعد ولادته بشهرين أو ثلاثة شهور، كل ذلك جائز، والله أعلم.
هل هناك حد محدود في الختان؟
لا، لم يرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فالأصل فيه الجواز، سواء كان حال ولادته أو بعده بشهر، أو بأسبوعين، أو بعد ذلك بشهرين أو سنة أو سنتين، أو قبل البلوغ، كل ذلك جائز، لكن الذي هو واجب هو حال البلوغ، لأجل أنه واجب، والله أعلم.
إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول: أننا حينما تحدثنا عن الحلقِ وغير ذلك من الأحكام فإننا يستحب لنا أيضا – كما يذكر الفقهاء – أن نتحدث عن حلق الرأس، فحلق الرأس له أربع مواضع:
الموضع الأول: حلقه في الحج أو العمرة.
فإنه واجب من حيث العموم، أن القص والحلق واجب؛ لأن الراجح أن حلق الرأس في الحج والعمرة واجب، وهو من واجبات الحج، إلا أن الحلق مستحب؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اغفر للمُحلِّقِين»، وفي رواية «اللهم ارحم المحلقين» ثلاث مرات. فالحلق سنة مؤكدة.
النوع الثاني: حلقه لحاجة، كالتداوي. فإن الإنسان أحيانا يحلق رأسه لأجل الحجامة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله وهو مباح.
النوع الثالث: وهو حلقه للتعبد والزهد، ودلالة على التوبة، فإن من العوام من إذا تاب ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه بالمُوسى، فيقول هذا نوع من التدين، وإذا تاب الله عليه فلا يُبقي شيئا من شعره، يقول: هذا أفضل.
نقول لا يا أخي، لا يسوغ لك أن تتعبد الله بغير ما شرع. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من علامات وشعار أهل البدع، وقد أنكر مالكٌ حلق الرأس إلا في حج أو تداو فإن كان لغير حاجة؛ كرهه مالك؛ خوفا من التشبه بأهل الأهواء.
فالراجح والله أعلم أنه إذا كان على وجه التعبد؛ فإنه من فعل أهل البدع، ولهذا تجدون إذا تاب الواحد قالوا: اذهب إلى الحلاق، وهذا لا يجوز.
الحالة الرابعة: حلقه بلا حاجة، يعني الشخص يقول: الشعر الكثير مُتعب، شعري طويل ولا يصلح معي خاصة إذا كنت ألبس القلنسوة أو الطاقية، فأنا أحب أن أحلقه لا لشيء ولكن لأنه أفضل لي، وأنا أرتاح. فما حكمه؟
الراجح والله أعلم – وهو مذهب الشافعية والحنابلة – أن ذلك جائز؛ لما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصبيِّ الذي رآه قد قزع في رأسه فقال: «احلُقُوهُ كله أو اتركوه كله»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «احلقوه كله» يدل على الجواز، والله أعلم، وهذا كما قلت هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال مالك هو مكروه، والصحيح أن ذلك جائز، والله أعلم.
هل يُستحب إطالة الشعر؟
ذهب الحنابلة إلى أنه يُستحب إطالة الشعر، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب المذاهبِ، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أبي داوود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر؛ فليُكرِمهُ»، وهذا الحديثُ في سندِه رجل يُقالُ له عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، وقد أنكر بعض أهل العلم حديثه.
ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث له طُرُقٌ مما يدل على أن له أصلا، ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على استحبابِ إطالة الشعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له شعر فليكرمه»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يخرج الإنسان مُتبذِّلا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُرجِّلُ شعره، وكان يدهنُ شعرهُ غِبّا، مرة دون مرة، يوما وراء يوم.
ولهذا كان يكره كثير من الإرفاه، كما جاء عند أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التّرفُّهِ، وتجدُ بعض الشباب كل صلاة قاعد يسرح شعره، فكأن حياته كلها بالتسريحة و”الجِلّ” وغير ذلك مما يعرفه الشباب. فهذا لا ينبغي أن يكون هذا ديدنه، لكن نعم ينبغي له أن يدهِن غِبّا مرة بعد مرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ولكن لا يدل عل استحباب إطالة الشعر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما كان شعره إلى الوفرة، دليل على أن هذا عادة من عادات قريش والعرب، وليس فيه استحباب.
وقد قال العلماء رحمهم الله في طريقة الإقتداء، ما كان من طريق الجبلة والعادة فإنه لا يُقتدى به، ليس على سبيل التعبُّد، مثل لبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسها لأجل عادةِ قومِه.
وكذلك أطال شعره في بعض المواطنِ لأجل عادة قومه، ومما يُقوِّي هذا القول الثاني (أنه إنما هو جائز) ما رواه أبو داود من حديث عاصم بن كُليب بن ذُهل عن أبيه عن وائل بن حُجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولِي شعرٌ طويل، فقال صلى الله عليه وسلم: «ذباب ذباب»، يعني ذُؤابة، أي ان شعره طويل، قال: فخرجتُ فجززتُ شعري، يعني قصّرتُه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لم أعنِك»، يعني لم أخاطبك، «إني لم أعنك، وهذا أحسنُ»، ولا أحسن من حُسنِ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل ذلك – وهو الأقرب والله أعلم – أن إطالة الشعر إنما هو جائز وليس بسُنة.
وبعض الشباب هداهم الله، في الشعر الكثيف ربما عقص رأسه، ووقت الصلاة يعقصه، وهذا منهي عنه للرجل أن يعقص رأسه وقت الصلاة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه رأى رجلا قد وقص أو عقص رأسه وهو يسجد، فقام ابن عباس فحلّهُ، فقال الرجل: يا ابن عباس، مالك وشعرِي؟! قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مثلُ هذا مثلُ من يُصلي وهو مكتُوف» يعني يُستحب للإنسان أن يسقُط شعره لأجل إذا سجد فإن له أجر بإذن الله إذا سقط على مواضع السجود أو على الأرض فإنه يؤجر على هذا. أما المرأة فلا بأس بذلك، لقول أم سلمة إني أنقُضُ رأسي، وهذا يدل على أن هذا من عادةِ النساء، والله أعلم.
وبعض الشباب يبالغون في إطالة الشعر، وإذا سألتهم عن ذلك قالوا هي سنة، وتجد أنه إذا جاء وقت الحج والعمرة والسنة فيها الحلق، ما حلق ولا قصّر إلا شيئا يسيرا، فإذا قلت لماذا؟ قال: أليس جائزا؟! فلماذا هذه سنة وهذا جائز؟! ولكن هذا يدلُّ على شيء في هواه.
حكم القزع:
القزع هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه. إذن لا بد فيه من الحلق، وأما التخفيف بأن يجعل الأمام أكثر من الخلف فهذا ليس من القزع في شيء، والقزع إنما هو حلق بعض الرأس وترك بعض، مثل ما يفعله بعض الناس، حينما تكون مقدمة رأسه فيها شعر كثيف والخلف محلوق، أو قريبا من الحلق وهو الحّفُّ، فإن هذا يُسمى قزعا.
وأما التخفيفُ بأن يجعل أمامه أكثر، فهذا يسمى قُصّة على الصبيان، وهو الذي يسمونه العوام “التّوالِيت”، وكل بلد له طريقته، وهذا الأصل فيه الجواز، وقد نص عُبيد الله بن عُمر حينما روى حديث نافع، قال: وأما القُصة فلا بأس بها، وكذلك صح عن إبراهيم النخعي، وأشار إليه البخاريُّ مُعلقا، وأشار إليه مالكٌ في الموطأ ونهى عنه مالك، والراجح هو جواز ذلك وهو مذهب الجمهور، والله أعلم.
وأما حكم القزع وهو الحلق فهو مكروه، وسبب النهي إما لأنه فعل العجم وقد جاء عند أبي داود، وإما لأنه تشويه للخلق كما ذكر ذلك بعض المالكية. ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والحديث متفق عليه.
صبغ بعض الشعر للنساء وترك البعض؟
الصبغة للمرأة إذا لم تكن سوادا، فالأصل فيها الجواز، سواء صبغت بعض الشيء وتركت بعض، مثل ما تسميه العامة: “ميش”، فإن كان بصبغة عادية فلا حرج إن شاء الله، وأما إذا كان بمادة كيميائية وتعزل وصول الماء إلى هذا الشعر، وكان كثيرا فإنه لا يجوز، لأنّ الأصل أن المرأة يجب عليها أن تمسح رأسها، فإن كان في خصلة أو خصلتين أو خمس خصلات؛ فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
وأما الصبغة العادية، أو صبغة أعشاب، أو الصبغة التي تُباع في الصيدليات فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
وأما السواد؛ فقد اختلف العلماءُ في ذلك، فذهب جُمهور الفقهاء إلى أن صبغه مكروه، وهذا هو الراجح والله أعلم، ودليل ذلك هو عدم وجود الدليل، وأما حديث: «وجنِّبُوهُ السواد» فقد رواه مسلم، وقد تكلم العلماء فيه، والصواب أنه من زيادة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس المكِّي، فقد روى زهير بن معاوية فقلت لأبي الزبير الراوي لحديث جابر بن عبد الله: هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، فدل ذلك على أنها مُدرجة، وأما حديث ابن عباس: «سوف يكون في آخر الزمان قوم يخضِبُون بالسوادِ، لا يجدون رائحة الجنة»، فهذا حديث رواه التِّرمِذِيّ، وقال: حسن صحيح، لكن هذا يُفيدُ الذّمّ، وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على الكراهة، وليس فيه ما يدل على التحريم، والله أعلم.
ومثله مثل حديث عمران بن حصين كما في الصحيحين أنه قال: «ثم يأتي قوم في آخر الزمان يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يُؤتمنون، ويظهر فيهم السِّمنُ»، فهل كل سِمن حرام؟ لا، لكن هذا من صفاتهم، فكون هذه صفته، ليس يدلُّ على الحرمة، نعم يدل على الكراهة، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهةِ الصبغ بالسوادِ.
4. سنن الوضوء
الوضوء وسننه:
هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لها ولغيرها؟ – تعريف الوضوء – سنن الوضوء .
هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لها ولغيرها؟
من المعلومِ أنّ الشّارِع الحكِيم أوجب على أُمّة محمد الوضوء.
والذي يظهر والله أعلم أنّ الوضوء ليس خاصّا بأُمّة محمد، بل هو لكلِّ الأُمم، إلا أنّ وضوءنا بهذه الصِّفة إنّما هو من خصائص أُمّة محمد صلى الله عليه وسلم.
فوضوءنا بهذه الصِّفة والتّرتيب والكيفيّة التي جاءت في كتاب ربِّنا وبيّنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أفعاله إنّما هو – كما ذكر أبو العباس ابن تيمية – من خصائص هذه الأُمّة، وإلا فإنّ الوضوء من سُنن المرسلين، فقد جاء أنّ إبراهيم عليه السلام كان يتوضّأ، وجاء ذلك عن بعض الأنبياء أيضا، فهذا الوضوء المقصود به وضوءٌ خاصٌّ.
وأمّا وضوء أُمّة محمد فهو وضوءٌ بيّنه ربُّنا في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الآية [المائدة: 6]، وبيّنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
ولأجل هذه الخُصُوصِيّة فإنّ «من توضّأ بهذِهِ الكيفِيّةِ – التي سوف نذكرها – ثُمّ قام فصلّى ركعتينِ لا يُحدِّثُ فِيهِما نفسهُ إلا غفر اللهُ لهُ ذنبهُ»، والحديث متّفقٌ عليه من حديث عثمان رضي الله عنه.
قال النبيّ صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إن أُمتي يُدعون يوم القيامةِ غُرّا مُحجّلِين من آثارِ الوضوءِ»، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ» يعني الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من أمتك من لم تره، فقال: «أرأيتم لو أن رجلا عنده خيلُ دُهمٌ وبُهمٌ ألا يعرِفُ خيلهُ؟»، قالوا: نعم، قال: «فإن أمتي يوم القيامة يأتون محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطُهُم على الحوضِ» الحديث، فدل ذلك على أن هذه الصفة إنما هي من خصوصيات أمة محمد، وأما الوضوء في أصله فإن كل أنبياء الله يتوضؤون. ولهذا نجد في الحديث المتفق عليه في قصة جُريج العابد، “حينما اتُّهم أنه زنا بالمرأةِ، فقالوا: إنك زنيت بهذه وهذا ولدها، فقال: أمهِلُونِي حتى أصلي، فتوضأ، والشاهد: «ثم صلّى»، فوضع يده على بطن الصبيِّ فقال: من أبوك، فقال: إن أبي هو الراعي”. وجه الدلالة أن جريجا توضأ.
وكذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة سارة زوجة أبينا إبراهيم عليه السلام، حينما همّ الملِك بأن يمسّها، قال: “فتوضأت، ثم صلت.. فهذا وضوء لكن ليس كالوضوء الذي شرعهُ اللهُ سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا”.
وأما حديث: «هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» فهو حديثٌ ضعيف لا يصحُّ، فإن في سنده رجلا يُقال له: زيد العمِّي، يرويه عن مُعاوية بن قُرّة عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر. وقد ضعف الحديث غيرُ واحد من أهل العلم؛ كأبي داود وغيره، وضعفه أبو حاتم والبيهقِي وآخرون.
تعريف الوضوء:
الوضوء لغة من الوضاءة، وهي الحُسن والجمال.
وأمّا في الاصطلاح الشّرعيِّ: فهو استعمال الماء لأعضاء مخصوصة في كيفيّة مخصوصة في وقت مخصوص.
ومعنى (وقت مخصوص) يعني لعبادة مخصوصة؛ كالصّلاة وقراءة القرآن ليمس المصحف.
سنن الوضوء:
الأول: التّسمِية.
وهي سُنّةٌ عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضُ أهلِ العلم إلى أنّها واجبةٌ، والرّاجح أنّها سُنّةٌ.
وقد جاء في حديث عند البيهقِي أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما نبع الماءُ من بين أصابعه – وكانوا قد عطِشُوا وليس عندهم ماءٌ: «توضّؤُوا بِاسمِ اللهِ»، فهذا يدلُّ على أنّه يُشرع للإنسان أن يُسمِّ الله سبحانه وتعالى.
وأمّا الحديث الذي جاء فيه: «لا صلاة لِمن لا وُضُوء لهُ، ولا وُضُوء لِمن لم يذكُرِ اسم اللهِ»، فإنّه حديثٌ يرويه يعقوب بن سلمة اللّيثِي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يصحُّ في الباب حديثٌ.
وإذا قال مُحدِّثٌ كبيرٌ وإمامٌ مُتقدِّمٌ كالبخاري وأحمد وابن المدِينِي: (أحسن شيء في الباب حديث كذا)، فهذا لا يُفيد التّصحيح. فهو يقول: كلُّ الأحاديث ضعيفةٌ، وأحسنها هذا. وهذا لا يدلُّ على أنّه صحيحٌ. وهذا كما أقول أنا: أحسن طريق إلى مكّة طريق كذا. فهل هذا الطّريق هو أفضل طريق؟ لا، هو أحسنها من حيث أسوئها، لكن لا يدلُّ ذلك على أنّه ليس فيه مشاكل، والله أعلم.
فإذا قلنا: (لا يصحُّ في وجوب التسمية في الوضوء حديثٌ) فاعلم أنّ كلّ الأحاديث التي جاءت؛ فهي أحاديث ضعيفةٌ، حكم على ضعفها العلماء كالإمامُ أحمد وأبو حاتم الدّارقُطنيّ وأبو زُرعة وابن القطّان، وغيرُ واحد من أهل العلم.
وقد، قال البخاريُّ: “أحسنُ شيء في الباب حديثُ يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة”.
الثاني: السِّواك.
فهو يُستحبُّ عند الوضوء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشُقّ على أُمّتِي لأمرتُهُم بِالسِّواكِ عِند كُلِّ وُضُوء» أو «مع كُلِّ وُضُوء». رواه مالك في الموطأ، والله تعالى أعلم.
والسِّواك إمّا أن يكون قبل البدء بالوضوء، وإمّا أن يكون أثناء الوضوء؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مع كُلِّ وُضُوء»، قال أهلُ العلم: (مع) تُفيد أنّه لو توضّأ وشرع في الوضوء وتسوّك فإنّه يصدُقُ عليه أنّها مع للمعِيّة، والله أعلم.
الثالث: غسل الكفّين.
فإنّ غسل الكفّين سُنّةٌ، وقد جاء في الصّحيحين من حديث حُمران مولى عثمان، عن عثمان رضي الله عنه: أنّ عثمان دعا بوضُوء، ثم جِيء بقدح، فأدخل يده فاستخرجها، فغسل كفّيه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فتمضمض واستنشق من كفّ واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وهذا وجه الدِّلالة، حيث يفيد أنّ غسل اليدين من سُنن الوضوء.
وقد قال عثمان رضي الله عنه: “رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّأ نحو وُضُوئي هذا”. فهذا يدلُّ على أنه فعل هذا على نحو ما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يصنع.
وقد قال العلماءُ: من لم يغسل الكفّين لكنّه حينما أراد أن يغسل يديه قد غسل كفّيه مع يديه؛ فإن وضوءه صحيحٌ وصلاته صحيحةٌ، أمّا إذا غسل يديه إلا الكفّين، فلا يصح؛ لأنّه لم يغسل الكفّين، أو لأنّه حينما أراد أن يغسل اليدين لم يغسل عامّة اليد، فهذا فيه فرقٌ، والله أعلم.
الرابع: البدء بالمضمضة والاستنشاق.
ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، فدلّ ذلك على أنّ المضمضة والاستنشاق من ضمن الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، جاز، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، والله أعلم.
ومما يدلُّ على البدء بذلك ما جاء في الصّحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنّه أخذ وضُوءا ثم أدخل يده فيه واخرجها، فتمضمض واستنشق من كفّ واحدة، فعل ذلك ثلاثا.
وفي حديث عليِّ بن أبي طالب: فعل بثلاث غرفات. وهذا يدلُّ على أنّ البدء بالمضمضة والاستنشاق سُنّةٌ.
كذلك من السُّنن مع البدء: أن يجعل المضمضة والاستنشاق بكفّ واحدة، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فإنّ الأكثرية إذا أراد الواحد أن يتوضّأ يأخذ ثلاث غرفات للفمِّ، ثم ثلاث غرفات للاستنشاق، وهذا ليس من السُّنة.
وأمّا ما جاء في حديث طلحة بن مُصرِّف عن أبيه عن جده: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفصِلُ بين المضمضة والاستنشاق. فهو حديثٌ باطلٌ. قال يحيى بن معِين: “إيش هذا، طلحة بن مُصرِّف عن أبيه عن جده؟!”. يعني أن هذا الحديث منكرٌ، أي لا يوجد حديث بهذا الإسناد.
والصّحيح هو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كفّ واحدة.
وعلى هذا نقول: إذا أراد الإنسانُ أن يتمضمض ويستنشق في الوضوء فإنّه يأخذ بكفِّه فيجعل شيئا من الماء في فمه، والشيء الآخر يستنشقه.
والمضمضة هي إدخالُ الماء إلى الفمِ، فإن أدارهُ فهذا أفضل، وإن لم يُدِرهُ فلا حرج في ذلك، وإن ابتلعه قال بعضُ أهل العلم: لا يُجزِئُهُ. والصّحيح جواز ذلك؛ لأنّه لا يلزم مجُّهُ، فلو ابتلعه لا حرج، ولكن المقصود بالمضمضة إدخال الماء إلى الفم، والله أعلم.
أمّا الاستنشاق: فهو جذب الماء إلى الخياشيم، فإن استنشق فهذا أفضل؛ لما جاء عند أبي داود والإمام أحمد من حديث لقِيط بن صبِرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خلِّل بين الأصابِعِ، وبالِغ فِي الاستِنشاقِ، إلا أن تكُون صائِما».
والاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الشّهِيق، فهذا أفضل، إلا حال الصوم فإنّه لا يُستحبُّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبالِغ فِي الاستِنشاقِ، إِلا أن تكُون صائِما»، فلا يُستحبُّ المبالغةُ حال الصّوم، وأمّا غير الصّوم فإنّه يُستحبُّ، والله أعلم.
إذن المبالغة فيهما سُنّةٌ من سنن الوضوء (في المضمضة والإستنشاق عدة سنن).
السادس: التّيامُن.
ومعناه: أن يبدأ باليمين فيما فيه عُضوان، فالسُّنة أن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليُسرى، وأن يبدأ بغسل رِجله اليمنى قبل اليسرى، وقد جاء في حديث عند عليِّ بن أبي طالب – وإن كان في سنده بعضُ الكلام: «لا أُبالِي غسلتُ يدِي اليُسرى قبل اليُمنى»، ولكن السُّنة أن يغسل يده اليمنى لأجل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال الله: ﴿فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم﴾ [المائدة: 6]، فذكر الله لفظا عامّا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه باليمين، وهذا يدلُّ على الإستحباب، والله أعلم.
وكل الذين رووا أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنّه كان يبدأ باليمين، وهذا فِعلٌ، والفِعل يدلُّ على الإستحباب، ولم يأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بوجوب ذلك، وقد كان يُحِبُّ التّيمُّن في تنعُّلِه، وفي طُهُورِهِ، والله أعلم .
فلو غسل المتوضئ رِجله اليسرى قبل اليمنى جاز ذلك، ولو غسل يده اليسرى قبل اليمنى جاز أيضا، والله أعلم .
السابع: مسح الرأس. وهل يأخذ ماء جديدا لأُذُنيهِ؟
فإذا أراد أن يمسح رأسه يأخذ ماء فيُبلِّل يده، ثم يمسح رأسه، ثم بعد ذلك يأخذ ماء جديدا لأُذُنيه، فهل أخذُ ماء جديد لأُذُنيه سُنّةٌ أم لا؟
الجواب: ذهب بعضُ العلماءِ إلى أن أخذ ماء جديد للأُذُنين سُنّةٌ، وهو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني في المسألة أنه ليس بسُنّة، بل يكتفي بالماء الذي أخذه لرأسه؛ لأنّه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أخذ ماء جديدا لأُذُنيه، والحديث الوارد في ذلك ضعيفٌ؛ فإنّ في سنده رجلا يُقال له: عبد الله بن محمد بن عقِيل.
والصّحيح أنّ حديث: «أخذ ماء جديدا لأُذُنيه» حديثٌ ضعيفٌ، وهو حديث الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ حديثٌ ضعيفٌ، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فكل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفةٌ.
وأصحُّ شيء في الباب ما رواه مسلمٌ: «أنّه أخذ ماء لرأسه غير الماء الذي فضل من يديه» هذا هو الحديث، وأمّا أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، فالصّحيح أنّ الأُذُنين من الرأس، وإذا كانت الأذنان من الرأس فإنّها تُمسح بالماء الذي أخذ للرأس، والله أعلم.
وعلى هذا فليس من السنة.
الثامن: أن يغسلها ثلاثا.
فإذا غسل يده مرّة فإنّه قد أدّى الواجب، فمن السُّنن أن يغسلها ثلاثا، ولهذا فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عثمان بن عفان حينما توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: «من توضّأ نحو وُضُوئِي هذا، ثُمّ صلّى ركعتينِ، مُقبِلٌ على اللهِ – تعالى- بِوجهِهِ؛ غفر اللهُ لهُ ذنبهُ».
وفي هذه الأيام تجد من يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يتوضأ، فليتب من ذلك فإن صلاة التوبة معروفةٌ كما جاء عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب أنّه قال: “كان إذا حدّثني أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي وإلا، وحدثني أبو بكر – وصدق أبو بكر – أنّه قال: «ما مِن مُسلِم يُذنِبُ ذنبا فيتوضّأ ثُمّ يُصلِّي ركعتينِ إِلا غفر اللهُ لهُ ذنبهُ”.
ومن المعلوم أنّ الوضوء سُنّةٌ يغفل الناسُ عن أهميتها، فإذا كان الواحد طاهرا وقلت له: توضأ. قال: أنا طاهرٌ. فنقول له: حتى إن كنت طاهرا، الأفضل أن تُعيد الوضوء للصلاة الثانية؛ لأنّ العبد المسلم كما جاء في صحيح مسلم: «إِذا توضّأ العبدُ المُسلِمُ – أو المؤمن – فغسل وجهه خرج مِن وجهِه كُلُّ خطِيئة نظر إِليها بِعينيهِ مع الماءِ، أو مع آخِرِ قطرِ الماءِ، فإِذا غسل يديهِ خرج مِن يديهِ كُلُّ خطِيئة كان بطشتها يداهُ مع الماءِ، أو مع آخِرِ قطرِ الماءِ، فإِذا غسل رِجليهِ…» الحديث، وهذا يدل على أنّه يُستحبُّ للإنسان أن يكون على طهارة، وإن كان ذلك في أول الإسلام، ولهذا ذكرنا حديث: أنّه كان في أول الإسلام يتوضأ الإنسانُ لكلِّ صلاة. قلنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرتُ بِالوُضُوءِ لِكُلِّ صلاة، طاهِرا أو غير طاهِر، فلمّا شقّ ذلك على أمته أُمِر بالسِّواك لكلِّ صلاة. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وقلنا أنّ الحديث رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود، وابنُ خُزيمة، وإسناده جيد.
وعلى هذا نقول: ينبغي للإنسان إذا لم يشُقّ عليه ذلك أن يتوضّأ، وقد قال الشافعيُّ في تفسير قول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ﴾ [المائدة: 6]، قال: “فهذا يدلُّ على الأمر بأن يتوضأ الإنسانُ عند كلِّ إرادةِ صلاة، فلمّا جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه صلى بوضوء واحد جميع الأوقات؛ دلّ على أنّ هذا الأمر للإستحباب”، والله أعلم.
التاسع: أن يبدأ بمُقدّم رأسه إذا أراد أن يمسح الرأس.
فيبدأ بمُقدّم رأسه حتى ينتهي بيديه إلى قفاهُ، ثم يرُدُّهُما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في الصّحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.
فهذا سُنّةٌ، ولو أنّه مسح رأسه بأيِّ طريقة؛ مثل أن يُعمِّم رأسه بيد واحدة، أو بجميع اليدين بطريقة أخرى، فكل ذلك جائزٌ؛ لأنّ الواجب هو مسح الرأس كله أو غالبه، كما هو مذهب المالكيّة والحنابلة، خلافا للشافعيّة وأبي حنيفة.
العاشر: قال المالكيّةُ أنّ يَفْرُكَ (الفَرْكُ) وهو الذي يُسمّى الدّلْكُ.
فأوجب المالكيّةُ الدّلك في الوضوء والغسل، وذهب الجمهورُ إلى أنّ الدّلك سُنّةٌ؛ لأجل أنّه نوعٌ من الإسباغ، وإلا فلو سكب الماء على جميع أعضائه حتى أسبغ فإن ذلك جائزٌ.
وأمّا حديث جابر عند الدّارقُطنيّ: “أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مِرفقِه”. فهو حديثٌ ضعيفٌ.
فإن دلك فهذا داخلٌ في عموم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسبِغُ الوضوء، وإسباغُ الوضوء عبادةٌ، خاصّة في وقت شِدّة الصّيف، أو في شدّة الشتاء؛ لأنّ الناس أحيانا بسبب شدة البرد يتألّمون من الماء البارد، فربما أدخلوا أيديهم في الماء سريعا ثم أخرجوها، فلا يُسبِغُون الوضوء، مثلا في البرارِي، تجدهم يتوقّون وقوع الماء على أيديهم من شدة البرد، فربما إذا أدخل أحدهم يديه في الماء أخرجها سريعا ثم بدأ يمسح، وهذا ليس من السُّنة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أدُلُّكُم على ما يرفعُ اللهُ به الدّرجات ويحُطُّ به الخطايا؟ ثلاث: إِسباغُ الوضوءِ على المكارِهِ، وكثرةُ الخُطى إلى المساجِد، وانتِظارُ الصّلاةِ بعد الصّلاةِ، فذلِكُم الرِّباطُ، فذلكم الرِّباطُ، فذلكم الرِّباطُ».
ومعنى «إسباغ الوضوء على المكارِه» أن يُسبغ الوضوء في وقت المكاره، وهو شدّة الحرِّ أو شدّة البرد.
لهذا نقول: ينبغي أن تعلموا أنّ ذلك عبادةٌ، ولا يعني ذلك أن يستخدم الماء البارد ويترك الماء الساخن إذا كان عنده في بيته أجهزة تسخن الماء؛ لأنّ المشقّة ليست مقصودة في العبادة لذاتها، لكنّها إن كانت مُتطلّبة لأجل فعل العبادة فلا حرج، مثل شخص يسكن بعيدا عن المسجد، فيستطيع أن يركب السيارة إلى المسجد، ولكنّه يريد أن يمشي، فنقول: المشي أفضل، وهذا التّعبُ تُؤجر عليه، لكن هذا التعب غير مقصود، فلو كان هو المقصود لأُمِر الإنسانُ بالجري، والجري ليس من السُّنة.
فدلّ ذلك على أنّ المشقّة ليست مقصودة لذاتها، لكن العبادة التي فيها تعبٌ ليست كالعبادة التي ليس فيها تعبٌ؛ لأنّ أجرك على قدر تعبك، وليس المقصودُ من العبادة أنّ الشّارع يريد أن يشق على الناس كما تفعله بعضُ الطوائف حينما يقولون: نفضل الجوع الدائم، أو يضرب أحدهم جسده بيده ليتألم، أو يُلطِّخ وجهه.. إلخ، كل ذلك مُحرّمٌ ولا يجوز؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإِنّ لنفسك عليك حقّا، فأعطِ كُلّ ذِي حقّ حقّه»، والله أعلم.
إذن الرّاجح أنّه يُستحبُّ له أن يُدِير الماء ويسبغ الوضوء على المكاره، والله أعلم.
5. أركان الوضوء وواجباته
فروض الوضوء:
متى فُرض الوضوء؟ – فروض الوضوء – الفرقُ بين الشرط والواجب – حكم الزيادة على الفرض في غسل أعضاء الوضوء – هل يُستحب غسل العنق؟
متى فُرض الوضوء؟
ذهب جماهير أهل العلم إلى أنّ الوضوء شرع وفُرِض مع الصلاة، أي عندما فرضت الصلاة.
وذكر عامة أهل العلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ صلاة قط إلا بوضوء، ولهذا قال ابن المُنذِر: “ومعلوم عند جميع أهل السِّير، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه الصلاة والجنابة جميعا، قال: ومعلوم أنّ الغُسل من الجنابة لم يُفرض قبل الوضوءِ”، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة إلا بوضوء، فدل ذلك على أن الصلاة حينما فرضت فرض الوضوء.
وصفة الوضوء بهذه الطريقة على أمة محمد لم تثبت إلا في آية المائدة، وسورة المائدة نزلت قريبا من السنة السادسة للهجرة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فُرض الله عليه الوضوء، لكن الوضوء بهذه الطريقة إنما فرض بنزول آية: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم﴾ [المائدة: 6].
فروض الوضوء:
الأول: غسل الوجه.
أجمع أهل العلم على أنه من أركان الوضوء؛ لقول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم﴾ [المائدة: 6]، وقد نقل غيرُ واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على أنّ غسل الوجه واجبٌ، فما هو الوجه ؟
يبدأ الوجه من منابت الشعر إلى أدنى اللِّحية، أو إلى أدنى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا مع الصُّدغين، والصُّدغ هو البياض الذي يكون من الأذن إلى العين، فيجب غسلُ الصدغين لأنّهما من الوجه، والله أعلم.
وعلى هذا لا يجوز غسل بعض الوجه وترك البعض لا يصله الماء، فإن بعض الناس خاصّة أصحاب اللحى أو بعض الشباب يُهملون هذا، فربما يبقى شيء من اللحية أو من العارضين، فلابُدّ من تعميم الماء على الوجه، فيضرب بالماء وجهه من منابت الرأس حتى يبلغ سائر وجهه، والله أعلم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويلٌ للأعقابِ مِن النّارِ» ثلاثا، وهذا يدلُّ على أهمية غسل كامل العضو، وعلى أن من لم يغسل كامل العضو فويلٌ له.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العقِب من باب أنّه رأى قوما ولا يكملون الوضوء في الأعقاب، وكذلك من لم يغسل كامل وجهه نقول له: ويلٌ للوجوه من النار؛ لأنّه لابُدّ أن يُعمِّم سائر أعضاء الوضوء.
الثاني: المضمضة والاستنشاق.
وهو من الوجه.
والراجح والله أعلم أنّ المضمضة والاستنشاق حُكمهما: أنهما واجبتانِ، أما المضمضةُ؛ فلِما جاء عند أبي داود أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للقِيط بن صبِرة: «إذا توضأت فمضمض».
وقد صح عن ابن عباس – كما روى ابن المُنذِر – أن رجلا اغتسل وترك المضمضة، فسأل ابن عباس فقال: تمضمض الآن، فدل ذلك على أن المضمضة واجبة، فلما وجبت في الغُسُل فهي تجب في الوضوء، وهذا القول هو مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة في الوضوء.
أمّا الاستنشاقُ، فإنّه قد جاء الحديثُ الصّحيحُ في الصّحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا توضّأ أحدُكُم فليجعل فِي أنفِهِ ماء ثُمّ لِينتثِر». ومعنى (يجعل في أنفه ماء): هو الاستنشاق، والله أعلم.
وذهب مالك والشافعي إلى أنهما سُنتان، والراجح والله أعلم وجوبُ ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضّأ على هذه الطريقةِ، ولم يُنقل لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة، وقد قال الله تعالى: ﴿إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم﴾ [المائدة: 6]، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعلُه بيانا لِمُجملِ الآية.
ولو أنّ إنسانا غسل وجهه، ثم تمضمض واستنشق، هل يصحُّ وضوؤه؟
يصح. والدّليل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولم يُوجب ذلك، فدلّ على أنّ البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه دليلٌ مع أنّ الله أمر بالوجه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ بالمضمضة والاستنشاق، إذن يصح غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، لأن البداءة مستحبّةٌ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد دليلٌ يُوجب ذلك، وأمّا في القرآن فأوجب الوجه، ولم يُوجب المضمضة، والمضمضة والاستنشاق إنّما بُدِئ بهما لفعله صلى الله عليه وسلم وأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم إذن هناك فرقٌ.
فبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، فدلّ على أنّ فعله يدل على الإستحباب، والله أعلم.
ما هو الإنتِثار؟
هو إخراج الماء الذي علِق على خياشِيمِ الأنف بعد إدخاله، فما حكمه؟
جمهور العلماء – وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم – على أنه سُنّةٌ.
وذهب أحمدُ في رواية إلى وجوب ذلك. والرّاجح أنّه سُنّةٌ، إلا أنّه يُستحبُّ استحبابا شديدا حال قيام الإنسان من نومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فليجعل فِي أنفِهِ ماء ثُمّ لِينتثِر؛ فإِنّ الشّيطان يبِيتُ على خياشِيمِهِ».
الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين.
أما غسل اليدين؛ فإنه ثابت بالإجماع، لم يُخالف في ذلك أحدٌ من أهلِ العلم؛ لقوله تعالى: ﴿ فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم إِلى المرافِقِ﴾ [المائدة: 6].
والسؤالُ: هل المِرفقانِ يُغسلان مع اليدينِ أم لا؟
الجواب: قال جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقولٌ عند المالكية، انه: يجب غسل المرفقين؛ وذلك أنّ المعنى في قوله: ﴿وأيدِيكُم إِلى المرافِقِ﴾ [المائدة: 6] أن “إلى” هنا بمعنى “المعية”، يعني “مع المرفقين”، كما قال الله تعالى في قوله تعالى: ﴿من أنصارِي إِلى اللهِ﴾ [آل عمران: 52]، يعني من أنصاري مع الله، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ ويزِدكُم قُوّة إِلى قُوّتِكُم﴾ [هود: 52]؛ يعني قوة مع قوتكم.
وقد ذكر علماء اللغة كالمُبرِّد رحمه الله أن “إلى” الغائِيّةِ، إذا كان الحدُّ من جنسِ المحدود؛ فإنه يدخل معه، فإذا قلت: قطعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف فإنه يدخل، وأما إذا كان ليس من جنسه؛ فإنه لا يدخل، وعلى هذا فـ “إلى” الغائية تدخل في الشرع في ثلاثةِ مواطن:
الأول: دخول المرفقين مع اليدين بـ “إلى”.
الثاني: دخول الكعبين مع الرجلين ﴿وأرجُلكُم إِلى الكعبينِ﴾ [المائدة: 6]؛ يعني مع الكعبين،
الثالث: التكبير المطلق والمقيد الذي ذكره العلماء رحمهم الله، وهو إجماع من الصحابة كما نقل بعض أهل العلم كالحاكم وغيره، على أنه يُكبِّر إلى آخرِ صلاة العصرِ من أيام التشريق، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله.
إذن إدخالُ المرفقين مع اليدين في الوضوءِ هو قول عامة أهل العلم.
وليس من الوجوبِ أن يدلك، فلو أمرّ الماء على أعضائه حتى أسبغ فإنه يجزئه، إلا أن مالكا أوجب ذلك، وليس مع مالك حديث صحيح في ذلك، وأما الحديث الذي رواه الدّارقُطنيّ عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مِرفقيه، فهو حديثٌ ضعيفٌ، ضعفه ابن حجر وغيره.
الرابع: مسح الرأس.
لم يختلف أهلُ العلم في وجوبِ مسح الرأس، وهو محلُّ إجماع في الجملة؛ لقوله تعالى: ﴿ وامسحُوا بِرُءُوسِكُم ﴾ [المائدة: 6]، إلا أن أهل العلم اختلفوا في “الباء” هذه، ﴿ بِرُءُوسِكُم ﴾ [المائدة: 6]، هل هي للتبعيض، فيجوز مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أم للإلصاق فتفيد وجوب تعميم سائر الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد؟
والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وضوءا إلا وعمم سائر رأسه، فدل ذلك على أن الباء هنا للإلصاق، بل قال ابن بُرهان – من علماء اللغة –: “من ادعى أن “الباء” تأتي في اللغة بمعنى التبعيض؛ فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون!”.
والواقع أنّ من علماء اللغة من أشار إلى أن الباء تأتي للتبعيض، لكنه قول قليل، يعني غير مشهور، المهم أن الراجح والله أعلم أن كل الصحابة الذين نقلوا لنا هذا، وعددهم أكثر من أربعة عشرة صحابيّا، لم ينقلوا لنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حينما مسح رأسه مسح البعض.
وأما ما جاء في حديثِ المُغِيرة بن شُعبة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على ناصِيّتِه؛ فهذا حديث مختصر، اختصره بعض الرواة، وإلا فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العِمامة، فدل ذلك على أن المسح لم يكن لبعض الرأس إنما كان لكامل الرأس وهو المسح على العمامة، فإذا كان بعض الرأس مكشوفا فإن الواحد يمسحه.
وعلى هذا: فالراجح أنّ الواحد يُعمِّم سائر رأسِهِ، وهذا هو مذهبُ أحمد ومالك، وهو اختيارُ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم.
ولكن لو أنّ شخصا قال: أنا مسحت بعضه فهل يصح وضوئي؟
الجواب: إن كان مسحُك في وضوء سابق، فعفا الله عما سلف؛ فقد كان لك سلف. أما إذا فعلت ذلك الآن، فنقولُ: الأولى أن تُعيد الوضوء إذا كانت أعضاؤك قد جفّت، فإن كانت أعضاؤك لم تجف؛ فامسح رأسك، ثم بعد ذلك اغسل رجليك كما هو معلوم في مسألة الموالاة.
هل يمسح الشعر المتصل؟ فبعض الناس عنده شعر – أو بعض النساء عندها ذوائبُ متصلة، فهل تمسح المرأة الذوائب؟
الراجح أنه لا يُمسح، فالواجب هو مسح ما صعد إلى الرأسِ، فلو أنّ المرأة مسحت رأسها، ولم تمسح ذوائبها؛ فإن وضوءها صحيح ولا إشكال، فإن مسحت من بابِ الخروج من الخلافِ فلا حرج، لكنه لا يجب، والله أعلم.
ما كيفية المسح؟
كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بدأ بِمُقدّم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكانِ الذي بدأ منه.
هذه صِفة مسنونة، فإن كان شخص لديه “قُصّة” وهو لا يُريد أن تُبعثِر ترتيب رأسه، فإننا نقول: لا حرج؛ فإنه إذا كان رأسه مُفرّقا فإن له أن يمسح بيده هكذا، واليد الأُخرى هكذا، مثل المرأةِ، أو أنّ رجلا عنده “قصّة” فهو لا يُريدها؛ فلا حرج كما سُئل الإمام أحمد: ما تصنع المرأة في مسح رأسها؟ قال: “تضع يدها على يافُوخِها ثم تجرها إلى الأمام، ثم تضعها في المكان الذي بدأت منه ثم تجرها إلى الخلف”. وهذا يدل على أن أي صفة مُسِح بها الرأس فجائز، إلا أن السنة هي الطريقة التي قُلناها.
وبعض الإخوة يرفع قُلُنسُوّتهُ ويأخذ بيد واحدة يمسح بها رأسه (واليد الأخرى ممسكة بالقلنسوة)، فنقول: إذا عمّم سائر رأسِه فلا حرج، وأما إذا أخذ بأول المقدم؛ فنقول: الراجح أنّ ذلك لا يُجزئ، والله أعلم.
ومسح الرقبة؟
لا يُشرع، سواء كان الأمام أو الخلف.
هل يُمسح الرأس ثلاثا أم يمسحه مرة واحدة؟
جماهيرُ أهل العلم يقولون إنّ المسح مرة واحدة، هذا هو مذهب جمهور أهلُ العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافا للشافعية، ذلك أنّ غالب من ذكروا صفة وضوءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم المِقداد بن معدِي كرِب عند أبي داود، وعلي بن أبي طالب عند الإمام أحمد وأهل السنن، وعبد الله بن زيد بن عاصم في الحديث المتفق عليه، وعثمان بن عفان في الحديث المتفق عليه، وابن عباس، فإنهم ذكروا أنه مسح برأسه مرة واحدة، ولو كان المسح أكثر من مرة فيه فضيلة؛ لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة.
فدل ذلك على أنه ليس من السنة أن يمسح الإنسانُ رأسه أكثر من مرة.
وأما ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا، فهذه الزيادة خطأ، وقد ضعفها أبو داود، وقال: “جميع الأحاديث الصحاح عن عثمان مسح برأسه مرة واحدة”.
وكذلك جاء حديث آخر، في سنده رجل يقال له: ابن البيلمانِي وهو ضعيف.
إذن الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، والحمد لله.
الخامس: غسل الرجلين.
ذكر جماهير أهل العلم وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن الرجلين تُغسلان، والخلاف في هذا خلافٌ مُندثِر.
فائدة: أحيانا نجد أن بعض أهل العلم ينقلون الإجماع في بعض المسائل، ثم نجد خلافا، فكيف ذلك؟
الجواب: أنّ نقل الإجماع عند أهل العلم يُشارُ معه إلى أنّ الخلاف حادِثٌ بعد وُجودِ إجماع، فلا يُعوّلُ على ذلك الخلافِ، هذه نقطة. ولهذا عندما نجد بعض الأئمة ينقلُ الإجماع في مسألة، ثم نجد خلافا في المسألةِ، فلربما كان هذا الخلافُ خلافا حادثا، جاء بعد الإجماع، ولهذا تجدون دائما الخلاف الذي يكون حادثا ليس له دليل بل هو استدلال عقلي أحيانا، هذا واحد.
الثاني: أن نقل الإتفاق عند الأئمة أحيانا يقصدون به اتفاق الأئمة الأربعة، المقصود عند العلماء إذا قال باتفاقِ الفقهاء يقصدون به الأئمة الأربعة، وإن كان في المسألة خلاف.. أما إذا قالوا بإجماع فإنما يقصدون إجماع عامة أهل العلم، ولهذا لا تثريب على العالمِ إذا قال باتفاق الفقهاءِ، ويقصد بذلك الأئمة الأربعة، وليس ذلك من خلل في الأمانة العلمية، فقد كان أبو العباسِ ابن تيمية يُطلق ذلك، وكان ابن هُبيرة من علماء الحنابلة يُطلق ذلك، وكان ابن القيم يطلق ذلك، وكان أبو عُمر ابن عبد البر، بل ينقل أبو عُمر الإجماع مع أن في المسألة خلافا، وكذلك ابن المُنذِر.
فينبغي أن نعرف مصطلحاتِ الأئمة، ومصطلحات العلماء، فلكلِّ علم مصطلحُه، فلا ينبغي أن يُثرّب أو يُعنّف على من سلك طريقة أهل العلم في مصطلحاتهم؛ فإن العتب على من لم يعرف مثل تلك المصطلحات.
والواجب في الرجلين هو الغسلُ، وهذا كما قلتُ هو قول عامة أهل العلم.
وأما ما جاء في حديث علي أنه رشّ رجليه، فإن الرش أو المسح إنما هو الغسل الخفيفُ، كما عند بعض علماء اللغةِ، ولهذا تقول: تمسّحتُ للوضوء؛ أي: اغتسلت للوضوء، فكان من لغة العرب الغير مشهورة؛ أن التمسح هو بمعنى الغسل الذي ليس كثيرا، والله أعلم .
ثم إنّ الحديث الوارد في أن عليّا مسح رِجليه؛ حديثٌ ضعيف، ولو صحّ فإنه إنما مسح لأجل وجودِ نعلينِ في رجلِه، فكان غسل ما خرج ومسح ما خرج ولكن أدخلهما فكانت بمثابة الرش أو بمثابة المسح. والصحيح أن الحديث ضعيف.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقابِ من النار»، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عائشة عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة. فقوله: «ويل للأعقاب من النار»، فكان صلى الله عليه وسلم قد قدم من مكان بعيد، فرأى بعض أصحابه لا يهتمون بغسل العقِبينِ، فقال: «ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار».
ورأى أبو هريرة قوما يصنعون ذلك، فقال: “أسبغوا الوضوء؛ سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار»”. فإذا كان هذا الحديث الصحيح فيه هذه العقوبة؛ دلّ على أنه لا يُجزئ إلا الغسلُ، والله أعلم.
والكعبان: هما العظمان النّاتِئانِ من جانِبي القدم، وهما مجمع مفصلِ الساق والقدم، ويجب غسلهما، وتكون “إلى” هنا بمعنى المعية.
هل يُشرع أن يغسل ما زاد إلى أول الساق؟
نقول السنة: أن لا يفعل ذلك، فإن فعل من باب التأكيد، لا من باب أنه سنة؛ فذلك جائز، والزيادة لا تُسنُّ كما قلنا في مسألةِ اليدين، والله أعلم.
السادسُ: الترتيبُ بين الأعضاءِ.
ذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى وُجوب الترتيبِ في أعضاء الوضوء، كما أمر الله في كتابه ورتبها سبحانه وتعالى فقال: ﴿ فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم إِلى المرافِقِ وامسحُوا بِرُءُوسِكُم وأرجُلكُم إِلى الكعبينِ ﴾ [المائدة: 6]، وفعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته عند ابن حبان بسند لا بأس به؛ فقال: «توضّأ كما أمرك اللهُ»، فدل ذلك على أن الله أمره بهذا الأمر.
وإن كانت “الواو” لا تقتضي الترتيب، فإن “الواو” تقتضي العطف دون الترتيب، وإنما الذي يقتضي الترتيب من حروف العطف “ثم” و”الفاء”، أما “الواو”؛ فقالوا: لا تقتضي الترتيب.
الجواب: نقول: نعم؛ إن “الواو” لا تقتضي الترتيب، لكن الله حينما رتّب ذلك، وأمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما أمرنا ربُّنا؛ فدلّ ذلك على أن الترتيب ليس لأجل وجود “الواو”، ولكن لأجل وجود أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر واضح والحمد لله.
الثاني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منذ أن فرض الله عليه، ولم يُنقل أنه أخلّ بالترتيب، وقد روى الإمام أحمد من حديث قابوس عن أبيه عن عليّ رضي الله عنه أنه سُئل: فقيل له: أحدنا يستعجلُ فيغسل شيئا قبل شيء. قال: “لا؛ حتى يكون كما أمر الله”، وهذا قولُ صحابي، وهو الراجح والله أعلم، وهو أن الترتيب واجب.
ويسقط الترتيب مع الجهل، إذا كان الواحد جاهلا، فمن بدأ بالرأسِ قبل اليدينِ، ثم صلى؛ فإننا لا نأمرُه بالإعادةِ؛ لأنه كان جاهلا.
القاعدة في ذلك: أن كل من فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى فأخطأ فيه بسبب الجهلِ باجتهاد، أو تأويل، أو تقليد؛ فإنه لا يُؤمرُ بالإعادةِ، والله أعلم.
فيجبُ الترتيبُ، وعليه فلو أن شخصا أحدث ثم أراد أن يغتسل في البِركة، ثم قال: أنا نويت الوضوء ثم غمس جسده كله في الماء، ثم خرج، وقال لقد توضأت، فهل يجزئ؟
الجواب: عند من قال بوجوب الترتيب؛ فإنه لا يجزئه.
شخص عليه جنابة، ثم نوى رفع الحدث، ثم دخل الماء، ثم خرج، وقال: نويت الوضوء، هل يجزئ؟
نعم، يُجزئ، لأنّ الإغتسال غير الوضوء، الوضوء حدث أصغر، والإغتسال حدث أكثر، وإذا نوى الإنسان رفع الحدث وعمّم سائر بدنه، وتمضمض واستنشق؛ فإن الحدث الأصغر يدخل في الحدثِ الأكبرِ، والله أعلم.
w
وعلى هذا أيها الإخوة والأخوات الذين يدخلون في بركة السباحة وعليهم حدث أصغر ثم يدخلون البركة والمسبح، ثم يخرجون وقد نووا الوضوء، فلا يكفي، حتى يُرتِّب. ما معنى “يُرتِّب”؟
يعني لو فعل هكذا، وهو في الماء؛ أجزأ بأن تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم مسح رأسه، ثم بعد ذلك غسل رِجليه؛ فإن ذلك يُجزئ، ولو خرج مُرتّبا.
هذه مسألة افتراضية يذكرها الفقهاء، قالوا: لو خرج من البركة مرتبا أجزأ، كيف ذلك؟
قالوا: يُخرِجُ وجهه ثم يديه، ثم يخرج رأسه ثم يخرج رجليه؛ فإن ذلك يجزئ، وهذه مسألة افتراضية لا يمكن تطبيقها إلا بعسر وبمشقة.
ودائما يا إخوان المسائل الافتراضية، إنما هي من باب التّرويح في مسائل العلم، ويسميها أهل العلم: مُلح العلم، والله أعلم.
إذن الراجح هو أن الترتيب واجب، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
السابع: المُوالاة.
الموالاة هي ألا يُؤخِّر غسل عُضو حتى ينشِف العُضوُ الذي قبله بزمن معتدل، معنى ذلك أنه لا يسوغ له أن يبدأ بغسلِ رِجليه وقد جفّ مسحُ رأسِه، ولا يسوغ له أن يمسح رأسه وقد جفت يداه؛ لأنه يُشترطُ فيه الموالاة.
ومعنى: “بزمن معتدل”، أي أنه إذا أراد أن يتوضأ في شِدّةِ برد – في شدة هواء؛ فإذا غسل يديه أو مسح رأسه وأراد أن يغسل رجليه، فربما من شدةِ الهواء ينشِفُ، فهذا معفُوٌّ عنه؛ لأنه في زمن غير معتاد، والله أعلم.
وكذلك إذا كان الماء قليلا، بحيث يشُقُّ عليه استخراجه مثل أن يتناوله تناولا، يتوضأ عند بئر فيدخل يديه ثم يغسل وجهه، ثم يدخل يده ثم يغسل يديه، وربما جف بعضها نتيجة ذلك العمل، فذلك مما يُعفى عنه. وقد روى ابن المُنذِر أن ابن عمر عندما قل الماء خارج المسجد، دخل المسجد وغسل رجليه. فإذا كان الوقتُ يسيرا، وهو مشتغلُ بشرط الطهارة؛ فإن ذلك معفوٌّ عنه، والله أعلم.
ومن ذلك ما تفعل بعض النساء إذا غسلت يديها فإنها تمسح “المناكِير” وربما هذه الإزالة قد يجِفُّ البعضُ فإذا كان يسيرا، فلا حرج إن شاء الله.
الثامن: النية.
وقد أخّرتها لأن لها مسائل، فالنية من فروضِ الوضوء؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: «وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».
فمن توضأ ليُعلِّم الناس، فهذا لا يصلي به، أي لا يجزئه؛ لأنه لم ينوِ، نيته لم تكن من أول الوضوءِ، والله أعلم.
النية في اللغة: هي القصد والعزم، وعلى هذا فمتى أراد الإنسان أن يفعل شيئا؛ فقد نواه، ومتى عزم على فعل شيء فقد نواه، وبمجرد أن يقوم الإنسان من فراشه ناويا صلاة الظهر؛ فقد نوى الطهارة.
إذن النية ليست بحاجة إلى أن نتكلف استحضارها؛ لأنها حاصلة من حين القيام، فلهذا بعض الناس يقول: أنا لا أدري نويت الوضوء أم لم أنوِ الوضوء؟ فنسأله أنت حينما دخلت دورات المياه ماذا كنت تريد؟ فإذا قال: أريد صلاة الظهر، فنقول له: أنت من حين قيامك لذلك فقد نويت الوضوء، فهذه نية كافية، وإن كان الأفضل استحضار النية حال الوضوء، فإذا كان هذا هو الأفضل، فليس معنى ذلك أن غيره لا تجوز.
ولهذا قال العلماء: إن النية تكون مستحضرة حال الوضوء أو تكون حُكمية، وهو من حين خروجه من فراشه أو من قيامِه من فراشه إلخ.
ففي الوضوء والصلاة والعبادة، فإنه بمجرد أن الواحد يخرج من بيته يُريد الصلاة، فقد نوى، ولا يحتاج إلى قول: نويت صلاة الظهرِ، أم لم أنو؟! فهو من حين خرج للصلاة فقد نوى.
والعلماء يسمون هذه: النية الحُكمِيّةِ، وهي أن تكون مُستحضرة إلى حين ابتداء العبادة (فعلها)، فمتى وُجد ما يقطعها؛ خرجت النية؛ مثل أن يقوم يريد أن يتوضأ فيحس بالبرودة، ثم يقول لا زال هنالك وقت على موعد الصلاة، فيرجع، فهنا يكون قد قطع النية، حتى إن غسل وجهه بعد ذلك ثم أنهى كامل أعضاء الوضوء، فهذه النية لا تنفعه لأنه قطعها.
وعلى هذا فإن النية هي العزم والقصد على فعل شيء، ومحلها هو القلب.
ولا يشرع التلفظ بها:
والتلفظ بالنية على حالين: إما أن يتلفظ بها سرّا، وإما أن يتلفظ بها جهرا.
أما التلفظ بها سرا فإن من الفقهاء من قال بإستحبابه، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية.
والظاهر والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من خمسة عشرة صحابيا ذكروا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اللهم إني نويت أن أرفع حدثي”، أو “اللهم إني نويت أن أصلي بها الظهر”، أو غير ذلك من الألفاظ، ولو كان بينه وبين نفسه، فلما لم يُنقل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؛ دلّ على أنّ مثل التلفظ ليس من السنة، بل هو غير مشروع؛ لأنه لو كان مشروعا لفعله الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا بإتباع السنة أحرى، وبموافقة الحق أقرب، حيث إنهم أبعد عن التكلفِ، وأقوى تعمُّقا في العلم، فهُم على الطريق المستقيم، فبهم فلنقتد.
وعلى هذا فإنّ قول: “اللهم إني نويت ..”، ولو كان بين الإنسان وبين نفسه؛ نقول: لا يُشرع، وليس من السُّنة.
أما الجهرُ بها، بأن يجهر بحيث يُسمع الآخرين، فيقول: “اللهم إني نويت ..”، أي يُسمع الآخرين، فإنه لا يُشرع باتفاق الأئمة.
وقد ذكر أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله: أنّ الجهر بالنية لا يُشرع، ولم يفعله واحد من السلفِ، وليس من السنة، وهي بدعة إذا داوم عليها الإنسانُ، أما إذا خطرت بنفسه فنقول: هذا لا يُشرع، وقد فعل أمرا غير مشروع، وقد ذكر ابن تيمية أن ذلك بدعة.
وأما ما نُقل عن الشافعي رحمه الله كما ذكر ابن الأعرابي في معجمه من طريق محمد بن خُزيمة عن الربيع بن سليمان أن الشافعي رحمه الله كان إذا أراد أن يصلي يقول: “اللهم إني نويت” بينه وبين نفسه، فهذا قول اختاره الشافعي رحمه الله، وقد أنكر ابن تيمية أن يُنقل عن الشافعي مثلُ ذلك، وقد خفِي عليه، فقد روى ذلك ابنُ الأعرابيِّ من طريق محمد بن خُزيمة عن الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله، ولكن هذا اجتهاد من عنده رضي الله.
والعالم يجتهد بما يُوافق السنة، وأحيانا بما يخالف السنة، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: “إذا صح الحديثُ؛ فهو مذهبي”، وقال مالك: “كُلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر”، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الذي ثبت إنما هو بالإسرار، وأما الجهر فلم يُنقل عن واحد من السلف أنه جهر بها، وعلى هذا فالإسرار غير مشروع والجهر غير مشروع وهو آكدُ في معنى غير المشروعِية من الإسرار، بل قال أبو العباس ابن تيمية: إنّ ذلك بدعة.
وأقول: وهذا في غالب العبادات، وأما في الحجِّ؛ فإن قول: “اللهم إني نويت”؛ لا حرج فيه، كما نص على ذلك الإمام أحمد، أن ذلك مباح في الحج، وأما غير الحج فلا.
وقولنا في الحج؟ لأنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، ومن ذلك ما رواه الشافعيُّ في مسنده من طريق عُروة بن الزبير أنّ عائشة أم المؤمنين قالت له: “هل اشترطت في حجك؟ قال: يا أم المؤمنين، وماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردتُ، ولك عمدتُ، فإن كان الحج فاللهم، وإلا فمحلي حيث حبستني”، وهذا الحديث إسناده صحيح، يرويه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقاعدة أبي العباس ابن تيمية والعلماء: أن كلّ فعل فعله الصحابةُ في عهد الخلفاء الراشدين فليس ببدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»، ولو كان بدعة؛ لأُنكر على عائشة، ولما لم يُنكر؛ دل ذلك على جوازه، ولا نقول بإستحبابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فدل ذلك على جوازه، وأما غير ذلك من العبادات فلا يشرع، والله أعلم.
والنية هي من الواجبات وهي من الشروط أيضا، إلا أن الشرط آكدُ من الواجبِ.
الفرقُ بين الشرط والواجب:
الجواب: أن الشرط خارج الماهية، وأما الواجب فهو داخل في الماهية، ومعنى الماهية: يعني أصل العبادة. فإذا تحدثنا عن الوضوء، فإننا نقول: الوضوء له واجبات، غسل الوجه المضمضة الاستنشاق غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس، هذه عبادات موجودة في ذات الوضوء.
أما النية فإن الأصل فيها أنها توجد خارج الوضوء، وإن كانت باقية إلى انتهاء الوضوء، جعلها بعض العلماء من واجبات الوضوء، ولما كانت لا بد من وجودها أو يجوز أن توجد قبل الوضوء، جعلها بعض العلماء من الشروط، هذا فرق.
الفرق الثاني: أن الشرط ثبت وجوبُه وثبت عدم صحة العبادة إلا به، وأما الواجبُ فقد ثبت وجوبه ولم يدل دليل على فساد العبادة عند عدمه، وعلى هذا فالشرط مثاله: الطهارة، ثبت وجوبها، ﴿إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، وثبت أيضا أنّ العبادة لا تصح إلا بالطهارة، «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ومن صحيح مسلم من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة من غير طُهور، ولا صدقة من غُلُول»، فدل ذلك على أن الشرط يختلف عن الواجبِ من وجهين.
إذا ثبت هذا فإن الشرط عند العلماء يقولون: هو ما يلزمُ من عدمِهِ العدمُ، ولا يلزم من وجوده وُجُودٌ ولا عدمُ لذاته.
ولعلنا نشرح معنى هذا التعريف، يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إذن عندنا ثلاث جمل. لعلنا نشرح كل جملة، يقولون:
ما يلزم من عدمه العدم: إذن عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة. وعدم دخولِ الوقت يلزم منه عدم صحة الصلاة المفروضة.
وعلى هذا فإذا صلى ظانا دخول الوقت قبل الظهر، هل تصحُّ عبادته؟ لا تصحُّ بالإجماع، فالمأسُور مثلا، لو ظن أن صلاة الظهر قد حضرت، فصلى؟ نُلزمه بالإعادةِ، لعدم صحة الصلاة، ولأنه مأمور أن يُصليها بالوقت، فإذا لم يُصلها، نقول: أنت معذور بجهلك، ويجب عليك أن تقضيها.
أما: ولا يلزم من وُجوده وجودٌ، فإذا وُجدت الطهارة، هل يلزم وجود الصلاة؟ لا، فجائز أن أتوضأ ولكن لا يلزم أن أصلي بها، وجائز أن يدخل الوقت ولا أصلي بدخوله، فربما أصلي في الوقت الثاني لأجل الجمع، أو لأجل أن الواحد لا يلزم يكون معذورا كالمرأة الحائض فيكون وُجد سبب عدمه، فنقول: لا يلزم وجوده وجود.
أما: ولا عدم لذاته، هذه العبارة لا بد من توضيحها، الآن توجد الطهارة، ولا توجد الصلاة، شخص توضأ ولم يصل، لكن عدم صلاته ليس لوجود الطهارة، يقولون: ولا يلزم من وجوده عدم، لا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة، فعدم الصلاة لم يكن لأجل وجود الطهارة، ولكن لأجل مانع آخر، وهو عدم دخول الوقت، فمنعُ عدم الصلاة ليس لأجل ذات الشرط، إنما هو لأجل مانع آخر، فهذا معنى “لا يلزم من عدمه ولا عدم لذاته”.
إذن نعيد: ما معنى “ولا يلزم من وجوده عدم لذاته”؟ هو أنه قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة، ولكن عدم وجود الصلاة ليس لأجل وجود ذاتِ الشرط وهو الطهارة، بل لأجل مانع آخر وهو عدم دخول الوقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
ولا يصح غُسلٌ ولا طهارة إلا بالنية:
فلو أن شخصا دخل البِركة، فلما انتهى من السباحة، قال: أنا نويت رفع الحدث، هل يجزئه؟ لا يجزئه ذلك، لماذا؟ لأنه لم ينو ذلك، ولو كان حدثا أكبر؛ لأن الحدث الأكبر يجزئ منه تعميم سائر البدن مع المضمضة والاستنشاق، أما الحدث الأصغر فعلى القول الراجح لا بد من وجود الترتيب، هل يجزئه؟ لا يجزئه إلا أن يخرج مرتبا، أو أنه يُمِرّ يديه على أعضاء الوضوء ولو كان في البِركة، فيتمضمض ثم يغسل وجهه وهو داخل الماء إن شاء أو إن خرج، ثم يغسل يديه لأجل أنه لا بد فيه من الترتيب وهو مذهب الحنابلة والشافعية؛ خلافا لأبي حنيفة ومالك، كما هو الراجح من مذهب أهل العلم، والله أعلم.
والنية إنما شرعت لثلاثة أمور:
أولا: للتمييز بين العبادات بعضها ببعض. فأنا حينما أصلي للظهر، فإنني ميزت صلاة الظهر عن صلاة العصر بالنية، وكذلك عند جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل مطر أو سفر، فلا يستطيع أن يُميِّز بينهما إلا بالنية.
فهذا يدل على أن النية إنما شُرعت لأجل التمييز بين العبادات. أو للتمييز بين الواجبات والمستحبات، مثاله: غُسلُ الجنابة وغُسلُ الجمعة، فغسل الجمعة الراجح أنه سُنة كما سيأتي بيانه، وهذا مذهب عامة أهل العلم، كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر، وغيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم.
وإذا كانت على الواحد جنابة وقام إلى صلاة الفجر يوم الجمعة، وأراد أن يغتسل للحدث الأكبر، وأراد أن يجعل غُسله هذا ينفع لصلاة الجمعة، فإن هذا يجزئه إذا نواهما معا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لأن الشافعي وأحمد يقولون: يُجزِئُ غُسل الجمعة من طلوع فجر يوم الجمعة، وأما مالك بن أنس وكذلك يروى عن أبي حنيفة: أن ذلك يبدأ من طلوع الشمس، وقال مالك: إنما هو لأجل الرّواح، متى يريد أن يذهب يغتسل، وأما إن اغتسل من الفجر فإن ذلك لا ينفعه.
والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أن الغسل يوم الجمعة يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة؛ لأنه يُجزئ أن ينطلق ويذهب إلى مسجد من دخول وقتِ يوم الجمعة، ودخول وقت يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، والله أعلم.
ودخول وقت الجمعة غير دخول وقت الصلاة؛ فدخول وقت الصلاة الراجح أنه يبدأ من بعد زوال الشمس، كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، كما سيأتي بيانه.
ومن فوائد النية أيضا: أنها للتمييز بين العبادات والعادات، إذن تمييز بين العبادات، الفروض بعضها من بعض، وتمييز بين المستحبات بعضها من بعض، وتمييز بين الواجبات بعضها من بعض، هذا القسم الأول.
الثاني التمييز بين الواجبات والمستحبات، هذا القسم الثاني.
القسم الثالث للتمييز بين العبادات والعادات.
فلو أن إنسانا يريد أن يتوضأ ليُعلِّم الآخرين، إذن وضوؤه لأجل التعليم فهل يرفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه؛ لأنه لم ينو، فأما إن قال: أنا أريد أن أرفع حدثي وأُعلِّمُ الآخرين، فهل يرفع حدثه؟ نعم يرفع حدثه؛ لأنه نوى رفع الحدث، والله أعلم.
وعلى هذا فإذا كان مُحدِثا فلا بد أن ينوي رفع الحدث، والحدث هو وصفٌ قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، إذن هو يريد أن يرفع هذا الوصف القائم في البدن، فإذا وُجد الحدث الأصغر، فلابد أن ينوي رفع هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها.
لو أنه نوى الطهارة لما لا يباح فعله من عبادة إلا بالطهارة، مثل أن يريد أن يقرأ القرآن، أي ليمس المصحف – فإن الراجح وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا وهو طاهر – فلو أنه توضأ لأجل أنه يريد أن يمس المصحف وهو ما يصح إلا بطهارة، فهو نوى لما لا يصح فعله إلا بالطهارة، فجاز له أن يصلي بهذا الوضوء كل الصلوات.
فلو قال: أنا توضأت لأجل قراءة القرآن، ثم دخل وقت الظهر فهل يجوز أن أصلي الظهر؟
نقول: نعم، وإن لم تنو صلاة الظهر، لأنك نويت رفع حدث لا تصح العبادة إلا برفعه، وهذا يكفي، والله أعلم.
وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقد حُكي فيه إجماع، والله أعلم.
لكن لو قصد بالنية التنظف فقط أو تعليم غيره الوضوء فقط، فلا يجزئ.
إذا ثبت هذا فإنه لو نوى الطهارة لفعل عبادة مستحبة، فهل ترفع حدثه فيمكنه فعل عبادة واجبة؟ الجواب: نعم ترفعه، مثلما قلنا في مسِّ القرآن، فإن قراءة القرآن ومس المصحف مستحبة، فلو أنه أراد أن يُصلي بهذه الطهارة جاز ذلك.
ولو نوى رفع حدث لصلاةِ بعينِها، مثل أن يقول: أنا نويت رفع الحدث لصلاة الظهرِ وحدها، وبقي طاهرا إلى صلاة العصر؟ فهل يجزئه؟
نعم يجزئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الفجر ولم يُحدث حتى صلى بها الظهر، فقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث بُريدة: لقد صنعت يا رسول الله شيئا لم تكن تصنعه قبل ذلك، فقال: «عمدا صنعته يا عمر». فدل ذلك على أن من نوى رفع حدث لعبادة معينة فرضِيّة كانت أو سنة، فإنه يجوز له أن يصلي بها ما شاء من العبادات ولو كان لم ينوها؛ لأن رفع الحدث رفع لوصفٌ قائم بالبدنِ يمنع من الصلاةِ ونحوها، فإذا نوى فإن هذا الوصف يزول من سائرِ البدن، والله أعلم.
لو نوى تجديد وُضُوء، كشخص طاهر لم يُحدث، وقال: أريد أن أتوضأ، أي تجديد وضوء، والمستحب هو الوضوء لكل صلاة، وأريد أن أتوضأ للتجديد، فهل يُجزئ أن أصلي بها فرضا؟ فهو لم ينو رفع الحدث.
يجزئ: لأنه حينما يُصلي فإنما يُصلي بنية الوضوءِ الأول، والوضوء الثاني تأكيد له.
ولأنه وإن لم ينوِ رفع الحدث الذي هو قائم بالبدن، ولكنه نوى بهذه الطهارة فعل عبادة لا تصحُّ إلا بطهارة، فهو نوع من رفع الحدث، فأنا وأنا طاهر أريد أُن أصلي ركعتين، فأحببت أن أتوضأ وضوءا يُرفعُ به الحدثُ لأجل فعل العبادةِ، فنقول: هذا يكفي، فأنت إنما توضأت لأجل فعل عبادة لا تصحُّ إلا بطهارة، وقد فعلت، والله أعلم.
وماذا عن المُستحاضة التي حدثُها دائم، ومن به سلسُ البول الذي حدثه دائم، لو أنه نوى رفع الحدث؟ مع العلم أنه لو نوى تجده يخرج منه شيء (الدم في حالة المستحاضة، أو البول في حالة صاحب سلس البول)، أو من به بواسير. فهل هذا إذا نوى رفعُ الحدث ينفعه أم لا؟
قال بعض الفقهاء – كالحنابلة وبعض الشافعية وغيرهم –: ان من حدثه دائم لو نوى رفع الحدث لا يُجزئه، لأن الحدث لا يرتفع، لكن ينوي به استباحة الصلاةِ، وفرقٌ بين استباحة الصلاة ورفع الحدثِ، فهو لو نوى رفع حدثُه لا يرتفع لأنه قائم، هذا قول.
والراجح أنه لا بأس بذلك، والشارع لم يُفرِّق، ومثل هذا الأمر لو كان من الواجب؛ لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فلما لم يبينه؛ دل على أن الأصل الجواز، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
فمن حدثه دائم سواء نوى رفع الحدث أو نوى استباحة العبادة، كل ذلك جائز؛ خلافا لما يُنقلُ عن الحنابلة والشافعية.
والراجح والله أعلم، أنه يصح ولو نوى رفع الحدث؛ لأن هذا هو معنى إرادة الوضوء، فهو إنما أراد أن يتوضأ؛ لأجل فعل العبادة، وسواء نوى رفع الحدث أو استباحة العبادة؛ فإن هذا مبني على أن ثمة فرقا بين إباحة العبادة ورفع الحدث، كما يقول الحنابلة والشافعية في التيمم، فإنهم يقولون: إن التيمم مُبيحٌ وليس برافع، وهذا لو تيمم بنية رفع الحدث لم يُجزئه؛ لأنه إنما يتيمم لاستباحة فعل العبادة، والصحيح جواز أن يتيمم لرفع الحدث أو أن يتيمم لإستباحةِ العبادة كل ذلك جائز، كما هو ظاهر اختيار أبي العباس ابن تيمية في مسألة التيمم، والله أعلم.
حكم الزيادة على الفرض في غسل أعضاء الوضوء:
لو أن الواحد أراد أن يغسل يديه، ما حُكم الزيادة على ذلك؟
الجواب: استحبّ الحنابلة على أن يزيد وكذلك بعض الفقهاءِ، أن يزيد الإنسانُ على الفرضِ.
واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة كان إذا توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضُدِ، وإذا غسل يده اليسرى غسل يده حتى أشرع في العضدِ، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، فقال له أبو حازم: ما هذا الوضوءُ يا أبا هريرة؟ فقال: أنتم هاهنا يا بني فرُّوخ؟! لو علمتم أنكم هاهنا؛ ما توضأت هذا الوضوء! سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحِليةُ من المؤمنِ حيث يبلغ الوضوءُ». فقالوا إن أبا هريرة أطال، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني: لا يُستحب الزيادة، إلا زيادة يُعلمُ بها غسل العضو الفرض كاملا.
قالوا: لا يُستحب إلا زيادة يُتيقّنُ بها غسلُ كامل العضوِ، مثل أن يغسل المرفقين، فيزيد حتى يتيقن أنه غسل كامل المرفقين.
قالوا: هذا هو الأصل؛ ذلك أنّ كلّ من وصف وُضوءِ النبي صلى الله عليه وسلم لم يُشر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في وضوئه، ولا زاد على جميع الأعضاء، فإن الذين ذكروا غسل يديه إلى المرفقين لم يذكروا أنه أطال حتى أشرع في العضد، والذين ذكروا صفة غُسل رجليه لم يذكروا، فدل ذلك على أنه لا يستحب.
واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذا الوُضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم»، وهذا الحديث ضعيف بزيادة “أو نقص”، وكذلك هو بنفسه ضعيف، حتى لو لم يُذكر زيادة “نقص”، أشار الإمام مسلم رحمه الله في كتاب “التمييز” إلى أنه ضعيف، وكذلك ضعفه أبو داود، وغيرُ واحد من أهل العلم.
والراجحُ أنه إذا كان ثمة سنة؛ لفعلهُ النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فلما لم يذكره ولم يفعله صلى الله عليه وسلم دلّ على أنّ هذا الوضوء هو الذي يُغفر به الذنوبُ وتُحطُّ به السيئات، ولهذا توضأ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حِمران عن عثمان رضي الله عنه، ثم قال: «فمن توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتينِ؛ لا يحدث بهما نفسه؛ إلا غفر الله ما تقدّم من ذنبه»، فدلّ ذلك على أن السُّنة هي عدمُ الزيادةِ، فإن زاد فجائز، ولكن السنة تركُه.
هل يُستحب غسل العنق؟
بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه يمسح عنقه، هل هذا من السنة؟
الجواب: لا يصحُّ حديثٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه مسح العنق، ولأجلِ هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يُستحب غسل العنق، بل ذكر النوويُّ أن غسل العنق في الوضوء بدعة. ولا شكّ أن إطلاق البدعة عليه محل نظر، إلا إذا فعله الواحد على أنه سُنة يُتعبّدُ بها ويُؤجر عليها؛ فيكون نوعا من الزيادةِ في الشرع، وهي البدعة التي قال صلى الله عليه وسلم: «وكل بدعة ضلالةٌ»، أما إذا فعلها هكذا، فإننا نقول: هذا ليس من السنة، وهو مكروه، والله أعلم.
6. شروط الوضوء
شروط الوضوء:
شروط الوضوء – ماذا عن دخول البحرِ أو النهر للإغتسال من جنابة؟
سبق أن ذكرنا فروض الوضوء، والآن نتحدث عن شروط الوضوء، شروط الوضوء سبق منها شرط واحد وهو:
الشرط الأول: النية
وقد عرفنا فيه الفرق بين الشرط والواجب. وقلنا إن الشرط ما كان خارج ماهية العبادة، أما الواجب فداخل في ماهية العبادة.
الشرط الثاني: الإسلام
فلا يصح للكافر أن يتوضأ؛ لأنه لا تصح منه عبادة، والنية لا بدّ فيها من إرادة وجه الله قبل كل شيء، قال الله تعالى: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾ [الفرقان: 23]؛ وليس له نية عبادة يقصد بها هذا الواجب. إذن لا بد من الإسلام.
الشرط الثالث: العقل.
فلا يصح وضوء المجنون؛ لأنه بلا عقل، وهو غير مُكلّف أصلا، والعبادة تنفع في حقِّ المكلف فقط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفِيق ».
الشرط الرابع: التمييز.
فمن شروط العبادة: التّميِيز. ومعنى التمييز أن يكون الإنسان مُميِّزا في عِبادته، بحيث يعرف الخطاب ويرد الجواب، وقد حدّده بعض العلماء بسبع سنين، والذي يظهر أن سبع سنين هو حدٌّ غالِب، وإلا فإنه يُجزِئ لمن كان عمره ست سنوات لأنه يفهم، فلو قيل له: توضأ لرفع حدثك؛ فإنه يفهم ذلك، والله أعلم.
أو حتى خمس سنوات ونصف، أي متى ما فهم الخطاب وردّ الجواب، فإنه يكون حينئذ مميزا، وإن كان لا يدرك ما يدركه البالغ، فإننا نعلم أن البالغ يدرك من المسائل ما لا يدركه الصبي المميز، فكذلك العالم يُدرك من المسائل ما لا يُدركه العاقل الذي ليس عنده علم.
فعلى هذا، نقول للمدرسين إذا أرادوا لأبناء أن يقرؤوا القرآن، أن يأمروهم بالطهارة، ويعلموهم ذلك؛ لأن التمييز من شُروط الوضوء.
الشرط الخامس: طهورية الماء.
فلو توضأ إنسان بماء نجس فلا يرفع حدثه.
لا يرفع حدثه إلا الطاهر الذي هو في صفته ماء، أما غير الماء فلا يصح به ذلك؛ فالمرق طاهر، وكذلك العصير لكن لا يُجزئ، لأنه ليس بماء. فالأصلُ هو وجود وصف “ماء” فيه، ولو وقع فيه بعض المباحات من الأشياء الطاهرة؛ فإن ذلك لا يُغيره ما دام اسم الماء فيه، والله أعلم.
إذن الماء النجس لا يرفع الحدث. الذي يرفعه هو الماء الطاهر.
الشرط السادس: إزالة ما يمنع وصول الماءِ إلى العضو.
يجب إزالة ما يمنع وصول الماءِ إلى العضو، فلو كان في بدنه عجِينٌ أو دم قد يبُس أو بعض الصمغ الذي يمنعُ وصول الماء، فيجب إزالته حتى يصيب الماءُ سائر الأعضاء.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد الذي رواه بُحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظُفر لم يصبه الماء فقال: «ارجع، فأعد وضوءك». قال الإمام أحمد: إسناده جيد. وليس الذي في صحيح مسلم، فالذي في صحيح مسلم هو من حديث جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك موضع قدر الدرهم لم يُصِبه الماء، فقال: «ارجع، فأحسن وضوءك». فإحسانُ الوضوء لا يلزم منه الإعادة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أما حديث «ارجع، فأعد وضوءك»؛ فدل على أن الإحسان المقصود به إعادة الوضوء، والله أعلم.
ومن ذلك أيضا وجوبُ إزالة “المناكِير”، فهذه الصِّبغ التي تضعها النساء في أظفارهن يجب إزالتها، لأن المرأة مأمورة أن تغسل سائر يدِها بما في ذلك الأظفار، فالأظفار لها حُكم الأصابع، وعلى هذا فلا بد من إزالة ذلك عنها، ولو بقي وصلت، فإننا نقول: لا يجزئ.
لكن إذا كان شيئا يسِيرا يشقُّ التحرُّز منه مثل ما يقع لبعض أصحاب الحِرفِ في المزارع والمخابز وغيرها عندما يعملون بأيديهم؛ فإن طبقة من الترابِ أو العجيب أو غيره قد تتراكم تحت الأظفارِ، وهذا يمنع وصول الماء، فتشق إزالتها تماما.
فهذا مما يُعفى عنه كما ذكر الحنفية ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، كذلك بالنسبة للمرأة إذا أزالت المرأة المناكير (الصِّبغ) وبقي شيءٌ يسير تحت الأظفار أو في جوانب الأظفار وشقّ التحرُّز منه، فإننا نقول: ذلك يُعفى عنه، والله أعلم.
ونقول للمرأة: حُكِّيه ما استطعت، فإن عجزت عن إزالته تماما، فيكون حينئذ مع عدم القدرة، فصار حكمه حكم الجبِيرة، أما مع القُدرة فلا بد فيه من الإزالة، ولا ينبغي التهاوُن في ذلك، فإن ذلك في الإثم، نسأل الله العافية والسلامة.
من عندها حدث أكبر، ثم اغتسلت فلما اغتسلت وجدت “المناكير” فأزالته، فهل يلزمها أن تعيد الغسل مرة ثانية؟
الجواب: الراجح أنه لا يلزمها ذلك، هذا هو قول عامة أهل العلم، بل قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كان في نقل الإجماع نظر كما ذكر ابن رشد في “بداية المجتهد”، لأن الموالاة في غسل الجنابة لا تُشترط، فالمرأة التي اغتسلت ولم يبق إلا شيء على أظافرها فلها أن تزيله بغسل أظفارها فلا بأس بذلك.
وقد روى ابن المُنذِر أن رجلا قال لابن عباس: “إني اغتسلت ولم أتمضمض، قال: تمضمضِ الآن”، فدلّ على أنه لا بأس أن يغسل رأسه في الليل مثلا، ثم في الفجر يُعمم سائرِ بدنه، فلا حرج في ذلك، والله أعلم .
الشرط السابع: إباحةُ ماء.
فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء بمغصوب؛ لأن المغصوب منهي عنه؛ لأنه حقٌّ لإنسان آخر. لكن هل يرفع حدثه؟
الراجح أعلم أنه يرتفع حدثه، وهو مذهب جمهورِ أهل العلم خلافا للحنابلةِ، فإن الحنابلة قالوا: لا يرتفع حدثُه؛ والراجح أن العبادة هنا ليست مُتعلقة بالماء، إنما هي متعلقة بحكم آخر، والله أعلم.
لأن النهي ليس عائدا على ذاتِ العبادة، والقاعدة في هذا أن النهي إذا لم يعُد على ماهية العبادة ولا على وصفِها الذي لا ينفكُّ عنه (ومعنى وصفُها الذي لا ينفكُّ عنه: هو الشروط التي لا تنفك عن وجودها الوجودُ الشرعي)، فإذا لم يقع النهي على ماهية العبادةِ، ولا على وصفها الذي لا ينفكُّ عنه؛ فإن الأصل أن العبادة صحيحة مع الإثم، وهذا هو مذهب الشافعية والحنيفية ورواية عند الإمام أحمد، وذهب إلى ذلك كثير من المحققين.
الشرط الثامن: انقِطاعُ مُوجِب.
الموجب هو ما يُوجب الوضوء. فالذي يُوجب الوضوء هو الحدث، فلا بدّ أن ينقطع – إلا من به حدث دائم، أي توقف الحدث.
وهل من الشروط استجمارٌ قبل وضوء؟
في المسألة خلاف سوف نذكره إن شاء الله، وإن كان القول بأنه يصح مع وجوب أن يُزيله بما لا يزيد من خروج الحدث، فإن ذلك إن شاء الله يُجزئ على الراجح، والله أعلم.
فلو أن إنسانا قضى حاجته ولم يستجمر أو يستنجِ ثم توضأ ثم استنجى، فنقول: ما دام في الوقت فلا بدّ أن يُعيد الوضوء خروجا من خلافِ أهل العلم، وأما إذا صلى ونسي، ثم غسل ذلك بالماء، فإن ذلك يُجزئه إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه لم يخرج منه شيء من حين شُروعه في الوضوء، وإن كان الأولى ألا يصنع ذلك؛ لأن مثل هذه المسائل مسائل لا ينبغي الاجتهاد فيها خاصة أنها طهارة، فلربما صلى الواحد على غير طهارة، والله أعلم.
الشرط التاسع: دخولُ وقت على من حدثه دائمٌ.
فإننا نعلم أن جمهور أهل العلم من الحنيفية والشافعية والحنابلة خلافا لمالك قالوا: من حدثه دائم يتوضأُ لكل صلاة، أو يتوضأ لدخولِ وقت كل صلاة. فقال بعضهم: لا بد لمن حدثه دائم أن يدخل وقت صلاة الظهر ليتوضأ، أو يدخل وقت صلاة العصر ليتوضأ، وهذا مذهب الجمهور.
والراجح والله أعلم أنه له أن يتوضأ لدخول الوقت، وله أن يتوضأ قبل دخول الوقت لإرادةِ عبادة فرضية (عبادة مفروضة)، فلو أننا قلنا: لا يصح إلا بدخول الوقت، فشقّ ذلك على من حدثُه دائم في صلاة الجمعة، فإنه أحيانا يأتي إلى الجمعة بين الثامنة والحادية عشرة مثلا، فإذا قلنا: يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت، وقلنا: إن الراجح هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد زوال الشمس، فسوف يضطر إذا دخل الإمام أن يذهب للوضوء، ولكنّ الراجح أنه متى ما توضأ لإرادة صلاة الجمعة فإن ذلك يُجزئ، والله أعلم.
وعلى هذا فهذا شرط، وهو قولهم بوجوب الوضوء لدخول وقت كل صلاة، والراجح أنّ له أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وله أيضا أن يتوضأ لإرادة فعل عبادة فرضِيّة ولو لم يدخل الوقت كمن يتوضأ قبل الظهر لإرادة صلاة الظهر، والله أعلم.
ماذا عن دخول البحرِ أو النهر للإغتسال من جنابة؟
لا حرج في حال كان حدثه أكبر؛ لا بأس بذلك لأننا نقول: إن الراجح أن الحدث الأكبر لا يُشترط فيه الترتيب؛ لما جاء في قول الله عز وجل: ﴿وإن كنتم جُنبا فاطهروا﴾، والطهارة تقتضي جواز التعميم، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، أن رجلا أجنب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذ هذا، فأفرِغهُ عليك» ولم يأمره بترتيب، فدل ذلك على أن من حدثه دائم يجوز له أن يُفرِغ الماء على سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأت فمضمِض»، فإذا أوجب الشارع المضمضة في الوضوء فالغسل من باب أولى كما ذكر ابن رجب في كتابه “فتح الباري” والله أعلم.
7. مستحبات الوضوء
ما يستحب في الوضوء:
مستحبات الوضوء – الإعانة في الوضوء؟ – استعمال المِنشفة؟
مستحبات الوضوء:
أولا: استحضار التقرب إلى الله بإزالة الأوساخ.
فمن المهم وهو من آداب الوضوء، أن يستحضر العبد أنّه حين وضوئه إنّما يُريد به إزالة الأوساخ المعنويّة من المعاصي التي رأتها عيناهُ، والمعاصي التي بطشتها يداه، والمعاصي التي مشت إليها رجلاه.
فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا توضّأ العبدُ المُسلِمُ فغسل وجهه خرج مِن وجهِه كلُّ خطِيئة نظرتها عيناهُ مع الماءِ، أو مع آخِر قطرِ الماءِ، وإِذا غسل يديهِ خرج كلُّ خطِيئة بطشتها يداهُ مع الماءِ، أو مع آخِر قطرِ الماءِ …» (الحديث). وهذا يدلُّ على أنّ المسلم إذا أراد أن يتوضّأ يستحضر ذلك، أنّه يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
وقد ذكر غيرُ واحد من أهل العلم كابن القيم رحمه الله أنّه يُستحبُّ الوضوءُ بسبب المعصية، وقد جاء في ذلك ما يدلُّ عليه، ومن ذلك ما رواه الإمامُ أحمد من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه قال: “كان إذا حدّثني أحدٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم استحلفتُه، فإن حلف لي وإلاّ، وقد حدّثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، فقال: إِذا أذنب أحدُكُم ذنبا ثُمّ ذهب فتوضّأ فأحسن الوُضُوء، ثمّ صلّى ركعتينِ؛ غفر اللهُ لهُ ذلِك”.
إذن عندما يشرع في الوضوء يستشعر هذا الأمر، فإنّه يُؤجر على ذلك. وهو بذلك يستحضر انكساره وافتقاره إلى ربِّه، وفي الصّحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنّه توضّأ ثلاثا ثلاثا”. يعني غسل وجهه ثلاثا، وتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، ثم قال: “من توضّأ نحو وُضُوئِي هذا، ثمّ صلّى ركعتين مُقبِلٌ على الله تعالى بوجهه، لا يُحدِّث فيهما نفسه؛ إلا غفر اللهُ له ذنبه”.
ويتضمن أمرين: وجودُ حُسن وضوء، ووجود حُسن صلاة. فمن منّا لم يقع في الذّنب؟! من منّا لم يقع في المعصية؟! فيجب الإستعانة بذلك عليها.
ثانيا: الدعاء بعد الوضوء.
يُستحبُّ للمسلم إذا أتمّ وضوءه أن يقول ما ورد من الأذكار. والذي ورد بعد الوضوء دُعاءان صحيحان، وما عدا ذلك فهو حديثٌ ضعيفٌ.
أمّا الدُّعاء الأول: فما رواه مسلمٌ في صحيحه، من حديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه قال: “ما أحسن هذا! قال عمر: التي قبلها أجود، سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مِن مُسلم يتوضّأ فيُحسِنُ وُضوءه، ثمّ يقولُ: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شرِيك لهُ وأشهدُ أنّ مُحمّدا عبدُهُ ورسُولُهُ؛ إِلا فُتِحت لهُ أبوابُ الجنّة الثّمانِيةِ يدخُلُها من حيثُ شاء” (رواه مسلمٌ).
أي يقول: “أشهدُ أن لا إِله إلا اللهُ وأشهدُ أنّ مُحمّدا رسولُ الله»، أو يقول: «أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شرِيك لهُ وأشهدُ أنّ مُحمّدا عبدُهُ ورسُولُهُ». كُلُّ ذلك ورد.
والحديث الثاني ما رواه أهلُ السُّنن وأحمدُ من حديث أبي سعيد الخُدرِي موقوفا عليه، أنّه كان إذا توضّأ قال: “سُبحانك اللّهُمّ وبحمدِك، نشهدُ أن لا إِله إلا أنت، نستغفِرُك ونتوبُ إليك”.
وهذا يُقال عند الوضوء، وهو حديثٌ صحيحٌ موقوفٌ على أبي سعيد، وأبو سعيد لا يأخذ من بني إسرائيل، فيكونُ له حكم الرفع، والقاعدة…
وأمّا الحديث الذي رواه التِّرمِذِيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضّأ فقال: اللّهُمّ اجعلنِي من التّوّابِين، واجعلنِي من المُتطهِّرِين». أو: «أشهدُ أن لا إِله إلا اللهُ وحدهُ لا شرِيك لهُ، وأشهدُ أنّ مُحمّدا عبدُه ورسُولُه، اللّهمّ اجعلنِي من التّوّابِين، واجعلنِي من المُتطهِّرين»، فهذه الزِّيادةُ مُنكرةٌ، أنكرها الإمامُ البخاري، وضعّفها الإمام التِّرمِذِيّ؛ وهي روايةٌ ضعيفةٌ.
وحسبك بالإمام البخاري أنّه قال: “لا يصحُّ في الباب، أو كل الأحاديث ضعيفة”. وكذلك التِّرمِذِيّ رحمة الله تعالى على الجميع.
فإذا قالها الواحد أحيانا ليس على أنّها سنة، ولكن لأنها تفتح أبواب الجنة الثمانية؛ فلا حرج، ولكن السنة عدم قولها، فوجود الأحاديث الصحيحة كافية بإذن الله، والله أعلم.
وعلى هذا فإنّ ما يفعله بعضُ العامّة مع استقبال القبلة ورفع أُصبُعه: “أشهد أن لا إله إلا الله”، ليس له أصلٌ، لكن من العادة أنّ الإنسان إذا تشهد ورفع أُصبُعه فلا حرج، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في استقبال القبلة أو عدم استقبالها.
أمّا إذا قال: «أشهد أن لا إِله إلا اللهُ» ورفع الأُصبُع، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم حثّ عليها في قوله: «أحِّد أحِّد، فو اللهِ إنّها لأشدُّ على إِبلِيس مِن جبلِ أُحُد». وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقّاص يرفع أُصبُعا يُمنى وأُصبُعا يُسرى، فقال له: «أحِّد » يعني بأُصبع واحدة، «فو اللهِ إنّها لأشدُّ على إِبلِيس من جبلِ أُحُد». والله أعلم.
الإعانة في الوضوء؟
فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنّه صبّ له بعضُ أصحابه الماء، كما جاء في الصحيحين من حديث المُغِيرةُ بن شُعبة، وجاء أنّه يتوضّأ من الإِداوة عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: “فأحمِل أنا وغلامٌ نحوي إِداوة من ماء وعنزة، فيتوضّأ بالماء”. وهذا الحديث متّفقٌ عليه.
وهذا يُفيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضّأ بنفسه، وأحيانا يصُبُّ له بعضُ أصحابه الماء، أمّا المُداومة على أن يخدمه الآخرون فليس من المشروعية إذا كان الواحد يظُنُّ أنّه مشروعا، وليس من الخُلق أن يترك الآخرين يخدمونه دائما، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “ما أُحِبُّ أن يُعِيننِي على وُضُوئِي أحدٌ”.
لكن لو صبّ له الماء أحدٌ فلا حرج، أمّا أن يقوم أحدٌ بإمرار الماء على يديه ويمسح مرافقه، فإن كان لحاجة مثل المريض، ونوى المريض رفع الحدث، وصب له ابنه أو قريبُه الماء وأمرّ الماء على أعضائه وفَرَكها، فهذا: يرفع حدثه إن شاء الله، وأمّا لو صنع به ذلك وهو مُغمى عليه، أو وهو نائِمٌ؛ فإن ذلك لا ينفع، والله أعلم.
استعمال المِنشفة؟
نقول: لا يصحُّ حديثٌ في الباب، أنّ النبي أمر بالمِنشفة أو نهى عنها، أو أمر بالمِندِيل أو نهى عنه، وأصحُّ شيء في الباب هو ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة قالت: “فأتيتُه بالمِندِيل فردّه، فجعل ينفضُ الماء بيده”.
ونقول: لا بأس باستعمال المِنشفة في الوضوء، وقد قال ابنُ عباس بسند لا بأس به: “كانوا لا يرون بالمِندِيل بأسا”، يقصد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وعلى هذا فالأصل أنّ للإنسان أن يُنشِّف أعضاءه بالمِندِيل أو بالخِرقة ونحوِها، وله أن يترُك ذلك.
وأمّا ما جاء في حديث ميمونة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ردّ المنديل وجعل ينفض الماء بيده، فنقول: الجواب على ذلك أنّها قضيّةُ عين، وقضايا الأعيان لا يُقاس عليها، فلربما ترك صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنّه يُحبُّ أن يبقى الماءُ عليه لأجل التّبرُّد، بدليل أنّه جعل ينفض الماء بيده، فلو كان المقصودُ عدم إزالة آثار العبادة، فنقول: فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد نفض ذلك، فهذا يدلُّ على أنّ ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، فتنشيف الأعضاء أو تركها، كلُّ ذلك جائزٌ، وليس من التّعبُّد في شيء، والله أعلم.
8. المسح على الخُفّين
المسح على الخفين:
تعريف المسح على الخفين – هل الأفضل أن يمسح على خفيه أم يغسل رجليه؟ – ما هو الخف؟ – هل المسح على الخفين مُؤقّت بمُدّة؟ – لو أن الواحد سافر سفر معصِيّة فهل له أن يمسح؟ – هل يخلع عند انتهاء المدة؟ – متى تبدأ مدة المسح؟ – هل صحيح أن خلع الجورب كحلق الرأس؟ – باب المسح على الخفين ليس فيه أحاديث في مسائل كثيرة – إذا تبلّل الخفان بالماء فما حكم المسح عليهما؟ – شروط المسح على الخفين – مبطلات المسح على الخفين – المسح على الجبِيرة.
تعريف المسح على الخفين:
يبدأ المُصنِّفون في العادة بباب المسح على الخفين بعد باب الوضوء، وثمّة مناسبة وهي: أنّ المسح على الخُفّين مسحٌ لأحد أعضاء الوضوء، وأحكامه تتعلّق بأحد أعضاء الوضوء، فناسب ذلك أن يُذكر بعد باب الوضوء، فإن الذي يُغسل أو يُمسح هو الرجلان، والرجلان إذا وضع فيهما الخف فإنّهما يُمسحان.
وباب المسح على الخفين جاءت فيه أحاديثُ كثيرةٌ، قال الإمام أحمد: “سبعٌ وثلاثون نفسا كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مسح على الخُفّين”.
وقال الحسنُ البصري – كما ذكر ذلك ابنُ المُنذِر في كتاب الأوسط: “أدركتُ سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين”.
وقد ذكر ابنُ المبارك رحمه الله إجماع الصحابة على جواز المسح على الخفين، وما يُنقل من الخلاف فإنّما كان في أول الإسلام، وقد أجمعوا على ذلك، حتى أصبح المسح على الخفين شعارا لأهل السنة ضد أهل البدع والأهواء الذين يرون أنّ ثمّة مانعا، فلا يُجوِّزونه، والصحيح جوازه.
ولأجل أنه مُخالفةٌ لأهل البدع؛ جعل بعضهم المسح على الخفين في كتب الاعتقاد ضمن عقيدة أهل السنة؛ لأنّه صار شِعارا لأهل السنة، كما صنع ذلك أبو علي الصّابُونِي في كتابه “عقيدة أهل الحديث”، وغيره (يقول عن أهل السنة: ويمسحون على الخفين).
وعلى هذا فإننا نقول أنّ المسح على الخفين سُنّةٌ مشروعةٌ، وهي رُخصةٌ من سُننِ النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمسح على الخفين ثابت بالنص من كتاب وسنة، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وما نُقل عن عائشة وعلي وابن عباس من أنهم أنكروا المسح على الخفين، كل ذلك لم يثبت عنهم.
وقد قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: “ولم يثبت عن أحد من التابعين أنه أنكر المسح على الخفين”، وعلى هذا فكل الرواياتِ الواردة في إنكار بعض الصحابة المسح على الخفين لم تثبت عنهم، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلمِ، وكذلك التابعين.
هل الأفضل أن يمسح على خفيه أم يغسل رجليه؟
اختلف العلماءُ في ذلك على ثلاثة أقوال: جمهور الفقهاء يقولون إنّ الأفضل هو غسلُ الرجلين؛ لأنّ ذلك هو الأكثرُ من حالِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول عمر رضي الله عنه لما قيل له: “لماذا خلعت الخُفّينِ؟ قال: إنّه حُبِّب إليّ الطّهورُ”. يعني: حُبِّب إلي الوضوء. فهذا إنّما فعله عمر لأجل أنّه يحب الوضوء فقط، وليس في ذلك نكارةٌ على المسح، أي أن البعض يُحبُّ الوضوء، يحب غسل الأعضاء من جميع البدن، ولا يعني ذلك استحباب الغسل من عدمه.
والقول الثاني مذهب الحنابلة، حيث قالوا: “إنّ الأفضل المسحُ على الخفين”.
قالوا: “لأن ذلك إظهارٌ لمخالفة أهل البدع”. فإن أهل البدع لا يمسحون على الخفين، فلأجل إظهار هذا الأمر صار أفضل.
وقالوا: “ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث صفوان بن عسّال، كما روى ذلك التِّرمِذِيّ والنّسائِي وأحمد: “أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيّام إذا كُنّا مُسافرين بِليالِيهِنّ، ولكن مِن غائِط وبول ونوم”. فقال الراوي أنّ الرسول أمرهم ألا ينزعوا، وهذا دليلٌ على أنّ المسح أفضل”. هكذا قالوا.
والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الثالث، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وهو أنّ الأفضل مراعاة حال الرِّجل، فإن كان في الرِّجلين الخُفُّ فالأفضل أن يمسح فلا يخلع ليغسل، وإن لم يكن في الرِّجلين الخُفُّ فالأفضل أن يغسل لا أن يلبس ليمسح. وعلى هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنّه كان إذا شرع في الوضوء فإنه يُنظرُ إلى حاِل رِجليه، كما في حديث المُغِيرةُ بن شُعبة، قال: “فأهويتُ لأنزِع خُفّيه، فقال: دعهُما فإِنِّي أدخلتُهما طاهِرتينِ. ومسح عليهما”. فهذا يدلُّ على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلّفُ، فمتى لم يكن في الرِّجلين خُفٌّ غسل رِجليه، ومتى كان فيهما الخُفُّ مسح قدميه.
وعلى هذا فليس من السُّنة التّكلُّفُ في الخلع ليغسل، ولا التّكلُّفُ في اللبس ليمسح.
هذا هو الذي يظهر، وهو جمعٌ بين الأقوال، تبارك من أعطى في مثل هذا من أعطى من أهل العلم، فإن أبا العباس رحمه الله قد وفّقه ربي لمعرفة أقوال الأئمة وجمع ما لم يجمعه غيرُه، فوفقه ربي لمثل ذلك، والواحد إذا سأل ربّه الهِداية والتّوفيق بأن يمنحه الفقه في الدين؛ نال حظّا وافرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: «إِذا سألت فقُل: اللّهُمّ إنِّي أسألُك الهُدى والسّداد. واذكُر بالهُدى هِدايتك الطّرِيق، وبالسّدادِ سداد السّهمِ». اللهم اهدِنا وسدِّدنا، والله أعلم .
ما هو الخف؟
تم ذكر الخفين على سبيل الغالب، وإلا فإن كلّ حائِل من جوارِب وجُرمُوق ولفائِف وعصائب وتساخِين وعمامة وخِمارُ المرأة؛ يدخل في باب المسح على الخفين، ولهذا عبّر بعضُ الفقهاء بلفظ: “باب المسح على الحائِلِ”، بدلا من المسح على الخفين لأجل أن يدخل ذلك كله، والله أعلم .
هل المسح على الخفين مُؤقّت بمُدّة؟
قبل ذكره نذكر خلاف أهل العلم فيه، فالجمهور من أهل العلم يرون أن المسح على الخفين مُؤقّتٌ بمُدّة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء خلافا لمالك بن أنس، فإنّه قال: “ليس بمُؤقّت بمُدّة”.
والصّحيح أنّه مُؤقّت بمدة؛ وذلك لأنّ غالب الأحاديث الصّحيحة دلّت على ذلك: ومن ذلك ما رواه الإمامُ أحمد والتِّرمِذِيّ والنّسائِي وغيرُهم من حديث صفوان بن عسّال قال: “أمرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ألا ننزِع خِفافنا إذا كُنّا مُسافرين إلا ثلاثة أيّام بلياليهِنّ، ولكن من نوم وغائِط وبول”. وكذلك ما رواه مسلمٌ في الصّحيح من حديث شُريح بن هانِئ قال: “سألتُ أمّ المؤمنين عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عن ذلك علي بن أبي طالب؛ فإنّه كان كثير الأسفار مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم”، قال: “فسألناه، فقال: جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيّام بلياليهنّ، وللمُقِيم يوما وليلة”. وهذا يدلُّ على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقّت للمسح مدة ثلاثة أيّام بلياليهنّ للمسافر، ويوما وليلة للمُقِيم، وهذا هو الرّاجح، والله أعلم.
وأمّا ما جاء في سُننِ الدّارقُطنيّ وشرح معاني الآثار للطّحاوِي، عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنّه قال: “خرجتُ من الشّام إلى عمر يوم الجمعةِ، فوصلتُ يوم الجمعةِ وأنا على خُفي لم أنزعهما، فقال لي عمر: متى كنت تلبس خفيك؟ قال: منذ خرجتُ. فقال: أصبت. وفي رواية: أصبت السُّنة”.
قال مالك بن أنس: “فهذا يدلُّ على أنّه مسح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ولم يخلع، فدلّ ذلك على أنّ المسح ليس له مُدّة”. هذا قول.
والراجح في هذا الحديث أنّ رواية: “أصبت السُّنة” ضعيفةٌ، كما ذكر ذلك الدّارقُطنيّ رحمه الله، وقد قال عمر رضي الله عنه: “يمسحُ من ساعته إلى اليوم الذي وصل منه”. وهذا أثرٌ صحيحٌ رواه ابنُ المُنذِر وغيرُه، ويدلُّ على أنّ عمر رضي الله عنه يرى التّوقيت، فكون عمر رضي الله عنه يرى ذلك يدلُّ على أنّ كلّ الأحاديث الواردة عنه وفيها خلافه، فيها نكارةٌ، وهذه طريقة عند الأئمة في تضعيفهم للأحاديث.
فإذا ثبت عن عمر أنّه يقول بشيء، ثم جاء عنه حديثٌ مرفوعٌ أو موقوفٌ أقل، فإنّهم يقولون: هذا المرفوع ضعيفٌ.
وهذه طريقة الأئمّة، فلا يقولون: العبرة بما روى لا بِما رأى، فهذه طريقة المتأخرين، أمّا طريقة الإمام أحمد، وطريقة الإمام البخاري، وطريقة الإمام الدّارقُطنيّ، وطريقة الإمام أبي داود، فإنّهم يقولون: إذا جاء عن الصحابي حديثا مرفوعا يُخالف ما رآه دلّ على أنّ ما رواه يُفيد الضعف، ومن ذلك ما جاء في قصة حديث أبي هريرة، ورواه هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعهُ القيءُ فلا قضاء عليهِ، ومنِ استقاء عمدا فليقضِ».
فهذا الحديث تكلّم فيه أهلُ العلم بسبب تفرد عيسى بن يونس بروايته عن هشام بن حسان، فقال البخاري: صحّ عن أبي هريرة أنّه قال “الوضوءُ مما خرج لا مما دخل، والفِطرُ مما دخل لا مما خرج”. قال: فهذا يدلُّ على أنّ البخاري رحمه الله يرى أن ما خرج لا ينقٌضُ الصوم، فجعل ما رآه دليلا على ضعف ما رواه؛ لأنّه يبعُدُ أن يروي الصحابي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يُخالفه؛ لأنّهم كانوا من التّقوى والبِرّ الذي يستحيل معه أن يُخالفوا حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يغضبون إذا رأوا أحدا يُخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة، فابن عمر عندما كان يأكل مع أولاده، فقال لهم: “إنِّي أُحبُّ الدُّبّاء، فإن النبيّ كان يُحبُّ الدُّبّاء”. فقال أحدُ أبنائه: “والله لا أحب الدُّبّاء”. قال: “لا تُحبُّ شيئا أحبّه صلى الله عليه وسلم؟! لا كلّمتُك سائر اليوم”. وقال عبد الله بن مُغفّل حينما رأى ابن عمِّه يخذِفُ بالحصى الصّغير: “لا تخذِف؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذفِ وقال: «إنّها لا تصِيدُ صيدا، ولا تنكأُ عدُوّا، إنّما تفقأُ العين، وتكسِرُ السِّنّ». فلما رآه بعد ذلك يخذف، قال: “أُحدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُعارِضُ فيه! لا كلمتُك أبدا”. وهذا يدلُّ على عِظمِ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وحُسن الإنقياد له؛ فهابوا أن يُخالفوه، أو يروا أحدا يُخالفه.
فهذا يدلُّ على أنّ الرّاجح والله أعلم هو أنّ المسح على الخفين إنما يُؤقّتُ بمُدّة، ولكن مع القول بأنّ الراجح أن التّوقيت بمُدّة، فإنّ أبا العباس ابن تيمية قال: إنّه إذا كان الإنسانُ معذورا خوف فوات رُفقة، فإنّه لا بأس أن يترك التّوقيت. والجمهور قالوا بخلاف ذلك، ولعل قول الجمهور أقرب؛ وذلك لأنّ حديث عقبة ليس فيه أنه تركه لأجل فوات رفقة أو نحو ذلك، وما جاء في بعض كتب المغازي – كما ذكر أبو العباس – أنّه كان لأجل أن يُدرك عمر، فهذا أولا: لأنّ مغازِي ابن قانِع به رواية ضعيفة. ثانيا: أنّ رواية الدّارقُطنيّ – وهي أصح – أنّه قال إنّما تركتها لأجل أنّه يرى ذلك. وهو رأي يرويه الصحابي عقبة؛ ولهذا قال الإمامُ أحمد: العبرة بما كان عليه النبي، فالنبي أولى أن يُتّبع من قول عقبة. فهذا يدلُّ على أنّ قول الصحابي حُجّةٌ إذا لم يُخالف قول صحابي غيره، أو لم يُخالف الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن إذا كان يتضرّرُ بنزع الخُفّين صار بمنزلة الجبِيرة، كمن آلمته رجلاه وفيها الخفان، فإنّه يصعب إزالتها؛ لأنّها أحيانا تكون قد التصقت بالخفين، فيرى الأطباءُ أنّ نزعها ربما يكون سببا لنزع اللحم، فيمسح على الخفين حتى تُجرى له عملية جراحية، لا حرج في ذلك.
ومن ذلك أيضا إذا كان في برد شديد، مثل الذين يكونون في سيبيريا، فلربما لو نزع الواحد منهم خُفّيه لأشتدّ ذلك عليه، ولربما وقف الدّمُ، فحينئذ يكون هذا في حكم الجبيرة، فيُعذر صاحبُه، وهذا ضرورةٌ، والضّرورة تُقدّرُ بقدرها، والله أعلم.
لو أن الواحد سافر سفر معصِيّة فهل له أن يمسح؟
أي لبس خُفّيه وسافر، مثل الشباب الذين يسافرون بنية فعل الحرام لبعض الدول الغربية.
ذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ المسافر سفر معصية لا يجوز له التّرخُّص بأحكام الرُّخص، قالوا: لأنّ ثمّة قاعدة عند الفقهاء يقولون: الرُّخصُ لا تُناطُ بالمعاصي. وعليه قالوا: لا يجوز المسحُ على الخفين لمن سافر سفر معصية، ولا يجوز القصرُ؛ لأنّ سفره سفرُ معصية، قالوا: لأنّ الله إنما خفّف ذلك تخفيفا لعباده، فإذا فعلوا ذلك لمعصية فلا يجوز ﴿يُرِيدُ اللهُ أن يُخفِّف عنكُم﴾ [النساء: 28]، أي عباده الذين أطاعوه، هكذا قال الجمهور.
والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم الظّاهِرِيّ، واختيار أبي العباس ابن تيمية: أنّ المسح على الخُفّين والقصر مُناطٌ بمجرد وجود السفر، والمسح مُناطٌ بمجرد وجود الخُفّين بشروطهما، وأما كون سفرهم مُحرّما أو غير مُحرّم فلا علاقة له بذات العبادة، فالعبادة وُجِدت فيها الشُّروط الشّرعية، وليس من الشُّروط الشّرعية وجود سفر مُباح أو مُحرّم، فقاعدة: “الرُّخص لا تُناط بالمعاصي”، ذلك يعني أنه لا يُؤجر عليه، ولكن له أن يفعله. وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم.
لأنّ المسح على الخفين ترتبت عليه شروطٌ ليس من بينها وجود السفر المباح أو سفر المعصية؛ لأنّ هذا مُتعلِّقٌ بذات المُكلّف، والمسح على الخفين له شروطٌ متعلِّقةٌ بالأحكام الوضعية، فثمّة فرقٌ بين الأمرين، والله أعلم.
هل يخلع عند انتهاء المدة؟
نقول: يخلع عند انتهاء المدة، ولا يجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك، كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
والغسلُ إنّما هو غسل الرِّجلين بالماء، والطهارة طهارة مائية وليست طهارة مسحِيّة، فلو أنه بعد الثلاثة أيام بيوم وليلة لبس الجوارب على جورب، وقال: أنا لبسته ومسحت على طهارة. فنقول: لا، المقصود بالطهارة طهارة غسل وليست طهارة مسح، والله أعلم.
وعلى هذا يجب عليه أن يخلع كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك بن أنس، والله أعلم.
متى تبدأ مدة المسح؟
اختلف العلماءُ في هذا على ثلاثة أقوال، أشهرها قولان: جمهور الفقهاء يقولون إنّ مدة المسح إنّما تبدأ من أول حدث بعد لُبس.
ما معنى هذا؟ يقولون: إذا غسل الإنسانُ رِجليه ثم لبِس خُفّيه أو لبس الجوارب، فهل تبدأ مدة المسح؟ لا، قالوا: فإذا أحدث بعد أن لبِس فإنه تبدأ مدة المسح وإن لم يمسح، لأنّ وجود الحدث هو سبب بداية التّوقيت – وقت المسح الذي هو يوم وليلة –، قالوا: فيأخذ حكم السّببِ حُكم وُجُودِهِ – وجود المسح –، وهذا مذهب الجمهور.
والقول الآخر في المسألة أنّ المسح إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث.
وصورته: قالوا: فإذا غسل الإنسانُ رِجليه، ثم لبس خُفّيه، فإنّ مدّة المسح لا تبدأ، فإن أحدث وخُفّاه على رِجليه فإنّ الرّاجح أن مدة المسح لا تبدأ، فإن توضأ ومسح فإنّه تبدأ مدة المسح.
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يمسحُ المُسافِرُ يوما وليلة». فعلّق هذا بمجرد المسح، وقد قال صفوان بن عسّال: “أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيّام بليالِيهِنّ إذا كُنّا قد مسحنا”. وهذا يدلُّ على أنّ العبرة بالمسح بعد الحدثِ، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها جمعٌ من المُحقِّقين، وهي المُفتى بها عند مشايخنا، كما هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع.
وعلى هذا فليست العبرةُ بيوم وليلة أنها خمس صلوات كما يفهم العامة، وإنما العبرة بأربعة وعشرين ساعة، فجائز أن يلبس الإنسانُ خُفّيه وتبقى عليه اثنين وسبعين ساعة، كيف؟
نذكر الصورة: يقوم لصلاة الفجر فيغسل رِجليه، ثم يلبس الخُفّين، ولا يُحدِث إلى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الفجر، ثم بعد ذلك يُحدِث أو ينام، ولا يتوضّأ إلا بعد دخول وقت الصّلاة – صلاة الفجر –، يعني قبل الصلاة بعشر دقائق (يؤذن للصلاة مثلا الساعة الخامسة والنصف فيتوضأ)، إذن كم جلس بالخف؟ جلس أربعة وعشرين ساعة، ثم مسح عليه، فيبقى يمسح حتى الساعة الخامسة والنصف من الغد، فتصبح ثماني وأربعين ساعة.
وعلى القول بأنّه ما دام طاهرا يجوز له أن يُصلِّي ولو انتهت مدةُ المسح، وهو اختيار ابن تيمية، ورأي شيخنا محمد بن عثيمين، فإنّه لو توضأ قبل الوقت يعني مثلا قبل الساعة الخامسة والنصف – مثلا توضأ الخامسة والربع – ثم استمر على طهارته إلى العشاء؛ فيكون قد بقي على خفيه اثنين وسبعين ساعة، وعلى القول الآخر – وهو مذهب الجمهور وسوف نأتي إليه – بأن انتهاء مدة المسح يعتبر انتهاء لأحكامه حتى الطهارة، وسوف نذكر هذه المسألة بنوع من الإسهابِ والتفصيل.
مسألة ابتداءُ مدة المسح:
ذكرنا أن المسألة على قولين، وقلنا: ذهب جمهورُ الفقهاء إلى أن المسح إنّما يبدأ من أول حدث بعد لُبس، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والقول الثاني في المسألة – وهو رواية عند الإمام أحمد ومذهب ابن حزم وقول ابن المُنذِر والنووي – أنّ المسح إنّما يبدأ من أول مسح بعد حدث؛ وذلك لأنّ الألفاظ الشرعيّة التي بيّنت مُدّة المسح إنّما علّقتها بلفظ “المسح”، ولفظ “المسح” إنّما يدلُّ على وجوده، ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرّزّاق في مصنفه وغيره: “يمسح إلى مثل ساعته من ليلته ويومه”. فهذا يدلُّ على أنّه إنّما يبدأ من حين يمسح، وهذا كما قلنا هو الراجح، والله أعلم.
هل صحيح أن خلع الجورب كحلق الرأس؟
مسألة خلع الجوارب هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ هي مسألة طويلة، وبعضهم استدلّ بأنّه لا ينقض وضوءه مثل ما لو حلق رأسه، فإنّه لا يُعيد الوضوء، فكذلك خلع الجوارب.
ولكن هذه المسألة فيها نظرٌ؛ وذلك لأنّ المسح إذا خلع دخل في غسل، والرأس إذا حلق فهو ما زال مسح، فهذا يفرق فيه بين الحكمين.
ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، ومع أنّ القول بأن الخلع لا ينقض الوضوء، أو أنه له أن يستمر على طهارته، إلا أن الأحوط مذهب الجمهور، وسوف نذكر هذه المسألة.
باب المسح على الخفين ليس فيه أحاديث في مسائل كثيرة:
ليس فيه إلا مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح، وأنّ مدّة المسح يومٌ وليلةٌ، وباقي الأبواب ليس فيها حديثٌ، إنّما كانوا يلتمسون من حاله وفعله، فمثلا مسألة أن يكون الخفين ساتِرين للمحلِّ، أي لا يجوز لبس الخف الرقيق، هذه مسألة ذكروها لأجل حال الصحابة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يدلُّ ذلك على أن غيره لا يُجزئ.
إذا تبلّل الخفان بالماء فما حكم المسح عليهما؟
هل تذهب الطهارة ويجب الخلع والإعادة؟
إذا تبلل الخفان – وقد لبسها على طهارة – فإننا نقول: امسحهما ولو كان فيهما ماء؛ ذلك معذور، كمن يلبس الكنادِر أو الجوارب مع الجزمة، ويخوض في الماء. فنقول: لا حرج أن تبقيهما، ولكن إذا جاء وقت المسح تمسح عليهما.
شروط المسح على الخفين:
من المعلوم أنه لا يجزئ كل خُفّ في المسح على الخفين، بل لا بد من وجود خف بحسب ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فما هو؟ لأجل هذا اختلف العلماء في شروطه كما سيأتي، فبعضهم قال ليس الخف الجديد، بل الخف الذي كان من عادة الصحابةِ اعتماده، أي الخف الذي مضى عليه زمنٌ من الدهر، فأثّر عليه من خرق ورتق وفتق، وغير ذلك.
فهل كان اختلافهم لأن كلّ ما كان مستورا مما فرضُه الغسل ينتقل إلى المسح، ولهذا قالوا: كلُّ ما وُجد فيه فتق من الرِّجل فإنه لا يصحُّ المسح عليه، فجعلوا الحكمة معلقة بِسترِ المفرُوضِ، ومتى لم يُستر المفروض؛ فإنه لا يصح المسح حينئذ؛ لإجتماع فرض حُكمه الغسل وفرض حُكمه المسح، ولا يصحُّ الجمع بين الغسل والمسح.
والقائلون بجواز اختلاف بعض هذه الشروط قالوا لأننا ننظر إلى الحكمة وإلى المقصد، فإن الحكمة والمقصد من المسح على الخفين هو رفعُ الحرج، ووجود الرخصة، فمتى اشتُرط المسح على الخفين ما لم يكن معتادا فعله عند الصحابة؛ فإننا أخرجنا المسح على الخفين من حِكمته الأصلية وهي رفع الحرج والرخصة.
ومن أسباب الخلاف أن بعضهم يشترط شروطا بموجب وجود أحاديث، وبعضهم يُضعِّف هذه الأحاديث ولا يُثبتها، كما في المسح على الجوارب، فمن أهل العلم من نفى المسح على الجواربِ لعدم وجود حديث صحيح في هذا الباب، في حين أن بعضهم أثبت هذه الأحاديث، وقال إن فِعل الصحابةِ يدل على هذا الأمر.
إذا ثبت هذا فلعلنا ندلف إلى شروط المسح على الخفين:
الشرط الأول: أن يلبسهما بعد كمالِ طهارة.
وهذه الطهارة لا بد أن تكون طهارة مائيّة. وقد نقل الإتفاق والإجماع عليه أبو محمد ابن قُدامة في كتاب “المُغنِي”، بأن لا نعلم فيه خلافا في اشتراطِ هذا الشرط، وهو أن يُدخِل الخُفّ على طهارة.
وهل يُشترط في هذه الطهارةِ أن تكون مائيّة أم لا؟
نقل الإمام الشنقيطيُّ في كتاب “أضواء البيان” الإجماع على أنه لا بد أن تكون طهارة مائية، والواقع أنه ليس في المسألة إجماع، لا من حيث الطهارة المائية ولا من حيثُ كمال الطهارة من حيث الجملة، فكل مسألة قد وقع فيها خلاف، وإن كان عامة أهل العلم على أنه لا بد فيها من كمال الطهارة، وكذلك أن تكون الطهارة مائية.
وأما إذا كانت غير مائية فقد وُجِد قولٌ عند مالك اختاره أصبُغ من المالكية، وقول عند الحنابلة، بجواز هذا، والواقع أن ذلك لا يجوز، والراجح أنه لا بد أن تكون الطهارةُ طهارة مائية.
ودليل هذا الشرط: ما ثبت في الصحيحين من حديث المُغِيرة بن شُعبة وفيه قال: “فلما أهويتُ لأنزِع خُفّيهِ قال لي: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين”، ومسح عليهما.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهما طاهرتين، والطهارة هنا هي الطهارة المائية المعتادة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
وقد اختلف أهل العلم في معنى كمال الطهارة، هل المقصود أن لا يمسح حتى تكتمل طهارتُه، أم أنّ المقصود ألا يلبس خفا إلا بعد كمال الطهارة؟
القول الأول: ذهب جمهورُ الفقهاء إلى أن المسلم لو غسل رِجله اليمنى ثم لبس خُفه، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس خُفه الثاني؛ فإنه لا يصحُّ له المسح على خُفيه، قالوا: لأنه أدخل الخفّ في رِجله اليمنى قبل اكتمالِ الطهارةِ. والواجب أن لا يمسح إلا بعد اكتمال الطهارةِ، وهذا هو قول جمهور الفقهاء؛ خلافا لمالك، وقد رجّح هذا القول النوويُّ وابن حجر.
والقول الثاني هو مذهب أبي حنفية، ورواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم الظّاهِرِيّ، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وقد رجحه من الفقهاء المحققين المُزّنِي من الشافعية، وابن المُنذِر، فقالوا: إنّ ثمة فرقا بين المسحِ قبل اكتمال الطهارةِ ولبس الخف قبل اكتمال الطهارة، قالوا: فإن الواجب ألا يمسح إلا بعد اكتمال الطهارةِ، أما كونه يلبس الخف قبل اكتمال الطهارة؛ فلا أثر لذلك على شرط كمال الطهارة.
وقد قال أبو العباس ابن تيمية كلمة قوية، – في ذلك الرأي – وهي: “وهل هذا إلا عبثٌ تتنزّهُ الشريعةُ عنه؟!”، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى.
إذن الأحوط للمسلم ألا يلبس الخف – أو يلبس أحدهما، إلا بعد اكتمال كامل الطهارة، ولو فعل، فغسل رِجله اليمنى، ثم لبس الخف؛ فإن الراجح أنه يجوز له أن يمسح؛ لأن الحكم إنما عُلِّق بالمسح لا باللُّبسِ، فهو قد لبس قبل اكتمال الطهارة ولا أثر لذلك، لأنّ وجود الخف في الرِّجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، لا حُكم له كما يقول العلماء، فهو بمثابة المعدومِ شرعا، فلما غسل رجله اليسرى جاز له أن يمسح، وحينئذ يكون قد أدخلهما طاهرتين. هذا هو الأقرب، والله أعلم.
ومما استدل به أهل العلم: ما جاء في حديث صفوان بن عسّال عند أهل السنن – واللفظ لأهل السنن – قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، إذا كنا قد أدخلناهما على طُهر ثلاثا إذا كنا سافرنا، ويوما وليلة إذا كنا قد أقمنا».
ففي: “على طُهر”، قال الجمهور: المقصود بالطهر كمال الطهارة ثم لبس الخفين، أما القائلون بجواز لبس أحدهما ثم غسل الرجل اليمنى، فقالوا: المقصودُ هو الطهر المائي، وهو لن يمسح إلا بعد كمال الطهارةِ، إذن لا أثر للبس الخف إذا كنا قد أوجبنا عليه أن لا يمسح إلا بعد اكتمال الطهارةِ، وبالتالي لا نكونُ قد خالفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال أهل العلم: وهذا الشرط – وهو أن يلبسهما بعد كمالِ الطهارة – هل هو واجب في المسح على الخفين والجوربينِ فقط، أم يأخذ حكم كل مسح على حائل، كالمسح على الجبيرة والمسح على العِمامة؟
فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا يجوزُ له أن يمسح على الجبيرة، إلا أن يكون قد أدخلها طاهرة، فلو أنه قد كُسرت يده فذهب إلى المستشفى يُريد أن يُجبِّر يده، فإننا نقول: قبل أن يجبر الطبيب يدك لا بد أن تتطهر وتتوضأ لأجل ألا تلبس الجبِيرة إلا وقد أدخلتها طاهرة.
ولا شك أن قياس المسح على الخفين على المسحِ على الجبِيرة، قِياس مع الفارقِ، وقد ذكر بعض العلماء كصاحب “الإنصاف” المِرداوِي أن ثمة فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبِيرة، وذكر تسعة فروق.
ولهذا فإن الراجح هو مذهب أبي حنيفة وهو قول لمالك ورواية عند أحمد اختارها ابن حزم وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو اختيار ابن قُدامة وصاحب “المُحرّرِ”: أنه لا يُشترطُ الطهارة في المسح على الجبِيرة؛ وذلك لأنّ المسح على الجبِيرة إنما جُوِّزت لأجل المشقةِ، فإلزامُ الطهارة مع وجود المشقة مشقةٌ غير معتادة.
ثانيا: ولأن المسح على الجبِيرة لم يكن في الغالب باختيار المرءِ، وإنما تأتي فجأة، وعلى هذا فإن اشتراط الطهارة يحتاج إلى دليل، خاصة وأن الأحاديث الواردة إنما هي في المسح على الخفينِ، ولا يسوغ أن نحمِل الطهارة على غير المسحِ على الخفين إلا إذا كان حُكمُهُمُا كحكم المسحِ على الخفينِ، وهل الجبِيرة حُكمها كحُكم المسح على الخفين؟! لا، بدليل أنه لو انتهت مدة المسح، هل نقول له: اخلع الجبِيرة، أو اذهب إلى الطبيب وتقول: انتهت مدتي، اغسلها ثم بعد ذلك ضع لي جُبيرة أخرى؟!! لا.
ولهذا لما فارقت الجبِيرة المسح على الخفين في الوقت، فكذلك خالفته في سائر الشروط، وهذا هو الراجح والله أعلم.
ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث جابر في قصة الرجل صاحب الشّجّةِ، حينما شُجّ، فقال صلى الله عليه وسلم: «قتلوه، قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِيِّ السؤالُ»، وهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في الجبِيرة مثل ما يفعل في المسح على الخفين، وقد قال البخاري مُعلقا بصيغة الجزم عن الحسن البصري: “ما زال المسلمون يُصلون بجراحاتهم”، ومعنى الجراحاتِ هي اللفافة التي تكون في الجرح ويظهر فيها الدم، ومع ذلك لم يُؤمروا أن يغيروا هذه الأشياء؛ لأجل انتهاء المدة، فدل ذلك على أن الجبِيرة شيء، والمسح على الخفين والجوربين شيء آخر.
ما تقولون في العمامة؟
هل لو أن الواحد لبسها في شدة البرد، هل له أن يمسح عليها قبل اكتمال الطهارة، أم لا بد أن يتوضأ ويمسح؟
ذهب الحنابلة إلى أنه لا يصحُّ له أن يمسح على العمامةِ إلا بعد اكتمال الطهارة، كالمسح على الخفين، وذهب الشافعي رحمه الله وهو مذهب ابن حزم واختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ وذلك لأن العمامة يُمسحُ عليها، وإذا لم تُلبس؛ فإن حق الرأس المسح، وأما الخف إذا لم يلبسه؛ فحقه الغسل، فصار ثمة فرقٌ بين العمامة والمسح على الخفين، هذه نقطة.
الدليل الثاني: قالوا ولِما جاء من حديث الإمام أحمد من طريق راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم سرِيّة، فأصابهم البرد، فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخِين، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقد اختلف أهل العلم في صحة سماع راشد بن سعد عن ثوبان، فأنكر الإمام أحمد وأبو حاتم سماع راشد بن سعد عن ثوبان، وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا، وهو الضعيف.
وذهب الإمام البخاري إلى صِحة سماع راشد بن سعد عن ثوبان، ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة يشترطون في السماع اللُّقيا مع المُعاصرةِ؛ خلافا لمسلم، الذي يشترط المعاصرة دون اللقيا، وكون الإمام البخاري أثبت السماع فإن من أثبت حُجَّةٌ على من لم يُثبت. وعلى هذا فالقول بأن الحديث حسن قول قوي، ولهذا ذكر الإمام الذهبي أن الحديث إسناده قوي.
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العمامة، ولم يشترط عليهم شرطا، ولا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابةُ أشكل عليهم المسحُ على العمائم، فكونهم يشكلُ عليهم شُروط المسح من باب أولى، فلما لم يُبينِ النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للمسح على العمائم؛ دل على أنه متى ما وُجدت العمامة جاز المسح عليها، ومتى لم توجد؛ فإنه يجب فيها المسح على الرأس، والله أعلم.
ومما يدل على ذلك أن الصحابة الذين ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمائم كما في حديث المُغِيرة بن شُعبة وكما في حديث بلال، وكما في قصة أم سلمة في المسح على خِمارِها، فإنه لم يذكر فيه أنها كانت تمسح بوقت معين مثل المسح على الخفين، والله أعلم.
الشرط الثاني: أن يكون الخف أو الجورب مباحا.
وعليه فلا يجوز أن يمسح على خفّ أو جورب مسروق أو من حرير؛ لأن ذلك والحرير لا يجوز في حق الرجل، وهناك شبه إجماع في حُرمة لبس المحرم، إلا أن هذا الإجماع هل يقتضي منه عدم صحة المسح أم لا؟
اختلف العلماء فيه:
فذهب الحنابلة رحمهم الله وقول عند المالكية، إلى أن المسح يكون باطلا؛ لأن النهي يقتضي الفساد، هذا مذهبُ الحنابلة وقول عند المالكية.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الطهارة والمسح صحيح، لكنه يقع في الإثم.
قالوا: لأنه قد فعل ما أمره الله من حيث وجوبُ الطهارة، فغسل ما وجب غسله، ومسح ما وجب مسحه، وأما كون الشيء محرما لغير ذات العبادة، فهذا نهيٌ خارجٌ عن الماهية مثله مثل أي نهي يعود على خارج الماهية، وكل نهي لا يعود على الماهية فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الأقرب، والله أعلم.
الشرط الثالث: أن يكون الخفان ساترين للمفروض.
وهذا الشرط مُجمعُ عليه في الجملة، بمعنى أنه لو لم يكن على العقِبِ شيء، فإنه لا يصح له أن يمسح.
والربطة على الرجلِ، أي التي تُشدُّ على نصف الرجل، هذه لا تُسمى خفا، وليست ساترة للمفروض أو غالبه، وبالتالي لا يصح المسح عليها.
والخف في الغالب ساتر للمفروض، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض جُزئياته. قال الحنابلة والشافعية: يلزم من ذلك أن لا يجوز المسح على خف ولا على جورب مُخرّق، فمتى وُجد خرقٌ ولو كان يسيرا يظهر منه ما حقه الغسل من الرجل؛ فلا يجوز المسح عليهما.
ودليلهم في هذا، قالوا: لأنه لو مسح في خف مُخرّق فإنه يكون قد جمع بين مسح وغسل؛ لأن ما ظهر من البدن فحقه الغسل، وما بطن من الخُفِّ فحقه المسح، فيكون حينئذ قد جمع بين المسح والغسل في عضو واحد، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، والدليل قوي.
ويجب على طلبة العلم إذا أرادوا أن يكتسبوا الملكة الفقهية أن يتقمّصُوا شخصية المخالِف، فحينما يلوحُ لهم أن القول بالتحريمِ، يتقمصون شخصية المبيح لأجل معرفة وجهة نظره، والعكس إذا كان القول بالإباحة، يتقمصون شخصية المحرم لمعرفة وجهة نظره.
والجواب على هذا أن نقول:
إن قولكم: إن ما لم يظهر من البدن فحقه المسح، ليس على إطلاقه، بدليل أن الخفّ والجورب لو لم يظهر شيء تحت الرِّجل فهل نقولُ: يمسح عليه؟ لا، وإنما يمسح على أعلى الخف، فدل ذلك على أنه ليس كل ما غُطِّي من الرجل حقُّهُ المسح، فكذلك ليس كل ما ظهر من الرجل حقه الغسل.
وإذا كانت إحدى المقدمتين غير صحيحة؛ يقتضي ذلك عدم صحة النتيجة.
وعلى هذا: فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى جوازِ مسح الخفِّ المخرّق إذا كان يسيرا، يمكن المشي والسير عليه بنفسه أو بغيره، فمتى أمكن المشي عليه ويسمى خُفا، ولم يفحش؛ فالراجح والله أعلم جواز المسح عليه، ومما يدل على ذلك أدلة كثيرة لعلنا نذكر منها:
أولا: أن السنة جاءت بالمسح على الخفين بإطلاق من غير تقييد بقيد، فيجبُ حملُ المطلق على إطلاقِه ما لم يرِد فيه قيد، ولم يرد، فدلّ ذلك على أنّ الأصل حمله على عمومِ مُسمى الخف، والقاعدة في هذا: أن كل ما أتى في الشرع ولم يُحدّد؛ فإن الذي يُحدده هو العُرفُ، والخف الذي جاء الشرعُ بجواز ذلك، قالوا: إن العُرف والعادة أن الصحابة يمسحون على الخف، والعادة أنه لا يخلو خُف في الغالب من فتق أو رتق أو خرق، خاصة أن الصحابة فقراء، ولُبسُهُم للخف لُبسٌ قد مضى عليه مدة من الزمن، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخف المعتاد لبسه، والذي يكون فيه أحيانا خرقٌ؛ دل ذلك على أنه يجوز المسح على الخف المخرّق ما دام اسم الخف عليه صحيحا، ولو كان لا يجوز؛ لما تركه صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من باب “لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة”، وذلك مستحيل.
ولهذا قال الإمام الثوري: “اِمسح على الخفين ما أمكنك المشي عليه، وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مُخرقة مُشققة مُرقعة؟!”.
وعلى هذا فالذي يظهر هو جواز المسح على الخف المخرّق ما دام اسم الخف أو اسم الجورب واقعا فيه، والله أعلم.
هل يجوز المسح على خف قد ظهر منه الكعبانِ؟
مثل لبس الجزمة الآن بدون “شراب”. هل له أن يمسحها؟
الجزمة مقطوعة بحيث يظهر الكعبان، فهل يجوز المسح عليه؟
الجواب: ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يصحُّ المسح على خف قد ظهر فيه الكعبان، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.
القول الثاني في المسألة: جواز المسح على الخف ولو بدا الكعبان، وهو اختيار ابن حزم، وقولٌ عند المالكية.
والراجح هو عدم الجواز، ودليل ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن بالمسح على الخفين، والخف إذا قُطِع دُون الكعبين فلا يُسمى خفا؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج «ومن لم يجد النعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»، فقطعُ الخفِّ أسفل من الكعبينِ يُخرجه عن مُسمى الخفِّ، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الأقرب، وهو الأحوط.
وعليه ما حكم لبس الجوارب الرياضية التي تكون بمقدار القدم، وقد غُطيت العقِبان ولم يغطّ الكعبان؟
لا يصح، وهل هي مسألة إجماع؟ ليست مسألة إجماع، ولكنه مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لابن حزم القائل بذلك.
وبالمناسبة: نقل ابن مِفلِح و المِرداوِي في “الإنصاف” أن أبا العباس ابن تيمية يُجوِّزُ ذلك، والواقع أن كلام ابن يتيمة في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أنه يمنع، ولهذا قال: “والخف إذا قطع أسفل من الكعبين لا يُسمى خفا”، فالظاهر أن ابن تيمية يمنع، أو يقال: له قولان في المسألة، وإن كان الذي يظهر أن المشهور عنه هو عدم جواز المسح، والله أعلم.
الشرط الرابع: أن يكون الخفان أو الجوارب صفِيقة.
أي غليظة لا يظهر منها القدم، وعليه قالوا: لا يصح المسح على خف أو على جوارب بلاستيكية تظهر فيها الرِّجل أو على جوارب رقيقة.
قالوا: لأنه إذا ظهر شيء من القدم؛ فإن ما ظهر حقُّه الغسلُ، وما لم يظهر حقه المسح، والجواب على هذا ذكرناه سابقا، ولهذا فإن في المسألة قولا ثانيا وهو جواز المسح على الخف أو الجورب الرقيق، وهذا هو مذهب ابن حزم، اختاره ابن المُنذِر، وقولٌ عند مالك ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول الصّاحِبينِ، وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وعلى هذا: فالراجح جواز المسح على الخفِّ الرقيق.
ومن ذلك ما تلبسه النساء في العادة من جوارب يظهر فيها القدم، فلا بأس، وإن كان الأحوط والأولى أن الواحد يبحث له عن جوارب لا تظهر فيه القدم.
وحينما نقول: في الغالب؛ يعني أن الجوارب التي يظهر فيها إذا دقق النظر لا بأس – أي بصعوبة شيئا ما، أما الجوارب الرقيقة جدا فتركها أولى، وإن كان الأصلُ الجواز؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمسحوا على العصائب والتّساخِين، والتساخين هي اللفائف، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام عليهم شرطا، والله أعلم.
ولو لبس خفا لا يثبت بنفسه بل بِربطِه؟
قال بعض الفقهاء: لا يجوز. والصحيح جوازه، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، لأنه يطلق عليه اسم خف.
الجوارب المنعلتين بغير الجلد؟
“منعلين” أي توجد طبقة تحت الرجل، قالوا: إذا كانت قماشا فلا يصح حتى تكون جلدا.
فمن العلماء من لم يُجوِّز المسح على الجواربِ مطلقا إلا بأن تكونا مُنعّلتينِ من جِلد، يعني موطئهما من جلد، فلو كان موطئهما ليس بجلد، فقد منع الشافعية والمالكية ذلك، وهو قول عند الحنفية والحنابلة، والحنابلة لهم شروط.
والراجح جواز المسح على الجوارب سواء كانا منعلين أو لم يكونا منعلين، والحنابلة لم يشترطوا أن تكونا منعلتين، لكنهما قالوا بشرط أن تكون ثابتتين بنفسيهما، والراجح أنه جائز سواء ثبتتا بنفسيهما أو بغيرهما، والله أعلم.
w
ماذا عن المسح على النعلين إذا كان لابسا جوربين؟ وكذلك إذا نزع الخفّ أو النعلين هل يبقى على طهارة أم تنقض طهارته؟
أما المسح على النعلين فقد اختلف العلماء فيها، والذي يظهر لي أن المسح على النعلين إن كان تحتهما جوارب فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكونا نعلين مثل “السبتتين”؛ فإننا نقول لا ينبغي له أن يمسح؛ لأنه لو مسح فإنما مسح على الجورب؛ لأن مسحه على الجورب ليس مسحا على كل الجورب بل يمسح خطوطا على بعض أصابعه، فحينئذ لو خلع النعلين لا أثر لهذا الخلع.
أما إذا كانا نعلين من النوع الذي تُدس الأرجل فيه ولا يظهر العقِب، فإنا نقول: الأولى ترك ذلك، والله أعلم.
ولو مسح عليها وخلعها، فقد اختلف العلماء في مسألة الخلعِ، هل ينقضُ وضوؤُه أم لا؟
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يبطُلُ مسحه، وذهب ابن تيمية وهو قولٌ عند الحنابلة إلى جوازِ طهارة ذلك، واستدل بفعل علي بن أبي طالب كما عند البيهقِي، أنه مسح على النعلين، ثم خلعهما وصلّى، والذي يظهر لي أن حديث علي بن أبي طالب لا يُفيدُ أن من مسح على خفّ ثم خلعه أنه يبقى طاهرا؛ لأن النعلين التي كان علي رضي الله عنه يلبسها قد كان تحتها شيء من الساترِ، إنما مسح عليه، وبالتالي فإننا نقول: الأحوط أن من مسح على شيء ثم خلعه أنه يعيد الوضوء، والله أعلم.
وهذا هو قول الأئمة الأربعة إذا لم يغسل رجليه، وسوف نبحث المسألة إن شاء الله.
إذا تمزق الجورب بعد المسح، هل يكون طاهرا؟
الجواب: إذا كان قد لبس الجوربُ ثم لعب به رياضة مثلا، ثم خرقه حتى خرج عن مسمى الخف، فمن قال: إن نزع الخف ينقض الوضوء، قال: هذا في حكم النزع، ومن قال: إنه ما زال طاهرا – وهو قول للثوري، واختيار ابن تيمية، ورواية عند الإمام أحمد – قال: فإنه يبقى على طهارته، وسوف نتحدث عنها، وإن كنت أقول إن القول ببقاء الطهارة قوي، وإنّ القول بعدم نقض الطهارة قول أحوط، وهو مذهب الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة إذا لم يكن قد غسل رجليه ولم يغسل رجليه فإن الأئمة الأربعة متفقون على أن طهارته ناقصة لم تكتمل بعد، وأبو حنيفة يقول: “لا يُصلي حتى يغسلها”، ومالك يقول: “يجب غسل الرجلين بعد الخلع مباشرة، وإلا لم يصح”، وذهب الشافعي وأحمد إلا بُطلان الطهارة بمجردِ الخلع.
فدل ذلك على أن الأئمة الأربعة يقولون: إذا لم يغسل رِجله فيكون غير طاهر، والله أعلم.
ما تقولون في رجل غسل رجله ثم لبس الجوارب، ثم بعد ذلك أحدث، فهل يبدأ مدة المسح؟
طالب: الراجح أنه يكون بعد المسح.
الشيخ: أن يكون في أول مسح بعد لُبس، إلى الآن لم يبدأ المسح؛ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “امسح من ساعتك إلى الساعة التي أنت بها من الغد”، وهذا يدل على أن الحكم معلق بالمسح والله وأعلم.
شخص غسل رجليه ولبس الخفين، ثم أحدث ومسح عليهما، فالسؤال هل له أن يلبس خُفا آخر بعد أن مسح على الخف الأدنى، أم ليس له ذلك؟
الشيخ: له أن يلبس لكن لا يُعلِّقُ عليه حُكما آخر بالمسح، إذن الجواب: له أن يلبس لكن كونه يلبس شيء، وكونه يمسح عليه بعد لُبسِهِ شيء آخر، فإن جمهور أهل العلم قالوا: لا يسوغ له إذا لبس أن يمسح عليها؛ لأنه أدخلها طاهرة مسح، فلا يسوغ له ذلك، خلافا لأصبغ من المالكية كما ذكرنا.
هناك مسألة سبق أن طرحناها ونذكرها على عجل، وهي:
مبطلات المسح على الخفين:
اختلف العلماءُ في مبطلات المسح على الخفين مع ذكر مبطلات الوضوء، فكلُّ مُبطل للوضوء فهو مُبطِلٌ للمسح على الخفين، إلا أنّ المسح على الخفين يزيد بعض الأشياء التي اختلف العلماءُ فيها، ومن ذلك:
1. انتهاء مدة المسح:
هل ينقُضُ الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هل تبطُلُ الطهارة أم لا تبطل الطهارة؟ وكذلك خلع الخُفّين: هل يُبطل الطهارة ويبطل المسح أم لا؟ هي مسألتان:
المسألة الأولى: وهي مسألة انقضاء المدة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن انتهاء مدة المسح ينتهِي بذلك الوضوء، فلو أنه مسح الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة، فإنّ مدة المسح إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من يوم السبت ظهرا فإنه يكون قد نُقِض وضوءه، ولو كان قد توضّأ قبل ذلك بعشر دقائق أو بنصف ساعة، فقالوا: إنّ وجود الطهارة لا ينفع؛ لأنّ مدة المسح قد انتهت.
وقالوا: فكما أنّ الرُّخصة إذا زالت زال حكمُها، كالماء إذا وُجِد مع وجود التيمم، فإنّ التيمم يبطل مع وجود الماء. قالوا: فكذلك الرُّخص إذا وُجد فيها المُبدل فإن البدل يكون لاغيا. قالوا: فهذا يدلُّ على أن انقضاء المدة يكون به انقضاء الوضوء.
والقول الثاني في المسألة هو مذهب طائفة من السلف، كالنّخعِيّ وعطاء والحسن، وهو مذهب الظّاهِرِيّة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فذهب هذا القول إلى أن انتهاء المدة شيءٌ وانقضاء الوضوء شيءٌ آخر، فقالوا: إذا انتهت المدةُ والواحد ما زال طاهرا فإنّ له أن يُصلِّي بهذا الطهور. قالوا: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحُكم على المسح وعلى انتهاء مدة المسح. وقالوا: إن انتهاء مدة المسح شيءٌ، وانقضاء الطهارة شيءٌ آخر، فدلّ ذلك على أنّ الطهارة إنّما ثبتت بيقين، فلا تزولُ إلا بيقين، واليقين ليس فيه إلا الإجماع أو النّص، وليس ثمّة إجماعٌ ولا نصٌّ، فنُبقِي الأمر على الطهارة.
وهذا القول قويٌّ بلا شكّ إلا أنّه في مثل هذه المسائل – المسح على الخفين – الأحوط أن يبرأ بنفسه ويخرج من عهدة الطلب بيقين بأن يتوضّأ، فإن رأى أن الوضوء يشُقُّ عليه، أو أنّه في سفر ولا يحتاج إلى ذلك؛ فالقول بأنّ الطهارة باقيةٌ قولٌ قويٌّ.
2. هل خلع الخُفِّ ينقُضُ الوضوء أم لا؟
نستطيع أن نقول في هذه المسألة أن الواحد إذا خلع خُفّيه ولم يغسل رجليه؛ فإن الأئمة الأربعة مُتّفقون على أنّه لا يسوغ له أن يُصلِّي بالوضوء الذي قد توضّأ به قبل ذلك.
فلو افترضنا أن شخصا توضأ ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك خلع، وكان هذا المسح بعد حدث، فهل ينقُضُ الخلع وضوءه أم لا؟
اتفق الأئمةُ الأربعةُ على أنه إذا لم يغسل رجليه لا يصح له أن يصلي بهذا الوضوء السابق، إلا أن أحمد والشافعي قالا أنّه من حين خلع الخُفِّ ينقُضُ وضوؤه. وقال مالك: إن خلع فغسل رجليه مباشرة جاز أن يُصلِّي.
وقال أبو حنيفة: إن خلع وأراد أن يُصلِّي فلابُدّ أن يغسل رجليه. أمّا إذا لم يغسل رجليه فإن أبا حنيفة يقول: لا يصح أن يُصلِّي.
وسبب الخلاف بينهم هو مسألة الموالاة في الطهارة، وذكرنا الخلاف في الموالاة في الطهارة وقلنا: الراجح أنّه يجِبُ الموالاة في الطهارة، وقلنا أن هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، إلا إذا كان هناك حاجة، وقلنا أن حديث الرجل الذي توضأ فترك موضع ظُفُر أو موضع قدر الدرهم لم يُصبِهُ الماء؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الوضوء كما عند الإمام أحمد في رواية، فدلّ ذلك على أنّ الموالاة واجبةٌ، وعلى هذا فقد صارت المسألة على أربعة أقوال:
الأول: أنّه يبطل الوضوءُ من حين الخلع.
الثاني: وهو مذهب مالك: أنّه إن خلع فغسل رِجليهِ فله أن يُصلِّي، وإن تأخّر فلا يصح وضوؤه.
الثالث: قول أبي حنيفة وهو: أنّه إن أراد أن يُصلِّي فلابُدّ أن يغسل رجليه.
الرابع: هو مذهب الظّاهِرِيّة، واختيار أبي العباس ابن تيمية، ورُوِي عن عليّ رضي الله عنه وهو قول النّخعِي والحسن، قالا: أنّ من خلع خُفّيه وهو ما زال طاهرا فإن خلع الخُفِّ لا يُعدُّ ناقضا ولا مُبطلا للطهارة.
وهذا هو مذهب ابن حزم، وهو قول الحسن والنّخعي، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا.
قالوا: إنّ الطهارة ثبتت بيقين، ولا يُبطل هذا الوضوءُ إلا بيقين، واليقين إنّما هو نصٌّ أو إجماعٌ، ولا نصّ ولا إجماع؛ فدلّ ذلك على بقاء الطّهارة.
وقالوا: ولأنّه صحّ عن عليِّ بن أبي طالب – كما روى البيهقِي وصحّحه – أنّه أراد أن يتوضأ فتوضأ ومسح النّعلين، ثم خلعهما فصلى. قالوا: ولأنّه قولُ صحابيّ ولم يأتِ ما يُخالفه، فكان شبه إجماع.
والجواب على هذا أن نقول: أمّا ما جاء عن عليّ رضي الله عنه فإنما مسح على النّعلين، وهي مسألةٌ معروفةٌ في الخلاف، فأنتم لا تقولون بالمسح على النعلين، وإنّما عَلِيّ مسح بمعنى غسل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، أي أنّه أبقى رجله على نعليه وبدأ يمسح حتى صارت مثل الغسل، وبالتالي فإنّ نزع النّعلين هنا ليس مثل نزع الخُفِّ الذي هو المسح، فليس هو مثل الخف أو الجورب الذي هو المسح، ولكن عليّا مسح النّعلين فصار هذا المسح بمثابة الغسل، فلا يمكن الاحتجاجُ بهذه المسألة التي نحن بصدد البحث فيها، وهي أنّ الواحد لبس خُفّا فمسح عليه ثم نزعه، وأمّا حديث عليّ فإنّما مسح بمعنى غسل كما ذكر ذلك غيرُ واحد من أهل العلم، وبالتالي فإن الاحتجاج بحديث عليّ محلُّ نظر.
وأمّا رواية «فمسح على خُفّيهِ» فهي روايةٌ مُنكرةٌ، والصّحيح أنّ هذا إنّما هو مسح النّعلين بمعنى غسل النّعلين، مع أنّ رواية المسح على النّعلين تكلم فيها الحُفّاظ، هـذا أمرٌ.
والثاني: أنّهم يقولون إنّ الطهارة ثبتت بيقين، ولا تبطل إلا بيقين.
فالجواب أنّ اليقين لا يلزم منه وجود نصّ أو إجماع، بدليل أنّكم تقولون: لو أنّ شخصا خلع إحدى خُفّيه ثم أعادها فلا يسوغ له أن يمسح، قلنا: ما الدليل على ذلك وقد خلع خُفّا واحدا؟
فإذا قلتم: لأنّه خلع. قلنا: فلكونه خلع لم تُجيزوا له أن يمسح، فكذلك إذا خلع لم يجُز له أن يبقى على طهارته.
وهذا يدلُّ على أنّه ليس كل ما جاء في المسألة دليلٌ عقليٌّ أن نرُده، فإن ابن حزم رحمه الله لا يرى القياس، ولا يرى الأخذ بالعموم الشُّمُولي، ولكن الرّاجح والله أعلم أنّنا نأخذ بالتعليل وبالقياس إذا كان بنفي الفارق أو بقياس العلة، وإن كان قياسُ العلة لا يُحتجُّ به في العبادات، ولكن يُحتجُّ بقياس نفي الفارق، والله أعلم.
والذي يظهر لي أنّ خلع الخُفِّ ينقض الوضوء، وهذا أظهر، وهو أحوط، وهو أبقى؛ لأننا نقول: لو خلع إحدى خُفّيه لا يسوغ له أن يمسح، فكذلك لا يسوغ له أن يبقى على طهارته، فدلّ ذلك على أنّ الخُفّ إنّما بقي على طهارة مسح، فإذا خلع خُفّه فإنّ الواجب بعد ذلك هو غسل الرِّجلين، وحيث أنه قد جفّت الأعضاء فلا يسوغ له أن يغسل الرِّجلين؛ لأنّ الشرط هو الموالاة، ولا موالاة إذن، فدلّ ذلك على صِحّة مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن الواحد إذا خلع خُفّيه فإن طهارته تبطُل، والله أعلم.
3. لو مسح مسح مُقِيم ثم سافر، أو مسح مسح مُسافِر ثم أقام، فما الحكم؟
الجواب: الصورة الأولى: لو أنّه مسح مسح مُقِيم ثم سافر قبل انتهاء مدة مسح المقيم:
فقد اختلف العلماءُ فيها، والراجح والله أعلم هو أنّ له أن يمسح مسح مُسافر، خلافا للمشهور عند الحنابلة، وذلك لأنّه داخلٌ في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسّال: أمرنا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ألّا ننزِع خِفافنا إِذا كُنّا سفرا ثلاثة أيّام بِليالِيهِنّ. وهذا الشخص قد سافر قبل انقضاء المدة، كما لو سافر ثم مسح، فدلّ ذلك على أنّ الصحيح أنّه يمسح مسح مُسافر.
صورة المسألة: شخصٌ مسح على خُفّيه بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة، فلمّا كان عشاء يوم الجمعة سافر خارج بلدته، فلمّا أراد أن يمسح من الغدِ لصلاة العصر كانت المدة قد انتهت، أليس كذلك؟ نعم إذا كانت مدة مُقِيم، لكنّه لما سافر في أثناء مدة الإقامة فإن له أن يمسح، بقي له يومان، وهذا هو الراجح، والله أعلم، وهو المذهب المعتمد عن الحنفية، وهو اختيار مشايخنا، كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، والله أعلم.
المسألة الأخرى: مسح مسح مُسافِر ثم أقام:
الجواب: أنّه يعتمد على مسح مُقِيم، فعلى هذا لو مسح مُسافِرٌ يوما ونصف يوم، ثم قدم بلدته فهل تنتهي مدة المسح؟
الجواب: تنتهي مدة المسح، وهذا محلُّ إجماع عند أهل العلم ممن يقول بوجوب التوقيت، خلافا للمالكية، فذهب عامّةُ أهل العلم القائلين بوجوب تحديد مدة المسح، ثلاثة أيّام ولياليهن للمُسافر، ويوما وليلة للمُقِيم خلافا لمالك؛ فقالوا كل من قال بالتوقيت قال إذا رجع إلى بلده بعد انتهاء مدة مسح يوم وليلة، فإن وضوءه حينئذ يكون باطلا، ويجب عليه أن يخلع الخُفّ، ويغسل رِجليه بعد وضوء كامل.
وهذا قال فيه ابنُ قُدامة : بغير خلاف نعلمه. وحكى ابنُ المُنذِر إجماع أهل العلم على ذلك فيمن يرى التّوقيت، والله أعلم.
القول بأن عامة أهل العلم يقولون بتحديد المدة، فهل يكون تحديدُ المدة ووقتها مع النية أو لاحقا حينما يُسافر الواحد؟
الجواب: لا، تحديد المدة – وهي مدة المسح – إنّما تكون للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وللمُقِيم يوما وليلة، ونحن في أول شرحنا ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في: هل التوقيت يُؤقّتُ أم لا؟ فذهب مالكٌ إلى أنّه ليس له مُدّةٌ، والرّاجح أنّ له مُدّة، فالقائلون أنّ له مُدّة قالوا: لو كان مُسافرا ثم رجع إلى بلده، فإن كان حال سفره مسح أكثر من يوم وليلة؛ فإن مدة المسح حينئذ تكون مُنتهية، وعلى هذا فيجب عليه أن يخلع، فإن كان قد مسح وهو مسافِرٌ نصف يوم ثم قدِم إلى بلده؛ فله أن يمسح أثناء هذه المدة بحيث يستكمِل يوما وليلة، وهذا – كما قلت – هو قول عامّة من يرى التوقيت في المسح.
4. لو أنه لبس الجزمة التي يُسمِّيها العامة الآن “الكنادِر” أو “الشوز” باللغة الأجنبية، فلبسه على طهارة ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإذا مسح على الكنادر والجوارب ثم خلع، فالرّاجح أنّه لا يصح مسحُه كما قلنا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لكن على قول من قال أنّه يصح قالوا: يُصلِّي على الجوارب، لكنه إذا أراد أن يمسح مرة ثانية، فذهب عامةُ أهل العلم إلى أنّه ليس له أن يمسح مرّة ثانية، لِم؟ لأنّ الطهارة هنا طهارةُ مسح وليست طهارة غسل، لماذا؟ لأنّه مسح على خُفّ ثم نزعه، فلا يسوغ له أن يمسح مرّة ثانية به.
وهذا قول عامّة أهل العلم، وعلى هذا فإذا كان وقت الشتاء فلبس الواحد جوربا واحدا ثم أحسّ ببرودة ثم لبس عليه جوربا آخر، فهل له أن يمسح على الجورب الثاني الأعلى؟
ذهب جمهورُ أهل العلم إلى أنّه ليس له أن يمسح، قالوا: لأنّه حينما أدخل الخُفّ الثاني أو الجورب الثاني أدخله بطهارة مسح، والرسول صلى الله عليه وسلم علّق ذلك بقوله: «إِنِّي أدخلتُهُما طاهِرتينِ». أي طهارة مائية، كما نقلنا ذلك القول عن عامة أهل العلم خلافا لِزُفر من المالكية.
وعلى هذا؛ فالذين يريدون أن يلبسوا جوربا ثانيا لا حرج عليهم، لكن لا يُعلِّقُون به مسحا. فإذا لبس الخُفّ الأدنى ثم مسح عليه؛ فله أن يلبس الخُفّ الأعلى، لكن إذا أراد أن يتوضأ فيخلع الخُفّ الأعلى ثم يمسح على الأدنى.
الصورة الأخرى: غسل رِجليه ثم لبس جوربين، ثم مسح بعد حدث على الجورب الأعلى، فإذا خلع الجورب الأعلى فهل تبقى طهارتُه أم لا؟
قلنا: إذا كان قد لبِس خُفّين وخلع الأعلى، فالذي يظهر – والله أعلم – أن هذا حكمه حكم الخُفِّ الذي له بِطانة وظاهِرة، وليس مثل الذي نزع خُفّه وبقي عضو الغسل الذي هو الرِّجل، فالراجح في هذا أنّه يبقى طاهرا؛ ولكن لا يسوغ له أن يمسح مرّة أخرى، والله أعلم .
العبرة بانكشاف العضو، أمّا إذا كان قد لبِس خُفّين ثم نزع الأعلى فيبقى طاهرا لأنّه مثله، ويمسح بمُدّة المسح، لكن الأحوط في هذه الصورة أنّه له أن يبقى طاهرا، لكن لا ينبغي له أن يمسح، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، والله أعلم.
سؤال: في المسح على الخفين، الأول: أن فِعل المسح ثم نزع ليُغيِّر الجوارب، ما الحكم؟
نقول: إذا كان قد غسل رِجله ثم لبِس الخف أو لبس الجوارب، ثم نزع، فنقول إلى الآن هو طاهر، لأن وجود الخف أو نزعه لم يُعلّقُ به حُكمٌ بعد، لكنه لو أحدث ثم خلع فلا يسوغ له أن يعيد مرة ثانية.
نقول: إذا كان قد غسل رجله ثم لبس الخف أو لبس الجوارب، ثم نزعها ولم يحدث، فإنا نقول له أن يغير الخف مرة ثانية.
المسألة الأخرى: إن مسح على الأول ثم لبس الثاني، وهو لا يزال على طهارة، ما الحكم؟
نقول: إن كانت الطهارة طهارة مسح، فله أن يلبس، لكن لا يمسح على الثاني، وإن كانت الطهارة الأولى طهارة غسل ثم لبس الخف وهو ما زال طاهرا لم يحدث فله أن يلبس الخف الثاني، ويمسح على الثاني ويكون الحكم مُعلّقا بالمسح على الثاني، والله أعلم.
الثالث: لبس الجورب الثاني ونزعه أي الثاني وهو لا يزال على بقاء طهارته ما الحكم؟
ذكرنا الخلاف وقلنا أن الذي يظهر على أن من نزع خفه، هو مذهب الشافعي والحنابلة هو أنه ينقُضُ وضوءه وهذا هو الأحوط لإبراء الواحد من ذمته وخروجه من عهدة الطلب بيقين.
سؤال: ما قولكم فيمن يقولون بأن مقدار المسح على الخف يكون بنحو عدة أصابع؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبيِّن لنا صِفة المسح، إنما كان يمسح على ظاهر قدمه، كما روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، هذا هو الأصل، وعلى هذا فإنه يمسحه بما يستطيع، أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع، فإن هذا يكتفي بإذن الله؛ لأنّ هذا هو غالبُ اليد، والمقصود بذلك المسح بغالب اليد الماسحة فإذا كانت هي الغالب بالأصابع فإن ذلك يُجزِئُ، أما المسح بإصبع واحد فليس هذا هو المسح باليد؛ لأن اليد لا تطلق على الإصبع، إنما تطلق على جميع الأصابع، والله أعلم.
5. المسح على الجبِيرة:
ذكرنا المسح على الجبِيرة، وقلنا: الرّاجح أنّ المسح على الجبِيرة لا يُشترط لها الطّهارة، وقلنا أنّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أدخلتُهُما طاهِرتينِ». إنّما هو في الخُفِّ، وليس في العِمامة ولا الجبِيرة، وهذا هو الراجح؛ وذلك لأنّ الأصل في العضو قبل وجود العمامة هو المسح، وبعد وجود العمامة هو المسح، فلا أثر للتغيير حينئذ.
وأمّا الجبِيرة: فإن لُبسها إنّما كان لحاجة وفجأة، فلو قلنا أنّه لابُدّ أن يُدخِلها طاهرة لشقّ ذلك على المسلمين، خاصّة وأن المسلمين يُجاهدون في سبيل الله فيقع عليهم الجُرحُ فيربِطُوهُ، ولهذا قال الحسن – كما روى البخاري مُعلّقا بصيغة الجزم: “ما زال المسلمون يُصلُّون بجراحاتهم”. وهذا يدلُّ على أنّ جراحاتهم كانت ملفوفة ولم يُؤمروا بأن يتوضّؤوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلمّا لم يُبيِّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم دلّ على أنّ مسح الجبِيرة يُفارق المسح على الخفين.
ولعلنا نتذكر نحن وإيّاكم الفروق بين المسح على الجبِيرة والمسح على الخفين:
الفرق الأول: أنّ المسح على الجبِيرة لا يلزم منه الطهارةُ، وأمّا المسح على الخُفّين فيلزم منه الطهارةُ المائية.
الفرق الثاني: أنّ الراجح في المسح على الجبِيرة أنّه لا يُشترط له مُدّة، بخلاف المسح على الخفين فيُشترط له المدة.
الفرق الثالث: أنّ المسح على الجبِيرة الراجح فيه أنه يمسحها كلها، وأمّا المسح على الخُفّين فإنّما يمسح الأعلى منهما ولا يمسح الأدنى، وقد جاء في ذلك حديثٌ عن علي بن أبي طالب حيث قال: “لو كان الدِّينُ بِالرّأيِ لكان مسحُ أسفلُ الخُفِّ أولى بِالمسحِ مِن أعلاهُ، وقد رأيتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسحُ أعلى الخُفِّ”. وهذا الحديث في سنده نكارةٌ، وذلك لأنّ حفص بن غِيّاث أخطأ في ذلك، والمشهور عن عليّ أنّه قال: “رأيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ أعلى الخُفِّ”. فقط، ولم يقل: “لو كان الدِّينُ بِالرّأي…”. فهذه زيادةٌ من حفص بن غياث، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو داود -رحمه الله- فهذا هو الفرق الثالث، وهناك فروق أخرى ذكرها الإمام المِرداوِي في كتاب “الإنصاف”.
إذا ثبت هذا، فلنعلم أنّ المجروح لا يخلو جُرحُهُ من أن يكون على حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الجُرحُ مكشوفا.
الحالة الثانية: أن يكون الجرحُ مستورا.
فالجرح إذا كان مكشوفا فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: إذا كان لا يضره الغسلُ، فإنّه يجب عليه أن يغسل هذا الجرح؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «أسبِغُوا الوُضُوء». وقول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم إِلى المرافِقِ وامسحُوا بِرُءُوسِكُم وأرجُلكُم﴾ [المائدة: 6].
الحالة الثانية: إذا كان يضره الغسل، ولكن لا يضره المسحُ، فإن الواجب في حقِّه أن يمسح ولا يتيمم؛ وذلك لأن طهارة مسح الماء أقوى من طهارةِ مسح التراب. وعلى هذا فالراجح أنّه يمسح، وهذا أقوى كما أشار إلى ذلك الحنابلة – رحمهم الله.
الحالة الثالثة: أن يضره الغسلُ ويضره المسحُ، فإنّه حينئذ يتيمم، يتيمم للعضو الذي يضره الماء، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا بجواز الجمع بين الماء والتيمم، وعلى هذا فإذا أراد أن يتوضأ فهو بالخيار: إمّا أن يتوضأ للأعضاء التي لا يضرها وصولُ الماء ثم بعد ذلك يتيمم لما لم يُصبه الماء، ويكون الترتيب حينئذ معفُوٌّ عنه.
أو يتيمم ابتداء لما يضره وصول الماء إليه، ثم بعد ذلك يتوضأ.
فلو أن إنسانا جُرِح في يده، وشقّ عليه غسله ومسحه، فإننا نقول: أنت بالخيار: إمّا أن تتيمم بنية رفع الحدث عن هذا العضو ثم بعد ذلك تتوضأ لجميع أعضائك ما عدا هذا، أو أنّك تتوضأ وتغسل أعضاءك ما عدا مكان الجرح، ثم بعد الوضوء تتيمم، ولا شكّ أنّ الحالة الثانية فيها مشقّةٌ؛ لأن يديهِ ما زالتا رطبتين، فربما تيمم فعلِقت في يديه الأتربة وشقّ ذلك عليه، والله -تبارك وتعالى- أعلم.
هذه ثلاثة أحوال للعضو إذا كان مكشوفا.
الحالة الثانية إذا كان العضو مستورا، وهذا هو المسح على الجبِيرة، والراجح أنّ المسح على الجبِيرة لا يُشترطُ له الطّهارة، ولا يشترط له المدة، وهذا رواية عند الإمام أحمد، وهو قولٌ عند الحنفيّة والمالكية، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية – رحمه الله.
وعلى هذا فإنّه يمسح الجبِيرة إذا جاء وقتُ العُضو الذي هو وقته من حيث الترتيب، فلو كانت شجّته في رأسه ثم وضع جُبيرة عليها ثم أراد أن يتوضأ، فإنّه يتوضأ فإذا جاء إلى الجبِيرة فإنّه يمسحها، هذا هو الراجح – والله أعلم .
وذهب ابنُ حزم إلى أنّه لا يتيمم ولا يتوضأ؛ لأنّه قال: هذا في حكم العاجز، والعاجز لا حكم له.
والراجح والله أعلم أنّه لابُدّ فيه من تيمُّم أو مسح، ولا شكّ أنّ المسح أقوى، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والله أعلم.
مسألة: أن بعض الإخوة في الجبِيرة يُبالغ في الزيادة، فإذا كان الكسر في الساعد تجد أنه يزيد حتى أعلى المرفق، مع أن الأطباء يستطيعون أن يجعلوها في أول الإبهام، فحينئذ نقول: شروط المسح على الجبِيرة ألا يزيد عن موضع الحاجة، والله أعلم.
9. نواقض الوضوء
نواقض الوضوء:
تعريف الناقض – 1. النواقض التي تنقض بالإجماع – 2. النواقض المختلف فيها والراجح نقضها للوضوء – 3. النواقض المختلف فيها والراجح عدم نقضها للوضوء – ما حُكم مس المُحْدِث للمصحف؟ – هل يمكن للجنب قراءة المصحف؟ – هل يمكن للحائض قراءة المصحف؟ – من تيقّن الحدث وشّكّ في الطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث؟
تعريف الناقض:
النواقض جمع ناقض، وهي الأسباب والعِللُ المُؤثِّرةِ على الوضوء، ذلك أن من النواقض ما هو ناقضٌ بنفسه كالريح والبول والغائط ونحوِ ذلك. ومنها ما هو سببٌ مُوجِبٌ، وليس لذاته، مثل: مس الرجل امرأته بشهوة عند من يقول بذلك وهم الحنابلة والشافعية، وإن كان الشافعية يوجبون الوضوء حتى ولو لم يكن بشهوة. أو النوم، فإن النوم ليس ناقضا بذاته، ولكنّه مظِنّة الحدث، فصار ذلك بالسبب وليس بذاته، والله أعلم.
ونواقض الوضوء ثلاثة أنواع:
أولا: نواقض تنقض بالإجماع.
ثانيا: نواقض مُختلفٌ في حُكمِها، والرّاجح النقض.
ثالثا: نواقض مختلفٌ في حكمها، والرّاجح عدم النقض.
إذا ثبت هذا فلنشرع في القسم الأول.
1. النواقض التي تنقض بالإجماع
المجمع عليه من النواقض هو اثنان، الأول: الخارج من السبيلين كالريح والبول والغائط والمني والمذي، والثاني: زوال العقل.
الناقض الأول الخارج من السّبِيلين:
السّبِيلُ هو الطريق، والمقصود به الخارج من القُبُلِ والدُّبُرِ، وهذا الخارج محل إجماع عند أهل العلم في الجملة، فليس كلُّ ما خرج من السّبِيلين ناقضٌ؛ لأنّ هناك بعض الصور ليست بناقضة كالريح من قُبُلِ المرأة، وكرطوبة فرجِ المرأة، فالراجح أنّه لا ينقض الوضوء.
والخارج من السّبِيلين على نوعين:
النوع الأول: خارج مُعتادٌ كالريح والبول والغائط والمذِيُّ والوديُ، فهذا ناقضٌ بإجماع أهل العلم.
النوع الثاني: ما خرج من غير اعتياد كالشعر والحصى، فهذا عامّة أهل العلم على أنه ناقضٌ خلافا لمالك، ويُسميه العلماء “غير معتاد”، فليس من المعتاد أن يخرج الحصى من السّبِيلين. وكذلك خروج حصوة كلى مع البول، قال جماهير وعامة أهل العلم أنّه ينقض؛ لأنّه لابُدّ أن يكون قد علِق به شيءٌ من النجاسة، والله أعلم.
ومن المجمع عليه أيضا المذي:
والمذي هو ما يخرج بعد فتور الشهوة من غير قذف، فهذا يجب فيه الوضوء؛ لما جاء في الصّحيحين من حديث عليّ رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عنه فقال: «يغسِلُ ذكرهُ ويتوضّأ». وفي رواية مسلم: «توضّأ وانضح فرجك». فهذا يدلُّ على وجوب الوضوء.
ومن المجمع عليه أيضا خروج المني:
فإنّه ناقضٌ للوضوء بإجماعِ أهل العلم، وكون المني طاهرا أم ليس بطاهر شيءٌ، وكونه ينقضُ للوضوء شيءٌ آخر.
وكذلك الحيض والإستحاضة ينقض:
ولكن من كان حدثه دائما، وهو الذي يتبوّل من غير إرادة منه، فهذا حدثُه دائمٌ، وهو ما يُسمّى بسلس البول، كالمستحاضة فحدثها دائم، فهل خروجه ناقضٌ أو ليس بناقض؟
ذكر ابن تيمية أنّ من كان حدثُه دائما فإنّه لا ينقض على الإطلاق، قال: وهذا باتِّفاق الأئمة. قال: وغاية ما في ذلك اختلافهم: هل يجب الوضوءُ لدخول وقت كلِّ صلاة أم لا يجب؟
ونقول: ذهب الحنفيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ إلى أنّ من حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لدخول وقت كلِّ صلاة، أي لصلاةِ الفريضة كلها، على الخلاف بين أبي حنيفة وبين الشافعي وأحمد.
قالوا: لأن الأصل أنّ من خرج منه الحدثُ يجبُ عليه الوضوء؛ لقول الله تعالى: ﴿أو جاء أحدٌ مِنكُم مِن الغائِطِ﴾ [النساء: 43]. قالوا: ولكن كونُ حدثِه دائمٌ خُفِّف في ذلك، فكان لو صلى فخرج فإن صلاته صحيحةٌ من باب التّخفيف ورفع الحرج، فإذا دخل وقت الصلاة فإن الله يأمرنا بقوله: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم﴾ [المائدة: 6]، فيكون من ضمن المخاطبين بذلك.
وهذا القول أحوط.
وأمّا الحديث الذي جاء في المستحاضة: «وتوضّئِي لِكُلِّ صلاة»، فإن الصحيح أن هذا من قول عروة بن الزبير، وأن حمّاد بن زيد رواه عن أيوب السّختِياني فأخطأ فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الرواة رووه عن أيوب السّختياني من غير زيادة: «وتوضّئِي لِكُلِّ صلاة». ولو كانت هذه الزيادة صحيحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكلِّ صلاة، ولأجل هذا الخلاف قال مالك – وهو القول الثاني – أنّ الطهارة لإرادة الصلاة مُستحبة. وهذا اختيار ابن تيمية.
والأحوط هو الوضوء، وذلك لأن الحديث وإن كان من قول عروة لكن الأصل أن الواحد مأمور بالوضوء إذا دخل وقت كل صلاة، لكن خرج هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمدا صنعتُ يا عُمرُ». أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فصار فيه دليلٌ على عدم وجوبِ الوضوء لكلِّ صلاة، فدلّ ذلك على استحبابه.
فكل من كان حدثُه دائما وجب عليه الوضوء لكل صلاة، والله أعلم (لا يضره ما خرج بعد ذلك).
وهل ينطبق هذا الكلام على من يشك هل خرج منه شيء كرائحة وغيرها؟
الجواب: لا، فالذي يشك هل خرج مني شيءٌ أم لا، ليس حدثُه دائما كمن به سلس البول. فهذا يشك في خروج شيء، والأصل عدم خروج شيء إلا أن يتأكد.
أمّا من كان لا يخرج منه البولُ إلا بعد قضاء الحاجة، وهو الذي يسمى صاحب سلس البول المتقطع، فإذا أحدث يبدأ يخرج منه لمدة ساعة أو أكثر ثم يتوقف حتى يحدث مرة أخرى:
فهذا إذا جاء وقت الصلاة التالية يتوضأ، فإن لم يخرج منه شيءٌ بعد ذلك فلا يلزمه الوضوء، والله أعلم (يجب عليه الإنتظار حتى يزول ذلك فيتوضأ، ولا يتوضأ وهو عليه لأن وضوءه غير صحيح في تلك الحالة، فإن تأكد من انقطاعه ثم عاد فجأة وهو في الصلاة فلا شيء عليه).
ولكن ينبغي له أن يغسل ثوبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي: «يغسِلُ ذكرهُ ويتوضّأ». ويقول: «انضح فرجك».
وقد أجمع أهلُ العلم على أنّ نضح الثوب واجبٌ، ولكن اختلفوا في وجوب غسله، والراجح أن النضح أخفُّ من الغسل، والله أعلم.
سؤال: هل يجوز لمن عنده سلس بول متقطع بحيث ينزل منه نقطة في أوضاع معينة إذا جلس مثلا، أن يقوم لصلاة التّهجُّدِ ليلا أي قبل الفجر بحوالي ساعة ثم يصلي الصبح بنفس الوضوء الذي صلى به التهجد؟
الجواب: سلس البول ينقسم إلى قسمين: سلس دائم، وسلس منقطع، أي غير دائم.
فالسلس الدائم، يتوضأ الواحد لكل صلاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنيفية والشافعية الحنابلة.
أما السلس المنقطع، وهو أن يأتي بعد قضاء البول بعشر دقائق مثلا، فنقول: إن كان يمكن أن يتوضأ قبل الوقت أو بعد الوقت بمسافة، فإنه إذا قضى حاجته يتأخر لا يتوضأ، إلا إذا خشي صلاة الجماعة فإنه يتوضأ، ثم ما خرج منه بعد ذلك، فلا يُعوّلُ عليه، ويستمر في صلاته، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنه يتوضأ، فإن استمر وضوءه من غير حدث حتى جاء وقت الصلاة الأخرى فإنه لا يتوضأ؛ لأنه لم يخرج منه شيء.
وعلى هذا فالسلس المُتقطِّع، إن نزل شيء فهو مأمور أن يتوضأ، ولا يصلي صلاة الفجر بصلاة التهجد؛ لأنه أحدث، والله أعلم.
الناقض الثاني من النواقض المجمع عليها: زوال العقل.
وهو إمّا أن يكون بالكلية كالجنون، وإمّا أن يزول لمُدّة كالسُّكرِ والإغماء والنوم.
أمّا الجنون والسُّكر والإغماء فإنّه ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن المُنذِر رحمه الله في كتابه “الإجماع”، ودليل ذلك ما جاء في الصّحيحين أنّ النبي صلى الله عليه وسلم في حال وفاته أُغمِي عليهِ ثُمّ أفاق فقال: «أصلّى النّاسُ؟» قالوا: لا، هُم ينتظِرُونك يا رسُول اللهِ. قال: «ضعُوا لِي ماء فِي المِخضبِ». فذهب وتوضّأ، ثُمّ ذهب لِينُوء، فأُغمِي عليهِ ثُمّ أفاق، فقال: «أصلّى النّاسُ؟» قالُوا: لا، وهُم ينتظِرُونك يا رسُول اللهِ. فقال: «ضعُوا لِي ماء فِي المِخضبِ». ثُمّ توضّأ.
الشاهد: أنّه حينما توضأ ثم أُغمي عليه ثم أفاق أمر بأن يتوضأ مرة ثانية، فدلّ ذلك على أن زوال العقل بالإغماء أو بالسُّكرِ أو بالجنون أنه ينقضُ الوضوء، والله أعلم.
2. النواقض المختلف فيها والراجح نقضها للوضوء:
الناقض الثالث: النوم. وقد اختلف العلماءُ فيه.
لكن أولا هل النوم حدثٌ أم مظِنّة حدث؟
الراجح – وهو مذهب جماهير أهل العلم – أنّه مظِنّة الحدث، لأن الأصل أن الواحد إذا شكّ هل استغرق في النوم أم لا، هو عدمُ الحدث.
وقد اختلف العلماءُ في مسألة النوم: هل هو ناقضٌ أم لا؟
على ثمانية أقوال، ذكرها الحافظُ ابن حجر في “فتح الباري”، والذي يهُمُّنا هو القول الراجح، وهو مذهب أهل التحقيق: وهو أنّ النوم إذا لم يكن مُستغرقا، ولم يكن كثيرا، وسواء على أيِّ حالة كان، فإنّ وضوئه باق، فإن ظنّ بقاء الطهارة أو غلب على ظنه أنّه لم يخرج منه شيءٌ، فالراجح أنّه لم يخرج منه شيءٌ، وإن غاب عقلُه في النوم بحيث بدأ يحلم أي تعمق في النوم ورأى رؤيا مثلا؛ فإن هذا يدل على أنه قد استغرق.
وعلامة الاستغراق من عدمه ليست هي وجود الغطيط أو سقوط الرأس أو كونه مضطجعا، بل النوم الكثير الذي لا يستحضِر صاحبه ولا يعِي من بجانبه، فإذا كان قد نام وهو مع ذلك يسمع ضجيج الناس ولكنه لا يستوعبه فهذا يسمى نوما خفيفا، وأمّا إذا رأى رؤيا في منامه فهذا قد استغرق، أي ربما لا يستشعر بوقوع الحدث منه.
فإن استغرق في نومه فقد انتقض وضوؤه؛ لقول علي رضي الله عنه: “العينُ وِكاءُ السّهِ، فإِذا نامتِ العينانِ استطلق الوِكاءُ”، والحديث صحّحه بعضُ أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن في سنده انقطاعٌ؛ وذلك لأن عبد الرحمن بن عائِذ لم يسمع من عليِّ بن أبي طالب.
وقد جاء ما يقويه عن معاوية بن أبي سفيان، فيدل على أن الحديث له أصل، وحديث معاوية فيه ضعفٌ، ولكن بمجموع طُرقه يدلُّ على صحة رواية: “العينُ وِكاءُ السّهِ” وحدها.
ومعنى (وكاء السه): أن العين بمثابة الرِّباط الذي يربط دُبُر الواحد بحيث يستحضر، فإذا نامت العينان فكأن ذلك نوعٌ من استطلاق الوكاء، والله أعلم.
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: “كان أصحابُ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ينامُون عِند صلاةِ العِشاءِ، ثُمّ يقُومُون ويُصلُّون ولا يتوضّؤُون”. وفي رواية: “تخفِقُ رُؤُوسُهُم”. وفي رواية عند الدّارقُطنيّ مُصحّحة قال: “حتّى إِنّ لأحدِهِم غطِيطا – الشّخِيرُ – ثُمّ يقُومُون فيُصلُّون ولا يتوضّؤُون». فهذا يدلُّ على أنّهم لم يستغرقوا في النوم.
وأمّا قول الحنابلة أنّهم كانوا جلوسا، فمن كان جالسا ونام نوما يسيرا فلا ينقض وضوؤه، فهذا الراجح أنّه حِكايةُ حال، أي هيئة، والهيئة في الغالب لا يُعلّقُ بها حكمٌ.
ولهذا صار القولُ الراجحُ، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية وقول بعض فقهاء الإسلام، هو الجمع بين الآثار، فجاءنا حديث صفوان بن عسّال: “أمرنا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن لّا ننزِع خِفافنا ثلاثة أيّام بِليالِيهِنّ، ولكِن مِن غائِط وبول ونوم”. فدلّ ذلك على أنّ النوم ربما يكون حدثا أو مظِنّة حدث. فلمّا جاءنا حديثُ أنس: “ينامُون ثُمّ يقُومُون ولا يتوضّؤُون”. دلّ الجمع بين الحديثين على أن حديث صفوان هو في النوم المُستغرق، وحديث أنس في النوم غير المستغرق، والله أعلم.
إذن النوم إذا لم يكن مُستغرقا ولا كثيرا، فسواء كان على أيّة حال، أي سواء كان جالسا أو مضطجعا أو أو ساجدا أو غير ذلك؛ فلا أثر لهذه الهيئة والحالة، وإنّما الأثر هو الاستغراق.
وقد قلنا إن في المسألة ثمانية أقوال: فبعضهم يقول: نوم الجالس يُعذر وما عداه لا. وبعضهم يقول: نوم الساجد يُعذر وما عداه لا. وبعضهم يقول: النوم على الجنب يعذر. وغير ذلك من الأقوال.
والذي يظهر هو أن العبرة بحال النوم واستغراقه لا بهيئته، فالعبرة بكيفيته فإن لم ير ولم يسمع ولم يشعر بأحد، فهذا نوم مستغرق أي ناقض للوضوء، أما إن أحسّ بضجيج الآخرين ولكنّه لم يستوعبه؛ فهذا يدلُّ على أنه نوم خفيف، والله أعلم.
وأحيانا يقول الواحد: أنا ما أدري هل نمت أم لا؟
خاصّة الذين يذهبون من الميقات، ربما تخفِقُ رُؤُوسُهم، وربما ينامون.
نقول: إذا شككت هل نمت أم لا، فالأصل هو بقاء الطهارة، والله أعلم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولكِن مِن غائِط وبول ونوم» دليلٌ على أنّ النوم مظِنّةُ الحدث، كما أشار إلى ذلك الإمامُ ابن رُشدِ في “بداية المجتهد”، وابن تيمية.
وقول أنس: “تخفِقُ رُؤُوسُهُم” دليلٌ على أنّ وجود الغطيط لا يدلُّ على الاستغراق في النوم، والله أعلم.
وكون الصحابة قد ناموا وهم جلوسٌ لا يدلُّ على تعليق الحكم بفعلهم؛ لأنّ هذا يُسميه العلماء الوصف الطّردِي، ولا يُعلِّق الشارعُ الحكم به، مثل: قول أعرابي منفوش الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكتُ. حينما جامع أهله في نهار رمضان، فلا يُعلّق بأن يكون أعرابيّا وأن يكون نافش الشعر؛ لأن هذا من الأوصاف الطردِيّة، والوصف الطردي لا يُعلِّق الشارعُ به حكما.
الناقض الرابع: مسُّ الذكر أو مس القُبُلِ.
فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال.
القول الأول: وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا ان مس الذكر أو مس القبل للمرأة ناقض للوضوء.
وذلك لأحاديث منها حديث بُسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره؛ فليتوضأ»، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن معِين، وقال البخاري: أصح شيء في الباب، وكذلك صححه التِّرمِذِيّ، وصححه غير واحد من أهل العلم، وهو أصح من حديث طلق بن علي، الذي رواه قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجلِ يمسُّ ذكره فقال: «إنما هو بضعةٌ منك».
إذن الراجح هو أنّ مس الذكر أو مس القُبُلِ ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وأما مالك رحمه الله؛ فإنما يرى أن الوضوء من مس الذكر مستحب، قال: لأن حديث طلق صحيح، وقد صحح حديث طلق علي بن المدِينِي، وكذلك ابن حبان، وابن حزم، وغيرهم.
فقالوا: إن حديث طلق صحيح، وحديث بُسرة صحيح، وهو: «من مس ذكره؛ فليتوضأ»، قالوا: فدل ذلك على أن الأمر يدل على الإستحباب، والبقاء على الأصل “إنما هو بضعة منك” يدل على عدم الوجوب.
وهذا يقوله جمعٌ، والذي يظهر والله أعلم هو أن حديث بسرة أولى من حديث طلق لأمور:
أولا: لأن حديث بسرة أصح من حديث طلق، وذلك لأن قيس بن طلق بن علي اختُلِف فيه، مع أنه اختلف في سماعه عن أبيه.
الثاني: أن حديث بسرة قد تلقاه الصحابة بالقبول، وبدأوا يروونه، فلهذا كان ابن عمر حينما بلغه حديث بسرة بنت صفوان رجع إليه، وكذلك سعد بن أبي وقاص.
الثالث: أنه جاءت أحاديث تعضُدُ حديث بسرة ولم يأت أحاديث أخر غير حديث طلق بن علي، فجاءنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس الفرج؛ فليتوضأ»، أو «إذا أفضى أحدُكم إلى فرجه؛ فليتوضأ»، وقال البخاري: حديث عبد الله بن عمرو، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عندي صحيح، وإن كان الإمام أحمد نُقل عنه ضعفُه، وكذلك جاء من حديث أم حبيبة صححه الإمام أحمد، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، فهذه أحاديث تدل على أن حديث بسرة بنت صفوان هو الأصل.
الرابع: أن حديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء، وحديث طلق بن علي «إنما هو بضعة منك» لا يوجب الوضوء، قالوا: وحديث طلق بن علي هو بناء على الأصل، وحديث بسرة هو ناقِلُ عن الأصل، فدل على أن حديث بسرة هو المتأخر، قالوا: والقاعدة في هذا أن كل حديث ناقل عن الأصل هو أولى منه.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مس الذكر أو القبل لا ينقض الوضوء، ورأى أن حديث طلق بن علي أصح في هذا الباب.
لكن الذي يظهر وهو الأحوط لإبراء الذمة أن مس الذكر أو مس القبل ينقض الوضوء.
إذن مس الذكر أو القبل ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم ليس بشهوة، هذا هو الذي يظهر.
وأما إذا كان ذلك المس بغير قصد فلا يقال انه “أفضى بيده إلى فرجه” لأن الإفضاء يكون بقصد، فلا ينقض. لذا يجب أن يقصد مس الذكر، سواء كان بشهوة أو بغير بشهوة حتى ينتقض وضوئه.
وهذا القول أي “بشهوة أو بغير بشهوة”، أحوط.
هل يدخل مس الدبر (حلقته) في حديث “من مس فرجه فليتوضأ”، أم لا؟
قال بعض أهل العلم إن الفرج إذا أُطلِق إنما يقصد به القبل. والذي يظهر والله أعلم، وهو الأحوط، وهو مذهب الحنابلة أن مس حلقة الدبر كمس القبل.
وبالنسبة للمرأة:
قبلها هو الأمر الداخل، أما ما كان بجانبه فلا ينقض الوضوء، فمس الشفرتان لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء مس المكان الذي فيه ختان المرأة؛ لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: «أيُّما امرأة أفضت بيدِها إلى فرجها؛ فعليها الوضوء».
والمقصود في المس أي باليد:
والمقصود باليد الكف، باطنها وظاهرها، وأما من مس فرجه بذراعه أو بساعديه فلا يُعلّقُ به حُكمٌ، وذلك لأن اليد في لغة العرب هي الكف؛ لقول الله تعالى: ﴿ والسّارِقُ والسّارِقةُ فاقطعُوا أيدِيهُما ﴾ [المائدة: 38]، والله أعلم.
والممسُوس لا ينتقض وضوئه بل الماس:
فلو أن رجلا مس عورة امرأة فالمنتقض وضوؤه هو الرجل؛ لأنه اللامس، وأما المرأة فلا ينقض وضوؤها، أو العكس لو أنّ امرأة مسّت عورة زوجها؛ لأنّ العِبرة باللامسِ لا بالملموس، وهذا قول عامة أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من مسِّ الفرج.
ما حكم مس عورة الطفل، هل ينقض الوضوء أم لا؟
للحنابلة روايتان: ذهب الحنابلة وهو فتوى للإمام أحمد في آخر أمره، إلى أن الطفل ليس له عورة أصلا، وبالتالي إذا أرادت المرأةُ أن تنظف صبِيّها فمست عورته فإن وضوءها باق، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
والقول الثاني: أن مس المرأة عورة صبيها ينقُضُ الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسّ الفرج؛ فعليه الوضوء»، فجعل الفرج عامّا، و”أل” تفيد الاستغراق، ولا شك أن هذه المسائل ليس فيها شيء مقطوع به، ولهذا كان الأحوط بالمرأة أن تتوضأ، فإن لم تتوضأ فالذي يظهر أن الصبي لا عورة له، والله أعلم
فإن شق عليها الوضوء كأن تكون في نزهة برية في وقت البرد، فلو وضعت قفازين فهو أفضل، وإلا فإنه لا يلزمها الوضوء، والله أعلم .
واستندوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الحسن وقبل زبِيبتهُ، قالوا وهذا الحديث في سنده بعض الضعف، ولكن توجد أحاديث فيقوي بعضها بعضا، والذي يظهر لي أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقِي وغيره لأن في سنده محمد بن أبي ليلى، وهو كما قال أبو أحمد الحاكم يكاد الأئمة يتفقون على ضعفه.
وعلى هذا فالذي يظهر لي أن الصبي أجمع العلماء على أنه حال ولادته ليس له عورة، فلا بأس بالنظر إليه، قالوا: فلما دل على جواز النظر إليه، دليلٌ على أنه لا عورة له، والله أعلم.
والطفل الذي لا عورة له هو الطفل الذي لم يميز مثل الطفل الذي عمره سنة أو سنتان، أما إذا ميز أي أصبح ابن ست أو سبع سنين، فلا، والله أعلم.
ماذا عن مس الذكر من فوق اللباس؟
الجواب: هذا لا حُكم له، إذا كان بينه وبين عورته حائل فإنه لا ينقض وضوؤه، المقصود هو إذا لم يكن بين يده وفرجه حائل، وأما مع وجود الحائل لا ينقض الوضوء.
ويجب أن يكون حائلا يمنع وصول يده إليه، سواء كان من بلاستيك أو غيره (ملابس أو قفاز إلخ).
الناقض الخامس: هو أكلُ لحمِ الجزُورِ.
اختلف أهل العلم في حكم لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين: الأول: مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية هو أنّ أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. دليلهم ما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: “كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوضوءِ مما مستِ النار”، قالوا: فإن لحم الجزور إنما أُمِر به في أول الإسلام لأجل أنه مسته النار.
والجواب على هذا أن الحديث بهذا اللفظ حديث منكر، وأن الراوي إنما رواه بالمعنى. والصحيح أن الحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتزّ من كتِفِ شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، ولكن هذا شيء ولحم الجزور شيء آخر.
وقد قال الإمام أحمد وهذا القول الثاني: أن لحم الجزور ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو قول جابر بن سمُرة، وهو قول البراءِ بن عازِب، قال الإمام أحمد: حديثان حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، وهذا يدلُّ على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور.
وتذكر بعض كتب التاريخ قصة متداولة أن الصحابة كانوا يأكلون لحم جزور، فأحدث رجل بصوته – ضرط – فضحك الصحابة، ولا يُدرى من هو، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يُسَتهزئ به، فأمر الصحابة كلهم بالوضوء. فهذه القصة لا أصل لها، والأحاديث الواردة فيها كلها منكرة.
والصحيح هو رواية البراء بن عازب ورواية جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صح عنه حديث نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، ولهذا قال الإمام الشافعي: “إن صح حديث نقض الوضوء من لحم الجزور، قلت به”، قال الإمام البيهقِي في السنن الكبرى: “وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي”، فهذا يدل على أن الراجح أن لحم الجزور ينقض الوضوء، والله أعلم.
ما المقصود بلحم الجزور؟
هذه المسألة ليس فيها نص، فبعض أهل العلم يرى أن المقصود هو كل أجزاء الجزور، يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أكل لحم الجزور لأن اللحم إنما خرج مخرج الغالب، قالوا: كما إن ربنا سبحانه وتعالى قال في تحريم أكل الخنزير قال: ﴿ أو لحم خِنزِير ﴾ [الأنعام: 145]، ومن المعلوم أنّ الخنزير المحرم هو لحمه وشحمه كل أجزائه، فخرج اللحم مخرج الغالب، فإذا حرُم أجزاء الخنزير ككبده وطحاله وقلبه وغير ذلك، فكذلك يحرم لحم الجزور وكل أجزائه، واللحم إنما ذُكِر مخرج الغالب، وهذا رواية عن الإمام أحمد.
وأما الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي المذهب، فقالوا إن العبرة باللحم لا بالجوف كالكبد وغيره.
لكن أقول إن القول بأن الكبد أو الطحال أو غير ذلك ينقض الوضوء، قول قوي وهو ما أرى، فالأحوط الوضوء منها، فإن لم يتوضأ فله سلفٌ، والله أعلم.
ويجب العلم بأن العبرة بالأكل لا بشرب المرق،فشربه لا ينقض الوضوء لأن الشرب شيء والأكل شيء آخر، والله أعلم.
ما السبب في نقض لحم الجزور للوضوء؟
حاول بعض أهل العلم أن يلتمس لذلك التحريم علة، فقال بعضهم: لأنها خلقت من الجن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم إلى هبوبها ونفورها إذا نفرت»، وقال: «إن لهذه الإبل أوابِدٌ كأوابد الوحشِ»، فقالوا: إن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتوضأ.
لكن المسألة تحتاج إلى إثبات يقيني وليس فيه يقين، والذي يظهر لي أن الإبل لها حالة غير حالة الغنم، والله أعلم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «غِلظُ القلوب والجفاءُ في أهلِ الإبلِ، والسكينةُ في أهل الغنم»، فالإبل فيها غِلظة، فلأجل هذا أراد الشارع ممن أكل لحم جزور أن يخفف ذلك بالوضوء، حتى لا يقع منه ما يقع من تلك الإبل (لها تأثير على الطباع)، ولهذا تجدون الذي يرعى الإبل ويهتم بالإبل، فيه من الجفاء والغلظة بسبب حركات الإبل وغِلظِها، فيتأثر بذلك، فإذا أكل منها زاد ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطفئه بالوضوء، وهذا مجرد احتمال، والمهم والحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله سواء عرفنا سببه أم لا.
3. النواقض المختلف فيها والراجح عدم نقضها للوضوء:
الناقض السادس: غسل الميت.
ذهب الحنابلة إلى أن الميت إذا غُسِّل نقض الوضوء، واستدلوا بفعل ابن عمر وبقولِه: “من غسّل ميتا فليغتسل”، فالراجح أن حديث ابن عمر ضعيف، ولا يصح في الباب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث أبي هريرة: «من غسّل ميتا فليغتسل، ومن حملهُ فليتوضأ» فهذا حديث مُنكر أنكره أبو داود، والإمام أحمد، وغيرُ واحد من أهل العلم كالأئمة الكبار.
والصحيح أن ابن عباس سئل كما روى عبد الرزاق، عن الرجل يُغسّلُ أنتوضأ منه؟ قال: أنجستُم ميِّتكُم. فهذا يدل على أن الراجح خلاف مذهب الحنابلة وهو مذهب أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو الراجح.
الناقض السابع: إسلام الكافر وانتقال المني.
قال بعض أهل العلم: “كل ما أوجب غُسلا أوجب الوضوء”، كإسلام الكافر وانتقال المني.
أما إسلام الكافر، فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، يعني يكون مُحدِثا، فيجب عليه أن يغتسل. قالوا: لما جاء في حديث عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثُمامة بن أثال أن يغتسل، والحديث أصله في الصحيحين، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإغتسال. وقصة ثُمامة مشهورة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد فقبضوا على ثُمامة بن أثال، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عليه، فقال: “ما عندك يا ثُمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل نُعطِك ما شئت. ثم تركه النبي فجاءه من الغد فقال له: ما عندك يا ثُمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل عما شئت. ثم جاءه اليوم الثالث فقال له صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثُمامة؟، فقال مثل ما قال، فقال: أطلقوا سراح ثُمامة، فذهب إلى حائط للأنصار فاغتسل ثم جاء فقال: يا رسول الله، والله لقد كان دينك أبغض الأديان كلها إليّ، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إليّ.. الحديث، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالغسل، وعلى هذا فالذي يظهر لي أن رواية الغسل في حديث عبد الرزاق منكرة، والله أعلم.
الحديث الآخر:
قالوا: لِما روى أبو يعلى وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عمرو حينما أسلم أن يغتسل. وهذا الحديث في سنده نكارة، ولو صح؛ فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عمرو لا يدلُّ على الوجوب، بدليل أنه أسلم خلق كثير في فتح مكة وغيره من المواقف التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وأسلموا، ومع ذلك لم يأمر أحدا إلا قيس بن عمرو، فدل ذلك على أن أمره لقيس بن عمرو دليل على الإستحباب.
ولهذا فالذي يظهر وهو الراجح، أن اغتسال الكافر لا يجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله، ولكن بعض أهل العلم قال إن كان قد أجنب فيجب عليه الغسل، وإن لم يكن أجنب فلا يجب، والذي يظهر أنه إن أسلم وهو حال جنابته، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما إن كان قد أجنب فإن ذلك لا يُعلّقُ به حُكمٌ، فلا يلزمه ذلك، والله أعلم.
انتِقالُ المني:
ذهب الحنابلة إلى أن الواحد إذا داعب زوجته وأحس بانتقال المني من صُلب ظهرِهِ إلى مكان الإنزال، ولم يُنزِل، فهل هذا الانتقال وهذا التحرك يدل على وجوب الوضوء؟
ذهب الحنابلة إلى وجوب الوضوء، قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وإِن كُنتُم جُنُبا ﴾ [المائدة: 6]، قالوا: والجنب هو الإبعاد، فدل ذلك على أن الماء قد أبعِد من الصُّلبِ إلى الإنتقال، قالوا: فهذا الانتقال مثله مثل الخروج، هذا مذهب الحنابلة. والراجح هو مذهب جماهير أهل العلم، على أن الحكم إنما هو معلق بالخروج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماءُ من الماءِ»، فعلق الأمر بوجود المني لا بانتقاله، فدل ذلك على أن الحكم ليس بالانتقال ولكنه بالخروج، والله أعلم.
الناقض الثامن عند بعضهم: وهو الخارج من الجسد من النجاسة، كالدم والقيحِ والصّدِيدِ.
فذهب الحنابلة إلى أن الدم إذا خرج من جسد الواحد ولو من غير السبيلين وفحُش فإنه ينقض الوضوء، وعلى هذا فالذين يصابون بحادث مثلا، وأصابهم نزيف فإنهم على مذهب الحنابلة، ينقض وضوؤهم.
والراجح هو مذهب مالك والشافعي واختيار ابن تيمية أن خروج الشيء النجس كالدم لا ينقض الوضوء، وكذلك القيء لا ينقض الوضوء، فالراجح أن القيء والدم لا ينقضان الوضوء.
وقد قلنا أن القيء عند الأئمة الأربعة نجس، وحكى ابن منذر الإجماع على ذلك. أما الدم فالراجح أنه نجس، فخروج الدم والقيء النجس لا يدل على نقض الوضوء، وهذا مذهب مالك والشافعي واختيار ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يُجرحُون ولم يُنقل عنهم أنهم توضؤوا من ذلك.
وقد جاء في ذلك حديث يرويه الدّارقُطنيّ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فلم يزد أن غسل محاجِمهُ، فهذا حديث منكر، وأما الحديث الآخر وهو في القيء، فهو حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال الراوي فذهبت إلى ثوبان قال: صدق أنا صببت له من وضوئه. وهذا الحديث قال عنه الإمام أحمد: جوّدهُ حُسين المُعلِّم، فهذا يدل على صحة هذا الحديث، لكنه يدل على فِعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدل على الوجوب، فغاية ما فيه أن من قاء عمدا يُستحبُّ له الوضوء ولا يجب، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
الناقض التاسع: شرب لبن الإبل.
هل ينقض؟ نقول: عامة أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، على أن شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء.
وأما ما جاء في حديث عند الإمام أحمد: «توضؤوا من ألبانِ الإبل»، فهذا الحديث في سنده الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس، فهو مع ضعفه يدلس في الحديث، فالصحيح أنّ حديث «توضؤوا من ألبان الإبل» ليس بصحيح، فدل ذلك على أن قول عامة أهل العلم أن شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء، ويوجد قول آخر عند الحنابلة أنه ينقضُ، لكن الصحيح هو أنه لا ينقضُ.
ما حُكم مس المُحْدِث للمصحف؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن مس المصحف حال الحدث لا يجوز، واستدلوا بثلاثة أحاديث.
الحديث الأول: ما رواه مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حول الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو في اليمن، وفيه: “أن لا يمسّ القرآن إلا طاهر”، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. قالوا: لأنه كتاب وليس له إسناد. والصحيحُ أنّه حديث – كما يقول أبو عمر ابن عبد البر –: تلقّتهُ الأمة بالقبول، فاستُغنِي عن إسناده.
فحديث عمرو بن حزم فيه كتاب، والكتاب يسمى عند أهل الحديث وِجادة، ولما مات عمرو بن حزم – وهو صحابي رضي الله – وجد أبناؤه هذا الكتاب الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وفيه الديات وبعض المسائل، فوجدوا فيه أن لا يمسّ القرآن إلا طاهر، فدل ذلك على أن الواحد لا يجوزُ له أن يمسّ القرآن إلا طاهر.
قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث لو صح فإنه لا يُحْمَل على الطهارة، طهارة الحدث الأصغر، إنما المقصود به طهارة الحدث الأكبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب إلى عمرو بن حزم إلى أهلِ اليمن وفيهم النصارى.
فالجواب: أن القاعدة في ذلك أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: «طاهر» لفظ مشترك يحتمِل الطهارة الصغرى ويحتمل الطهارة الكبرى ويحتمل الطهارة المعنوية وهي طهارة الإسلام. والقاعدة في هذا: أن اللفظ المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه من غير تضاد فإن جمهور الأصوليين والفقهاء يرون جواز حمله على جميع معانيه، أما إذا لم يمكن حمله على جميع معانيه كالقُرءِ؛ فإن القُرء إما الطهر وإما الحيض، فلا يمكن أن نقول القرء هو يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون طهارة؛ لأن أحدهما مناقض للآخر، فإذا كان شيئا من الألفاظ المشتركة يمكن حمله على جميع معانيه فإن جمهور الأصوليين يرون أنّ ما أمكن حملُهُ على جميع معانيه من الألفاظ المشتركة فهو حجة، والله أعلم.
ومما جاء في الآثار أو الأحاديث في هذا الباب حديث رواه الحاكم من حديث حكيم بن حِزام وقد قواه الحازِمِيّ في كتاب “الإعتبار”، وحسن إسناده، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه.
وكذلك جاء من حديث ابن عمر: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»، وقد حسّنه بعض أهل العلم كالجوزقانِيُّ، ولكن البيهقِي ضعّفه.
فأقول: حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم وهو وِجادة، يدل على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز مس المصحف إلا وهو طاهر، وأما آية: ﴿ لا يمسُّهُ إِلّا المُطهّرُون ﴾ [الواقعة: 79]، فالمقصود بها الملائكة. قال ابن تيمية: فكون الملائكة لا تمس اللوح المحفوظ إلا وهي طاهرة، أو وهي على طهارة؛ لأن الملائكة لا يحصل منهم حدث، قال: فبدلالة الإيماء يدلُّ على أن المسلم أولى بأن يكون مخاطبا في هذا، والله أعلم.
وخالف في ذلك ابن حزم: فقال رحمه الله ورضي عنه، أنه وهو اختيار الشّوكانِيّ: لا بأس بمس المصحف (وهو غير طاهر)، والراجح أن مس المصحف لا يجوز. والله أعلم.
ما المقصود بالمصحف؟ هل المصحف هو الجِلدة الحافِظة، أم هي الحروف والكتابات؟
أولا: الحروف والكتابات لا يجوز مسها لغير الطاهر بإتفاق الأئمة الأربعة، وأما الجلدة فبعض أهل العلم يقول: إن كل جلدة قد استمسكت بالقرآن بحيث لا تنفك عنه فلا ينبغي أن يمسها إلا بحائل، قالوا: لأن هذا أصبح كحكم المصحف لأنه لا ينفكُّ عنه.
وهذا أحوط إبقاء على كرامة المصحف، وبعض أهل العلم يرى أن العبرة إنما هي بالحروف والورق الذي فيه الكتابة. ولا شك أنّ هذا الورق هو الأصل ولكن أيضا ينبغي للواحد ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر، أو أن يجعل بينه وبينه حائلا، وعلى هذا فالحائض إذا أرادت أن تقرأ فإنها تلبس القفازين وتقرأ.
هل يمكن للجنب قراءة المصحف؟
هل الجنب يقرأ في المصحف أم لا، أو يقرأ القرآن أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم وهو قول عمر بن الخطاب كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وقد صح عن علي رضي الله عنه: أن الجنب لا يقرأ القرآن.
وقد جاء في ذلك حديث يرويه عبد الله بن سلِمة عن أبي الغرِيفِ عن علي بن أبي طالب أنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجِزُهُ عن القراءة شيءٌ ليس الجنابة”. وفي رواية أن علي خرج على أصحابه وقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا وقرأ القرآن قال: هكذا إلا الجنابة، أما الجنابة فلا ولا آية”، وهذا الحديث تُكُلِّم فيه. والذي يظهر أن الحديث إلى الحسن أقرب، ومما يدل عليه فعل علي رضي الله عنه وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع.
وذهب ابن حزم إلى أن الجُنُب لا بأس أن يقرأ القرآن وهو ظاهر صنِيع البخاريِّ.
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم قول الله تعالى: ﴿ قُل يا أهل الكِتابِ تعالوا إِلى كلِمة سواء بيننا وبينكُم ألّا نعبُد إِلّا اللّه ﴾ [آل عمران: 64]، فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى هِرقل، ومن المعلوم أن هرقل سوف يقرأ هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بقراءة المصحف للجنب.
والذي يظهر أنه ليس هناك أحاديث صحيحة قوية في هذا، ولكن قول الصحابيين علي وعمر، وقد صح عنهما، أولى بالأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أهل السنن: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضدوا عليها بالنّواجِذِ وإياكم ومُحدثاتُ الأمُورِ».
فهذا يدل على أنه لا يقرأ.
القول الثاني في المسألة وهو مذهب ابن حزم، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما –، أنه يقرأ.
والذي يظهر لي أن الجنب لا يقرأ القرآن، وذلك لأنه قادر على أن يُزيل هذا المانع – الحدث الأكبر – بأن يغتسل، والله أعلم.
هل يمكن للحائض قراءة المصحف؟
أما الحائض؛ فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تقرأ القرآن، وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، أنّ مذهب أكثر الفقهاء أن الحائض لا تقرأ القرآن.
والقول الثاني في المسألة: أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأمور:
أولا: أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة، من ذلك ما يرويه إسماعيل بن عيّاش عن عبيد الله عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، جديث: «إني لا أُحل القرآن لحائض ولا جنب».
الثاني: أن الصحابيّات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع، وهن القانتات التائبات العابدات السائحات كن يصبن بالحيض، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهن أن يقرأن شيئا من القرآن، ويبعُد أن تجلس الواحدة خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام لا تقرأ شيئا، ولو كان هذا ثابتا موجودا لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا مما تتوفر الدواعي إلى نقله، فلما لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعلهن على البراءة الأصلية.
وهذا القول أظهر، وبهذا نقول، فلا بأس أن تقرأ المرأة وهي حائض؛ لأنه لم يرد دليل على المنع، والأصل أن الجنب يختلفُ عن الحائض، فالحائضُ حيضُها ليس بيديها ورفعُهُ ليس بيدها، أما الجُنُب فذلك كله بيده، والله أعلم.
من تيقّن الحدث وشّكّ في الطهارة، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث؟
نقول الأصل أن يبني على اليقين، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل أنه محدث، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل أنه طاهر.
لكن لو أنه تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنا نقول أنه طاهر، ثم صلى ثم أُخبِر بعد ذلك أن ظنّهُ أن الأصل الطهارة كان خطأ بدليل أنه قد أكل لحم جزور مثلا قبل ذلك – على مذهب الحنابلة، فنقول حينئذ يجب عليه أن يعيد الصلاة، لماذا لأن هذا ليس جهلا بالحكم ولكن جهلا بواقع الحال.
والفرق بين الجهل بالحكم والجهل بواقع الحال أن الجهل بواقع الحال لا يُعذرُ صاحبه من حيث عدم الإعادة، بل يجب عليه أن يعيد، وأما الجهل بالحكم فإن الراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد إلا إذا كان في الوقت، والله أعلم.
10. الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة:
تعريف الغسل من الجنابة – مُوجِباتُ الغُسلِ – ما الدليل على أن الغُسل للحدث الأكبر يُجزئ عن الوضوء لإستباحة الصلاة؟ – ما هي صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ – إذا لم يكن عنده ماء وتيمم بنية رفع الحدث الأكبر هل يدخل فيه الحدث الأصغر؟ – ذكرتم واجبات الغسل، ولكن لم نعرف فرائضه وسننه؟
تعريف الغسل من الجنابة:
لابد للعبادة من التطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
وقد ذكر الفقهاء في هذا الباب: فروض الغسل، وسنن الغسل، وموجبات الغسل، والأحكام المتعلقة بمن به حدثٌ أكبر.
والغُسل يجوز فيه الضمُّ ويجوز فيه الفتحُ، وإن كان الفتح أشهر عند علماء اللغة، بل بالغ بعض علماء اللغة فقال: إنّ ضمّ الغين غلط، وقد رد الإمام النووي على هذا القول، وقال: إن الغَسل والغُسل لغتان معروفتان، وإن كان الأشهر هو الفتح.
وقد دل على مشروعية الغسل من الجنابة الكتابُ والسنة وإجماع أهل العلم.
فمن الكتاب: قول الله عز وجل: ﴿وإِن كُنتُم جُنُبا فاطّهّرُوا﴾ [المائدة: 6].
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخُدرِي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب رجل من الأنصار، قال: فخرج ورأسُهُ يقطُرُ ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لقد أعجلنا الرّجُل»، فقال: يا رسول الله، الرجل يُعجلُ عن امرأته ولم يُنزِل، قال: «إنما الماءُ من الماءِ». أي: إنما ماء الغُسلِ بسبب ماء المني الذي يجب فيه إذا خرج الغسل، والله أعلم.
والجنابة هي ما يُوجِبُ الطهارة الكبرى، وسميت جِنابة؛ لأن الواحد يبتعِدُ عن أداء بعض العبادات التي لا يصِحُّ فِعلها إلا بطهارة، فيبتعد عن قراءة القرآن على الراجحِ؛ لأنه لا بد فيه من طهارة كُبرى، ويبتعد عن الطواف لأنه لا بد فيه من طهارة كبرى، وهذا الابتعاد هو الجنابُ، وهو الجنبُ، أي الإبتعاد.
وقال بعضهم إنما سُمي الجنب جنبا؛ لأنه ينتقل الماء الذي في الصُّلبِ إلى مكان خروجه، فهذا إنتقال أي ابتعد عن موضعه، والله أعلم.
وقد اصبح الجنب وصفا لكل من به حدث أكبر يمنعه من أداء العبادة التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الغسل، والله أعلم.
إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الجنب يجوز فيه التّثنِيّةُ، ويجوز فيه الجمعُ، ويجوز فيه الإفرادُ، إلا أن الأفضل أن تبقيه على حاله، فهو اسم لا يتغير حال الإفراد، ولا حال التثنية والجمع، فتقول: رجل جُنُبٌ، وامرأة جنب، ورجلان جنب، وامرأتان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، وهذا أفصح. ويجوز أن تقول: رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنبان، وامرأتان جنبان، وغير ذلك، ولكن الأشهر هو عدم تغيير كلمة الجنب، والله أعلم.
مُوجِباتُ الغُسلِ:
وهي الأشياء التي توجب على المرء أن يغتسل لأجلها، فمنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وبعضهم يجعلها خمسة، وهو الراجح، وبعضهم يجعلها ستة بدخول الذي أسلم هل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ وبعضهم يجعلها سبعة بما يرى من أن انتقال المني من الصلب ولو لم يخرج، نوع من الجنابة يجب فيه الغسل.
أولا: خروج المني.
المني هو ماء أبيضٌ غليظ يخرجُ عند اشتداد الشهوة، وهذا في حق الذكر، وأما في حق المرأة فهو ماء أصفر رقيق ولا يكاد في الغالب تعرفه المرأة؛ لأن الرجل يعرف ذلك لأن خروجه يكون بدفق، أما المرأة فربما لا ترى شيئا فيشكل عليها هل الخارج منها مذي أم ماء؛ لأن غالب ما يخرج من المرأة يكون من الداخل.
ولهذا يظن بعض النساء أن أول ما يخرج منها حال وجود الشهوة مني، والصحيح أن هذا ليس بمني، وإنما هو مذي، ولهذا تتوضأ منه وتغسل فرجها كما ذكرنا في باب إزالة النجاسة، فهو مذي ولا يجبُ فيه الغسل، ولا ينبغي للمرأة أن تُوسوِس في مثل هذا، فقد دخل في النساء في هذا الباب باب من الوساوس الكثيرة، وهذا من قلة الفقه، فلا يجب طاعة الشيطان في مثل هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء»، وهذا من الاعتداء في الطهور، والله المستعان.
وخروج المني إما أن يكون حال اليقظة، وإما أن يكون حال النوم:
القسم الأول: إن كان في حال اليقظة فلا بد فيه من شرطين:
الشرط الأول: وهو أن يخرج بلذة وشهوة، وعلى هذا فلو خرج منِيُّ الرجل من غير شهوة ولا لذة، فلا يجب فيه الغسل، لأنه لم يخرج بشرطه، وشرطه هو اللذة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «إذا خذفت – وفي رواية إذا حذفت – فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا؛ فلا تغتسل من الجنابة». والحذفُ والخذفُ والفذخُ كله بمعنى القذف، فعلى هذا لا بد فيه من لذة.
الثاني: أن يخرج بِدفق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي يعلى: «إنما الغسلُ لمن دفق»، وهذا يدل على أنه لا بد فيه من شرطين، فلو كان يخرج منه لسبب مرضي، فإنه لا يجب فيه الغسل، لأنه يخرج من غير شهوة.، ولكن يجب عليه الوضوء لأن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين بأي شيء يوجب الوضوء، وقد نقلنا إجماع أهل العلم على أن الخارج من السبيلين على وجه معتاد يجب فيه الوضوء، وأما إذا كان على غير وجه معتاد فيجب أيضا وفقا لعامة أهل العلم خلافا لمالك.
وهذا يكون في حالِ اليقظةِ.
لو أحس بانتقال المني، ولكن أمسكه فلم يخرج، فهل يجب فيه الغسل أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يغتسل، قالوا: لأن الجنابة اسم لما يبتعد فيه الماء من صلبه إلى خارج الصلب، قالوا: وقد حصل انتقال، وأشبه الخروج، وما قارب الشيء يأخذ حكمه، فهو قارب خروجه فيأخذ حكمه.
وقال جماهير أهل العلم أن العبرة بالخروج الظاهر، ولا عبرة بالإنتقال، وتسمية اللغة العربية شيء، وتسمية الحقيقة الشرعية شيء آخر، فإذا وافقت الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية أخذنا بها، وأما إذا خالفت الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية، فالمعول في هذا على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه بلفظ «إنما الماءُ من الماء»، وأما البخاري ومسلم فقد رويا «إذا قحطت أو أعجلت فعليك الوضوء»، وأما رواية: «إنما الماء من الماء» فقد تفرد بها مسلم في صحيحه.
وعلى هذا نقول إن من أحس بانتقال المني فإنه لا يجب عليه الغسل لأن العبرة بخروج المني لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماء من الماء»؛ أي إنما ماء الغسل من ماء الجنابة وهو ماء الرجل، والله أعلم.
لكن، مع ترجيحنا أن من أحس بانتقاله لا يجبُ عليه الغسل، فلو خرج بعد أن حبسه، ولو لم يكن بِدفق، فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه قد خرج. ولأنه حبسهُ بعد أن أحس بانتقالِه مع وجودِ لذةِ، فالغالبُ أنّ فيه دفقا لكنه حبسه، فخروجه دليل على وجود الدفق، ولكنه حبسه، وهذا أظهر، والله أعلم.
القسم الثاني: إن كان خروج المني في حال النوم:
فلو خرج منه شيءٌ حال النومِ، من ماء الرجل أو ماء المرأة، فإنه يجب فيه الإغتسال، وهذا أمر مُجمعٌ عليه عند أهل العلم، واستدلّ العلماءُ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «إنما الماء من الماء» فهو عامٌّ حال اليقظةِ وحال النومِ.
وقد ذهب ابن عباس إلى أن حديث «إنما الماء من الماء» إنما هو خاص في حال الإحتلام، والصحيح أن هذا – كما يقول أهل العلم – إنما هو حال اليقظة من غير إتيانِ الرجل أهله، أو في حال النوم.
وأما إذا أتى الرجلُ أهلهُ كما سيأتي بيانه ولو لم ينزل؛ فإنه يجب فيه الاغتسال، لحديث آخر.
وعلى هذا فإذا قام من النوم فوجد بللا يعرف أنه ماؤه الذي يأتيه – أو يأتيها وقت اشتداد الشهوةِ، فإنه يجبُ عليه أن يغتسل، ودليلُ ذلك ما ثبت في الصحيحينِ من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُليم امرأة أبي طلحة، فقالت: “يا رسول الله، إن الله لا يستحيِي من الحق، فهل على المرأة من غُسلِ إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء”، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإغتسال بوجود الماء.
وعلى هذا؛ فلو أحسّ الواحد وقت نومه أنه يأتي أهله ثم قام فلم يجد بللا، فلا يجب عليه الاغتسال، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم «نعم، إذا هي رأت الماء»، يعني لو أنها لو لم تر الماء، لا يجب عليها الغسل.
وهذا قول واحد، بل حكى بعضهم الإجماع وإن كان في المسألة خلاف كما هو قول لبعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة.
وفي الحديث أن عائشة قالت: “فضحتِ النساء يا أمّ سُليم! ترِبت يمِينُكِ! قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتِ تربت يمينُك يا عائشة”.
وفي رواية أخرى، أن أم سلمة زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم، فبم يكون ولدُها شبهُها”، هذا دليل على أن المرأة عندها ماء، لكن قد تعرف خروجه، وقد لا تعرف، وقد تراه وقد لا تراه، وهذا يدل على أن هذا يختلف من امرأة إلى أخرى.
وفيه دلالة على أن الاحتلام يكون غالبا في الرجل، والغالب ألا يكون في المرأة، لكن قد يوجدُ عند بعض النساء وقد لا يوجد.
الحالة الثانية: أنه تذكر انه أتى أهله ثم قام من النوم ولم يجد شيئا؟
الراجح وهو قول عامة أهل العلم وقد حُكي إجماعٌ، هو أنه لا يجب عليه أن يغتسل.
الحالة الثالثة: أنه قام من النومِ، فوجد بللا ولا يعرف حاله، أي لا يدري هل هو مذي أو مني؟
نقول: إن كان قد تذكر في المنام أنه أتى أهله، فالغالب أنه مني، وإن لم يتذكر شيئا، فقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجبُ عليه أن يغتسل إذا لم يتيقن هل هو مني أو مذي، فالأصل هو براءة الذمة، والغسل لا يثبت إلا بيقين، ولا يقين.
والقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد: أنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الصلاة تُوجِبُ الطهارة، والطهارة لا تثبت إلا بيقين.
فهؤلاء أتوا بيقين وهؤلاء أتوا بيقين ! فنبقى على أنه يجب عليه أن يغتسل.
ولو قلنا في جمع هذه الأقوال: إنه إذا وجد ماء ولم يتذكر احتلاما فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يذكُر قبل أن ينام أنه أنه يأتي أهله فحصل منه شيء من رغبة في الجماع، فهذا يُعدُّ مذيا، فيغسل ما أصاب الثوب ويتوضأ، ولا يجب أن يغتسل، هذا في حال إذا تذكر قبل أن ينام ولم يجد شيئا في النوم.
أما إذا لم يتذكر ذلك قبل أن ينام ثم وجد بللا؛ فالأحوطُ أن يغتسل على مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عند الإمام أحمد، وهذا على سبيل الاحتياط، وإن لم يغتسل فالأصلُ أنه لا يجب عليه لأنه لا يعلمُ ما هو، فالأصل هو الطهارة، والله أعلم.
الموجب الثاني للوضوء: تغيِيبُ الحشفةِ
ويعبر الفقهاء عنه من باب الأدب ب”التقاء الختانين”، وهذا على سبيل المجاز.
فإذا أتى الرجل أهله فإنه يُغيِّبُ حشفة الذكر، فيجب عليه أن يغتسل، وأما إذا التقى رأسُ الذّكرِ بِقُبُلِ المرأة، فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وهو إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد، وإن كان في المسألة خلاف.
ومما يدل على أن العبرة هو بتغييب الحشفةِ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الخِتانانِ وتوارتِ الحشفة؛ فقد وجب الغسل» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهذا وإن كان في سنده بعض الكلام، لكنه جاء على سبيل التفسير، والله أعلم.
وعلى هذا فالعبرة بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأسُ الذكر، أو قدرها لمن كان قد جُبّ ذكره، والله أعلم.
ويستدل العلماء في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إذا جلس بين شُعبِها الأربع، ثم جَهِدَها؛ فقد وجب الغُسل، وإن لم يُنزِل»، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، واللفظ لفظ مسلم، وزيادة: «وإن لم ينزل» رواها مسلم.
وكذلك حديث عائشة في الصحيحين: «إذا التقى الختانان ومس الختانُ الختان؛ فقد وجب الغسل»، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، وهذا معناه ليس على ظاهره كما قلت، ولكن المقصود به هو أن يُغيِّب الحشفة في قبل المرأة، والله أعلم.
إذا ثبت هذا؛ فإننا نقول: إنه كان في أول الإسلام أنه إذا غيّب الواحد الحشفة في قُبل امرأته فإنه لا يجب عليه الغسل حتى يُنزل، ولكن هذا نُسخ، وبقي حديث: «إنما الماء من الماء» في أول الإسلام، بقي في حال اليقظة في غير وطء، وفي حال النوم.
ومما يدل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: “إن الفُتيا التي كانوا يُفتون بإنما الماء من الماء، فهي رُخصةٌ رخّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدءِ الإسلام، ثم أمر بالإغتسال بعد”.
فهذا القول هو قول عامة أهل العلم، وقد وُجِد خِلافٌ عند الصحابةِ، ولكنِ استقرّ الأمرُ بعد ذلك على أنّ الواحد إذا أتى أهله؛ فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم يُنزل.
فإذا قرأت بعض الأحاديث التي تخالف هذا فأعلم أنها في أول الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب عِتبان بن مالك، فخرج يجر ثيابه، فقال رسول الله: «لعلنا أعجلنا الرجل»، فقال: يا رسول الله الرجل يعجلُ عن امرأته ولم يُنزل، قال: «إذا قحطت – أي أكسلت؛ أي: لم تنزل –؛ فعليك الوضوء»، فهذا في أول الإسلام، وكذلك في حديث آخر قال النبي: «إنما يكفيك أن تغسل ما أصابك من أذى، وتتوضأ»، وهو أيضا في أول الإسلام.
ومما يدلُّ على هذا: أنه قد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه اختلف في هذه المسألة المهاجرون والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، يعني أنا أقضي على الخلاف، فذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أُماه، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيِيكِ، فقالت عائشة: لا تستحيِ أن تسألنِي ما تسأله عنه أُمُّك التي ولدتك؛ فإنما أنا أمك – انظر الأدب، عائشة رضي الله عنها عمرها سبع عشرة سنة أو ست عشرة سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة، قالت: لا تستحي أن تسألني عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك – فقلت: ما يُوجِبُ الغسل؟ ففهمت عائشة، وضحكت، وقالت: على الخبِيرِ سقطت – يعني سألت أعلم الناس بهذه المسألة –، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مس الختان الختان وجلس بين شُعبيها الأربع؛ فقد وجب الغسل».
فشفاهم أبو موسى، وعلِم المهاجرون والأنصار أنه يجب الغسل من مخالطة الرجل بأهله، يعني بإتيان الرجل أهله، ولكنه إذا لم يخالط فلا يجب إلا حال الإنزال، والله أعلم.
ولاحظ أنهم كانوا يُكَنُّونَ لأنهم يعلمون معنى ذلك، اما في حال عدم العلم فيجب التصريح. لكن الأدب هو أن يكني الواحد إذا من يخاطب يعلم ذلك. فينبغي أن يُكني مع الآخرين، أما مع أهله فذلك شأنٌ آخر. والله سبحانه وتعالى حيِيٌّ كريم، قال في معنى إتيان المرأة: ﴿أو لمستم النساء﴾، وفي قراءة: ﴿أو لامستُمُ النِّساء﴾، وهذا كله من باب الأدب.
وتأمل في قول الصحابة: “بل إذا خالط فقد وجب الغسل”. فكلمة “خالط” من باب الأدب، رضي الله عنهم أجمعين.
الموجب الثالث والرابع: هو خروج الحيض والنفاس.
أي خروج دم الحيض ودم النفاس، فهو ثلاثة وأربعة، وقد أجمع أهل العلم على أن خروجهما موجب من موجبات الغسل بعد انقطاعه، وقد قال الله تعالى: ﴿ويسألُونك عنِ المحِيضِ قُل هُو أذى فاعتزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ ولا تقربُوهُنّ حتّى يطهُرن﴾ [البقرة: 222]، ومعنى يطهرن: أي ينقطع عنهن الدم، ﴿فإِذا تطهّرن﴾؛ أي اغتسلن، ﴿فأتُوهُنّ مِن حيثُ أمركُمُ اللّهُ﴾.
ومما يدل على ذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض في وقت الحج: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهُرِي»، متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «حتى تغتسِلِي».
وفي الصحيحين من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض، فقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»، وهذا يدلُّ على أن دم الحيض ودم النفاس موجبٌ من موجبات الغسل، والله أعلم.
الموجب الخامس: الموت.
الموت موجب من موجبات الغسل، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصتهُ ناقتُهُ: «اغسلوه بماء وسِدر، وكفِّنُوهُ في ثوبين ولا تغطوا وجهه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيا»، فقوله: «اغسلوه بماء وسدر»، هذا واجب.
ومما يدل على ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أم عطِيّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أراد أن تُغسل بِنتُهُ أم كلثوم: «اغسِلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتُنّ ذلك بماء وسدر»، وهذا يدل على وجوب الغسل.
وسواء كان الميت صغيرا أم كبيرا، وأما السِّقطُ – وهو الجنين الذي خرج من بطن أمه قبل الوقت المعتاد –، فينقسم إلى قسمين:
فإن كان قد تم له أربعة أشهر، فإنه يكون إنسانا، وقد نفخ فيه الروح، والصلاة والغسل إنما تكون فيمن نُفخ فيه الروح ثم نُزِع، وعلى هذا فإذا كان له أربع أشهر فإنه يجب أن يغسل وأن يصلى عليه، وقد ذكر النووي إجماع أهل العلم على أن نفخ الروح إنما يكون فيمن له مئة وعشرون يوما، لحديث ابن مسعود كما في الصحيحين أنه قال: حدثنا الصادق المصدُوقُ: «إنّ أحدكم يُجمع خلقُهُ في بطن أمه أربعين يوما نُطفة، ثم يكونُ علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يُنفخُ فيه الرُّوحُ، ثم يُؤمرُ الملِك بِكتبِ رزقه وأجله، وشقي أو سعيد» الحديث.
فهذا يدل على أنه يُنفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما، وهي أربعة أشهر كما ذكر ذلك أهل العلم وحكوه إجماعا منهم.
أما إذا كان عمره أقل من ذلك، فإنه لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه، لأنه لم تنفخ فيه الروح.
وعلى فإن تسمِيّتُهُ، والعقِيقةُ عنه، وأن يُغسّل، وأن يُقبر في مقابر المسلمين، ويُصلّى عليه، كل هذا إذا كان له أربعة أشهر، وأما ما دون ذلك؛ فإنه لا يُسمى ولا يُغسل ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولكنه يُدفن في الصحراءِ أو في مكان خال.
هذا من حيث الأحكام الظاهِرة عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إذا استهلّ المولودُ صارِخا؛ ورِث»، كما جاء ذلك عند التِّرمِذِيّ وإن كان بعضهم يضعفه، ولكن إجماع أهل العلم عليه.
وأما في مسألة الإجهاض، فهذه مسألة أخرى، ولا يجوز إسقاط الجنين من بطن أمه ولو لم ينفخ فيه الروح، سواء كان عمره أربعون يوما أو أكثر من ذلك، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنابلة والحنفية الذين قالوا: إذا كان في الأربعين؛ فلا بأس (وما دونها)، والصحيحُ حُرمةُ ذلك، وقد صدر قرارُ المجمع الفقهيِّ لرابطة العالم الإسلامي في حُرمةِ الإجهاض ولو كان له أسبوع، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المرأة، فحينئذ لا بأس؛ لأن الإجهاض لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، فإذا قدرها الأطباء، فلا حرج إن شاء الله، وأما إذا كان بسبب أنها تقول إنني لا أستطيع أن أربي الأولاد، أو أنه كذا وكذا، وغير ذلك، فالأصل أنه لا يجوز، والله أعلم.
على ماذا استدل القائلون بأنه لا يُكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذا كان أبواه مسلمين؟
هو قبل نفخ الروح فيه يسمى حَمْلا ولا يُسمى إنسانا لأنه ، فيكون دم نفاس، لكن كونه إنسانا يترتب عليه أحكام فلا، لا يترتب عليه أحكام البتة من حيث أحكام الظاهر، أما من حيث قتله، فإنه لا فرق بين أن يكون نفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، وهذا هو السبب ذلك،
شرعت الصلاة في حق الميت، والميت لا يكون لا فيمن نفخ فيه الروح ثم زالت، وأما قبل نفخ الروح فهو أصله ميت. والله أعلم .
من مصدر آخر (CG):
القائلون بأن الجنين الذي سقط قبل نفخ الروح فيه (أي قبل 120 يومًا تقريبًا) لا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين استدلوا بعدة أدلة شرعية وأصولية، من بينها:
عدم تحقق صفة “الإنسان الكامل” قبل نفخ الروح فيه، أي أنه قبل نفخ الروح فيه ليس إنسانًا كاملًا، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الموتى المسلمين، لأن الصلاة والجنازة والتكفين والدفن في مقابر المسلمين تتعلق بمن مات وله روح.
قال الله تعالى في مراحل خلق الإنسان:
﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾
(المؤمنون: 14).فقوله “ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ” فُسِّر بأنه مرحلة نفخ الروح، أي أن الجنين قبل هذه المرحلة ليس شخصًا مكلفًا ولا تجري عليه أحكام الأموات.
واستدلوا بحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – عن نفخ الروح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات…” رواه البخاري ومسلم. يُفهم من الحديث أن الروح لا تُنفخ في الجنين إلا بعد 120 يومًا، ومن ثم فما قبل ذلك لا يُعامل معاملة الأموات الذين لهم روح.
واستدلوا بالقياس على السقط غير المستبين الخلق، فقال الفقهاء: إن السقط إذا لم يستبن فيه خلق الإنسان (لم تظهر ملامحه البشرية كالوجه والأطراف) فإنه لا تجري عليه أحكام الموتى. جاء في “المجموع” للنووي: “وإن لم يُستبن خلق الإنسان لم يُصلَّ عليه بلا خلاف عندنا”.
وذكر ابن قدامة في “المغني”: “إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهو كالدم، لا يُصلى عليه، ولا يُورث”. أي أن الجنين الذي لم يكتمل خلقه، وخاصة قبل 40 يومًا، لا يُعتبر شخصًا تامًّا في الأحكام.
واستدلوا بالإجماع العملي للسلف، ولم يُنقل عن الصحابة أو التابعين أنهم كانوا يصلون على الجنين الساقط قبل نفخ الروح فيه، مما يدل على أن الأمر كان مستقرًّا عندهم على عدم إجراء أحكام الجنائز عليه.
واستدلوا بعدم استحقاق الإرث والدية قبل نفخ الروح، فالفقهاء الذين أقروا وجوب الدية للجنين الساقط اشترطوا أن يكون قد نفخت فيه الروح، أما قبل ذلك فلا يستحق دية، وهذا يدل على أنه ليس في حكم الأموات المكلفين.
قال الإمام ابن القيم في “إعلام الموقعين”: “لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديةً للجنين إلا بعد نفخ الروح فيه”، مما يدل على أن قبل ذلك لا يُعامل معاملة الأموات.
ولكن من كان له خلق مستبين وسقط ميتًا بعد 80-90 يومًا، فبعض الفقهاء استحبوا تغسيله ودفنه في مقابر المسلمين، ولكن دون صلاة. انتهي المصدر الخارجي.
الموجب السادس: الدخول في الإسلام.
قال بعض أهل العلم هو الإسلام، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن من دخل في الإسلام؛ وجب عليه أن يغتسِل والمسألة فيها خلاف على ثلاثةِ أقوال، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يجبُ على الواحد أن يغتسل إذا دخل في الإسلام، واستدلوا بما جاء في حديث خليفة بن حُصين عن جده قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل حينما أسلم، وهذا الحديث يرويه الثلاثة: أبو داود والتِّرمِذِيّ والنّسائِي، وكذلك يرويه الإمام أحمد.
وقد حسنه بعض أهل العلم، فصححه ابن خُزيمة وابن حِبّان، إلا أنّ الذي يظهر والله أعلم، هو أنه منقطع بين خليفة بن حصين وجده، أو فيه ضعف وهو أن والد خليفة حديثه ضعيف لأنه مجهول، ولهذا فالذي يظهر أن الحديث فيه ضعف.
وجاء في حديث آخر، وقد رواه عبد الرزاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثُمامة بن أثال أن يغتسل حينما أسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وليس فيه أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم ثُمامة بأن يغتسل، وقد سبق أن ذكرناه، ودل على أنه لا يجب. هذا المذهب الأول.
المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار بعض أهل العلم، قالوا، وهو القول الثاني: إن كان قد أجنب حال الكُفرِ فإنه إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يجنب حتى أسلم فلا يجب عليه الإغتسال، فجعلوا موجب الاغتسال هو الجنابة وليس الكفر، وهذا القول قوي، وهو أقوى من القول الأول.
القول الثالث: أنه لا يجب الغُسلُ أصلا لأجلِ الإسلام، وذلك لأن لنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمُر من أسلم في فتح مكة ولم يأمر أصحابه حينما يذهبون إلى بلاد الشرق والغرب ليفتحوا الأمصار بأن يأمروا من أسلم بالإغتسال، قالوا: ومثل هذا مما تتوفر الدّواعِي على نقلِهِ لو كان، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع توفر الدواعي لنقله ومع وجود موجبه دل ذلك على أنه ليس بواجب، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مستحبّا.
والقول الثالث قوي، وهو عدم الوجوب، لكن إذا كان قد وُجِد منه جنابة قبلُ فالأحوط أن يغتسِل، أحوط وليس واجبا عليه. فالأحوط أن يغتسل إذا وجد منه الجنابة، والله أعلم.
ما الدليل على أن الغُسل للحدث الأكبر يُجزئ عن الوضوء لإستباحة الصلاة؟
أي إذا كان الواحد محدثا حدثا أكبر فإذا عمم سائر بدنه وتمضمض واستنشق، ما الدليل على أن ذلك يجزئه ولا يتوضأ للصلاة؟
الدليل هو قول الله تعالى: ﴿وإِن كُنتُم جُنُبا فاطهرُوا﴾ [المائدة: 6]، فالله سبحانه وتعالى لم يُفصِّل في هذا، فدل على أن الواحد إذا عمّم جسده فإنه يكون داخلا في هذا، فترك الإستفصال في مقام الإحتمال يُنزّلُ منزلة العُموم في المقالِ، فلما كان هذا المعنى مُحتمِلٌ أن يتوضأ أولا يتوضأ ولم يذكر الشارع شيئا من ذلك، دل على أن ذلك عام، والله أعلم.
ومما يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عِمران بن حُصين أن رجلا أجنب. فقال له صلى الله عليه وسلم: «ما لك لم تصلي؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولا ماء، ثم أعطاه الماء، ثم قال: خُذ هذا فأفرغه على جسدك»، وفي رواية «فأفرغه عليك»، فدل ذلك على أن مجرد الإفراغ يرفع به الحدث الأكبر، فيرفع به حينئذ الحدث الأصغر، والله أعلم.
ما هي صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
الغسل المجزئ: هو – كما جاء في حديث عمران بن حصين «خذ هذا فأفرغه عليك» وقوله تعالى: ﴿ وإِن كُنتُم جُنُبا فاطّهّرُوا ﴾ [المائدة: 6] – أن يعمم سائر بدنه، ويبلغ أصول شعره بالماء، ويتمضمض ويستنشقُ، هذا هو الغسل المجزئ.
وأما الغسل الكامل: فإنه يتوضأ أولا، يعني يغسل فرجه ثم يتوضأ ثلاثا كوضوئه المعتاد، ثم يغسل سائر جسدِه ولا يضع يده على مكان فرجه حتى لا يُعِيد الوضوء على الخلاف في ذلك، وهو الراجح، وحينئذ يكون هذا هو الغسل الكامل، والله أعلم.
إذا لم يكن عنده ماء وتيمم بنية رفع الحدث الأكبر هل يدخل فيه الحدث الأصغر؟
إذا كان الواحد مجنبا، وليس عنده إلا التراب، ليس عنده ماء، فإننا نقول: يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، فإن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فهذا أفضل، وإلا فإذا نوى رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، مثلما قلنا في غسل الجنابة بالماء، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ.
أما إذا كان عنده ماء لا يكفي إلا لأعضاء الوضوء وهو مُجنِب أو يخاف على نفسه الهلكة لو اغتسل، فإننا نقول: يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، ثم يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر، والله أعلم.
ذكرتم واجبات الغسل، ولكن لم نعرف فرائضه وسننه؟
نقول: كما قلنا؛ الواجب على الواحد في الغسل هو أن يعمم سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الوضوء، وقلنا: إن المضمضة الاستنشاق واجبان في الغسل وفي الضوء، وكذلك تعميمُ سائر البدن، والله أعلم.
11. التيمم
التيمم:
تعريف التيمم – شروط التيمم – فروض التيمم – مُبطلات التيمم – صفة التيمم – ما الذي يُشترط في تراب التيمم؟ – ماذا لو كان عنده بعضُ الماء الذي لا يُطهِّرُ كامل أعضاء الوضوء، فهل يصح الجمع بين الماء والتيمم؟ – إذا أراد أن يصلي وفي جسده نجاسة لا يستطيع أن ينفكّ عنها، فهل يصح أن يتيمم بدلا عن إزالة النجاسة بالماء؟ – هل يتيمم الواحد لرفع الحدث الأكبر؟ – هل الحجر من الصعيد؟ – كيف يتيمم في الأماكن التي فيها ثلج، ولا يستطيع الحصول على الماء؟
تعريف التيمم:
التيمم في اللغة بمعنى القصد، قال الله تعالى: ﴿ولا تيمّمُوا الخبِيث مِنهُ تُنفِقُون﴾ [البقرة: 267]، أي ولا تقصدوا الخبيث لأجل النفقة والصدقة والزكاة، فإن بعض الناس إذا أراد أن يُزكِّي قصد الحبوب والثِّمار الرديئة التي سماها الله “الخبيث” لِيُزكي منها، وترك الجيد لنفسه أو لبيعه.
وأمّا في الاصطلاح: فإنّ التيمم هو التّعبد لله تعالى برفع حدثه بأن يمسح وجهه ويديه بنيّة مخصوصة، على صفة مخصوصة.
والتيمم ثابتٌ بكتاب ربنا وسُنّة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماعِ سلف الأمة، فقد قال الله تعالى: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا﴾ [النساء: 43].
وأمّا السُّنة: فقد تكاثرت أحاديثُ النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت على أنّه كان يتيمم، منها حديث عمّار بن ياسر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّما كان يكفِيك أن تتيمّم، أن تقُول بِيديك هكذا». ثم ضرب الشمال على اليمين ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ومسح ظاهر كفيه ووجهه.
وكذلك حديث حذيفة، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصائص هذه الأمة أن الله أباح لها التيمم، فجاء في حديث جابر في الصّحيحين: «أُعطِيتُ خمسا لم يُعطهُنّ أحدٌ مِن الأنبِياءِ قبلِي». وذكر منها: «وجُعِلت لِي الأرضُ مسجِدا وطهُورا». وكذلك في حديث حذيفة: «فُضِّلتُ على الأنبِياءِ بِثلاث». وفي حديث أبي هريرة: «فُضِّلتُ على الأنبِياءِ بِسِتّ». فدلّ ذلك على أنّ من هذه جعلت لنا تربة الأرض طهورٌ.
وهذا يدلُّ على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وقد حرّمه الله سبحانه وتعالى على أُمم أخرى، ولم يُبحه إلا لهذه الأمة؛ لأنّ الله رفع عنها الآصار والأغلال والشِّدّة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إِنّما بُعِثتُم مُيسِّرِين ولم تُبعثُوا مُعسِّرِين».
ولهذا قال ابن تيمية: “من ترك التيمم وهو مُحتاجٌ إليه – يعني الاحتياج الشرعي – فإنّ فيه شبهٌ من اليهود والنّصارى”. وهو يقصد من يترك التيمم بتكلّف، ويظن أنّ التيمم لا يرفع حدثه، فلا بارك الله في رجل لم ترفع حدثه سُنّةُ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال كما في السنن ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه: «الصّعِيدُ الطّيِّبُ طهُورُ المُؤمِنِ، وإِن لم يجِدِ الماء عشر سِنِين، فإِذا وجد الماء فليتّقِ الله ولِيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ». والحديث رواه أبو داود واللفظ له، وكذلك التِّرمِذِيّ، وأمّا لفظ «عشر سِنِين»، فلم تذكره بعض الروايات.
فدلّ ذلك على أن التيمم من خصائص هذه الأمة.
وأمّا الإجماعُ: فقد أجمع أهلُ العلم على أنّ التيمم بدلٌٌ عن الماء حين العجز عنه، ونقل الإجماع الكاسانِي من الحنفية، ونقله ابنُ المُنذِر، ويُقال أن ابن المُنذِر أصوله شافعية، ونقله ابنُ قُدامة، ونقله غيرُ واحد من أهل العلم، وكذا ذهب النووي إلى أن التيمم مُباحٌ عند العجز عن الماء، والله أعلم.
هل التيمم عزِيمةٌ أم هو رٌخصةٌ؟
الصحيح هو أن التيمم منه ما هو عزِيمةٌ، ومنه ما هو رُخصةٌ.
أمّا العزِيمةُ: فهو إذا حضرت الصلاةُ ولم يجد الواحد الماء، فإنّه يجب عليه أن يستعمل التيمم الذي هو التراب، فإنّها حينئذ تكون عزيمة؛ لأن الواحد واجبٌ عليه أن يُصلِّي بطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبلُ اللهُ صلاة أحدِكُم إِذا أحدث حتّى يتوضّأ»، والوضوء يعني رفع الحدث، ورفع الحدث إنّما يكون بالماء أو بالتيمم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصّعِيدُ الطّيِّبُ طهُورُ المُؤمِنِ، وإِن لم يجِدِ الماء عشر سِنِين، فإِذا وجد الماء فليتّقِ الله وليمسّهُ بشرتهُ».
وأمّا الرُّخصة: فهو الرجل الذي يشق عليه استعمال الماء، إمّا لخوفِ برد، فيزيد مرضُه أو يتباطأ شِفاؤُه أو يجد حرجا في استعماله، كما لو كان بيده جُرحٌ، فالماء لا يُؤدِّي به إلى التّهلُكة لكنّه يتضرّر أو يتباطأ البُرءُ، فإن الشارع أباح له أن يتيمم، كما جاء ذلك عند أهل السُّنن من حديث عبد الرحمن بن حاطِب عن عمرو بن العاص أنّه تيمم ثم صلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صلّيت بِأصحابِك وأنت جُنُبٌ؟» قال: يا رسول الله، ذكرتُ قول الله تعالى: ﴿ولا تُلقُوا بِأيدِيكُم إِلى التّهلُكةِ﴾ [البقرة: 195]. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنده انقطاعٌ كما أشار إلى ذلك الإمامُ البيهقِي حيث أن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمرو بن العاص، والحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن حاطب عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، وهذا أصح، لكن ليس فيه التيمم، وإنّما توضأ فغسل مغابِنهُ وصلى بأصحابه.
وعلى كلِّ حال هذه هي حالة العجز التي يجوز للإنسان فيها أن يستعمل التيمم، وهي الرخصة، فإن استخدم الماء وتحمّل المشاقّ؛ فهو مأجورٌ على ذلك، وإن تركه خوفا من مرض أو برد، فإنّه لا بأس بذلك، ويكون رُخصة.
ومن ذلك أنه ربما يكون في البرّ، والبرودة شديدة، فيصعُب التوقي منه إلا في البيوت أو الخيام المحصنة من البرد، فقد يجد كُلفة وحرجا، وربما إذا احتلم في الليل وأراد الاغتسال خاصّة عند عدم وجود ماء حارّ، يخاف على نفسه المرض أو الهلكة، بمعنى زيادة المرض، فربما تيمم، فهذا التيمم رخصةٌ.
إذا ثبت هذا، فلتعلموا أن التيمم له صفةٌ، وله شروطٌ، وله فروضٌ، وله مُبطِلاتٌ..
شروط التيمم:
ذكر أهل العلم رحمهم الله للتيمم شروطا، وهم يختلفون في عدد الشروط بناء على القول الرّاجح عندهم، فمن أهل العلم من جعل شروط التيمم ثلاثة، وهي:
دخول الوقت – العجز عن استعمال الماء، أو عدمُ الماء – طلبُهُ في رحلِهِ.
وهذا هو مذهب الحنابلة والشّافعية ومن وافقهم.
وبعضُ أهل العلم يجعل شروط التيمم شرطان، وهما: العجز عن استعمال الماء، وطلبه.
وبعضُ أهل العلم يجعل شروط التيمم شرطا واحدا، وهو: العجز عن استعمال الماء.
فإذا غلب على ظنِّه أنّه ليس عنده ماء فتيمم، ثم وجد الماء في رحلِه، ولم يكن ذلك عن نقص أو تقصير أو إهمال، فإن صلاته صحيحةٌ؛ لأنّ صلاته بُنِيت على غلبةِ ظنّ.
الشرط الأول: عدمُ الماءِ.
قال الله تعالى: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا﴾ [النساء: 43]. وعدم وجودِ الماء نوعان: حِسِّيٌّ ومعنوي.
فأمّا الحِسِّي فهو أن يريد أن يصلي فلا يجد ماء أصلا، فهذا داخلٌ دخولا أوّلِيّا في قول الله تعالى: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا﴾ [النساء: 43].
ماذا يسمى هذا الدُّخول بالدلالة اللغوية: بدلالة الإلتزام أم بدلالة التّضمُّن أم بدلالة المطابقة؟
نقول: يدخل بدلالة المطابقة؛ قال تعالى: ﴿فلم تجِدُوا﴾ [النساء: 43] فعدم الوجود الحسي بدلالة المطابقة، وحينئذ نقول: إن عدم وجود الماء هو العدم الحسي.
النوع الثاني: العدم المعنوي، وهو أنّه غير قادر على استعمال الماء، إمّا لأنّه يخاف على نفسه، أو لأنّه زائِدٌ عن ثمنِ مِثلِهِ، أو لأنّه يجدُ حرجا في استعماله، فهو ليس معدوم، فالماء موجودٌ، لكنّه لا يستطيع أن يستعمله، لماذا؟ لأنّه يخاف على بدنه، أو يخاف على جُرحه، أو أنّه زائدٌ على ثمنِ مثله، مثل ما لو كان في البرد وأراد أن يتوضأ، فوجد رجلا يبيع ماء، فقال: بكم هذا الماء؟ فقال له: بألف ريال، وهو يساوي في العادة عشر ريالات، فإن الشارع يُجوِّزُ له أن لا يشتري هذا الماء؛ لأنّه زائدٌ عن ثمنِ مثله، فيكون حينئذ كأنّه معدومٌ حِسِّيّا؛ لأنّه حينما عجز عن استعمال الماء وقبضه، فكان هذا العدم المعنوي بمثابة العدم الحسي.
وهذا محلُّ إجماع من أهل العلم، وهو أنّ الواحد إذا خاف على نفسه أن يُؤدِّي استعمال الماء إلى الهلكة والعطب، فإنّه يجوز له أن يترك الماء ويستعمل التيمم.
وقد ذُكِر عن ابن أبي عمر صاحب كتاب “الشرح الكبير” أنّه قال: “لا نعلم في ذلك خلافا”. والواقع أنّ فيه خلاف عند بعض الظّاهِرِيّة، فإنّ بعض الظّاهِرِيّة لا يُبِيحُون له أن يتيمم إذا كان في الحضر، وكذلك لا يُبيحون له أن يتيمم إذا كان في الحدث الأكبر، كما رُوِي عن عمر وعبد الله بن مسعود، والله أعلم.
الشرط الثاني: دخول الوقت.
ذهب المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ في المشهور عندهم: إلى أنّ الواحد إذا كان يريد أن يتيمم فلا يصح أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها؛ لأنّهم قالوا أن التيمم طهارةٌ ضروريّةٌ، والضّرورة تُقدّرُ بِقدرِها، وقالوا: ولأنّ الله أمر عباده أن يتوضؤوا لدخول كل صلاة بقوله: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم إِلى المرافِقِ﴾ [المائدة: 6]، ثم قال: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا﴾ [المائدة: 6]، قالوا: فدلّ ذلك على وجوب الشروع في الوضوء أو التيمم لكلِّ صلاة عند دخول وقتها.
ثم قالوا: وجاءت الرُّخصةُ في ترك الوضوء لمن كان طاهرا – أي متوضئا، وبقي التيمم على حاله.
فما هو الدليل على استبعاد الوضوء؟
هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث بُريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقالوا: دلّ الدليلُ على أنّ الواحد يمكنه أن يترك الوضوء إذا كان طاهرا بطهارة مائيّة، أما التيمم فيبقى على حاله أي لابد منه لكل صلاة عند دخول وقتها. واستدلوا أيضا بما رواه ابنُ المُنذِر من أن ابن عمر كان يتيممُ لدخول وقت كلِّ صلاة، فهذه أدلة الجمهور.
والقول الثاني في المسألة: هو مذهب أبو حنيفة والأوزاعِي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهي الفتوى عندنا ورأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، قالوا: أن التيمم إنّما هو بمثابة الماء حين عدمه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «الصّعِيدُ الطّيِّبُ طهُورُ المُؤمِنِ، وإِن لم يجِدِ الماء». وفي رواية: «عشر سِنِين، فإِذا وجد الماء فليتّقِ الله وليُمِسّهُ بشرتهُ».
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام البدل وهو التيمم، مقام المُبدلِ وهو الماء، فدلّ على أن التيمم يأخذ جميع أحكام الماء، إلا ما دلّ الدليلُ الشرعيُّ عليه. قالوا: وأمّا قولهم إنّها طهارةٌ ضروريّةٌ فتُقدّرُ بِقدرها. قلنا: إنّ هذه القاعدة إذا خالفت عموم نصّ شرعيّ فلا يُعوّل عليها. وقالوا: وأمّا فعل ابن عمر رضي الله عنه فإنّما هذا غاية ما يكون فيه أنّه فِعلٌ، وفعل الصحابي لا يدلُّ على الوجوب، فإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يدلُّ على الوجوب، ففعل الصحابي من باب أولى، ولكن هذا يدلُّ على استحباب أن يتيمم الواحد لدخول وقت كلِّ صلاة.
فإن قال قائلٌ: أنتم لم تأخذوا بالوجوب فما دليل الإستحباب؟
قلنا: دليله هو عموم قول الله تعالى: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهكُم﴾ [المائدة: 6]، ثم قال: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا﴾ [المائدة: 6]، فإن تيمم الواحد لدخول وقت كلِّ صلاة؛ لأنّه يُشرع للواحد إذا أراد أن يفعل عبادة أن يُجدِّد لها وضوءا أو طُهُورا، فإذا فعل ذلك فقد أحسن أشد الإحسان، والله أعلم.
وعلى هذا، فإنّه يجوز للإنسان أن يتيمم ولو لم يدخل الوقتُ.
الشرط الثالث: طلبُهُ في رحلِه أو قريبا منه.
قالوا: لا يجوز للإنسان أن يتيمم حتى يبحث في رحله، يعني في بيته أو في خيمته أو مكانه الذي هو فيه؛ لأنّ الواجب أن يستعمل الماء، فلا تصح دعوى عدم وجود الماء إلا بيقين، واليقين لا يتحقّق إلا بالبحث، قالوا: فإذا لم يبحث ثم تيمم، ثم وجد الماء بعد ذلك في رحله، فواجب عليه أن يُعِيد الوضوء؛ لأنّه لم يكن عاجزا عن استعمال الماء ولم يكن الماء معدوما، فدلّ ذلك على وجوب البحث.
والراجح والله أعلم أن البحث مبنيٌّ على عدم وجود الماء، فإن غلب على ظنِّه عدمُ وجود الماء، ثم وجد الماء بعد، فالرّاجح أنّه لا يجب عليه أن يُعيد؛ لأنّ الصلاة بُنِيت على طهارة وهي التيمم، وعلى غلبة الظّنِّ، وغلبة الظن من الأحكام الشّرعيّة التي أناط الشّارعُ عليها.
مثال ذلك: بعض الناس قد يستعد لرحلة مثلا، فيضع أغراضه في سيارته، ثم تأتي الزوجة فتأخذ جالُون الماء، وتضعه خلف مرتبةِ السيارة، وهو لم يعلم بذلك، ثم يذهب في رحلته ويصل ويبني الخيمة، ثم يبحث عن الماء فلا يجده، ثم يتيمم ويصلي، ثم يجد فيما بعد الماء في المكان الذي وضعته فيه زوجته، فالراجح أنّه لا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنّه بنى صلاته على غلبة ظنّ، وأمّا إذا كان مُفرِّطا أو جاهلا، أو علم ولكنه نسي، فإن الراجح أنّه يُعيد الصلاة.
مثال: بعض الناس أتى بالماء فوضعه في السيارة، ثم نسي، فلمّا صلى تذكر أن قد أتى بالماء، وهو في الوقت، فنقول: الأحوط – وهو مذهب الحنابلة – أنّه تلزمه إعادة الصلاة، لأن النسيان في الشرط ليس كالنسيان في اجتناب المحذور.
فلو أن إنسانا نسي أنّه أكل لحم جزُور وصلّى، فإنّ لحم الجذور شرط، قالوا: فإن نسيانه لا ينفعه فيجب عليه أن يُعيد، فكذلك الطهارة شرطٌ للصلاة، فإذا نسي المشروط، فلا أثر لنسيانه، ويجب عليه أن يُعيد، والله أعلم.
إذا ثبت هذا، فإنّه إذا تحقّق أو بحث ولم يجد الماء، فلا يلزمه إذا جاء وقت الصلاة الثانية أن يبحث مرّة ثانية كما يقوله من يقوله من فقهاء الشّافعية، فإنّهم قالوا: يلزمه عند دخول وقت كلِّ صلاة أن يبحث. والراجح: أنّه إذا بحث مرّة واحدة وغلب على ظنِّه، أو تيقّن عدم وجود الماء؛ فلا معنى لأن يبحث مرّة ثانية؛ لأنّه مبنيٌّ على غلبة ظنّ أو يقين، واليقين لا يزول بغير اليقين، ولا يقين حينئذ، والله أعلم.
فروض التيمم:
الفرض الأول: مسح الوجه، والفرض الثاني: مسح اليدين.
فهو مسحُ، يجب تعميم المسح لا تعميم التراب، وهذه قاعدة.
فإذا قلنا أن من فروض التيمم تعميم المسح، تبسط أصابع يدك وتضرب ضربة واحدة ثم تمسح فتُعمِّم المسح، ثم تمسح ظاهر كفيك ووجهك.
وتعميم المسح شيءٌ، وتعميم التراب شيءٌ آخر؛ لأنّه لا يلزمك أن تجعل التراب في كلِّ بقعة من بُقعِ وجهك، وليس واجبٌ أن تجعل التراب في كلِّ بقعة من بقع يديك؛ لأنّ ثمّة فرقٌ بين تعميم المسح، وتعميم التراب، والله أعلم.
ويشترط فيه أيضا: الموالاة: أي أن لا يتأخر بين أعضائه، بحيث أنه لو كان هذا ماء لجفّ العُضو الذي قبله.
فإذا لم يكن لحاجة فالتفريق يُعدُّ نوعا من الإهمال، فيجب عليه أن يُعيد لما جاء في حديث الرجل الذي ترك موضع ظُفر على قدمه، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الوضوء.
ويشترط فيه أيضا: الترتيب في التّيمم: عند بعض أهل العلم. وهو أن يغسل وجهه قبل يديه. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في التّرتيب في الوضوء، وقلنا أنّ الراجح وجوب الترتيب خلافا لبعض الحنفية.
والحنابلة والشافعية قالوا: الترتيب في الوضوء بالماء كالترتيب في التيمم، فيجب عليه أن يمسح وجهه قبل يديه. هذا هو القول الأول، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا فامسحُوا بِوُجُوهِكُم وأيدِيكُم﴾ [المائدة: 6]، فيجب أن يبدأ الواحد بما بدأ الله به وهو الوجه.
القول الثاني: قال أصحابه لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوء في التيمم؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين: «إِنّما يكفِيك أن تقُول بِيديك هكذا»، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الشِّمال على اليمِينِ، وظاهر كفّيهِ ووجهِهِ. قالوا: ان النبي صلى الله عليه وسلم علّم عمارا أن يمسح اليدين قبل الوجه، فلو كان الترتيب واجبا لأمره أن يمسح بالوجه قبل اليدين. قالوا: فعلّم عمارا أن يتيمم، ولم يُوجب عليه أن يبدأ بالوجه، فدلّ ذلك على أن الواحد إن بدأ بالوجه على ظاهر القرآن فلا حرج، وإن بدأ باليدين على ظاهر السُّنة فلا حرج، فدلّ ذلك على أن الترتيب ليس بشرط، وليس بواجب، والله أعلم.
وبعض أهل العلم يجعل من فروض التيمم: دخول الوقت.
والراجح أن دخول الوقت ليس من فروضه، والله أعلم.
إذن: إذا أراد الواحد أن يُصلِّي فله أن يتيمم ويصلي، سواء دخل وقتُ الصلاة أم لم يدخل، ولو دخل وقتُ الصلاة فلا يلزمه أن يتيمم؛ لأن الراجح أن التيمم بمثابة الوضوء، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا: إن التيمم مُبِيحٌ وليس برافع.
هل التيمم مُبِيحٌ أم رافِعٌ؟
اختلف أهلُ العلم في ذلك على قولين: فذهب جمهورُ أهل العلم إلى أن التيمم مُبِيحٌ، ومعنى “مبيح” أن التيمم إنّما هو مُبِيحٌ لأداء العبادة، وليس رافعا للحدث الذي هو وصفٌ قائمٌ بالبدن.
والقول الثاني: إن التيمم رافعٌ للحدث، فهو بمثابة الماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصّعِيدُ الطّيِّبُ طهُورُ المُؤمِنِ، وإِن لم يجِدِ الماء»، والرّاجح أن التيمم رافعٌ وليس بمُبِيح.
وثمرة الخلاف في هذا هو مسائل أن من قال: إنّ التيمم مُبِيحٌ وليس برافع وجب عليه أن يتيمم لدخول وقت كلِّ صلاة. ومن قال: إن التيمم رافعٌ، فلا يُوجِب عليه أن يتيمم إذا لم يُحدِث.
وقال بعض من قالوا إنّ التيمم مُبِيحٌ: لو نوى رفع الحدث بالتيمم لم يصح تيممه.
قالوا: لأنّه نوى رفع حدث، وهو ليس بماء، ولكنّه تيمم، وهذا مذهبٌ قال به الحنابلةُ ومن وافقهم.
والرّاجح أن التيمم رافعٌ، فلو نوى أن يكون مُبِيحا للصلاة أو رافعا فإنّه لا أثر لذلك لأنّ القصد هو فعل العبادة، والله أعلم.
مُبطلات التيمم:
فمِن مبطلاته مبطلات الوضوء، وزاد شيئا آخر، وهو وجود الماء. فإذا وجد الماء فقد بطلت طهارتُه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإِذا وجد الماء فليتّقِ الله وليُمِسّهُ بشرتهُ».
وماذا لو أنّه تيمم لأداء صلاة الظهر ثم كبّر وصلّى، وفي أثناءِ صلاتهِ جاء الماءُ، فهل وُجود الماء – ولو كان في أثناء صلاته – يُوجِبُ عليه أن يقطع الصلاة؛ لأنّه حين وُجِد الماء كانت طهارتُه ليست بصحيحة؟
أم نقول أنّه ما دام قد بدأ صلاته بطهارة شرعيّة وهي التيمم، فلا تبطل هذه الطهارةُ حتى يُكمل عبادته؟
قولان لأهل العلم:
ذهب مالكٌ وهو روايةٌ عند الإمام أحمد إلى أنّه لا يلزمه أن يقطع الصلاة، قالوا: لأن الطهارة ثبتت بِمُقتضى دليل شرعيّ، فكان بمثابة ما لو عجز عن الهدي ثم شرع في الصوم، فلو شرع في الصوم وصام يوما أو يومين لمن لم يجد الهدي في الحج ثم وجد الهدي – أي قدِر على الهدي – فلا يلزمه أن يعود إلى الهدي بل يستمر في صومه.
ولعل الأحوط أنّه يُعيد الصلاة ويُعيد الوضوء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فإِذا وجد الماء فليتّقِ الله وليُمِسّهُ بشرتهُ». فلا فرق بين أن يمسه بشرته إذا وجده حال الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان لا يستطيع أن يمسه بشرته حال الصلاة إلا بقطعها، دلّ على أن قطعها هو الأصل.
والمسألة فيها كلامٌ طويلٌ عند علماء الأصول، وهو ما يُسمّى باستِصحابِ الإجماعِ، قالوا: فإن الإجماع مُنعقِدٌ على صِحّةِ طهارتِهِ في أوّلِ الصلاة. قالوا: فيُستصحبُ الإجماع إلى نهاية الصلاة. ولكن استصحاب الإجماع لا يُقال به في حالةِ وجودِ دليل يُبطِلُهُ، وهو وجود الماء هنا، والله أعلم.
ومن مُبطِلات الوضوء عند جمهور أهل العلم: أنّ الماسِح على الخُفِّ إذا خلع خُفّيهِ فإنّه تبطُلُ طهارتُه.
وقد ذكرنا الخلاف في المسح على الخُفّين، وقلنا: إنّ جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة قالوا: واجبٌ عليه ألا يُصلِّي حتى يغسِل قدميه. وذهب الإمامُ أحمد والشافعي إلى أن مجرد خلع الخُفّين يُبطِل طهارته، وقلنا القول الثالث أو الرابع وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وقول رُوِي عن النّخعِي، ورُوِي عن الحسن البصري، وقتادة وسليمان بن حرب: أن طهارته باقيةٌ.
لكن على مذهب من قال إن الخلع يبطل الطهارة، لو أنّه تيمم ولبس الخُفّ ثم خلعه، فهل خلعُ الخُفِّ يُبطِلُ الطهارة؟ أم لا علاقة بين طهارة المسح على القدمين وطهارة مسح عُضو الوجه واليدين؟
الجواب: اختلف العلماءُ في ذلك على قولين: فذهب الحنابلةُ إلى أنّ الواحد إذا خلع خُفّه ولو كانت طهارته طهارة تيمُّم، فإنّ طهارته تبطل، قالوا: لأنّ البدل يأخذ حكم المُبدل.
وذهب سائرُ الفقهاء، لا أقول جمهور أهل العلم، بل سائر الفقهاء إلى أن الواحد إذا خلع خُفّه وكانت طهارتُه طهارة تيمُّم، فإنّ طهارته باقيةٌ ما لم يُبطِلُها ناقضٌ من النواقض المعروفة، وأمّا خلع الخُفِّ فإنّه ليس بناقِض؛ لأنّه لم يتعلّق به حكمٌ، فالتيمم يكون للوجه واليدين، فلم يتعلق به حكم، وأمّا في الوضوء على القول بأنّ النزع يُبطل، فإنّه تعلّق به حكمٌ، فأُمِر أن يمسح، فإذا خلع فإنّه بمثابة من انتقل من المسح إلى الغسل، ولا غسل حينئذ.
وهذه المسألة ذكرنا الخلاف فيها، وقلنا أنّ الأحوط أنّ الواحد يُعيد الوضوء، والله أعلم.
وقلنا أنّ مسألة القياس على الرأس خطأٌ؛ لأن الرأس الأصل فيها المسح، وأمّا الرِّجلُ فالأصل فيها الغسل، فإذا خلع الممسوح فقد رجع إلى الحكم وهو الغسل، ولهذا ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنّه يجب عليه أن يغسل رِجليه، ولكن مالك قال: يُوالِي بينهما. أي يُوالي بين الفسخِ والغسلِ. وقال أبو حنيفة: إذا أراد أن يُصلي فلابُدّ أن يغسِل رِجليه. لأنّه لا يرى الموالاة في الوضوء.
والرّاجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو أن الخلع يُبطل الطهارة، والله أعلم.
وأمّا اختيار أبي العباس ابن تيمية فهو مُشكِلٌ؛ لأنّ الخُفّ قد نُزع ونُزعت أحكامُه، وأمّا الاستدلالُ بفعل عليّ رضي الله عنه فإنّ حديث عليّ الذي رواه البيهقِي إنّما هو في مسحِ النّعلينِ، أي رشُّها حتى يكون كالغسل، وأمّا النّعلان المعروفتان، فلا يصح فيهما مسحٌ حتى يُغسل القدمُ، ثم إنّ الأثر عن علي بن أبي طالب فيه كلامٌ، والله أعلم.
صفة التيمم:
هل يكون التيمم بضربة واحدة أم يكون بضربتين؟
اختلف العلماءُ في ذلك، ويُعجبني كلام الإمام الحافظ ابن حجر حينما قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم إلا حديث عمار بن ياسر وحديث أبي الجُهيمِ الذي رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم عليه رجلٌ وهو يقضي حاجته، ثم أقبل إلى جدار وضرب يديه بالجدار ومسح وجهه ويديه، وأمّا ما عدا ذلك فإنّه إمّا أن يكون حديثا ضعيفا، أو يكون موقوفا وليس بمرفوع، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله.
ولعل ما يُشتهرُ في هذا هو ما رواه الدّارقُطنيّ من حديث عليِّ بن ظُبيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التّيمُّمُ ضربتانِ: ضربةٌ لِلوجهِ، وضربةٌ لِليدينِ». وهذا الحديث الصواب أنّه موقوفٌ، وأن علي بن ظبيان قد أخطأ في رفعه كما أشار إلى ذلك غيرُ واحد من الحُفّاظ، وأنّ أكثر الرواة عن ابن عمر إنّما رووه من فعله، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وإذا ثبت هذا، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: «إِنّما يكفِيك أن تقُول بِيديك هكذا». ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة.
ولهذا قال الإمامُ أحمد: “السُّنة هي الضربة الواحدة، فإن ضرب ضربتان جاز؛ لأنّه فعلُ صحابِيّ”.
ولكن الرّاجح والله أعلم أنّه يُجزِؤُه ضربة واحدة وهي السُّنة، فإن ضرب ضربتان فإننا نقول: جائزٌ، ولكن السنة ترك ذلك، خلافا للشافعي وأبي حنيفة اللذين قالا بأن الواحد يتيمم بضربتين، والله أعلم.
فإذا تيمّم بضربتين أو بضربة واحدة، فماذا يمسح؟
الرّاجحُ أنّه يمسح الكُوعينِ، ولا يمسح الذِّراع، وأمّا ما جاء في مسح الذِّراع في حديث رواه البيهقِي، فإنّ هذا اجتهادٌ للصّحابة قبل إعلامُ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: «إِنّما يكفِيك أن تقُول بِيديك هكذا». ثم ضرب الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، فدلّ ذلك على أنّ الواجب هو الكفّان، وليس الذِّراعان، والله أعلم.
ما الذي يُشترط في تراب التيمم؟
اشترط العلماء في التراب شرطا واحدا أجمعوا عليه، وهو أن يكون طاهرا، فلا يصحُّ التيممُ بتراب نجس، سواء تبوّل فيه إنسانٌ أو وقعت فيه عذِرة، فذلك يدل على نجاسته.
واستدل العلماء على وجوب طهُورِية التراب بما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا﴾ [المائدة: 6]، قال الإمام الزّجّاجُ في “معاني القرآن”: “الطيب هو النظيفُ الطاهرُ”.
وهذا هو الأصل، فإن الطيب ضِدُ الخبيث، والطيب ضد النجاسة، والله سبحانه وتعالى حينما ذكر ذلك فإنما أمر بالطيب الحلال، والطيب ضد النجاسة.
وعلى هذا قال أهل العلم: أنه لا بد للمسلم أن يتيمم بتراب ليس بنجس، وكذلك ليس بِمغصُوب.
وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في حُكم الوضوء بالماء المغصوب، وذكرنا أن مذهب الحنابلة وقول عند المالكية: لا تصح الطهارة، والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم على صحة الطهارة مع الإثم.
وعلى هذا فالتراب إذا كان مغصوبا فالطهارة صحيحة وترفعُ الحدث، لكن الواحد يأثم باستعماله لذلك التراب الذي ليس له حقٌّ فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقِي والدّارقُطنيّ من حديث أبي سعيد: «لا يحِلُّ مال امرئ مسلم إلا بِطِيبِ نفس منه»، والله أعلم.
الشرط الثاني:
هناك شرط آخر، أشار إليه الشافعية والحنابلة، قالوا: أن يكون الترابُ له غُبارٌ.
وعلى هذا فإذا تيمم برمل ليس له غبار، قالوا: لا يصح التيمم.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقول الله تعالى ﴿فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا﴾، قالوا الصعيد هو ما رواه ابن المُنذِر والبيهقِي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: “الصعيد الطيب هو تُرابُ الحرث الذي له غبار”، وفي رواية: “هو تراب الحرث”. وهذا الأثر ضعيف يرويه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس.
والذي يظهر هو القول الثاني، وهو مذهب مالك، ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وكثير من المحققين كالشّوكانِيّ وغيره، وهو أن الصعيد هو كُلُّ ما علا على وجه الأرض منها، أو كل ما كان من وجه الأرض، كما أشار إلى ذلك الإمام الزّجّاج، فإنه ذكر في قوله الصعيد؛ قال: “لا أعلم بين علماء اللغة اختلافا، هو وجه الأرض”.
وعلى هذا: فوجه الأرض هو ما كان منها من التراب والرمل والحصى وغير ذلك، فإذا وُجِد في هذا ترابٌ أو رمل، فإنه يجوز فيه ذلك.
ومما يدل على هذا: ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في “ما امتنّ الله به على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن جعل التراب لها طهورا”، فقد جاءت أحاديث كثيرة من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حُذيفة ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ الله جعل تُربة هذه الأرض لنا طهُورا ومسجدا.
الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عبد الله بن عمرو بن شعيب: «وجُعلت الأرضُ لنا مسجدا وطهورا، فحيثُما أدركتك الصلاة فعندك طهورك ومسجدك».
وجه الدلالة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنك متى ما احتجت إلى الصلاة وقد دخل وقتها، فالأرضُ هي طهور، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون لها غبار. ومن المعلوم أنّ الرمل ليس له غبار في الغالب، فهذا يدل على أنه لا يلزمُ أن يكون الترابُ له غبارٌ. والقاعدة: “ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة”، تقول أنه فلو كان ثمة أمر واجب غير هذا؛ لبيّنهُ صلى الله عليه وسلم وقد بلّغ البلاغ المبين.
ومما يدل على هذا أيضا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار، ويقطع الفيافي والقِفار، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقُلُ التراب الذي له غبار، فدل ذلك على عدمِ وجوبِه. فقد نقل لنا الصحابةُ رضي الله عنهم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُنقلُ له العنزة – والعنزة هي الحربة – كانت تُنقل وتُحملُ، وكانت تُحملُ له الإداوة، فلما كان الشيءُ المباح أو المستحب يُنقل له، فلو كان الغبارُ واجبا؛ لأمر به أن يُنقل له، فلما لم يُنقل؛ دل على أن الأصل هو إباحة التيمم بكل ما على وجه الأرض.
وهذا هو مذهب مالك، وأبو حنيفة له وجه في هذا القول إلا أنه يُبالغ ويُدخل كثيرا من المسائلِ، وهو قول ابن حزم إلا أنه يقول: ما علا وجه الأرض مما هو متصل به، والله أعلم.
ماذا لو كان عنده بعضُ الماء الذي لا يُطهِّرُ كامل أعضاء الوضوء، فهل يصح الجمع بين الماء والتيمم؟
ذكرنا هذه المسألة، وقلنا: اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية والحنابلةُ إلى أنه يجوز الجمعُ بين الماء والتيمم إذا كان الماء قليلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فاتّقُوا اللّه ما استطعتُم﴾ [التغابن: 16]، قالوا: فإن اتقاء العبد عقوبة الله في هذا هو أن يستعمل الماء ثم متى ما انتهى وانقضى يدخُلُ التيمم فيه، وبهذا يكون قد فعل ما يستطيعه، فتوضأ في بعض أعضائه بالماء الموجود وتيمم للبعض الآخر.
وقالوا: إنه إن تيمم وترك الماء؛ فلم يكن غير واجِد للماء، وقد وُجِد، والله يقول: ﴿فلم تجِدُوا ماء﴾ [النساء: 43]، والوجود هنا إما وجود كامل أو وجود ناقص.
ثم قالوا: ولا يصح الإستدلال على المنع بأن يُقال: لا يجمع بين البدلِ والمُبدلِ، فقد ذهب المالكية والحنيفية إلى أنه لا يجوز أن يجمع في أعضاء الوضوء بين البدل والمبدل.
فالجواب على هذا: أن القاعدة صحيحة وسليمة وهي أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، لكن هذه القاعدة في عدم جواز الجمع بين البدل والمبدل في عُضو واحد، فأما نحن فلم نجعلِ الوجه يُتيمم له بالتراب ويتوضأ له بالماء، إنما التراب لما لم يصله الماء، فدلّ ذلك على أننا لم نجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، فإنما جعلنا البدل في بعض أعضاء والمبدل في أعضاء الأخرى، وهذا هو اختيار ابن تيمية، وهو الراجح، والله أعلم.
إذا أراد أن يصلي وفي جسده نجاسة لا يستطيع أن ينفكّ عنها، فهل يصح أن يتيمم بدلا عن إزالة النجاسة بالماء؟
وهذه مسألة، وهي في مذهب الحنابلة: فمن المعروف أن من كانت في بدنه نجاسة فواجب عليه أن يزيلها، لقوله تعالى: ﴿وثِيابك فطهِّر﴾ [المدثر: 4]، ولحديث أبي داود وأهل السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما أذى؛ فليُمِطهُ»، فهذا يدل على أنّ الواحد مأمور على أن يُزيل الأذى من بدنه وجسده الذي يُصلي فيه.
قالوا: فإن عجز، إما لعدم وجود الماء، وإما لعدم استطاعتِه، فهل يتيمم بنية الإزالةِ، والنجاسة موجودة لم تُزل؟
ذهب الحنابلة إلى أنه يتيمم كما لو حُبِس في بُقعة فيها نجاسة، فإنه يتيمم لرفع الحدث، ويتيمم للبقعة.
وذهب سائرُ الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية، وعليه أكثرُ فقهاء الأمصار إلى أن التيمم إنما جاء لعبادة وهي رفعُ الحدثِ، ولم يأت التيمم لإزالة النجاسةِ.
ثانيا: ولأنّ التيمم إنما جاء بصفة مخصوصة، وهي ضربُ الأرضِ ضربة واحدة ومسحُ الوجه واليدين، وليست هذه إلا في رفع الحدث، فأما إزالةُ النجاسةِ فهي عينٌ خبِيثة متى ما زالت زال أثرها، وإن بقيت فإنها كحُكم المعدوم، والقاعدة: أنّ المعدوم لا حُكم له.
وهذا هو الراجحُ، أن الواحد لا يصحُّ له أن يتيمم لإزالةِ النجاسة، أو لأن يكون بدلا عن إزالتها بالماء، والله أعلم.
هل يتيمم الواحد لرفع الحدث الأكبر؟
مثال: أناس في البر، فاحتلم أحدهم، ويشُقُّ عليه أن يغتسل؛ يخاف على نفسه الهلكة أو زيادة مرض، فهل يصح أن يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك، فذهب سائر فقهاء الأمصار وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى جواز أن يتيمم للحدث الأكبر، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ إِن كُنتُم جُنُبا فاطّهّرُوا وإِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ مِنكُم مِن الغائِطِ أو لامستُمُ النِّساء فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا صعِيدا طيِّبا فامسحُوا بِوُجُوهِكُم وأيدِيكُم مِنهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِيجعل عليكُم مِن حرج ولكِن يُرِيدُ لِيُطهِّركُم ولِيُتِمّ نِعمتهُ عليكُم لعلّكُم تشكُرُون ﴾ [المائدة: 6]، فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الحدث الأكبر ﴿كُنتُم جُنُبا﴾ والحدث الأصغر ﴿أو جاء أحدٌ مِّنكُم مِّن الغائِطِ﴾، فذكر ذلك وأمر بالتيمم ﴿فلم تجِدُوا ماء فتيمّمُوا﴾.
وذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كما روى ذلك البخاري ومسلم إلى المنع، فقد امتنعا ومنعا أن يتيمم الواحد للحدث الأكبر، وقيل إن عمر رجع إلى قول الجمهور.
وقال: عبد الله بن مسعود كما روى البخاري ومسلم، قال: قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، ما تقولُ في رجل أجنب ولم يجدِ الماء؟ قال: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا”. يعني لا يصلي حتى يجد الماء ثم يقضِي ما فاته؟! لكن خفيت عليه، وهذا يدل على أن الواحد مهما بلغ من العلم فقد تخفى عليه بعض المسائل، فهذا عبد الله بن مسعود الذي مُلِء علما، والحبرُ المُلهم عمر بن الخطاب، خفيت عليهما هذه المسألة، فنحن من باب أولى وأحرى، لأجل هذا ينبغي التماس المعذرة للآخرين، فالواحد مهما بلغ من العلم قد يهِم أو يخطئ أو يزل، قال ابن تيمية: “والغلطُ واقع في عامةِ الناس حتى من الصحابة”. فالصحابة غلِطُوا، فعدي بن حاتم جاء بحبلين فوضعهما أمامه فجعل يأكل حتى يتبين له رِئيُهما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن وِسادك إذن لعرِيض، إنما المراد بياض النهار من سواد الليل»، فالخطأ والوهم حاصل من الناس صغيرهم وكبيرهم، ولكن الخطأ الأعظم هو أن يُبيّن للواحد الخطأ فيبقى ويصر عليه.
قال يحيى بن معين: “ليس العيب ممن يخطئ في الحديث؛ ولكنّ العيب أن يُخطئ ولا يرجع عن خطئه بعد أن أُخبِر”. وهذا كلمة عظيمة، فالواحد كلما كثرت مروِيّاتُهُ ومحفوظاته وكثُر علمُه فإنه ربما ينسى، أما الذي عنده محفوظات أو علمه قليل فإنه يُكرره ولا ينسى.
هل الحجر من الصعيد؟
ذكر بعض أهل العلم أن الحجر من الصعيد، وهو قول للمالكية. وقال بعضهم: إن الحجر ليس منه، وهو قول لبعض الظّاهِرِيّة.
والذي يظهر والله أعلم من قول الله سبحانه وتعالى: ﴿أفلا ينظُرُون إِلى الإِبِلِ كيف خُلِقت * وإِلى السّماء كيف رُفِعت * وإِلى الجِبالِ كيف نُصِبت * وإِلى الأرضِ كيف سُطِحت﴾ [الغاشية: 17-21]، أنه سبحانه وتعالى غاير بين الأرضِ وبين الجبال، مما يدل على أن الأرض ليست من الجبال، ولعل هذا أظهر، إلا إذا كان هذا الحجر وهذا الجبل فيه غُبارٌ، فيكونُ قد علِق فيه شيء من أجزاءِ الأرض.
كيف يتيمم في الأماكن التي فيها ثلج، ولا يستطيع الحصول على الماء؟
مثل منطقة القطب الشمالي أو سيبيريا حيث إن الأرض مليئة بالثلوج، فلا يستطيع الناس أن إذابته ليحصلوا على ماء، ولا يجدون التراب، فهل يصح أن يتيمموا بالثلج؟
ذهب الحنيفية رحمهم الله إلى جواز التيمم بالثلج؛ لأنه من الصعيد، فكل ما علا على وجه الأرض صار صعيدا.
والقول الثاني هو قول سائرُ فقهاء الأمصار: أن الثلج إنما هو شيء عارض ليس من صُلبِ الأرض، ولا من صُلب الصعيد، والأصل في الأرض هو عدم وجود الثلج، والرسول صلى الله عليه وسلم خص الأرض والتراب، فقال: «وجُعِلت تُربتها لنا طهورا»، وقال: «وجُعِلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» فجعل هذه المِنّة إنما هي في الأرض، ولو كان شيءٌ مما يعلقُ في الأرض لذكره الله خاصة أن ذلك في مقام الإمتنان، فلما لم يذكره وليس من أجزاء الأرض، فالراجح أنه لا يجوزُ له ذلك.
فماذا يصنع؟
إن استطاع أن يأخذ الثلج فيتمسح به، ويكون بمثابة الوضوء فهو أفضل من عدمه، فإننا ذكرنا فيمن به جرح، إما أن يغسله وإما أن يمسحه بالماء وإما أن يتيمم له، فإذا استطاع أن يتمسح بالثلج فالحمد لله، وإذا لم يستطع فإنه ينوي رفع الحدث، ويصبح بمثابة ما لم يجد الماء ولا التراب، والراجح أن من لم يجدهما ينوي رفع الحدث ثم يصلي؛ لأن هذا هو ما يستطيعه.
هل يلزم لمن يسافر إلى أماكن فيها ثلوج أن يصطحبوا ترابا معهم لكي يتيمموا؟
لا يلزمهم. وقد ذكرنا في باب الوضوء أن الواحد لا يلزمه أن يحمل الماء، وقلنا أنهم لما قالوا: “يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته”، وهذا يدل على أنهم لما لم يُؤمرُوا أن يحمِلوا ماء لوضوئهم، فلا يؤمروا أن يحملوا ترابا لتيممهم، والله أعلم.
12. الحيض
باب الحيض:
ي ما هو دم الحيض – ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ – ما هو السن الذي ينقطع الحيض فيه عن المرأة؟ – ما أكثرُ مدة الحيض؟ – ما أقل مدة الحيض؟ – ما أقل الطهر بين الحيضتين؟ – المسألة الملفقة
ما أكثر مدة الطُّهرِ؟ – المُبتدِئة، وهي التي جاءها الحيض أول مرة – لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي أو تصوم – هل تؤجر المرأة الحائض على حيضها؟ – إذا جاء المرأة الدم في أقل من عادتها؟ – إذا كانت عادتها ستة أيام، فجاء الحيض الشهر الثاني بزيادة عن عادتها؟ – ما هي المرأة المُستحاضةُ؟ – ما هي الصُّفرةُ والكُدرةُ؟ – بعض النساء قد تستعجل الطهر فما هي علامات الطهر؟ – إذا وطئ الرجل الحائض فهل عليه كفارة؟ – ما حُكم دخول الحائض المسجد؟ – هل يقع الحكم إذا تدفق الحيض أم يكفي القليل منه؟ – هل يقع الحكم إذا تدفق الحيض أم يكفي القليل منه؟ – إذا نزفت المرأة في غير أيام الحيض، ويكون أحيانا من الرحم، فهل تعتبره؟ – هذا يؤخذ بالرأي الطبي في ألوان دم الحيض ومدته؟ – بعض النساء عندما تقارب الأربعين تحيض مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، مرات متقطعة، ويكون سببه إما اللولب أو اضطراب هرموني؟
ما هو دم الحيض:
باب الحيض من أدق أبواب الفقه، وقد قال الإمام أحمد: جلست تسع سنين أتأمل في باب الحيض.
وقال الإمام النووي رحمه الله: اِعلم أن باب الحيض من عَوِيصِ الأبواب، وغلِط فيه الكِبار، وصنّف فيه المحققون.
والسبب في هذا ليس في مسألة الحكم الشرعيِّ نفسها فهي واضحة، ولكن في تحقيقِ مناطِها على أجناسِ النساء؛ ذلك أنك تعلم مثلا أن أقل الحيض مثلا على قول من يقول يوم وليلة، ولكن هل الذي أتاها هو حيض أو دمٌ آخر، فقد يُشكل عليها هل هو دم الحيض الذي علّق الله به أحكام أو دم آخر.
وكتاب الحيض موجود في كل أبواب كتب الأئمة الكبار، فالحكم الشرعي موجود، وقد ذكروا أدلتهم، ويختلفون من حيثُ الراجحُ والمرجوحُ على حسبِ معرفة كلِّ واحد منهم للدليل، كما يختلفون في باب التيمم والوضوء والصلاة.. إلخ.
مثال: جاء في الحديث الذي رواه البخاري: أن النساء كنُّ يأتين إلى عائشة بالكُرسُف – يعني بالقُطنةِ التي تضعها المرأة في مكان الدم- فكانت عائشة تقول: انتظرن حتى ترين القصّة البيضاء. وهي سائل – على المشهور – يأتي المرأة بعد الجفاف كدلالة على نقاء الرّحِم، وبعض النساء لا تميز هل هو صُفرة فيكون في حُكم الحيض، أو هو دمُها الذي يأتيها وهو القصة البيضاء، فيُشكل عليها تطبيق الحكم الشرعي الذي تعلمُهُ، فهذا هو سبب الغموض.
والله سبحانه وتعالى قد وضع هذا الدم في المرأة رحمة بالجنين ليكون غذاء له، فالجنين في بطن أمه يتغذى على الدم الذي تقذفه المرأة في رحمها.
الحيض في اللغة: هو السّيلان، فإن الحاء والياء والضاد تفيد معنى السيلان والانفجار، ومنه سُمي الحوضُ حوضا؛ لأن الماء يحِيضُ إليه، وتقول: حاض السيلُ إذا انفجر أو سال.
وأما في الاصطلاح الفقهيِّ؛ فهو: دمُ طبيعةِ وجِبِلّة يخرجُ من قعرِ الرّحِمِ يأتي على أوقات معلومة.
وجملة “دم طبيعة وجبلة” تفيد أنه دم جبلة، كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعائشة «إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم».
وعلى هذا فإذا كان هذا الدم الذي يأتيها ليس هو الطبيعي الذي يأتيها في العادة، فهل يكون حيضا؟
لا يكون حيضا، فهو ليس دم جبلة وطبيعة، ولهذا تَعرف المرأةُ الحصِيفةُ الدم الذي يأتيها.
وأما ما يأتي المرأة عبر طهرها من خيوط وغير ذلك، فهذا أحيانا له أثر في نفسية وتعب المرأة، وهو ليس دم الحيض لأنه ليس دم طبيعة وجبلة.
الوصف الثاني: أنه يخرج من قعر الرحم.
فكونه يخرج من قعر الرحم لا بد أن يكون دم طبيعة وجبلة، وإلا فإنّ الدم أحيانا يخرجُ من قعر الرحم وهو عرق أي جرح، وليس دم الطبيعةِ والجِبِلّة؛ وقد يسببه وضع اللولب لمنع الحمل. ولكن إذا خرج بدم طبيعة وجبلة ومن قعر الرحم، فإنه يكون حيضا.
الوصف الثالث: أنه يخرج على أوقات معلومة – وقته معلوم عند غالب النساء – ولكن بعض النساء قد لا تدرك ذلك إذا كانت لا تُحسِنُ معرفة عادتِها، فإنها تخرج وترجع إلى التّميِيزِ، وهو أن تميز بين الدم البُحراني والدم غير البحراني.
وأفادنا العلماء بهذه الشروط أن دم الإستحاضة ليس بحيض، لأنه يخرج على غير أوقات معلومة. الثاني: لأنه ليس دم طبيعة وجبلة. والثالث: لأنه عِرق، والله أعلم.
ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟
في البداية نضع أصولا في باب الحيض؛ لتضبط لنا هذا الباب:
الأصل الأول: أن الشّارِع علق أحكام الحيض على وجوده، فقال تعالى: ﴿ويسألُونك عنِ المحِيضِ قُل هُو أذى فاعتزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة»، فجعل الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، وجود الدم دلالة على تطبيق أحكامه.
الأصل الثاني: أن الأصل أن كل دم يأتي المرأة منضبطا في أوقات ويرتفع في أوقات، أنه دم حيض، لأنه يأتي في أوقات معلومة.
الأصل الثالث: أن الحيض مرتبط بعامة النساء، كما جاء في الحديث الذي رواه التِّرمِذِيّ في قصة حمنة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحيّضِي في عِلمِ اللهِ ستّا أو سبعا، كما تحِيضُ النساء»، فعلق أحكام الحيض من حيثُ خفاؤُهُ أو ظُهُورُهُ على ما تعتادُهُ النساء في غالب حيضِهِن.
انتبه لهذه القاعدة: علّق الشارِعُ من حيث خفاءُ الدم أو حُكمُ الدم على غالب ما يأتي النساء، فالغالب الذي يأتي النساء هو الذي يعلق به حكم، وأما ما شذّ وندر، فإننا نقول: النادر لا حُكم له.
إذن نقول: اختلف العلماء في السنِّ الذي تحيض فيه المرأة، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أقل سِنّ تحِيضُ فيه المرأة هو تِسعُ سنين، وقد ذكروا على ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تِسع سنين فهي امرأة، يعني فحاضت فهي امرأة.
قالوا: ولأنّه هو السن الذي اعتادتِ النساء أن يقع عليهن الحيضُ، وإلا فإن الغالب أن البنت لا يأتيها الحيض إلا في سن 12 أو 13 أو 14، وهذا يختلف حسبِ برودة البلد أو رطوبته أو طبيعة النساء في ذلك البلد، مثل المرأة التي تعيش في الجبال، فهذا له أثر، لكنهم قالوا: الغالب في عامة النساء أنّ المرأة لا تحيض في أقلّ من تسع.
وعلى هذا جعلوا تسع سنين حدّا، فإن وُجد دمٌ قبل تسع سنين، قالوا لا عبرة له، لأن هذا نادرٌ أن يأتي النساء، والنادر لا حُكم له. وهذا قول عامة أهل العلم.
وذهب ابن تيمية وابن رشد من المالكية إلى أنه ليس ثمة سِنٌّ يُحدّدُ فيه حيضُ المرأةِ، فيمكن أن تحيض بنت ثمان أو سبع، فمتى وُجِد الدم الذي يأتي كعادته وجبلته وله أوقات معلومة فهو حيض، وإن كان عندها أقل من تسع سنين.
والدليل أن الله علق أحكام الحيض على وجوده ولم يحدده بسن معينة، فمتى وُجِد فقد ثبت حكمه، وهذا القول قوي، وهو أظهر، لكن بشرط أن نسأل، هل قريباتُها كأمها وخالتها وعمتها وأختها كان يأتيهن الدم قبل التاسعة أم لا؟ فإن كان يأتيهن في السن السابعة مثلا، وهو دم منضبط قلنا: هو دم حيض.
وأما إذا لم يكن يأتيهن إلا في التاسعة فإننا نقول: هذا نادر، والنادر لا حكم له.
فإن تكرر في الشهر الثاني والثالث حتى صار هو الأصل في حقها، قلنا: تُعلقين به الحكم؛ لأن الشارع علق الحكم على وجوده، فجاء هذا الدم منضبطا وفي أوقات معلومة ودم جبلة وطبيعة.
ما هو السن الذي ينقطع الحيض فيه عن المرأة؟
اختلف العلماء أيضا على أكثر الحيض، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه خمسون سنة، ينقطع الحيض عندها، وعليه لو رأت الدم بعد ذلك فلا تعتدُّ به، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند بعض المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال بعضهم: ستون سنة، وقال بعضهم: سبعون سنة.
والراجح – كما قلنا في أقله – أن الأصل والغالب أن المرأة ينقطع حيضها في الغالب إذا بلغت خمسين سنة. فإن كانت عماتها وخالاتها وأمهاتها وأخواتها يبقين إلى أكثر من ذلك، وهو في أوقات معلومة ودم منضبط جبلة وطبيعة، فإنها تعتد بالحيض، والله أعلم.
وعلى هذا فلا حاجة لأن نستدل بقول الله تعالى: ﴿واللائِي يئِسن مِن المحِيضِ﴾ [الطلاق: 4]، لأن اليأس من المحيض ليس له حد محدود، فربما تيأس المرأة من الحيض وهي في أربعين سنة أو سبعين أو ستين.
وقيل: إن المرأة لا يمكن أن تحمل إلا وهي تحيض، وقالوا ان امرأة إبراهيم عليه السلام كانت في السبعين، وهذا من أخبار بني إسرائيل، ولا يثبت فيه حديث صحيح يُصارُ إليه، والله أعلم.
ما أكثرُ مدة الحيض؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فربما حاضت المرأة يوما وليلة، أو يومين أو ثلاثة، أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، وهذا عند عامة النساء، لكن هل يمكن أن يزِيد الدمُ في حق النساء فما هو أكثره حينها؟
نقول: اختلف العلماء في ذلك، فذهب عامة الفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فمتى رأتِ الدم في أثنائها فهو حيض، فإن كانت تحيض ستة أيام ثم جاءها الدم في اليوم الثاني أو الشهر الثاني أكثر فإنها تعتد به إلى أن يكون خمسة عشر يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا يضرها الدم، وتتوضأ لكل صلاة.
هذا هو قول عطاء بن أبي رباح، وهو قول الشافعي، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر السلف كما يقول النووي رحمه الله. ويستدلون على هذا بأنه في غالب النساء.
إذن أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.
وليس ثمة دليل مرفوع ولا موقوف في أقل الحيض ولا في أكثره، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وكل إمام يلتمسُ ما كان من عادة النساء، فإن وجد بعد الاستقراء أن المرأة تحيض أقل من ذلك أو أكثر، علّق به حكما، فإذا لم يعلم بنى الأمر على عادة النساء.
وقد قلنا أن باب الحيض عُلِّق على عادة النساء، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه التِّرمِذِيّ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحَمْنَة بنت جحش: «تحيّضِي فِي عِلمِ اللهِ سِتّا أو سبعا كما تحِيضُ النِّساءُ»، فعلّق حيضها أو عادتها على عادة نسائها – قريباتها، خالاتها، عماتها، أخواتها، أمهاتها –، وهذا هو الحكم.
الأمر الآخر: أن الشارع علّق الحيض على وجوده، ورتب عليه أحكاما، أي متى ما جاءها الأذى فقد جاءها أحكام الحيض، ومتى ما زال عنها الأذى فقد زال عنها أحكام الحيض.
وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: «إذا أقبلت الحيضةُ فدعِي الصّلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسِلِي عنكِ الدّم وصلِّي»، فعلّق الحكم على إقبال الحيض وعلى إدباره. فإذا أقبل الحيض مُنِعت من الصلاة والصوم، وإن أدبر أُمرت بالصلاة والصوم، وهذا هو الأصل، وهو أنّه كلما وُجِد الدم فإن الشارع يُعلِّقُ به حكم الحيض.
لكن هذا الدم الذي علّق الشارعُ به، ربما يأتي المرأة في بلد في يوم وليلة، أو لا يزيد على خمسة عشر يوما، فالغالب والأصل أنّ كُلّ ما كان على عادة النساء – ما ينتشر عند النساء – فهو المُعوّل، فإن وُجِدت امرأة تزيد على ذلك أو تقِلُّ عنه – أقل الحيض أو أكثره – فإننا نقول: إن كان من عادة نسائها ما هي عليه فإنها تعتد به، وإن لم يكن من عادتهن واستمر في الشهر الثاني والثالث، علمنا أن ذلك هو عادتها، ولو كان أقل من غالب ما يأتي النساء. والراجح أن أقل الحيض يوما وليلة ما لم يأتيها أقل من ذلك ويعتاد فيجب حينها الإعتاد به لأنه معتاد لها. ولهذا قال الإمام الأوزاعي: “كانت امرأة تحيض غدوة وتطهُرُ عشِيّة وكانوا يرون أن ذلك حيض”. فالأوزاِعي أدرك امرأة تحيض في كل شهر نصف يوم أو يوم دون ليلتها، أي دون 24 ساعة، أي تقريبا 12 ساعة من كل شهر، فهذه المرأة علق الشارع بها حُكمُها على عادتها، فنقول: إن عادتها أولى من عادة قريباتها، وأقرب من عادة النساء عموما، لأن الأصل والمعول عليه هو عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحيّضِي فِي عِلمِ اللهِ سِتّا أو سبعا»، فنساء من هذا النوع تحيض أقل من ذلك، وهذا هو الراجح.
كذلك نقول في خمسة عشر يوما، أن الأصل هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن أكثر الحيض هو خمسة عشر يوما، فإن زاد على ذلك وتكرر كل شهر علمنا أن حيضها يزيد عن خمسة عشر يوما إلى ستة عشر أو سبعة عشر يوما، وعلى هذا فقس.
ما أقل مدة الحيض؟
اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وعلى هذا فلو وُجِد امرأة تحيض اثني عشر ساعة، فإنه لا يُعدُّ حيضا بل يكون دم فساد، فتتوضأ إذا جاءها ذلك الدم لأنه في حكم الحدث.
قالوا: لأننا لم نجد امرأة تحيض أقل من ذلك، والمرجِعُ في باب الحيض إلى عادةِ النساء، واستدلوا على ذلك بما رواه الدّارِمِي من حديث عامر الشّعبِي عن علي بن أبي طالب أن امرأة جاءت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تُخاصِمُ زوجها وقد طلقها، فادّعت أنها انتهت من عادتها في شهر – انتهت من عدتها في شهر، والعدة ثلاثة قُرُوء –، فقال علي بن أبي طالب لشريح: ما تقضي فيها؟ فقال: إن جاءت بامرأة من بِطانةِ أهلها يُرضى دينها وأمانتها تشهد أنها تحيض يوما وليلة ثم تطهر وتغتسل وتصلي، وإلا فلا.
وجه الدلالة: أنها ادعت أنها تطهر في يوم وليلة لأن أقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوما، فهي تحيض يوما وليلة، ثم تطهُرُ ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. كم عندنا؟ يوم وليلة حيض، وثلاثة عشر يوم طهر، فهذه أربعة عشر، ثم تحيض يوما وليلة، فهذه خمسة عشر، ثم تطهر ثلاثة عشر، ويصبح الجميع ثمان وعشرين، ثم تحيض يوما وليلة، تسع وعشرين، ثم بعد حيضها الثالث تطهُر، فتكون قد انتهت من عدتها في شهر، هذا دليلهم، دليل من قال أن أقل الحيض يوم وليلة.
ولا شك أن هذا الاستدلال محلُّ نظر من وجهين:
أولا: من حيث إسناده، وذلك لأن الحديث ضعيف، وذلك لأن عامر الشعبي رواه عن علي بن أبي طالب ولم يصح سماعُ الشعبي من علي، فدل ذلك على أن الحديث منقطع، والله أعلم.
الثاني: أن تأويل الحديث على أنّ حيضها كان يوما وليلة محلُّ نظر، فعلى مذهب الحنيفية يقولون: أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، وأقل الحيض ثلاثة أيام، هذا مذهب الحنيفية، فقالوا: إنها تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر عشرة أيام، كم هذه؟ ثلاثة عشر، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم تطهر عشرة أيام، كم هذه؟ ست وعشرين. ثم تحيض ثلاثة أيام، كم هذه؟ تسع وعشرين، ثم تطهر بعد ذلك فيكون حيضها وعِدّتُها ثلاثة قُرُوء في شهر، فليس فيه دلالة على أن أقل الحيض يوما وليلة، فجائز أن يكون ثلاثة أيام على مذهب الحنيفية.
ولهذا ذهب الحنيفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، فإن جاء الدم يوما وليلة أو يومين على مذهب الحنيفية فإنها لا تعتدُّ به.
والراجح أنه ليس لأقل الحيض حدٌّ محدود، فجائز أن يكون حيض المرأة أقل من يوم وليلة، شريطة أن يعتاد هذا في حقها، فإن لم يعتد فالأصل والغالب أن الحيض لا يكون إلا يوما وليلة.
فنحن حينئذ أخذنا بأنه جائز أن تكون المرأة تحيض أقل من ذلك؛ لأنهم استدلوا بالموجود، وقد روى الأوزاعي أنه قد كانت امرأة تحيض غدوة وتطهر عشِيّة، فهذا يدل على أن أقل الحيض يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة، وهذا القول هو مذهب مالك، واختيار ابن تيمية رحمه الله في الجملة، من حيث أنه لا حدّ لأقله.
ونحن نقول: الأقرب أن أقل الحيض يوما وليلة؛ لأن هذا هو غالب عادة النساء، فإن جاء المرأة أقل من ذلك واستمر على أن يأتيها اثنى عشر ساعة تقريبا، ثم ينقطع. فإننا نقول: إن استمر كل شهر على هذا فإنها تعتبره حيضا.
وأما إن كان أقل الحيض في العادة يأتيها يوما وليلة أو ثلاثة أيام، ثم فجأة جاءها أقلّ من يوم، يعني بعض النساء تطهرُ وتأتيها القصّة البيضاء، ثم تذهب بعد طهرها وقد اغتسلت فتذهب إلى دورات المياه، فتتمسح فتجد خيوطا حمراء، فنقول: هذا ليس بحيض، لأن الحيض لا يكون بهذه الطريق، والنساء يكون حيضها على الوجه المعتاد ثجّا، ثم بعد ذلك يتراخى بحيث لو مسحت وجدت دما، ولكن متى ما حصل الجفاف ونزلت القصة البيضاء بعدها فهذا هو الطُّهرُ الذي لا طُهر بعده.
أما هذه الخيوط أو نزول الدم ثجة ثم بعد ساعة ارتفع، هذا لا تعتبره حيضا، لأن الأصل أن عادتها ستة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام، فلا تُعوِّل على هذه الطريقة في ظهور الدم؛ لأن هذا قد يكون بسبب نفسيتها أو جُهدِ بدنِها، وعلى هذا فإن المرأة التي لها عادة وهي خمسة أيام أو ثمانية أيام، إن طهرت بعد ذلك فمسحت فوجدت خيوطا حمراء، لا تعول عليها بل تقول إنه دم فساد، والله أعلم.
إذن الراجح أنه لا حدّ لأقل الحيض إذا تكرر، ولكن الأصل هو أن أقله يوم وليلة ما لم يأت بأقل ويعتاد.
وعلى هذا نقول: أن ما جاء تحديده في الشرع لا يخلو من ثلاثة أشياء:
الأول: ما جاء تحديده في الشرع، وذلك مثل أنصِبةِ الزكاة ومقدار نِصاب الموارِيث وعدد ركعات الصلوات المفروضة الخمس والجمعة والاستسقاء، فهذا تحديده لم يُجعل للبشر، إنما جُعل في حق الشارع، فيجب المصِيرُ إليه.
الثاني: ما لم يأت تحديده في الشرع، وإنما جاء في اللغة، فيُصارُ إلى اللغة، مثل تحديد الشّهر، فالشهر تِسعٌ وعشرين وثلاثون يوما، والأسبوع سبعة أيام، واليوم وليلته أربع وعشرين ساعة، فهذا تحديدهُ في اللغة.
الثالث: ما لم يأت تحديده في الشرع ولا في اللغة، فالمُعوّلُ في ذلك على العادةِ والعُرف، وهذا مثل القبض، والحِرز، فكل من سرق مالا من حِرزِهِ فإنه يجب أن تُقطعُ يدُهُ، والحرز إنما هو مصير ذلك وتحديده إلى العُرفِ، ولهذا قال الناظم:
وكل ما أتى في الشّرعِ ** ولم يُحدّد فبالعُرفِ احدُدِ
وهذا مثل السفر عند بعض أهل العلم، كما ذكر ابن تيمية. ونحن نقول: مثل الحيض والنفاس، فإن أكثر مسائل الحيض مردها إلى عرف النساء، والله أعلم.
ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله: “لم يصح عن الأئمة في هذا الباب”، يعني تحديد أقل الحيض أو أكثر الحيض، ولا أقل النفاس ولا أكثر النفاس، وقد ورد في أكثر النفاس، لكن الحيض قال: “لم يصح عن الأئمة في ذلك حديث مرفوع ولا موقوف، وإنما المرجِعُ في ذلك إلى العادة”.
والقاعدة: أنه كل ما وجب تحديده ولم يرد في الشرع ولا في اللغة، فإن المصير إلى عرف الناس، والله أعلم.
ما أقل الطهر بين الحيضتين؟
المقصود به أن المرأة جاءها الحيض في عادتِها ثم طهُرت، فكم أقل الطُّهر حتى يأتيها الحيض التالي؟
بحيث لو جاءها الدم بعد طُهرِها بأسبوع، فهل تُعوِّلُ على هذا وتعتبره دم حيض أم لا؟
يعني: لو أن امرأة عادتها ثمانية أيام فجاءها الطهر بعد ثمانية أيام، ثم طهرت أسبوع، ثم جاءها دم آخر، فهل تعول على هذا الدم أو لا تعول عليه؟
فإن قلنا لا عول عليه فلأن أقل الطهر خمسة عشر يوما أو ثلاثة عشر يوما على الخلاف، فإن قلنا تعول عليه فإنها تعتبره حيضا، هذه المسألة.
إذن اختلف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، فذهب جماهير أهل العلم من الحنيفية والشافعية والمالكية، ورواية عند الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر خمسة عشر يوما.
قالوا: لأن أكثر الحيض هو خمسة عشر يوما فيكون أقل الطُّهرِ بين الحيضتين خمسة عشر يوما، والله أعلم.
وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن أقل الحيض ثلاثة عشر يوما، استدلالا بقصة علي التي مضت، وهي: إن جاءت بِبِطانة من أهلها له أمانة وعدل تشهد أنها تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثم تحيض، فهذا دلالة على أن الطهر ثلاثة عشر، تحيض يوما وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر فتكون قد انتهت من عدتها، ولكننا نقول إن هذا الحديث ضعيف (لأن الشعبي لم يسمع من علي)، والله أعلم.
وذهب ابن تيمية إلى أنه لا أقلّ لمدة الحيض، والذي يظهر والله أعلم، أنه لا بد من تحديد أقل الحيض؛ لأنه لا يمكن أن يكون الدم في غالب حالة المرأة، وأما أن نقول هو حيض ما لم تعبُر أكثره.
وكيف تعبر أكثره؟ كيف يقال متى تعبر؟ هي لا تعرف، فإذا نحن علقنا على عادتها تقول أنا لا أدري ما عادتي، فلا بد أن نحدد ذلك بمدة، ولهذا قال الحنيفية: لا ينضبط، وإلا وقع الناس في حرج وتكليف بما لا يستطيعونه، فلا بد من تحديد.
ولهذا الذي يظهر لي أن أقل الحيض هو إما ثلاثة عشر يوما؛ لأنه أقل ما وُجد، وإن كان الغالب هو خمسة عشر يوما، وعلى هذا، فإنه لا يُعوّلُ على الثلاثة عشر إلا إذا كان ذلك اعتاد منها كل شهر، والله أعلم.
وعلى هذا إذا كانت المرأة عندها عادة ثمانية أيام ثم اغتسلت، وبعد أسبوع أو أسبوع ونصف جاءها دم، وهذا يحصل دائما في وقت الحج أو العمرة، تطهُرُ المرأة من عادتها، وليس عندها إشكال لكن بسبب اضطراب نفسيتها ينزل الحيض – فهي تفكر قائلة أخشى لو نزل أن أحبس أهلي، وأخشى وأخشى – فبسبب الإضطراب النفسي ربما ينزل بعض هذا الدم، هذا الدم الذي ينزل بعد الطهر لا تعول عليه، لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما، فإذا كان الطهر ثلاثة عشر يوما ثم جاء دم، فإنها تعتبره حيض، وإن كان أقل من ذلك فلا تعتبره شيء إلا إذا كان لها تمييز أو عادة، مثلما لو جاءها الدم على ما هو معتاد، دم أسود، ثخين له رائحة كريهة فإنها تعتبره شيئا، أما إذا كانت لا تعرفه وترى دما في القطعة التي تضعها في مكان الدم فإننا لا نعول عليه.
وإذا ضبطت المرأة هذه المسألة فإنها بإذن الله لا يقع عندها إشكال.
إذن الذي يأتي بعد الطهر، إن جاء في أقل من ثلاثة عشر يوما فإنها لا تعتبره حيضا ما لم يكن فيه أوجاع الحيض، وهو دم أسود ثخين وله رائحة، وإلا فإنها لا تعتبره، أو كان هو عادتها.
المسألة الملفقة:
وهي مسألة عند أهل العلم، يقولون: يأتي المرأة أحيانا نقاءٌ يوما وليلة، وطُهرٌ يوما وليلة. فهذه تسمى عندهم بالمسألة المُلفّقة، أي لها عادة ثمانية أيام أو عادة سبعة أيام، لكن هذه المرة جاءها يوما وليلة أو يومين، ثم جاءها طهرٌ يومين أو يوم وليلة، ثم جاءها حيض يومين أو يوم وليلة، ثم جاءها طهرٌ يومين أو يوم وليلة، وعلى هذا استمر بها الدم، فما حكم ذلك؟
لقد قلنا أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
نقول: هذه امرأة خرجت عن عادتها؛ لأن الأصل أن عادتها ثمانية أيام أو سبعة أيام، وطهرت، لكن هذه نقصت عن عادتها، فجاءها الدم على غير المعتاد، فجاءها يوما وليلة، والأصل أن عادتها سبعة أيام أو ثمانية، أو جاءها يومين، والأصل أن عادتها سبعة، ثم جاءها يومين، ثم طهرت يوما أو يومين، ثم بعد ذلك جاءها حيض يومين، ثم بعد ذلك جاءها طهر يومين أو يوم وليلة، فما حكم هذه المسألة؟
هذه المسألة تسمى الملفقة، ولأهل العلم كلام طويل فيها، فللحنيفية قول، وللمالكية قول، وللشافعية قولان، وللحنابلة قولان، والراجح لي ، وهو ظاهر اختيار ابن تيمية على اختلاف في التفصيل، أن ما رأته من الدم يُعتدُّ به كحيض، وما رأته من الطهر يكون طهرا، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية في الجُملة، على اختلاف في المُبتدِئةِ والمُعتادة، وهو إذا رأت دما، يوما دما ويوما نقاء، فنقول: ما رأته من الدم فإنه حيض، وما رأته من الطهر فإنه طهر، ما لم يعبُر مجموعُهُما أكثر الحيضِ، وأكثر الحيض على الراجح خمسة عشرة يوما.
كيف هذه الصورة؟
امرأة عادتها سبعة أيام، طهرت من عادتها، ثم جاءها دمٌ يوما، ثم نقاء يوم، ثم دم يوم، ثم نقاء يوم، أو دم ثلاثة أيام نقاء ثلاثة، دم ثلاثة، نقاء ثلاثة. هذه تسمى المسألة الملفقة، أو السّحب.
قالوا: إنه إن كان لها عادة معتادة وهي ثمان أو سبع، ثم جاءها في شهر آخر دم يوم، ثم بعد يوم وليلة حصل نقاء، ثم بعد يوم وليلة حصل دم، بحيث لو مسحت تجد دما، ثم بعد يوم وليلة حصل نقاء، بحيث لو مسحت ما وجدت شيئا، فنقول: ما وجدته من الدم المعتاد فإنه يكون حيضا، لقوله تعالى ﴿ ويسألُونك عنِ المحِيضِ قُل هُو أذى﴾ [البقرة: 222]، فعلق الحكم على وجود الأذى، وهو الدم، فإذا وجد نقاء فقول الله تعالى ﴿قُل هُو أذى﴾ فإذا زال الأذى فقد زال حكمه، فيقولون: تعتبِرُ هذا دم وهذا نقاء، هذا دم وهذا نقاء، يقولون: ما لم يعبُرُ مجمُوعهُما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوما.
تستمر على هذا يوما وليلة، يوما وليلة، وعلى هذا قس، حتى يكون خمسة عشر يوما، ثم بعد ذلك تغتسل، أي بعد خمسة يوما، ثم تتوضأ لكل صلاة، ويكون حكمها كحكم المستحاضة، ثم ما رأته بعد ذلك من دم فإنها لا تعتبره شيئا؛ لأن مجموعهما صار خمسة عشر يوما.
ما معنى مجموعهما؟
الحنابلة يقولون مجموع الدم ومجموع النقاء، فيكون على هذه الحالة، خمسة عشر يوما من مجموع الدم ومن مجموع النقاء. وذهب مالك وقول عن الشافعية أنها تُلفِّقُ أيام حيضها، أي: تجمع الدم ثم الدم ثم الدم، حتى يكون خمسة عشر يوما، يعني تجلس شهر؛ لأن الشهر خمسة عشر يوما، هذا قول عند المالكية في المبتدئة وهو قول عند الشافعية.
وأما الحنابلة فقالوا: يعبُرُ مجموعُهُما، فجعلوا المجموع الذي هو السّحبُ؟ والسحب قالوا هو: اليوم والنقاء، تسحب يوم النقاء والحيض جميعا، وهذا هو الأصل، وهو الذي لا يسع الناس إلا هو، والأصل أن الشريعة جاءت سمحة لا تُعذِّبُ المرأة، فلو بقيت المرأة على هذا المنوال لتعذبت واضطربت نفسيتها، فرفع الحرج عنها مطلب، خاصة وأن هذا ليس الأمر المعتاد في حق النساء، والله أعلم.
فعلى هذا أيها الإخوة، إذا قلنا أن أقل الحيض يوما وليلة فهذا إنما هو فيمن لها عادة معتادة، وأما هذا فهي طريقة عرضت عليها فخرجت عن أقل من عادتها، والله أعلم.
ما أكثر مدة الطُّهرِ؟
نحن ذكرنا أقل الطهر بين الحيضتين، فقلنا أقل الطهر ثلاثة عشرة؛ لأن هذا أقل ما وُجِد، ما لم يكن عادتها أقل، لكن هذا لا يمكن أن يكون أقل؛ لأن لو قيل بأقل من ذلك لصار أكثر الحيض هو أكثر الشهر وهذا لا يكون، فنقول: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (ثم يأتي حيض).
طيب ما هو أكثر الطهر؟
اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ لأكثرِ الطهرِ، فيمكن أن المرأة تطهر سنتين أو ثلاثة سنين ولا يأتيها الدم، وهذا خاصة فيمن بها مرض الغُدد، حيث يرتفع عنها الحيض، فلا تحيض إلا في السنة مرة أحيانا، أو مرتين، أو شهرين ثم يرتفع.
إذن اتفق الفقهاء على أن أكثر الطهر ليس له حد محدود. والله أعلم.
المُبتدِئة، وهي التي جاءها الحيض أول مرة:
أحيانا يأتي البنت الدم، فلا يخلو مجيء هذا الدم من أحوال، مثلا بنت عمرها إحدى عشر سنة أو اثنتى عشر سنة أو ثلاثة عشر سنة، أو تسع سنوات، جاءها الدم، فإن الراجح، وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة، على أنه يصلُحُ أن يكون حيضا، أي أنها حاضت في وقت يصلح أن يكون وقت حيض، وهو بنت تسع سنين مثلا. فهي إذا بلغت تسع فهي جارية، والأصل أنه لا يأتي الحيض إلا بعد تسع، فإن جاء في بلد لنساء في أقل من ذلك، وكان من عادة نساء ذلك البلد فيغول عليه، وإلا فالأصل هو أن الحيض لا يأتي في أقل من تسع، والله وأعلم.
فإذا كانت ابنة تسع أو عشر أو إحدى عشر سنة فجاءها الدم، فجماهير أهل العلم يقولون: هذا الدم الذي جاءها لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يتجاوز أكثر الحيض.
الحالة الثانية: أن لا يتجاوز أكثر الحيض.
وأكثر الحيض هو خمسة عشر يوما.
فإن لم يتجاوز أكثر الحيض، أي جاءها عشرة أيام، أو ثلاثة أيام، أو خمسة عشر يوما، فإنها تعتبره حيضا؛ لأنه لم يتجاوز أكثر الحيض، ويمكن تكون أول عادتها بهذه الطريقة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنابلة.
أي مثلا جاءها ثمانية أيام فتعتبره ثمانية أيام (الحيض)، وأخرى جاءها ثلاثة عشرة يوم فتعتبره ثلاثة عشرة يوم، فإن جائها خمسة عشر يوما ثم انقطع، تعتبره حيضا.
الحالة الثانية: أن يتجاوز أكثر الحيض، وأكثره خمسة عشر، وفي هذه الحالة لا يخلو من حالين:
الأولى: أن تكون قد حاضت الشهر الذي قبله ولها عادة، ثمانية أيام، سبعة أيام، ثم الشهر الثاني تجاوز أكثر الحيض. أي جائها في الشهر الأول دم قبل ذلك وجلست ثمانية أيام أو سبعة أيام أو ستة أيام، ثم في الشهر الثاني تجاوز هذا العدد، فتعتبره حيض، فإن تجاوز أكثر الحيض علمنا أن الدم الذي جاءها أكثر من عادتها يكون استحاضة، فحينئذ تقضي الصلاة والصوم؛ لأن هذا يمكن إدراكه.
فعليه، إذا كان الشهر الأول جاءها ثمانية أيام، ثم الشهر الثاني استمر معها، أي زاد عن ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، نقول: اغتسلي وتوضئي، وستة عشر وسبعة عشر، علمنا أن هذا ليس حيض، فتغتسل ثم تقضي الصلاة والصوم من ما زاد عن عادتها، فإذا كانت عادتها ثمانية أيام، فتصلي التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى الخامس عشر يوما، لأننا علمنا أن هذه الزيادة ليست عادة وليست بحيض.
الثانية: أنه جاءها الدم أول مرة وجاوز أكثر الحيض. الشرط هنا أنه زاد على أكثر الحيض في أول مرة، فنقول: تعتبره حيض حتى يكون خمسة عشر يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، فإن استمر الدم في الشهر الثاني، وهي ما زالت، فإننا نقول إنها تعتد بحال قريباتها، والله أعلم.
فإن كانت تُميِّزُ الدم فإنها تعتبِرُ التمييز، لكن هذا لا يتأتّى في البنات الصغار، فهن لا يعرفن التمييز، لكن إن كانت تدرك التمييز وتميز بين الدم، فهي تعتبر بالتمييز، وإلا فإنها تعتد بعادة نسائها، ولكننا نقول: غالب البنات اللاتي يأتيهن الدم لا تميز.
وهذه المسائل تعتبر من حالة الطوارئ على الحيض، وإلا فالغالب أن البنت أول ما تحيض تعتبره حيضا، فإذا ارتفع فإنها تغتسل وتكون طاهرة وتصوم بعد ذلك.
ومن المؤسف أن بعض الأمهات والأخوات الكبار لا يعلمن أخواتهن الصغار بحجة الخجل، ولا شك أن هذا من أحكام الدين، فلا بد أن تعلم البنت مهما صغُرت أحكام هذه المسائل والحكم الشرعي فيها حتى تعبد ربها على يقين.
وكم هي المسائل والأسئلة التي تأتي المشايخ وطلبة العلم في بنت اعتمرت أو حجت مع أهلها وحاضت وطافت واعتمرت مع أنها حائض ولم تسأل ولم تخبر أهلها خجلا من ذلك، فلو أن الأم أخبرت ابنتها بهدوء وطمأنينة لأفصحت البنت للأم، لكن مشكلة الأمهات أحيانا السؤال بنوع من التوبيخ، وهذا أمر ليس بإرادتها ولا بمقدورها إمساكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنّ هذا أمرٌ كتبهُ اللهُ على بناتِ آدم، فانقُضِي عنكِ رأسكِ وامتشِطِي وأهِلِّي بِالحجِّ».
لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي أو تصوم:
وهذا محل إجماع كما قال صلى الله عليه وسلم: «أليست إِذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُم»، كما في الصحيحين. فهذا أمر مُجمعٌ عليه، ولا تقضي تلك الأيام التي حاضتها، بالإجماع.
وأما الصوم فإنها تقضيها، وبالإجماع أيضا، كما جاء في الصحيحين من حديث مُعاذة العدوِيّة أنها قالت لعائشة: «ما بالُ الحائِض تقضِي الصّوم ولا تقضِي الصّلاة؟»، قالت عائشة: «كان يُصِيبنا ذلِك فنُؤمر بِقضاءِ الصّوم ولا نُؤمر بِقضاءِ الصّلاة»، فكأن عائشة تريد أن تبين لها أن هذا أمر من الشارع، فنحن نُسلِّمُ بذلك. والله أعلم.
فالحائض لا يجوز لها الصوم.
وقال بعض أهل العلم: إذا كانت حائض، وجاء وقت الصلاة، هل تغتسل وتلبس ثياب صلاتها، وتجلس في مصلاها تسبح وتهلل، أم أنها لا يلزمها ذلك؟ يعني هل يشرع لها ذلك؟
ذهب بعض عُبّاد البصرة – كعادتهم واجتهاداتهم – إلى أن المرأة الحائض إذا جاء وقت الصلاة، فإنها تذهب وتتوضأ، أو تلبس لباس مصلاها، وتجلس في مصلاها تسبح وتهلل فإنها تؤجر على ذلك، والراجح أن ذلك لا يشرع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بذلك، ولم يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابيات، وهن أطهر وأعلم وأتقى وأنقى ممن جاء بعدهن، يصنعن ذلك، وكل أمر لم يفعله الصحابة ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم فالتعبد به بدعة، والله أعلم.
هل تؤجر المرأة الحائض على حيضها؟
لأنها لا تستطيع أي خارج عن إرادتها، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المرأة الحائض تؤجر؛ لأنها في حكم المريض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِذا مرِض العبدُ أو سافر كُتِب لهُ ما كان يعمله وهو صحِيحٌ مُقِيمٌ»، والصحيح هو أنها لا تُثابُ على تركها الصلاة؛ لأنها غير مأمورة، كما أن الرجل لا يثاب على ترك الصلاة في أوقات النهي؛ لأنه غير مأمور بذلك، وإن كانت تُؤجرُ على تركها المُحرّم في ذلك، مثل أن تترك بعض المحرمات، والله أعلم.
إذا جاء المرأة الدم في أقل من عادتها؟
من المسائل أنه من المعلوم أن للمرأة عادة وعادتها إما ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، فإن جاءها الدمُ أقل من ذلك، أي جاءها في الشهر دم أقل من ذلك، فإن الراجح أنه يكون ما رأت من الدم أقل من المعتاد إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يعتبر طُهرا صحيحا.
وعلى هذا فلو جاءها الدم أربعة أيام وكان عادتها خمسة أيام أو عادتها ستة أيام، فإننا نقول: إذا طهُرت بعد الأربعة؛ فإنها يجب عليها أن تغتسل وتُصلي.
وبعض النساء أحيانا تطهر في أقل من عادتها وتقول سأنتظر لأن الدم سوف يأتي، فنقول لها: لا يجوز للمرأة أن تتأخر في الإغتسال إذا تيقنت أنها قد طهرت، فلو حصل الجفاف وكان عادتها الجفاف، أو حصلت القصة البيضاء، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتأخر؛ لأنها مأمورة أن تُصلي.
وعلى هذا فإذا كان عادتها أيام معدودة، فكان الشهر الذي بعده جاء بأقل وهو أكثر من يوم وليلة؛ فإنها تعتبره دما، وما نقص عن المعتاد فإنه تعتبره طُهر، والله أعلم.
إذا كانت عادتها ستة أيام، فجاء الحيض الشهر الثاني بزيادة عن عادتها؟
نقول: الراجح، وهو مذهب الشافعية واختيار ابن تيمية: أنّ من المعلوم أن الحيض يتقدم ويتأخر، فإذا كان عادتها ستة أيام، فإن زاد حيضها أكثر من ذلك، فتعتبره حيضا، حتى خمسة عشر يوما وهو أكثر الحيض، فإن استمر أكثر من خمسة عشر يوما، علمنا أن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم فساد، فحينئذ فإنها تغتسل وتقضي الصلاة التي تركتها من بعد ما زاد على عادتها المعتادة، والله أعلم.
هذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيلات كالحنيفية والمالكية بما يسمى ثلاثة أيام الإستظهار، أو الحنابلة على أنها لا تعتبره شيئا حتى يتكرر، والراجح ما قلنا.
ما هي المرأة المُستحاضةُ؟
المستحاضة: تسمى المرأة مستحاضة إذا جاءها دمُ عِرق وهو ليس بدمِ حيض (أي ليس دم جِبلة وطبيعة بل دم عِرق يعني دم فساد) فما حُكم المستحاضة؟
والمستحاضة هي التي استمر دمها أكثر من خمسة عشر يوما، ولها عادة أو ليس لها عادة، ولا يخلو من ثلاث أحوال، التي جاءها الدم أكثر من عادتها، أو أكثر من خمسة عشر يوما، لا تخلو من ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون لها عادة؛ مثل أن يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام أو ستة أيام، فإننا نقول: تعتدُّ بهذه العادةِ في الشهرِ الثاني، فإذا كان عادتها ثمانية أيام، ثم في الشهر الثاني استمر الدم حتى خمسة عشر يوم، فإنها تعتبره حيضا، فإن استمرّ الدمُ أكثر من خمسة عشر يوما علمنا أنّ هذا الدم الزائد استحاضة، فإذا جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمرّا به، إذن: تعتدُّ بالعادةِ التي كانت تأتيها قبل ذلك، وهي ستة أيام وثمانية أيام، على حسب أول الشهر أو وسطه أو آخره، على حسبِ ما كانت تأتيها، إذن هذا في حال من استمر بها الدم ولها عادة، والراجحُ أن العادة مُقدمة على التمييز، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، خلافا للمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد.
والعادةُ هي الأصلُ كما قال صلى الله عليه وسلم: «فإذا جاءتِ الحيضةُ؛ فاجلسي قدر ما كانت تأتيكِ عادتُكِ»، فقولُه: «قدر ما كانت تأتيكِ عادتُكِ» يدلُّ على الاعتبار بالعادة وليس بالتمييز.
ثم اعلموا أنّ حديث: «إن دم الحيض دمٌ أسودُ يُعرفُ» صححه ابن حزم، ولكن ضعفه أبو حاتم وغيره؛ ذلك أن فيه نكارة، والراجح أن هذه الزيادة منكرة، ولم يروها البخاري ومسلم والقصة واحدة، فدلّ على أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
هذا من حيثُ من لها عادة.
الحالة الثانية: امرأة ليس لها عادة، لكن لها تمييز، تقول: أنا أميز، كل شهر يأتيني سبعة أيام الشهر الذي بعده ستة أيام، الشهر الذي بعده ثمانية أيام، أنا أُميِّزُ الدم، أعرف أوجاع الحيضِ، أعرف ثخونة الدم، أعرف رائحته الكريهة، فأميز.
فنقول: هذه المرأة، إنِ استمرّ معها الدمُ حتى الشهر الثاني؛ فإننا نقول: تعتبِرُ بالعادة، فإن لم يكن لها عادة، فإنها تعتبر بالتمييز.
فإذا كان التمييزُ، استمر بها الدم فلما كان أول الشهر جاء دمٌ أسود ثخينٌ، فبعد خمسة أيام خفّ الدم إلى دم أحمر، فإننا نقول الدم الأحمر، متى ما جاء فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وأما إذا جاء الدم الأسود فإنها تمسك عن الصوم والصلاة.
يقول ابن عباس رضي الله عنه: “أما ما رأت من الدم البُحرانِي، فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك؛ فلتصلِّي ولتصم”، ومعنى البحراني: هو الدم الثخين الأسود، “وأما ما رأت غير ذلك” يعني غير الدم الأسود، فإنها تعتبر أنها في حُكم المستحاضة، والله أعلم.
الحالة الثالثة: وهي ألا يكون لها عادة اعتادت عليها، ولا يكون لها تمييز.
وهذا غالبا ما يكون في المبتدِئة، وقد شرحنا حالها، فنقول: هذه المبتدئة إن لم يكن لها عادة ولا تُميز، فإنها إذا استمرّ بها الدم حتى الشهر الثاني فإنها تجلس ما كانت قريباتها كعماتها أو أخواتها أو خالاتها يجلسن عليه، أول الشهر أو وسطه أو آخره، ستة أيام أو سبعة أيام، على حسبِ مُتوسِّطِ أيام قريباتها. فبعض العمات أو الخالات، هذه ست وهذه سبع وهذه ثمان، فالمتوسط سبع، وعلى هذا فقس، والله أعلم.
إذن المرأة المستحاضة كما قلنا هي التي يأتيها دم كل وقت، فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم كالحنيفية والشافعية والحنابلة، خلافا لمالك فإنه استحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ وإلا لا يجب عليها ذلك، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول قوي، والأحوط هو مذهب الجمهور، لأنه حدثٌ وقد أُمِر العبد أن يتوضأ لدخولِ وقت كل صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا قُمتُم إِلى الصّلاةِ فاغسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، فدلّ ذلك على وُجوبه في كل صلاة.
فيبقى العام حجة في بعض أفراده، و يخرجُ الخاصُّ في بعض ما استُخرِج منه، والله أعلم.
إذا ثبت هذا فإننا نقول: إن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. الثاني: أنها إذا أرادت أن تتوضأ، تتلجّمُ وتغسل مكان الدم، ثم تضع قُطنة، ولا يضِيرُها نزولُ الدم بعد ذلك، فإذا جاء وقت الصلاةِ الثانيةِ هل تؤمر بإزالة هذه القطنة وهذه الثياب أم لا؟
وبعض الشافعية أمرها أن تُزِيل هذه القطنة، والراجح أنه لا يلزمُها هذا؛ لأنّ الدم مُستمر فيها، فعليه: لا تُؤمر بإزالة هذه القطنة، ولو امتلأت من الدم؛ لأن الشارع لم يأمر المرأة إلا بأن تتوضأ لكل صلاة، على خلاف في صحة الحديث، ولم يأمرها أن تُزيل ذلك.
ومما يُستدل به على عدم وجوب إزالتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنعُتُ لك الكُرسُف»، قالت: إني أثُجُّ أكثر من ذلك، قال: «فتلجّمِي» – والتلجم هو أن تربط على مكان الدم ربطة بحيث يصعبُ انفكاكها – فلو كان واجبا عليها أن تُزيله لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا هو الراجح.
ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري من حديث عائشة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، تقول عائشة: فكانت تضع الطّست تحتها وهي تصلي، وهذا يدل على أن هذا معذورة فيه، ولم تُؤمر بإزالة القطنة أو بإزالة الحفاظ كل صلاة لأن هذا مما يشق، ولو كان هناك دليل لنُقل لنا، فلما لم يُنقل لنا، والأصل رفع الحرج، وهذا من أعظم الحرج لو أُمرت المرأة به، والله أعلم.
ما هي الصُّفرةُ والكُدرةُ؟
الصفرة والكدرة هما شيء كالصّدِيدِ يعلُوهُ صُفرة، أو لون كلون الترابِ، وليس من الدماء المعتادةِ.
ويميل الصفرة إلى الصّفارِ مع خلط من الحُمرةِ، أما الكدرة فلون كالغبار و الطين، ويسميه بعض أهل العلم كالحنابلة: الكدرة، والحنيفية جعلوا الكدرة شيئا والتّرِبة شيئا آخر، وهو من الكدرة، وهو لون كلون التراب، ويُسميه المالكية التِّرية، أو التّرِيّة، وهي أسماء لا تخرج عن الكدرة، والله أعلم.
وعلى هذا فينبغي أن تعرف المرأة أن الصفرة تميل إلى الحمرةِ وإلى الصفرة، وأما الكدرة فهي تميل إلى لون الغبار والتراب والكاكاو، ولكنه ليس بدم معتاد، والله أعلم.
ولهذا قال أبو عمر ابن عبد البر: “أولُ الحيضِ دمٌ ثم صُفرة ثم ترية ثم كُدرة ثم يكون ريقا كالفضة ثم ينقطع”.
هذا هو غالب ما يأتي المرأة. “أول الحيض دم”، “ثم صفرة” يعني يخِفُّ الدم جدا، “ثم ترية” ومعنى الترية التراب أو الغبار، “ثم كدرة” أكثر انفتاحا، ثم كالريق الفضة، يعني ماء لزج يميلُ إلى البياضِ ولون الماءِ، “ثم ينقطع”.
وقد اختلف أهلُ العلمِ في حُكم الصفرة والكدرة، ولعلنا نُقسِّمُ ذلك إلى 3 حالات:
الحالة الأولى: الصُّفرة والكدرة بعد الحيضِ من غير انقطاع بينهما.
فمثلا عادتها ثمانية أيام، جاءها الدم أربعة أيام، ثم بعد ذلك جاءها صفرة وكدرة ولم يحصل انقطاع ولا جفاف بينهما، فهذا تعتبره حيضا، وهو قول عامة أهل العلم خلافا لابن حزم، فإنه لم ير الصفرة ولا الكُدرة حيضا، استدلالا بحديث البخاري: “كنا لا نعُدُّ الصفرة والكدرة شيئا”.
والأقرب أن ذلك شيءٌ بعد الحيض؛ لحديث أبي داوود: “كُنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهرِ شيئا”، وهذا هو الراجح.
إذن الحالة الأولى، وهي أن يكون الصفرة والكدرة بعد الدم من غير انقطاع: فهذا حيض، وهو قول الأئمة الأربعة؛ خلافا لابن حزم.
الحالة الثانية: الصفرة والكدرة بعد الطُّهر.
أما بعد الطهر فإنها لا تُعتبرُ على أنها شيء، فلو أنّ عادتها ثمانية أيام، فطهرت في ثمانية أيام أو أقل من ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الصفرة والكدرة بعد طُهرِها فإنها لا تعتبره حيضا، ولكنها تتوضأ لكل صلاة.
إذن الحالة الثانية، وهي أن يكون صفرة وكدرة بعض الطهر وقبل الحيض: فإن الراجح أنه لا يكون حيضا، خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي.
الحالة الثالثة: أن يأتي الصفرة والكدرة قبل الحيض، يعني متواصل قبل الحيض، فذهب الحنيفية والحنابلة إلى أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض يعتبر حيضٌ، ولا فرق في أول الحيض ولا في آخره، فلو أن امرأة يأتيها الصفرة والكدرة قبل الحيض ثم يأتي الدم وهو ما زال في زمن العادة فإنها تعتبره حيضا.
وذهب المالكية وقول عند الشافعية، إلى أن الصفرة والكدرة حيضٌ مطلق، وهذا وجِيه بعد الدم، وأما أن يكون بعد الطهر فلا، كما قلنا.
والذي يظهر في مسألة الصفرة والكدرة قبل الدم أنه إن كان قد اعتادت المرأة قبل حيضِها أن يأتيها صفرة وكدرة ومعها أوجاعُ الحيضِ، وكلّ شهر يأتي صفرة وكدرة قبل الدم، فإنها تعتبره حيض، وإن كان الغالب والأصل أن الحيض هو الذي يأتي أولا، أو الدم يأتي أولا في زمن العادة، وفي شهر من الشهور جاءها صفرة وكدرة فإنها لا تعتبره حيضا، لأن أم عطية تقول: “كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا”، فإذن الصفرة والكدرة قبل الدم لها حُكم الطهارة، إلا إذا كان فيها أوجاع الحيض وآلام الطّمث، واستمر معها دائما يأتيها بهذه الطريقة، فإننا نقول يكون حيضا، وإلا فإن الأصل أنه ليس بحيض.
إذن الحالة الثالثة، وهي أن يأتي الصفرة والكدرة قبل الدمِ، فنقول: الراجح أنها لا تعتبره حيضا ما لم يكن غالب حالتها وغالب عادتها أنه يأتي قبل الدم مع أوجاع الطمث، فإنها حينئذ تعتبره حيضا.
وأما إذا كان الغالب أنه يأتيها دم، وفي شهر من الشهور جاءها صفرة وكدرة قبل الدم، فلا تعتبره شيئا؛ لأن الراجح أن الصفرة ولا الكدرة لا يُعَدّان في زمن الطهر شيئا، والله أعلم.
سؤال: هل الكدرة والصفرة المتصلة بالدم الأحمر في بداية الحيض تأخذ حكم الحيض؟
هي متصلة بالدم، فالأصل أنه حيض، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم، أما إن جاءت الصفرةُ والكُدرة قبل الدمِ، سواء كان في زمنه أو في غيره، فالأصل أنه إن كانت المرأة غالبا ما يأتيها الدم بلا الصفرة ولا كدرة فلا تعتبر بالصفرة والكدرة، فإن جاءها الصفرة والكدرة ومعها أوجاع الطمث، أو كان هذا هو الغالب أن الدم لا يأتي إلاّ يسبِقُه صفرة وكدرة وهو في زمن الحيض، فإنها تعتبره حيضا والله أعلم.
بعض النساء قد تستعجل الطهر فما هي علامات الطهر؟
فنقول كما قال أبو عمر ابن عبد البر: “أنها إذا رأت الجفاف أو القصّة البيضاء فإنها تعتبر طاهرة”.
ومعنى الجفاف هو أن تضع القطنة في مكان الدم، ثم ترجع القطنة كما هي من غير تغيُّر. فهذه يعتبر طهرها بالجفاف.
وبعض النساء تعتبر الطهر بنزول القصة البيضاء، وهو ماء سائل رقيق كالريق، كما يقول أبو عمر ابن عبد البر، أو كالفضة، ينزل من الرحمِ كدلالة على طُهرها، وهذا أعلى الطُّهرِ، ولا طُهر أعلى منه، وهو علامة على الطهر.
فنقول: إن كانت المرأة تطهرُ بالجفافِ، ولا يأتيها القصة البيضاء إلا بعد يومين أو يوم، فإن طُهرها يكون بالجفافِ، وإن كان نُزول السائل الأبيض بعد الجفاف بفترة – يعني ساعات، فإنها تعتبر الطهر بالقصة البيضاء.
وقد جاء عن مالك رضي الله عنه عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاةٌ لعائشة قالت: كانت النساء يأتين بالدُّرجةِ فيها الكُرسُف، فيها القطنة، فتقول عائشة: “لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء”.
ومعنى القصة البيضاء: ماء يميلُ إلى البياض، وقال بعضهم: إن القصة البيضاء هو الجفاف، أي أن المرأة إذا أدخلت القطنة ثم رجعت كما هي بيضاء، فهذا نوع من الجفاف.
والذي يظهر أنّ القصة البيضاء نوعان: فالأصل هو الطُّهر اليقِينيُّ، وهو نزول الماءِ اللّزِجِ الذي كالريقِ، وهذا دلالة على النقاءِ التامِّ، لكن هناك نقاءٌ آخر، وإن لم يكن تاما ويجب أن تعتبره، وهو الجفاف، والله أعلم.
إذا وطئ الرجل الحائض فهل عليه كفارة؟
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوزُ للرجلِ أن يطأ الحائِض. وذهب عامة أهل العلم من الحنيفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد، وعليه أكثر السلف إلى أنه يجب عليه التوبة؛ لأنه فعل مُحرّما، ويستغفر الله ويتوب إليه، ولا يجب عليه أن يتصدق.
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا أتى امرأته في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، فإن جاء آخر الحيض فإنه يتصدق بنصف دينار، ورووا في ذلك حديثا عن ابن عباس مرفوعا، والصواب أنه لا يصحُّ رفعُهُ عن ابن عباس، وإنما هو موقوف، وابن عباس إنما قال ذلك من باب قاعدة الصحابة والسلف على أن الواحد إذا فعل ذنبا فإنه يتصدقُ؛ لأن الصدقة تُطفئ غضب الرب، مثلما قال هو وأبو هريرة في الرجل الذي لم يقضِ ما فاته من رمضان حتى جاء رمضان الثاني من غير عذر، فإنهم يقولون: يقضي ويُكفر عن كل يوم نصف صاع، وهذا من باب أنه فعل ذنبا فيجب عليه أن يتوب، وإلا فإن ابن عباس أرفعُ من أن يُلزِم الناس بدينار أو نصف دينار إلا بشيء ثابتِ محدودِ، ولكنه من باب الإستحسان أن يتصدق فأمره بذلك، والله أعلم.
ما حُكم دخول الحائض المسجد؟
الراجح أن المرأة الحائض، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة: أنها لا تدخل المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: “ناوليني الخُمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتكِ ليست في يدك”، والحديث متفق عليه.
وجه الدلالة: أن عائشة ترى أنه ممنوع أن تُدخِل المرأةُ يدها في مكان المسجد؛ ولما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة، فقالت: أنا حائض، أشار إليها أن حيضتها ليست بيدها، أي لا حرج عليك في ذلك. فدل على أنه أمر معتاد عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يدخُلن بأجسادهن المسجد.
من مصدر آخر CG:
طلب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة أن تُناولَه “الخُمرة”، وهي سجادة أو حصير يُصلى عليه. فاعتقدت عائشة أن كونها حائضًا يمنعها من مسّ الأشياء التي تتعلق بالصلاة. فبيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض لا يجعل يدها نجسة، وبالتالي يجوز لها أن تلمس ما تريد.
كيف يُستدل به على تحريم دخول الحائض للمسجد؟
قال بعض العلماء: لو كان يجوز للحائض دخول المسجد، لما ترددت عائشة رضي الله عنها في المناولة، ولما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى توضيح أن يدها طاهرة، بل كان بإمكانه أن يطلب منها إحضارها من المسجد مباشرة.
أي أن استبعاد عائشة رضي الله عنها فكرة لمس الخُمرة بسبب الحيض يدل على أن دخول الحائض للمسجد ليس أمرًا مألوفًا.
لكن هذا الاستدلال ليس قاطعًا، وهناك أدلة أخرى أقوى استُدل بها على المنع، منها:
حديث أم عطية في صحيح البخاري ومسلم، حيث أمر النبي ﷺ بإخراج النساء لصلاة العيد، وذكر أن الحُيّض يعتزلن المصلى، مما يُفهم منه منعهن من دخول مواضع الصلاة.
وحديث النبي ﷺ: “لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب” (رواه أبو داود، وضعفه بعض العلماء).انتهى المصدر الخارجي.
ومما يدل على ذلك، قوله تعالى: ﴿ ولا جُنُبا إِلّا عابِرِي سبِيل ﴾ [النساء: 43]، وقد قلنا إن الجنب والحائض لا يدخلان المسجد، وذكرنا الخلاف في هذا.
فالحائض لا تدخل المسجد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، إلا لحاجة. فإذا وُجدت الحاجة مثل أن تكون امرأة ليس لها بيت، أو امرأة مع زوجها في العمرة، وخافت إذا هي بقيت خارج المسجد الحرام، فإنها تدخل في أول الباب، فلا حرج في ذلك إذا استضفرت وتطهّرت.
هل يقع الحكم إذا تدفق الحيض أم يكفي القليل منه؟
الحيض كما يقولُ ابن قُدامة: أول ما يأتي يأتي دفقا، يأتي بثجّة، ثم بعد ذلك يتقلّل بحيث لو مسحت وجدت هذا الدم، وليس دائما ينزل. هذا هو الأصل، ولهذا تقول عائشة: في فورِ حيضتها، يعني في أكثر حيضها، فإنها تعتبره حيض، وكذلك في آخره فتعتبره حيض، لأنها متى ما مسحت مكان الدم تجد هذا الدم، فإذا نقطع بحيث لو وضعت الكرسف – القطنة – ترجع كما هي، فهذا يدل على وجود الجفاف والطهر، والله أعلم.
إذا نزفت المرأة في غير أيام الحيض، ويكون أحيانا من الرحم، فهل تعتبره؟
نقول: إذا كانت عادتها قد جاءت ثم جاء دم، فإن كانت تعلم أن هذا نزيف، فإنها لا تعتبره، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عرق»، فإن كانت تشك، فنقول: إن كان هذا الدم جاء في أقل من الطهر وهو ثلاثة عشر يوما، فإنها لا تعتبره على الأقرب، فإن جاءها دم ثم نقاء ثم دم فهذه هي المسألة الملفقة، وقد شرحناها، والله أعلم.
هذا يؤخذ بالرأي الطبي في ألوان دم الحيض ومدته؟
إذ كانت المرأة الطبيبة تدرك هذا وتميز، فإنها تأخذ به ما لم يكن لها عادة، فإذا كان لها عادة فإنها تعتبر بعادتها، ولا تعتبر بتميزها، والله أعلم.
بعض النساء عندما تقارب الأربعين تحيض مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، مرات متقطعة، ويكون سببه إما اللولب أو اضطراب هرموني؟
الاضطراب الهرموني أو اللولب، لا تعتبره المرأة شيئا؛ لأن هذا عِرق، فالعرق يمكن أن يكون داخل الرحم، ويمكن أن يكون خارج الرحم، إلا إذا كان له نفس لون الحيض وتُميِّز، وفيه أوجاع الحيض، فإنها تعتبره حيض، ويكون في مسألة الملفقة يوم حيض ويوم طهر، وعلى هذا تقيس في هذه المسألة التي ذكرنها، والله أعلم.
13. النفاس
أحكام النفاس:
تعريف النفاس – ما حكم ما يأتي المرأة الحامل من دم؟ – ما أكثر مدة النفاس؟ – وإن طهرت قبل الأربعين، فهل يعتبر طهرا أو لا؟ – وإن ولدت المرأة ولدين فإن أول النفاس وآخره من أولهما
تعريف النفاس:
النِّفاسُ: هو دمٌ يأتي المرأة بعد وِلادتها.
ودم النفاس كدم الحيض في أحكامه، وفيما يترتبُ عليه كما ذكر أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لابن حزم فإن له تفصيل في هذا، والراجح هو أنه لا فرق؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حينما قالت: “كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السرير إذ حِضتُ، فانسللت فلبست ثياب حيضتِي فجئتُ إليه، فقال: «مالكِ أنَفِسْتِ؟»، فقلت نعم..”، الحديث.
فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحيضة في حُكم النفاس، وقال: «أنفست»؛ أي حِضْتِ، وهذا يدل على أنه لا فرق بينهما، والله أعلم.
والنفاس هو دمٌ يأتي المرأة بعد ولادتها، أو قبل ولادتها بيوم أو يومين، وفيه أوجاع الطّلق.
ما حكم ما يأتي المرأة الحامل من دم؟
الذي يظهر لي أن الحامل لا تحيض – وهو قول الأطباء، خلافا لإب تيمية وابن القيم (تأكد) –، فالدم الذي يأتيها تعتبِرُهُ دم فساد، والله أعلم.
وعلى هذا فإنها تتوضأُ لكل صلاة، إلا إذا جاءها الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، أو مِياهِ جاءتها قبل الحيض بيوم أو يومين وفيه أوجاع الطلق فإنها تعتبره دم نفاس، والله أعلم.
وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم.
ما أكثر مدة النفاس؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أكثر مدة النفاس أربعون يوما، هذا هو مذهب الحنابلة في المشهور عندهم؛ لِما روى الدّارِمِيُّ عن أم سلمة أنها تقول: “كانت المرأة النُّفساءُ تجلِسُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما”.
وهذا الحديثُ إسناده فيه كلام ولكنه لا بأس به قابل للتحسين، والذي يظهر أنه على حسبِ المعتاد، أي على حسب العادة مثلما قلنا في أقل الحيض وفي أكثره، فإن الراجح أنّ غالب النساء يكون نفاسها أربعين يوما، فإن خرجت امرأة على هذا واستمر بها الدمُ على حال نسائها وقريباتها، فإنها تعتد به، يعني تعتد بالزيادةِ، أي إذا استمر مثلا إلى ستين يوما، فإن إن كان قريباتها على هذا، فإنها تعتبره نفاسا، وأما إذا كان قريباتها وعماتها وخالاتها لا يزِدن على أربعين، فإن الغالب والأصل أنها لا تزيد عن الأربعين إلا إذا وافق وقت عادتها، فإن وافق الدم الذي زاد على الأربعين وقت عادتها المعتادة قبل النفاس فإنها تعتبره حيضا، وإلا فإنها لا تعتبره شيئا، ويكون دم فساد، والله أعلم.
فإن ولدت بعد ذلك واستمر بها الدم مثل الحالة الأولى، علمنا أن عادتها حينئذ أكثر من الأربعين، ولا تسمى المرأة مُعتادة حتى يتكرر منها ذلك، ولا أقل من مرتين، لابد من مرتين لتسمى معاودة وعادة، والله أعلم.
وإن طهرت قبل الأربعين، فهل يعتبر طهرا أو لا؟
مثال: امرأة نفساء طهرت بعد عشرة أيام من ولادتها، فهل تعتبره طهرا أو لا؟
الغالبُ أن النساء في هذا الزمان لا تعتبره شيئا، وقد يُسميه النساء أحيانا الطهر الكاذب، ولا يأمرون المرأة النفساء أن تغتسل وتصلي، والراجح أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا انقطع دمها، ولو قبل الأربعين، إلا أنّ الحنابلة كرهوا لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل الأربعين؛ استدلالا بحديث عثمان بن أبي العاص أنه كان يعتزل نساءه إذا طهرن قبل الأربعين حتى يتم لهن الأربعون، ولكن ابن عباس سُئِل عن ذلك فقال: أليست تصلي وتصوم! يعني أنه ما دام أنها تصلي فلا بأس أن يأتيها زوجها إن كانت قد طهرت قبل الأربعين، وهذا هو الراجح والله أعلم.
والكراهة حُكم ُشرعي لا تثبُتُ إلا بدليل شرعيّ، والله أعلم.
فإن عاودها الدم بعد ذلك؛ يعني عاودها الدم بعد طهرها أقل من أربعين ثم رجع، فإننا نقول: الراجح أنها تعتبره دم فساد لأنه حينئذ وافق دم النفاس، والله أعلم.
والنفاس كالحيض في أحكامه فيحِلُّ ويحرُمُ ويجِبُ فيه مثلما يحل ويحرم ويجب في الحيض.
وإن ولدت المرأة ولدين فإن أول النفاس وآخره من أولهما:
يعني: لو أن المرأة ولدت ابنا في يوم السبت، وفي يوم الاثنين ولدت الآخر، فإن الحنابلة وبعض أهل العلم يرى أن أول النفاس هو أول ولادة الأول، وآخر النفاس هو آخر نفاس الأول، وهو الأربعين.
وعلى القول الراجح أن النفاس يمكنُ أن يكون أكثر من ذلك فإنها حينئذ تعتدُّ بعادة الولد الثاني؛ لأنه مُعلّقٌ به حُكمُ الدم، وقد قال تعالى: ﴿ قُل هُو أذى فاعتزِلُوا النِّساء فِي المحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]، وهذا هو الأصل، والله أعلم.
وعلى هذا فالمعول على أولِ النفاس على الولد الأول، وآخره على الولد الثاني، والله أعلم. ما لم يعبُر أكثرهُ، وأكثره ستون يوما، أو سبعون يوما على الخلاف، فإنه إن زاد على ذلك فإنه لا يُعوّلُ عليه، والله أعلم.