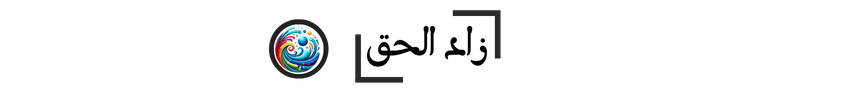ملخص كتاب منهاج السنة النبوية ابن تيمية
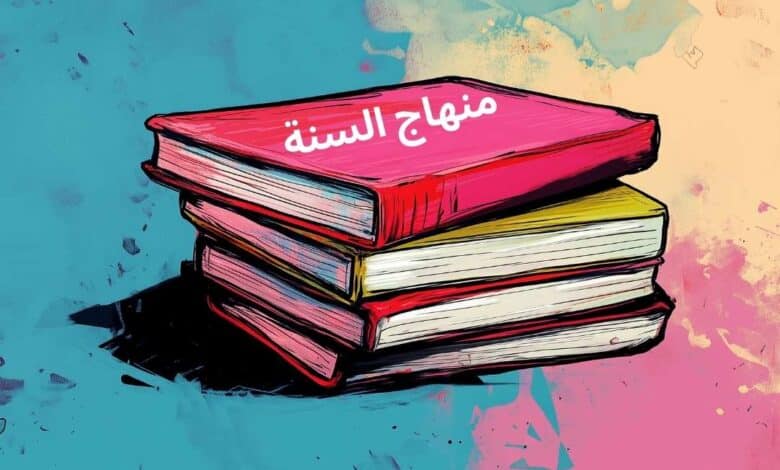
أبرز محاور وأبواب الكتاب
- التوحيد وتنزيه الله عن النقائص:
- إثبات صفات الله كما وردت في الكتاب والسنة دون تحريف أو تعطيل.
- بيان أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها.
- تفنيد اعتقاد الشيعة بأن الأئمة يعلمون الغيب.
- بيان فساد قول الشيعة بتوسلهم بالأئمة لجلب النفع أو دفع الضر.
- الرد على مفهوم الولاية التكوينية التي يدعيها الشيعة لأئمتهم.
- شرح منهج أهل السنة في عبادة الله وحده بلا وسيط.
- الإمامة وأصولها:
- نقد دعوى الإمامة لدى الشيعة الإمامية واعتبارها ركنًا من أركان الدين.
- بيان مفهوم الإمامة عند أهل السنة والجماعة.
- دحض عقيدة الشيعة في اعتبار الإمامة ركنًا من أركان الإيمان.
- بيان أن الإمامة ليست منصوصًا عليها في القرآن أو السنة.
- تفنيد أدلة الشيعة التي يزعمون أنها تثبت إمامة علي وأبنائه.
- مناقشة قضية العصمة التي يدعيها الشيعة للأئمة.
- إثبات أن الإمامة مسألة اجتهادية وليست عقدية.
- الرد على زعم الشيعة أن النصوص القرآنية تثبت إمامة علي (مثل آية الولاية وآية التطهير).
- توضيح أن اختيار الإمام حق للأمة بالشورى وليس بالنص.
- نقض عقيدة الرجعة التي يعتقدها الشيعة بأن الأئمة سيعودون للحياة قبل القيامة.
- بيان تناقض الشيعة في عدد الأئمة وغياب الدليل القطعي على حصرهم في اثني عشر.
- الصحابة والعدالة:
- الدفاع عن الصحابة والرد على الطعن فيهم.
- بيان منزلة الخلفاء الراشدين في الإسلام.
- الدفاع عن الصحابة وأفضليتهم في نقل الدين.
- إثبات عدالتهم بنصوص القرآن والسنة.
- الرد على الشيعة في طعونهم في أبي بكر وعمر وعثمان.
- بيان منزلة علي رضي الله عنه عند أهل السنة والجماعة.
- تفنيد الروايات الشيعية التي تطعن في الصحابة.
- الدفاع عن أمهات المؤمنين، خاصة السيدة عائشة رضي الله عنها.
- تفنيد الأكاذيب حول حرب الجمل وصفين، وبيان دوافعها الحقيقية.
- الرد على زعم الشيعة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
- تأكيد فضل الصحابة في نشر الإسلام وحفظ السنة.
- عقيدة القدر ومسائل القضاء والقدر:
- الرد على القدرية والجبرية في مسائل القدر.
- بيان العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر وفق منهج أهل السنة.
- الرد على القول بالجبر (القول بأن الإنسان مجبور في أفعاله).
- الرد على القول بنفي القدر (القدرية الذين ينكرون علم الله السابق).
- بيان وسطية أهل السنة بين الجبرية والقدرية.
- شرح أن أفعال العباد مقدرة، لكنهم مسؤولون عنها.
- التفصيل في مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق.
- الرد على مغالطات الشيعة في القول بخلق أفعال العباد.
- توضيح أن أهل السنة يؤمنون بتقدير الخير والشر مع الحكمة الإلهية في ذلك.
- بيان علاقة القدر بالدعاء والعمل.
- تفنيد مقولة أن الله يُجبِر العباد على المعاصي.
- الروايات والأحاديث:
- مناقشة الروايات التي يستند إليها الشيعة في إثبات عقائدهم.
- نقد منهجي للأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
- عرض الأحاديث التي يستدل بها الشيعة في إثبات عقائدهم.
- نقد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي يعتمد عليها الشيعة.
- إثبات صحة الأحاديث التي وردت عن الصحابة والخلفاء.
- بيان منهج أهل السنة في التعامل مع الأحاديث والروايات.
- توضيح دور السند والمتن في نقد الروايات.
- دراسة نقدية لأسانيد الروايات التي تعتمد عليها الشيعة.
- إظهار تناقض الشيعة في قبول الروايات عن أئمتهم وردها عن الصحابة.
- الرد على اعتمادهم على روايات الكافي والغيبة والطوسي.
- تحليل الأحاديث التي يدعون أنها تدعم الغلو في آل البيت.
- الرد على التأويلات الباطلة:
- نقض التأويلات التي قدمها الشيعة للآيات القرآنية.
- عرض التفسير الصحيح للأدلة الشرعية.
- نقض التأويلات الشيعية لآيات الإمامة في القرآن.
- الرد على ادعاء الشيعة أن القرآن فيه نقص أو تحريف.
- إثبات كمال القرآن وسلامته من أي تغيير.
- تفسير الآيات المتعلقة بآل البيت وفق منهج أهل السنة.
- تفنيد استخدام الشيعة للأحاديث لتأويل آيات على غير وجهها.
- تفنيد تفسير الشيعة لبعض الآيات المتعلقة بولي الأمر (مثل “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”).
- الرد على زعمهم أن آية التطهير خاصة بآل البيت فقط.
- توضيح خطأ تفسيرهم لآيات الاصطفاء (مثل آية: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت}).
- كشف المغالطات في فهم النصوص المتعلقة بالشفاعة.
- الحكم على الفرق والجماعات:
- عرض تاريخي ونقدي لفرقة الشيعة الإمامية.
- مقارنة بينهم وبين الفرق الأخرى كالقدرية والجهمية.
- تحليل نشأة فرقة الشيعة الإمامية وأفكارها.
- مقارنة بين الشيعة والقدرية والجهمية والخوارج.
- بيان خطورة المعتقدات الشيعية على وحدة الأمة.
- الحكم على الفرق من منظور عقائدي وشرعي.
- التأكيد على أهمية الرجوع إلى منهج السلف الصالح.
- بيان أن الشيعة الإمامية يعتمدون في عقائدهم على المرويات الإسرائيلية.
- توضيح دور عبدالله بن سبأ في تأسيس الفكر الشيعي.
- عرض الانقسامات الداخلية بين فرق الشيعة مثل الزيدية والإسماعيلية.
- نقد العقائد الباطنية للشيعة في مسائل الغيبة والمهدي المنتظر.
- منهج الدعوة والردود:
- التأكيد على أهمية الحوار العلمي في الدعوة إلى الله.
- بيان أساليب الردود على المخالفين.
- أسلوب شيخ الإسلام في الحوار العلمي مع المخالفين.
- أهمية الردود المبنية على الكتاب والسنة.
- الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
- الحث على اتباع منهج السلف في الردود العلمية.
- التأكيد على أهمية العلم الشرعي في مواجهة الفرق الضالة.
- التأكيد على اتباع الأسلوب العلمي بدل الجدال العقيم.
- الحث على الحوار البناء الذي يعتمد على الأدلة الشرعية والعقلية.
- توضيح أهمية الرجوع إلى العلماء المتخصصين في الرد على الشبهات.
- رفض أسلوب السب والشتم في الردود، والاعتماد على بيان الحق بالحجة.
الباب الأول: التوحيد وتنزيه الله عن النقائص
أولا: إثبات صفات الله كما وردت في الكتاب والسنة دون تحريف أو تعطيل
- الرد على عقائد الشيعة الإمامية حول الصفات الإلهية.
- إثبات كمال الله تعالى وأسمائه وصفاته.
مفهوم إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة
- الإثبات: يقصد به قبول صفات الله تعالى الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية كما هي، دون محاولة تغيير معانيها أو تشبيهها بصفات المخلوقات.
- التحريف: يعني تغيير لفظ أو معنى النصوص الشرعية المتعلقة بالصفات لتوافق أهواء معينة.
- التعطيل: هو نفي الصفات الإلهية بحجة تنزيه الله، مما يؤدي إلى إنكار ما أثبته الله لنفسه.
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات الصفات
- النصوص القرآنية والسنية مرجعية أساسية:
- إثبات الصفات كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، دون تجاوز النصوص أو محاولة تأويلها بغير دليل.
- مثال: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: 180).
- عدم التشبيه أو التمثيل:
- إثبات الصفات مع نفي مشابهتها للمخلوقات، كما في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى: 11).
- التركيز على الجمع بين إثبات الصفات ونفي التشبيه.
- رد على المؤولين والمعطّلة:
- يرد ابن تيمية على الفرق التي عطلت الصفات مثل المعتزلة والجهمية، موضحًا أن تعطيل الصفات يؤدي إلى إنكار كمال الله.
- يرفض تحريف النصوص لتأويلها بمعانٍ مجازية لا يدل عليها النص، مثل تأويل “استوى” بمعنى “استولى”.
- الوسطية في منهج الإثبات:
- يؤكد ابن تيمية على منهج أهل السنة كمنهج وسطي بين المشبهة الذين يشبهون صفات الله بالمخلوقين، والمعطلة الذين ينفون الصفات.
أمثلة على الصفات المثبتة
- الصفات الذاتية:
- مثل: الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر.
- مثال: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (النساء: 58).
- الصفات الفعلية:
- مثل: الاستواء، النزول، المجيء.
- مثال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ} (طه: 5).
الرد على شبهات المعطلة
- دعوى تنزيه الله:
- يوضح ابن تيمية أن نفي الصفات بحجة التنزيه هو في الحقيقة نفي لكمال الله.
- وأن التنزيه الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مشابهته للمخلوقات.
- دعوى التأويل العقلي:
- يبين أن التأويلات العقلية التي يعتمد عليها المعطلة مخالفة لنصوص الشرع، ولا تعتمد على دليل قطعي.
- ادعاء أن إثبات الصفات يؤدي للتشبيه:
- يرد ابن تيمية بأن التشبيه هو القول بأن صفات الله مثل صفات المخلوقين، أما إثبات الصفات فهو إثبات ما يليق بجلال الله.
أثر إثبات الصفات في العقيدة
- إثبات الصفات يعزز الإيمان بكمال الله وجلاله.
- يرسخ عبادة الله على بصيرة، بناءً على معرفته من خلال أسمائه وصفاته.
خلاصة منهج ابن تيمية
- الالتزام بما ورد في النصوص الشرعية دون تحريف أو تعطيل.
- التوسط بين التعطيل والتشبيه.
- الدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة في مواجهة شبهات المخالفين.
تعطيل الصفات عند المعتزلة والجهمية (والأشعرية بعدهما)
- المعتزلة:
- ذهبوا إلى نفي الصفات الإلهية بدعوى التنزيه، وقالوا إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء.
- اعتبروا أن إثبات الصفات يجعل الله مشابهًا للمخلوقات.
- أنكروا صفات مثل السمع، والبصر، والكلام، وأولوا الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول إلى معانٍ مجازية.
- الجهمية:
- بالغوا في تعطيل الصفات إلى حد إنكار الذات الإلهية نفسها.
- زعموا أن الله ليس له صفات حقيقية، وأن الأسماء التي وردت في النصوص لا تدل على صفات، بل هي مجرد ألفاظ.
رد ابن تيمية على تعطيل الصفات
- التعطيل ينفي كمال الله:
- يرى ابن تيمية أن نفي الصفات يعني نفي كمال الله تعالى، لأن الله وصف نفسه بهذه الصفات في القرآن والسنة.
- التعطيل يؤدي إلى تصور إله مجرد لا صلة له بالمخلوقات، وهو مخالف للعقل والنقل.
- التنزيه الحق يثبت الصفات:
- يؤكد أن إثبات الصفات لا يعني التشبيه، لأن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى: 11).
- يرى أن تعطيل الصفات بحجة التنزيه يؤدي إلى تشبيه الله بالمعدومات، لأن الموجود الكامل يجب أن تكون له صفات.
- تحريف النصوص لمعانٍ مجازية:
- يرد ابن تيمية على تأويلات الفرق مثل تفسير “استوى” بـ “استولى”، موضحًا أن:
- الاستواء في اللغة يعني العلو والارتفاع، وهو ما أثبته الله لنفسه.
- الاستيلاء ليس له علاقة بمعنى الاستواء، وهو تحريف لمعنى النصوص.
- هذا التأويل يناقض النصوص الأخرى التي تدل على أن الله عالٍ بذاته فوق عرشه، مثل قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ} (طه: 5).
- يرد ابن تيمية على تأويلات الفرق مثل تفسير “استوى” بـ “استولى”، موضحًا أن:
الرد على دعوى التأويل العقلي
- مخالفة التأويل للنقل:
- يرى ابن تيمية أن النصوص الشرعية هي أصدق المصادر في معرفة الله، ولا يجوز تحريفها بحجة العقل.
- النصوص الشرعية واضحة في إثبات الصفات، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تأويلها.
- ضعف التأويل المجازي:
- يشير إلى أن المجاز في اللغة يعتمد على قرينة صارفة عن المعنى الأصلي، والنصوص المتعلقة بصفات الله لا تحتوي على قرينة تصرفها عن ظاهرها.
- مثال: لا توجد قرينة تجعل معنى “استوى” هو “استولى”، بل هذا المعنى مرفوض عقلاً ولغة.
أثر التعطيل في العقيدة
- يؤدي تعطيل الصفات إلى تصور إله غائب عن الخلق، بلا علاقة بهم.
- يفقد المسلم الإيمان بكمال الله، لأنه ينفي عنه ما أثبته لنفسه.
- يضعف اليقين بالنصوص الشرعية ويجعلها عرضة للتحريف والتلاعب.
منهج ابن تيمية في الرد
- الرجوع إلى النصوص الشرعية:
- يعتمد على الآيات والأحاديث لإثبات الصفات كما وردت.
- مثال: قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} (البقرة: 255)، لإثبات صفة العلو.
- النقد العقلي للتعطيل:
- يوضح أن العقل السليم لا يتعارض مع النصوص الشرعية، بل يؤيدها.
- التعطيل يجعل الإله غامضًا لا يمكن معرفته أو الإيمان به.
- تفسير النصوص كما وردت:
- يؤكد أن النصوص يجب أن تُفسر بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وليس وفق اصطلاحات فلسفية مبتدعة.
الخلاصة
ابن تيمية يرد على المعتزلة والجهمية بتوضيح أن تعطيل الصفات ينفي كمال الله ويتناقض مع النصوص الشرعية والعقل السليم. التحريف لمعاني الصفات، مثل تفسير “استوى” بـ “استولى”، هو خروج عن اللغة والنصوص ولا يستند إلى دليل. إثبات الصفات كما وردت في الكتاب والسنة هو الطريق الصحيح لمعرفة الله وتنزيهه دون تعطيل أو تشبيه.
فائدة: الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في الصفات وأبرز أقوالهم:
هذه الفرق الثلاث بعضها من بعض، لذا تعجب عندما تجد الشعري يشتد على المعتزلة لقلتهم في هذا الزمن!! وهم من بعض، الأولى وهي الجهمية هي جدتهم وهي الأضل، والثانية وهي المعتزلة أمهم، أما الثالثة وهي البنت “الأشعرية” فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء!
1. الجهمية (أتباع الجهم بن صفوان)
- في الصفات:
- الجهمية هم الأكثر تطرفًا في التعطيل، حيث نفوا جميع صفات الله، وقالوا إن إثباتها يؤدي إلى التشبيه.
- أنكروا أسماء الله الحسنى إلا كألفاظ مجردة، دون أن يكون لها معانٍ حقيقية.
- قالوا إن الله لا يتصف بالحياة، أو العلم، أو القدرة، واعتبروا ذلك تشبيهًا بالمخلوق.
- قولهم في الصفات: “الله لا يُوصف إلا بالنفي”، مثل: لا يرى، لا يسمع، لا يعلم.
- أبرز اعتراضات العلماء:
- العلماء ردوا بأن هذا يؤدي إلى نفي كمال الله ويشبه الله بالمعدومات.
- التعطيل التام يناقض القرآن والسنة التي أثبتت الصفات لله بوضوح.
2. المعتزلة
- في الصفات:
- نفوا الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء.
- اعتبروا أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء (أي التشبيه بالشرك).
- أوَّلوا الصفات الذاتية مثل السمع والبصر والكلام، وقالوا إنها تعني “العلم” أو “الإرادة”.
- أبرز أقوالهم: “الكلام” عند الله مخلوق، و”الاستواء” يعني الهيمنة والاستيلاء.
- أبرز اعتراضات العلماء:
- قال العلماء إن تأويلهم للنصوص الشرعية تحريف لمعانيها الظاهرة.
- وصف الله لنفسه بالصفات في القرآن لا يقبل التأويل الباطل.
- نفيهم للكلام الإلهي يعارض قوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا} (النساء: 164).
3. الأشاعرة (أتباع أبو الحسن الأشعري)
- في الصفات:
- سلكوا طريقًا وسطًا بين أهل السنة والمعتزلة.
- أثبتوا الصفات الذاتية مثل الحياة، العلم، القدرة، الإرادة.
- أنكروا الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء، وأولوها بمعانٍ مجازية.
- قالوا إن “الكلام” عند الله هو معنى نفسي قائم بذاته، وإن القرآن مخلوق الحروف لا الحقيقية.
- أبرز اعتراضات العلماء:
- اعتبر العلماء أن تأويل الأشاعرة لبعض الصفات الفعلية مخالف للمنهج السلفي.
- رفضوا القول بالكلام النفسي، لأن النصوص أثبتت كلام الله بحروف وأصوات.
- قولهم في الصفات الفعلية اقترب من المعتزلة، مما فتح الباب للتعطيل.
المقارنة بين الفرق الثلاث في الصفات
| الطائفة | إثبات الصفات الذاتية | إثبات الصفات الفعلية | أبرز الأقوال |
|---|---|---|---|
| الجهمية | منكرون تمامًا للصفات | منكرون تمامًا | نفي مطلق للصفات والأسماء |
| المعتزلة | يؤولونها لمعانٍ عقلية فقط | ينفونها ويؤولونها | الصفات الفعلية مرفوضة، والكلام مخلوق |
| الأشاعرة | يثبتونها إجمالًا | يؤولونها لمعانٍ مجازية | إثبات مجازي للكلام والاستواء |
أقوال هذه الفرق في مسائل أخرى اعترض عليها العلماء
1. الجهمية:
- الإيمان: قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل.
- رؤية الله: نفوا رؤية الله يوم القيامة.
- الجبر: اعتقدوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، ولا اختيار له.
2. المعتزلة:
- الإيمان: اعتبروا الإيمان قولًا وعملًا، لكن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين (ليس مؤمنًا ولا كافرًا).
- رؤية الله: نفوا رؤية الله في الآخرة.
- القدر: بالغوا في القول بحرية الإنسان، وقالوا إن أفعاله مخلوقة له وليست مخلوقة لله.
3. الأشاعرة:
- الإيمان: اعتقدوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط.
- رؤية الله: أثبتوا رؤية الله يوم القيامة.
- القدر: قالوا بالكسب، وهو أن أفعال الإنسان مخلوقة لله، لكن للإنسان قدرة كسبية عليها.
خلاصة اعتراض العلماء:
- الجهمية: وصفوا بالتعطيل التام، وهو مخالف للعقل والنقل.
- المعتزلة: أولو النصوص الشرعية وحرفوها عن ظاهرها، مما أدى إلى نفي الصفات الإلهية.
- الأشاعرة: رغم اقترابهم من أهل السنة، إلا أن تأويلهم لبعض الصفات جعلهم أقرب إلى المعتزلة في بعض القضايا.
أدلة إثبات صفة العلو لله تعالى
صفة العلو من الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة والسلف الصالح. تنقسم الأدلة إلى أنواع متعددة: نصوص القرآن، نصوص السنة، العقل، الفطرة، وإجماع الأمة.
1. أدلة من القرآن الكريم
وردت آيات كثيرة تثبت علو الله تعالى، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
(أ) علو الذات:
- قوله تعالى: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (البقرة: 255).
- دلالة صريحة على علو الله بذاته فوق خلقه، مع وصفه بالعظمة المطلقة.
- قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} (النحل: 50).
- إثبات مباشر لعلو الله تعالى فوق عباده.
- قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ} (طه: 5).
- “استوى” بمعنى علا وارتفع، وهي الكيفية التي تليق بجلال الله، دون تشبيه أو تعطيل.
(ب) علو القهر:
- قوله تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (الأنعام: 18).
- “فوق” هنا دالة على علو القهر والسلطان، بالإضافة إلى علو الذات.
(ج) علو المكانة:
- قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ} (الأعلى: 1).
- لفظ “الأعلى” يدل على العلو المطلق في المكانة والذات.
2. أدلة من السنة النبوية
- حديث النزول:
- قال النبي ﷺ: “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟” (متفق عليه).
- دلالة واضحة على علو الله تعالى، حيث النزول لا يكون إلا من أعلى.
- قال النبي ﷺ: “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟” (متفق عليه).
- حديث الجارية:
- سأل النبي ﷺ الجارية: “أين الله؟” فقالت: “في السماء”. فقال: “من أنا؟” قالت: “أنت رسول الله”. فقال: “أعتقها فإنها مؤمنة”. (رواه مسلم).
- إقرار النبي ﷺ بقولها: “في السماء” دليل على إثبات علو الله فوق خلقه.
- سأل النبي ﷺ الجارية: “أين الله؟” فقالت: “في السماء”. فقال: “من أنا؟” قالت: “أنت رسول الله”. فقال: “أعتقها فإنها مؤمنة”. (رواه مسلم).
- الدعاء:
- كان النبي ﷺ يرفع يديه إلى السماء عند الدعاء.
- رفع اليدين إلى السماء دليل على علو الله، حيث يتوجه الداعي إلى من هو فوقه.
- كان النبي ﷺ يرفع يديه إلى السماء عند الدعاء.
3. أدلة من الإجماع
- أجمعت الأمة الإسلامية، بما في ذلك الصحابة والتابعون وأئمة السلف، على إثبات علو الله.
- قال الإمام أبو حنيفة: “من أنكر أن الله فوق السماوات فقد كفر”.
- قال الإمام مالك: “الله في السماء وعلمه في كل مكان”.
4. أدلة عقلية
- علو الكمال:
- الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وعلو الذات من صفات الكمال.
- التفريق بين الخالق والمخلوق:
- العلو يتناسب مع الله كخالق، بينما السفول والتحتية تناسب المخلوق الضعيف.
- العبودية والتذلل:
- الإنسان يتذلل ويرفع يديه ويطلب من الأعلى، مما يؤكد أن المعبود عالٍ فوقه.
5. أدلة فطرية
- الإنسان بفطرته يرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، حتى الذين لم تصلهم الرسالات.
- هذا دليل فطري على إدراك أن الله فوق خلقه.
6. الرد على شبهات المعطلة والمؤولة
- شبهة أن “فوق” تعني القهر أو السلطة فقط:
- الرد: النصوص القرآنية والسنية تجمع بين علو الذات والقهر، ولا يمكن اختزالها في القهر فقط.
- شبهة أن “استوى” تعني “استولى”:
- الرد: “استولى” ليست من معاني “استوى” في لغة العرب، كما أن القول بالاستيلاء يلزم منه أن يكون هناك من ينازعه، وهذا باطل.
- شبهة أن إثبات العلو يؤدي إلى التشبيه:
- الرد: إثبات العلو لا يعني تشبيه الله بالمخلوقات، لأن الله قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى: 11).
الخلاصة
صفة العلو لله تعالى ثابتة بالنصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة، وبإجماع الأمة، وبالعقل والفطرة. الله عالٍ بذاته فوق خلقه، عالٍ بسلطانه وقهره، عالٍ بمكانته وعظمته، ولا يليق به إلا ما يليق بجلاله وعظمته.
فائدة: عقيدة الأشاعرة في الكلام الإلهي
- الأشاعرة يعتقدون أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى، ولكنهم يفرقون بين نوعين من الكلام:
- الكلام النفسي: وهو المعنى القائم بالنفس، الأزلي، غير متعلق بالحروف أو الأصوات.
- الكلام اللفظي: وهو التعبير عن الكلام النفسي بالحروف والأصوات المسموعة.
- بناءً على هذا التفريق، قالوا إن الحروف والأصوات التي نُقل بها كلام الله (مثل القرآن الكريم) مخلوقة، لأنها ليست عين الكلام النفسي الأزلي.
أصل قولهم: “الكلام النفسي”
- الأشاعرة استندوا إلى أن الكلام النفسي هو معنى قائم بالنفس، لا يُتصور فيه حروف أو أصوات.
- قالوا إن الله لا يتكلم بحروف وأصوات لأن ذلك يستلزم حدوث الصفات فيه، والصفات عندهم أزلية غير قابلة للتجدد.
قولهم: الحروف مخلوقة
- القرآن مخلوق من حيث الحروف والأصوات:
- قالوا إن القرآن الكريم الذي نقرؤه ونتلوه هو تعبير عن كلام الله النفسي، لكن الحروف والأصوات التي تُسمع مخلوقة.
- دليلهم:
- استدلوا بأن الصوت والحرف يستلزمان الترتيب والتجدد، وهذا لا يمكن نسبته إلى الله الأزلي.
- اعتبروا أن التعبير بالحروف المسموعة كان بواسطة جبريل عليه السلام أو النبي ﷺ.
مناقشة هذا القول عند أهل السنة والجماعة
أهل السنة والجماعة يخالفون الأشاعرة في هذا القول، ويرون أن:
- الكلام صفة ذاتية وفعلية:
- الكلام عند أهل السنة صفة ذاتية قائمة بالله، بمعنى أن الله لم يزل متصفًا بالكلام.
- الكلام أيضًا صفة فعلية بمعنى أن الله يتكلم متى شاء، بما شاء، وكيف شاء.
- القرآن كلام الله غير مخلوق:
- القرآن بحروفه ومعانيه كلام الله، وهو غير مخلوق، كما دلت النصوص:
- قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} (التوبة: 6).
- إضافة الكلام إلى الله تدل على أنه قائم بذاته وليس مخلوقًا.
- القرآن بحروفه ومعانيه كلام الله، وهو غير مخلوق، كما دلت النصوص:
- الحروف والأصوات ليست مخلوقة:
- الكلام الذي تكلم به الله بحروفه وأصواته ليس مخلوقًا، بل هو صفة من صفاته.
- السلف أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
ردود أهل السنة على الأشاعرة
- القول بالكلام النفسي لا دليل عليه:
- القرآن والسنة أثبتا أن الله يتكلم بحروف وأصوات، ولم يُثبتا كلامًا نفسيًا مجردًا.
- قول النبي ﷺ: “ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.” (رواه البخاري).
- الحديث يدل على أن كلام الله مسموع وحقيقي.
- الكلام بالحروف والأصوات لا ينفي أزلية الله:
- التجدد في أفعال الله لا يعني حدوثه، لأن أفعاله تتعلق بمشيئته، وهي قديمة النوع، حادثة الأفراد.
- التفريق بين الكلام النفسي واللفظي تفريق باطل:
- أهل السنة يرون أن هذا التفريق لا أصل له في النصوص الشرعية.
- الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة يتعارض مع مفهوم الكلام في لغة العرب.
- اعتبار القرآن مخلوق يؤدي إلى القول بخلق صفة من صفات الله:
- قول الأشاعرة بأن الحروف والأصوات مخلوقة يجعل القرآن مخلوقًا، وهذا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة.
آثار هذا القول
- القول بأن الحروف مخلوقة أثار جدلًا في الأمة:
- أدى إلى انقسام في مسائل العقيدة المتعلقة بالكلام.
- القول بأن القرآن مخلوق كان أحد أسباب ظهور الفتن الكبرى، مثل محنة الإمام أحمد.
- ضعف الحجة الأشعرية أمام النصوص الشرعية:
- أدلة الأشاعرة تعتمد على التأويل العقلي، بينما النصوص الشرعية واضحة في إثبات أن كلام الله صفة حقيقية أزلية غير مخلوقة.
خلاصة
- قول الأشاعرة بأن الحروف مخلوقة بني على التفريق بين الكلام النفسي واللفظي، وهو قول مردود بالأدلة الشرعية والعقلية.
- أهل السنة والجماعة يرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بحروفه ومعانيه، وأن الله يتكلم متى شاء، وكيف شاء، بما يليق بجلاله.
الرد على الشيعة في اتهامهم لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم
- اتهام الشيعة لأهل السنة بالتشبيه والتجسيم:
- الشيعة غالبًا ما يتهمون أهل السنة والجماعة بالتشبيه والتجسيم في صفات الله بناءً على إثباتهم لما ورد في الكتاب والسنة من صفات مثل اليد، والاستواء، والنزول.
- يُستخدم هذا الاتهام لتبرير تعطيلهم للصفات الإلهية وتأويلها.
- أساس قولهم بالتشبيه:
- يرى الشيعة أن إثبات الصفات يؤدي إلى مشابهة الله بالمخلوقات.
- استندوا إلى تأويل النصوص بما يتناسب مع عقيدتهم، مثل تأويل “استوى” بـ “استولى”، و”يد الله” بـ “قدرته”، لنفي الصفات التي أثبتها أهل السنة.
- الرد المفصل على دعوى الشيعة بالتشبيه:
- التفريق بين إثبات الصفة والتجسيم:
- يقول ابن تيمية إن إثبات الصفات لا يعني بالضرورة أن الله جسم، لأن الجسمية مفهوم مخلوق، والله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
- اتهام الشيعة لأهل السنة بالتجسيم هو مبني على اعتقاد باطل بأن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، وهذا مردود.
- التفريق بين إثبات الصفة والتجسيم:
- كشف التناقض في موقف الشيعة:
- الشيعة يثبتون صفات لأئمتهم تتضمن التجسيم، مثل علم الغيب والقدرة المطلقة، بينما ينكرونها على الله.
- يدعون تنزيه الله عن الصفات، لكنهم يقعون في الغلو والتشبيه في تعاملهم مع أئمتهم.
- يرى ابن تيمية أن اتهام أهل السنة بالتشبيه هو جزء من محاولات الشيعة لنزع الشرعية عن العقيدة السنية، مستغلين سوء فهم العامة لبعض النصوص.
- التأويل الباطني للنصوص كان وسيلة الشيعة لتقديم أنفسهم كفرقة تنزيهية، على الرغم من تناقضاتهم.
تفصيل القول في نقطتي التجسيم والغلو لدى الشيعة
1. إثبات الشيعة صفات لأئمتهم تتضمن التجسيم
الشيعة الإمامية يثبتون لأئمتهم صفات تجعلهم في مقام الإلهية أو ما يقاربها، رغم إنكارهم هذه الصفات على الله عز وجل بحجة التنزيه.
(أ) علم الغيب
- إثبات علم الغيب للأئمة:
- يعتقد الشيعة أن الأئمة يعلمون الغيب علمًا مطلقًا.
- يقول الكليني في “الكافي”: “إن الإمام يعلم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليه شيء.”
- هذا القول يتضمن وصف الأئمة بعلم مطلق لا يحده زمان أو مكان، وهو صفة من صفات الله تعالى.
- رد أهل السنة:
- علم الغيب من خصائص الله تعالى، كما في قوله: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (النمل: 65).
- النبي ﷺ نفسه لم يكن يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه، كما قال: {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} (الأعراف: 188).
(ب) القدرة المطلقة
- إثبات القدرة المطلقة للأئمة:
- يزعم الشيعة أن الأئمة يملكون القدرة المطلقة على التصرف في الكون، ويدّعون أن الله أعطاهم هذه القدرة.
- مثال: في روايات الشيعة، يُقال إن الأئمة قادرون على إحياء الموتى، وإجراء المعجزات كما يشاؤون.
- رد أهل السنة:
- هذه الصفات تدخل في دائرة التجسيم والغلو، لأنها تنقل صفات الله إلى مخلوقاته.
- الله وحده هو القادر على كل شيء، كما في قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: 20).
(ج) العصمة المطلقة:
- إثبات العصمة للأئمة:
- يعتقد الشيعة أن الأئمة معصومون عن الخطأ، والزلل، والنسيان، مما يجعلهم في مقام ألوهي.
- رد أهل السنة:
- العصمة من الخطأ والنسيان هي من خصائص الله تعالى، إذ قال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم: 64).
- الأنبياء فقط معصومون في تبليغ الوحي، أما غيرهم فليس لهم العصمة المطلقة.
2. دعوى تنزيه الله عن الصفات مع الغلو والتشبيه في الأئمة
(أ) التنزيه عن الصفات الإلهية:
- دعوى الشيعة:
- ينفون صفات الله الفعلية مثل العلو، والاستواء، والنزول، بحجة أن إثباتها يستلزم التجسيم والتشبيه.
- مفارقة الغلو:
- بينما يعطلون صفات الله بزعم التنزيه، ينسبون صفات بشرية مفرطة في الغلو للأئمة، مما يؤدي إلى تشبيه الأئمة بالله.
(ب) أمثلة على الغلو والتشبيه في الأئمة:
- المهدي المنتظر:
- يدّعون أن الإمام المهدي يعيش منذ قرون، يعلم الغيب، ويتحكم في مصير العالم.
- هذا تشبيه صريح بصفات الله التي لا يشاركه فيها أحد.
- أئمة آل البيت:
- يعتقد الشيعة أن الأئمة لا يتخذون قرارات عن جهل، وكل أقوالهم تشريعات مطلقة.
- هذا التشبيه يتناقض مع بشريتهم، حيث قال تعالى عن نبيه: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ} (الكهف: 110).
- التأثير الكوني:
- ينسبون للأئمة القدرة على التدخل في نظام الكون وإحداث المعجزات كيفما شاءوا.
- هذا مشابه لما ينسب إلى الله وحده من التدبير الكوني.
(ج) الرد على التشبيه والغلو في الأئمة:
- بطلان ادعاء الغلو:
- قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ}، مما يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن غيره.
- الغلو بالأئمة مخالف للنصوص التي تضع البشر، مهما علت مكانتهم، تحت مظلة العبودية لله.
- تحذير النبي ﷺ من الغلو:
- قال النبي ﷺ: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله.” (رواه البخاري).
- التحذير من رفع البشر فوق مكانتهم يشمل الأئمة الذين غلت فيهم الشيعة.
خلاصة الإضافات الجديدة:
- الشيعة ينسبون للأئمة صفات كعلم الغيب، والقدرة المطلقة، والتدخل في الكون، وهي صفات تختص بالله وحده.
- يعطلون صفات الله بحجة التنزيه، ثم ينسبون الصفات ذاتها للأئمة بغلوّ صريح.
- أدلة القرآن والسنة تؤكد أن هذه الصفات لا يجوز أن تُنسب إلا لله، وتنفي الغلو في أي مخلوق.
نقض فكرة أن الله يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه
أهل السنة والجماعة ينفون مشابهة الله لخلقه نفياً قاطعاً بناءً على النصوص الشرعية الصريحة والعقل السليم. الاعتقاد بأن الله يُشبه خلقه بأي شكل من الأشكال يوقع الإنسان في التشبيه، وهو أمر منهي عنه في الإسلام.
قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى: 11)، وهذه الآية تعد قاعدة شاملة تنفي المثلية بين الله وخلقه، وتثبت له صفاته دون تشبيه أو تمثيل.
1. نصوص من القرآن الكريم تنفي التشبيه
- {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص: 4):
- تنفي الآية أي مكافأة أو مماثلة لله سبحانه وتعالى.
- {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (مريم: 65):
- تساؤل استنكاري يدل على أن الله لا مثيل له في ذاته أو صفاته.
- {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} (الأنعام: 103):
- نفي إدراك الأبصار لله يؤكد عظمته وتنزيهه عن مشابهة الخلق.
2. نصوص من السنة النبوية تنفي التشبيه
- قال النبي ﷺ: “إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه.” (رواه مسلم).
- يبين الحديث أن صفات الله تختلف عن صفات المخلوقين، مثل النوم.
- حديث الجارية: “أين الله؟” قالت: “في السماء.” (رواه مسلم).
- يُفهم منه إثبات علو الله مع تنزيهه عن الحاجة للمكان كالمخلوقين.
3. أدلة عقلية على نفي التشبيه
- اختلاف الخالق عن المخلوق:
- الله هو الخالق، والمخلوقات محدثة، فكيف يشبه المخلوق المحدَث من خلقه؟
- قال الله: {هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} (الحشر: 24)، مما يدل على أن الله متصف بالكمال المطلق.
- كمال الله ينافي التشبيه:
- المخلوقات ناقصة ومحدودة، بينما الله كامل في صفاته، والتشبيه يقتضي نقصًا في الكمال.
4. ردود على شبهات التشبيه
(أ) شبهة إثبات الصفات يلزم منها التشبيه
- بعض الفرق، مثل الجهمية والمعتزلة، زعموا أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه.
- الرد:
- إثبات الصفات لا يعني التشبيه، لأن الله أثبتها لنفسه في نصوص الشرع.
- مثال: إثبات السمع والبصر لله لا يعني أنه يسمع ويبصر كالمخلوقات، بل يسمع ويرى بما يليق بجلاله.
(ب) شبهة أن ذكر اليد أو الوجه تشبيه لله بالمخلوقات
- الرد:
- قال الله: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (الفتح: 10)، وأثبت لنفسه اليد، لكن لا تُشبه أيدي المخلوقات.
- أهل السنة يثبتون اليد لله كما وردت دون كيف، ودون تشبيهها بأيدي الخلق.
5. منهج أهل السنة في نفي التشبيه
- الإثبات بلا تشبيه:
- إثبات الصفات كما وردت في النصوص الشرعية مع نفي التشبيه، استنادًا إلى قاعدة: “إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.”
- التفويض في الكيفية:
- الكيفية مجهولة، ولا يجوز السؤال عنها.
- مثال: الإمام مالك عندما سُئل عن الاستواء قال: “الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.”
6. أقوال العلماء في نفي التشبيه
- الإمام أحمد: “لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولا يتجاوز القرآن والحديث.”
- ابن تيمية: “من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيهًا.”
7. مظاهر التشبيه عند المخالفين
- المجسمة:
- شبهوا الله بالمخلوقات، فقالوا إن له جسمًا محدودًا.
- هذا باطل لأن الله قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
- المعطلة:
- نفوا الصفات بحجة التنزيه، ولكن نفي الصفات يؤدي إلى تشبيه الله بالمعدومات، وهو باطل.
ثانيا: بيان أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها
مفهوم التوقيف في أسماء الله وصفاته
- التوقيفية تعني أن أسماء الله وصفاته تُثبت فقط بما ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة، ولا يجوز إطلاق اسم أو صفة على الله بالاجتهاد أو الرأي الشخصي.
- لا يمكن للإنسان أن يصف الله أو يسميه إلا بما ورد في النصوص الشرعية، لأن الأسماء والصفات توقيفية تتعلق بالله عز وجل، ويجب أن تكون مبنية على الوحي.
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: 180)، مما يدل على أن أسماء الله توقيفية، ولا يجوز أن يُسمى الله إلا بالأسماء التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله.
الأدلة على أن أسماء الله وصفاته توقيفية
1. من القرآن الكريم
- قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء: 36).
تحذير من الخوض في أمور الغيب، ومنها صفات الله وأسماؤه، إلا بدليل شرعي. - قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} إلى قوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (الأعراف: 33).
القول على الله بغير علم يدخل في دائرة الابتداع المحرم.
2. من السنة النبوية
- حديث النبي ﷺ:
“إن لله تسعةً وتسعين اسمًا، مئةً إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنة.” (متفق عليه).- يبين الحديث أن أسماء الله توقيفية ومحددة لا مجال للاجتهاد فيها.
- حديث الدعاء:
“أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك.” (رواه أحمد).- النص يوضح أن أسماء الله إما وردت في الوحي أو احتُفظ بها في علم الغيب، ولا سبيل لاجتهاد بشري فيها.
3. الإجماع
- أجمع العلماء على أن أسماء الله وصفاته توقيفية:
- قال الإمام النووي: “أسماء الله توقيفية، فلا يسمى إلا بما ورد به النص”.
- قال ابن تيمية: “ما لم يرد في النصوص من الأسماء والصفات، فلا يجوز إثباته لله”.
معاني كون الأسماء والصفات توقيفية
- لا يجوز إثبات أسماء لم ترد في النصوص:
- مثال: لا يجوز أن يُطلق على الله اسم “المهندس” أو “العقل الأول” لأنه لم يرد في النصوص.
- حتى لو كان في ظاهر اللفظ مدحًا، فإن عدم وروده دليل على أنه غير لائق بجلال الله.
- الصفات المستنبطة يجب أن تكون مستندة إلى النصوص:
- يُستنبط وصف الله بـ “الرحمة” من اسمه “الرحمن”.
- لا يجوز استنباط صفات لله بناءً على العقل المجرد أو الظنون.
- النصوص الشرعية هي المرجع الوحيد:
- لا مجال للرأي الشخصي أو التأويل الفلسفي في أسماء الله وصفاته.
الرد على المخالفين
1. أهل التعطيل
- قولهم: نفي الصفات الإلهية بحجة التنزيه.
- الرد: نفي الصفات يُعتبر قولًا على الله بغير علم، ويناقض النصوص الصريحة التي أثبتت الأسماء والصفات.
2. أهل التشبيه
- قولهم: إثبات الصفات على وجه يشبه صفات المخلوقين.
- الرد: أسماء الله وصفاته توقيفية، ويجب إثباتها بما يليق بجلاله دون تشبيه أو تمثيل.
3. الفلاسفة والمعتزلة
- قولهم: أسماء الله مجردة عن الصفات، ويفسرونها بالعقل.
- الرد: التوقيف يعني الالتزام بالنصوص الشرعية دون إخضاعها للتأويلات العقلية البعيدة عن ظاهر النص.
أمثلة على مخالفات التوقيفية
- إضافة أسماء وصفات لم ترد:
- مثل إطلاق أسماء فلسفية أو مصطلحات مبتدعة على الله، كقول بعضهم “العقل الأول” أو “المبدع الأول”.
- نفي أسماء أو صفات وردت:
- كإنكار الجهمية والمعتزلة لأسماء وصفات مثل “اليد”، “الوجه”، أو “الرحمة”.
خلاصة
- أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بما جاء في الكتاب والسنة.
- التزام التوقيفية يحفظ العقيدة من الابتداع والتشبيه والتعطيل.
- على المسلم أن يعبد الله بما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، وأن يمتنع عن الاجتهاد فيها، لأن ذلك من خصائص الوحي.
القول الصحيح في استخدام مصطلحات مثل “واجب الوجود” و”القديم” وأمثالها
1. تعريف هذه المصطلحات
- واجب الوجود:
- مصطلح فلسفي يستخدم للإشارة إلى وجود الله الذي لا يمكن أن يكون غير موجود، لأنه المبدأ الأول لكل موجود.
- أصل المصطلح مأخوذ من الفلسفة اليونانية وتأثر به علماء الكلام.
- القديم:
- لفظ استخدمه المتكلمون للإشارة إلى أزلية الله وأنه لا بداية لوجوده.
- هذا اللفظ ورد في كلام بعض المتكلمين ولكنه لم يرد في القرآن أو السنة.
2. موقف أهل السنة والجماعة من هذه المصطلحات
- أهل السنة والجماعة يتوقفون عند الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، فلا يثبتونها ولا ينكرونها إلا بعد التحقق من معانيها.
- لا يعتمدون على الألفاظ الفلسفية أو الكلامية إذا كان لها معانٍ باطلة أو تؤدي إلى التشبيه أو التعطيل.
3. أمثلة أخرى مشابهة لهذه المصطلحات
- الذات الإلهية: يشير إلى الله عز وجل، لكنه مصطلح لم يرد في النصوص الشرعية.
- العلّة الأولى: مصطلح فلسفي يشير إلى أن الله هو السبب الأول لكل موجود.
- الصانع: مصطلح يشير إلى الله كخالق، ورد معناه في النصوص لكن لم يُستخدم كاسم لله.
- الممكن الوجود والممتنع الوجود: مصطلحات فلسفية تُستخدم لتصنيف المخلوقات.
4. تفنيد أهل السنة لهذه المصطلحات
(أ) واجب الوجود
- المعنى الفلسفي:
- يُستخدم للدلالة على أن الله موجود بذاته، وأن وجوده لا يعتمد على غيره.
- موقف أهل السنة:
- إن كان القصد من “واجب الوجود” أن الله مستغنٍ عن غيره، وأنه الخالق الأزلي، فهذا المعنى صحيح.
- إن كان المصطلح يتضمن معاني فلسفية باطلة مثل نفي الصفات أو وصف الله بأنه مجرد وجود مطلق، فهو مردود.
- الرد:
- قال الله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} (الإخلاص: 2)، والمعنى أنه المستغني عن غيره والمحتاج إليه كل شيء، وهذا أبلغ من تعبير “واجب الوجود”.
(ب) القديم
- المعنى الفلسفي:
- يعني أن الله أزلي لا بداية له.
- موقف أهل السنة:
- لفظ “القديم” لم يرد في القرآن أو السنة كاسم من أسماء الله، ولهذا لا يُستخدم إلا بشرط:
- أن يُقصد به أن الله أزلي لا بداية له.
- مع عدم إطلاقه على الله كاسم مستقل.
- لفظ “القديم” لم يرد في القرآن أو السنة كاسم من أسماء الله، ولهذا لا يُستخدم إلا بشرط:
- الرد:
- القرآن استخدم تعبيرات أبلغ مثل {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} (الحديد: 3)، فالأولى الالتزام بالنصوص الشرعية.
(ج) الذات الإلهية
- المعنى الكلامي:
- يُستخدم للإشارة إلى الله عز وجل.
- موقف أهل السنة:
- المصطلح لا بأس به إذا كان المقصود هو الله عز وجل ذاته بلا فصل بينه وبين صفاته، لكن استخدامه يُفضل أن يكون موافقًا للنصوص الشرعية.
- الرد:
- النصوص القرآنية أثبتت صفات الله وأسماءه، ولم تستخدم لفظ “الذات”، لذا يُفضل الاقتصار على ما ورد.
(د) العلة الأولى
- المعنى الفلسفي:
- يُشير إلى أن الله هو السبب الأول لوجود الأشياء.
- موقف أهل السنة:
- مصطلح مرفوض لأنه مستورد من الفلسفة الأرسطية، ويُفهم منه أن الله علّة مثل علل المخلوقات.
- الرد:
- قال الله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (الزمر: 62)، ولفظ الخالق أبلغ وأدق من لفظ “العلّة الأولى”.
5. أسباب رفض أهل السنة لهذه المصطلحات
- التوقيفية في الأسماء والصفات:
- أسماء الله وصفاته توقيفية، ولا يجوز وصف الله بما لم يرد في النصوص.
- غموض المصطلحات:
- المصطلحات الفلسفية قد تكون غامضة أو متعددة المعاني، مما يفتح الباب للتأويل الباطل.
- تأثرها بالفلسفة:
- هذه الألفاظ مستوردة من الفلسفات اليونانية والفارسية، وتتناقض في أحيان كثيرة مع العقيدة الإسلامية.
- ترك الألفاظ الشرعية الأبلغ:
- النصوص الشرعية تستخدم ألفاظًا دقيقة وأبلغ في الدلالة على الله وصفاته.
6. الخلاصة في الحكم على المصطلحات
- المصطلحات مثل “واجب الوجود” و”القديم” و”العلة الأولى” وغيرها يجب فحص معانيها:
- إن كان المعنى صحيحًا وموافقًا للشرع: يجوز قبولها مع الحذر من اعتمادها كبديل للنصوص الشرعية.
- إن كان المعنى باطلًا أو يؤدي إلى اللبس: يجب رفضها.
- الأفضل الالتزام بالألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، لأنها أبلغ وأدق في التعبير عن صفات الله وأسمائه.
فائدة: أمثلة من المصطلحات التي يستخدمها الأشاعرة وردود أهل السنة عليها
الأشاعرة، كفرقة كلامية، استخدموا العديد من المصطلحات الفلسفية والكلامية لوصف الله وصفاته. هذه المصطلحات لم ترد في الكتاب والسنة، واعتمدت على التأويل العقلي المتأثر بالفلسفة اليونانية والمنهج الكلامي. فيما يلي أبرز الأمثلة على هذه المصطلحات وكيف رد أهل السنة عليها:
1. واجب الوجود
ما يقصده الأشاعرة:
- “واجب الوجود” عند الأشاعرة يعني أن وجود الله ضروري، وأنه لا يمكن أن يكون غير موجود، لأنه المبدأ الأول لكل الموجودات.
- يرون أن هذا المصطلح ضروري للرد على الملاحدة والفلاسفة الذين ينكرون وجود الله.
رد أهل السنة:
- توقيفية الأسماء والصفات:
- “واجب الوجود” ليس من الأسماء أو الصفات التي وردت في الكتاب والسنة.
- الأولى استخدام الألفاظ الشرعية، مثل {اللَّهُ الصَّمَدُ} (الإخلاص: 2)، التي تعبر عن استغناء الله عن غيره وحاجتهم إليه.
- التأثير الفلسفي:
- هذا المصطلح مستورد من الفلسفة اليونانية، ولا ينسجم مع منهج السلف في التوحيد.
- قول الله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص: 1) أبلغ في الرد على الملاحدة من مصطلحات الفلاسفة.
2. القديم
ما يقصده الأشاعرة:
- يقصدون بـ “القديم” أن الله أزلي، لا بداية له، وكان موجودًا قبل كل شيء.
- يعتقدون أن هذا المصطلح مهم لإثبات أزلية الله وردًا على من يقول بحدوثه.
رد أهل السنة:
- عدم وروده في النصوص:
- لم يرد اسم “القديم” ضمن أسماء الله الحسنى.
- النصوص الشرعية استخدمت تعبيرات أبلغ مثل: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} (الحديد: 3).
- إمكانية اللبس:
- لفظ “القديم” قد يُفهم منه معنى نقص، لأنه قد يطلق على الأشياء البالية أو القديمة في اللغة.
- الأسماء الشرعية لا تحتمل أي نقص أو شبهة، على عكس المصطلحات الكلامية.
3. المتكلم بالكلام النفسي
ما يقصده الأشاعرة:
- الأشاعرة يقولون إن كلام الله صفة نفسية قائمة بذاته، لا يتضمن حروفًا أو أصواتًا.
- يعتبرون القرآن الكريم تعبيرًا عن هذا الكلام النفسي، لكنه ليس عين كلام الله.
رد أهل السنة:
- القرآن كلام الله:
- القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، غير مخلوق.
- قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} (التوبة: 6)، وهذا يدل على أن كلام الله مسموع ومفهوم.
- نفي الكلام النفسي:
- القول بالكلام النفسي مفهوم مبتدع لم يرد في الكتاب والسنة.
- كلام الله يُثبت على الوجه الذي يليق بجلاله، وهو صفة ذاتية وفعلية.
4. الذات الإلهية
ما يقصده الأشاعرة:
- يشيرون إلى ذات الله باعتبارها الوجود الإلهي المطلق، المنفصل عن الصفات الفعلية.
رد أهل السنة:
- الفصل بين الذات والصفات:
- أهل السنة لا يفصلون بين ذات الله وصفاته، لأن الله موصوف بصفاته أزلًا وأبدًا.
- قول الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى: 11) يدل على ارتباط الصفات بالذات.
- الألفاظ المبتدعة:
- استخدام مصطلح “الذات الإلهية” فيه تكلّف وابتداع، بينما النصوص الشرعية غنية بالألفاظ الصحيحة.
5. الحقيقة والمجاز
ما يقصده الأشاعرة:
- الأشاعرة يميزون بين الحقيقة والمجاز في نصوص الصفات، فيقولون إن بعض الصفات مثل “اليد” و”النزول” يجب أن تُفهم مجازًا وليس حقيقة.
رد أهل السنة:
- نفي التأويل الباطل:
- أهل السنة يثبتون الصفات كما وردت في النصوص دون تأويل، مع نفي التشبيه.
- قال الله تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (الفتح: 10)، وهذه صفة تثبت لله على ما يليق بجلاله.
- التفريق بين المجاز والحقيقة:
- القول بأن نصوص الصفات مجاز يفتح الباب للتلاعب بالنصوص الشرعية ونفي الصفات.
6. الممكن والممتنع والواجب
ما يقصده الأشاعرة:
- الأشاعرة يستخدمون هذه المصطلحات لتصنيف الأشياء:
- “واجب الوجود” لله.
- “ممكن الوجود” للمخلوقات.
- “ممتنع الوجود” لما هو مستحيل عقلاً.
رد أهل السنة:
- مصطلحات فلسفية:
- هذه المصطلحات مأخوذة من الفلاسفة، وهي غير مألوفة في النصوص الشرعية.
- الاعتماد عليها يضعف منهج السلف الذي يعتمد على الوحي.
- الألفاظ الشرعية أولى:
- الألفاظ الشرعية مثل “الخالق” و”المخلوق” أبلغ وأوضح في الدلالة.
الخلاصة:
- الأشاعرة استخدموا مصطلحات مثل “واجب الوجود”، “القديم”، و”الكلام النفسي”، وهي مصطلحات مستمدة من الفلسفة والكلام.
- أهل السنة ردوا على هذه المصطلحات بأنها:
- لم ترد في الكتاب والسنة.
- قد تحمل معاني باطلة أو غير دقيقة.
- الأولى الالتزام بالألفاظ الشرعية لأنها أوضح وأدق في التعبير عن صفات الله.
ثالثا: تفنيد اعتقاد الشيعة بأن الأئمة يعلمون الغيب
1. تعريف علم الغيب عند الشيعة
- يعتقد الشيعة الإمامية أن الأئمة الاثني عشر يتمتعون بعلم الغيب، ويعلمون كل ما كان وما يكون وما سيكون.
- ورد في كتبهم الأساسية، مثل “الكافي” للكليني: “الإمام يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، ولو كشف الغطاء ما ازداد يقينًا.”
2. أدلة الشيعة على اعتقادهم بعلم الغيب للأئمة
- استنادهم إلى بعض الروايات المنسوبة للأئمة التي تدعي علمهم للغيب.
- تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية على أن الأئمة قد منحهم الله علم الغيب، مثل قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ} (الجن: 26-27)، حيث يزعمون أن الأئمة يدخلون في الاستثناء.
3. الرد على هذا الاعتقاد من القرآن الكريم
(أ) الغيب من خصائص الله وحده
- {قُل لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (النمل: 65):
- الآية تنفي علم الغيب عن أي مخلوق، مما يشمل الأئمة.
- {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 59):
- تخصيص العلم بمفاتيح الغيب لله وحده يؤكد استحالة أن يشارك أحد في هذا العلم.
(ب) الأنبياء أنفسهم لا يعلمون الغيب إلا بوحي
- {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} (آل عمران: 179):
- حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بما يخبرهم الله به.
- {وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} (الأعراف: 188):
- النبي محمد ﷺ نفسه ينفي عن نفسه علم الغيب.
- {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ} (الكهف: 110):
- دلالة على أن النبي بشر لا يعلم الغيب إلا من خلال الوحي.
4. الرد من السنة النبوية
- حديث المفاتح الخمس:
قال النبي ﷺ: “مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله…” (رواه البخاري).- هذا الحديث يثبت أن علم الغيب محصور في الله وحده.
- نفي علم النبي نفسه:
- عندما سُئل النبي ﷺ عن وقت قيام الساعة قال: “ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.” (رواه مسلم).
- إذا كان النبي ﷺ نفسه لا يعلم وقت الساعة، فكيف يدّعى علم الغيب للأئمة؟
5. الرد العقلي
- الغيب خاص بالخالق:
- علم الغيب يتطلب إحاطة كاملة بالماضي والحاضر والمستقبل، وهذا لا يليق إلا بالله الذي خلق الزمان والمكان.
- تناقض مع بشرية الأئمة:
- الأئمة بشر يأكلون ويشربون ويموتون. كيف يُنسب إليهم علم الغيب الذي هو من خصائص الله المطلقة؟
- تناقض مع نصوص الشيعة أنفسهم:
- ورد في بعض روايات الشيعة أن الأئمة كانوا يسألون الله أو يترددون في بعض الأمور، وهذا ينفي عنهم العلم المطلق.
6. كشف التلاعب بالنصوص الشرعية
(أ) استثناء الآية في سورة الجن
- {إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ} (الجن: 27):
- الاستثناء خاص بالرسل فقط، وليس الأئمة. الأئمة ليسوا رسلًا بل من البشر العاديين.
(ب) الاستناد إلى الأحاديث الضعيفة والمكذوبة
- الروايات التي تذكر علم الغيب للأئمة في كتب الشيعة تفتقر إلى السند الصحيح، بل كثير منها موضوع أو منسوب كذبًا للأئمة.
7. تناقض اعتقاد الشيعة مع توحيد الله
- شرك في الصفات:
- الاعتقاد بأن الأئمة يعلمون الغيب يساويهم بالله في صفة العلم، وهو شرك في صفات الله.
- التحذير من الغلو:
- قال النبي ﷺ: “إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو.” (رواه النسائي).
- نسبة علم الغيب للأئمة غلو يناقض تحذير النبي.
8. الخلاصة
- علم الغيب من خصائص الله وحده، ولا يجوز نسبته إلى الأئمة أو غيرهم.
- الأدلة من القرآن والسنة تنفي أي اشتراك للمخلوقين في هذا العلم.
- اعتقاد الشيعة بأن الأئمة يعلمون الغيب يتناقض مع النصوص الشرعية والعقل، ويدخل في دائرة الغلو المذموم.
تفصيل إضافي حول تفنيد اعتقاد الشيعة بأن الأئمة يعلمون الغيب
1. أمثلة إضافية من القرآن الكريم
(أ) حصر علم الغيب في الله تعالى
- قوله تعالى:
{قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} (الأعراف: 188).- الآية تظهر أن النبي ﷺ نفسه لا يعلم الغيب إلا بما شاء الله، مما ينفي صفة الغيب عن غيره من البشر، كالأئمة.
(ب) نفي علم الساعة عن جميع المخلوقات
- قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} (الأعراف: 187).- العلم بموعد الساعة، وهو من أعظم أمور الغيب، اختص الله به وحده.
(ج) الحوادث الطبيعية والغيبية بيد الله
- قوله تعالى:
{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 59).- مفاتيح الغيب تشمل كل الأمور الغيبية الكبرى التي لا يعلمها إلا الله، بما في ذلك المستقبل والمغيبات.
2. أمثلة إضافية من السنة النبوية
(أ) حديث المفاتح الخمس
- قال النبي ﷺ: “مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم أحد ما تغيض الأرحام، ولا متى يأتي المطر، ولا متى تقوم الساعة، ولا في أي أرض يموت أحد.” (رواه البخاري).
- هذا الحديث يؤكد حصر الغيب في علم الله فقط.
(ب) نفي علم النبي عن أحداث المستقبل
- عندما سأل خباب بن الأرت النبي ﷺ عن توقيت النصر للمسلمين، قال: “والله ليُتمنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت…” (رواه البخاري).
- النبي لم يخبر بتفاصيل زمنية دقيقة، مما يدل على عدم معرفته بالغيب إلا بما أوحى الله إليه.
(ج) واقعة عائشة رضي الله عنها
- في حادثة الإفك، لم يعلم النبي ﷺ براءة عائشة إلا بعد أن أنزل الله الآيات.
{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} (النور: 11).- لو كان النبي يعلم الغيب، لما انتظر الوحي.
3. أدلة عقلية وإضافية
(أ) غياب علم الغيب عن الأنبياء في مواقف حرجة
- وفاة إبراهيم ابن النبي ﷺ:
- النبي ﷺ قال عند وفاته: “إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.”
- لو كان يعلم الغيب، لعلم بموعد وفاة ابنه.
- حادثة موت الصحابي معاذ بن جبل:
- النبي ﷺ أوصى معاذ وهو يبكي وقال: “إنك لن تلقاني بعد عامي هذا.”
- رغم ذلك، لم يُخبره بتفاصيل موته، مما يبين أن علم الغيب ليس بيد النبي.
(ب) تناقض دعوى علم الغيب مع بشرية الأئمة
- الأئمة أكلوا وشربوا وماتوا، وأحداث حياتهم شهدت مواقف تدل على عدم علمهم بالغيب، مثل:
- الإمام الحسين رضي الله عنه: خروجه إلى كربلاء مع علمه بالغيب، كما يدعي الشيعة، يناقض الحكمة والعقل.
- الإمام جعفر الصادق: توجد روايات في كتب الشيعة أنه كان يخطئ في بعض الأمور اليومية، مما ينفي عنه العلم المطلق.
(ج) الاستعانة بالله دلالة على عدم علم الغيب
- النبي والأئمة كانوا يستعينون بالله في الأمور الغيبية.
- مثال: دعاء النبي ﷺ في غزوة بدر: “اللهم أنجز لي ما وعدتني.”
- هذا الدعاء يؤكد عدم علم النبي بمصير الغزوة إلا بعد تحققها.
4. أمثلة من كتب الشيعة تناقض دعواهم
(أ) في الكافي
- ورد في “الكافي” رواية عن الإمام جعفر الصادق يقول فيها: “لو كُشف لي الغطاء، لما ازددت يقينًا.”
- هذه العبارة تُفسر عادة بأنها دليل على علم الغيب، ولكنها تحتمل معنى آخر يتعلق باليقين الإيماني، مما يدل على تأويل النصوص لتعزيز دعاوى باطلة.
(ب) أخطاء الأئمة في حياتهم اليومية
- في بعض الروايات الشيعية:
- الإمام علي رضي الله عنه سأل الله أن ينصره في معركة صفين.
- الإمام الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، وهو تصرف يتناقض مع علمه المسبق بالغيب لو كان صحيحًا.
5. الرد على تفسير الشيعة لآيات الغيب
(أ) الاستثناء في قوله: {إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ} (الجن: 27)
- هذه الآية تخص الرسل فقط وليس الأئمة، لأن كلمة “رسول” صريحة.
- الأئمة ليسوا رسلًا، فلا يدخلون في الاستثناء.
(ب) محاولة تأويل الآيات لصالح الأئمة
- الشيعة يستدلون بآيات مثل {وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا} (الكهف: 65) للإشارة إلى علم الغيب للأئمة.
- الرد: هذه الآية تتحدث عن الخضر عليه السلام، الذي علمه الله بعض الأمور الخاصة بوحي مؤقت، ولا تدل على علم غيب مطلق.
6. الخلاصة الموسعة
- علم الغيب من خصائص الله المطلقة، والأدلة من القرآن والسنة والعقل تدحض دعاوى الشيعة بأن الأئمة يعلمون الغيب.
- اعتماد الشيعة على الروايات الضعيفة أو المكذوبة لا يصمد أمام نصوص الوحي القطعية.
- هذا الاعتقاد يوقعهم في الغلو والتشبيه، ويناقض توحيد الله في أسمائه وصفاته.
رابعا: بيان فساد قول الشيعة بتوسلهم بالأئمة لجلب النفع أو دفع الضر
1. مفهوم التوسل بالأئمة عند الشيعة
- يعتقد الشيعة الإمامية أن الأئمة الاثني عشر يمتلكون القدرة على التدخل لجلب النفع ودفع الضر، فيتوسلون بهم في الدعاء والطلب، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.
- يرون أن الأئمة وسطاء بين الله وعباده، وأنهم يشفعون ويجيبون الدعاء بقدرتهم الخاصة.
2. ممارسات الشيعة في التوسل بالأئمة
(أ) التوسل بالدعاء المباشر للأئمة
- يقولون: “يا علي مدد”، “يا حسين اشفع لي”، “يا فاطمة اغيثيني”.
- يطلبون منهم الشفاء، النجاح، الحماية من الشرور.
(ب) التوجه إلى قبور الأئمة
- يزور الشيعة قبور الأئمة، خصوصًا في كربلاء والنجف وقم، للدعاء وطلب الحاجات.
- يعتبرون أن زيارة القبور وسيلة للحصول على البركة والشفاعة.
3. الرد على هذا الاعتقاد من القرآن الكريم
(أ) الدعاء عبادة خالصة لله
- {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: 60).
- الدعاء عبادة خالصة لله، ولا يجوز صرفها لغيره.
- {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} (الأعراف: 194).
- الآية توضح أن المخلوقين، مهما علت منزلتهم، لا يمكنهم تلبية الدعاء أو تحقيق النفع والضر.
(ب) الله وحده هو المتصرف في الكون
- {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} (النمل: 62).
- الله هو الوحيد الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف عنهم السوء.
- {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 17).
- لا يستطيع أحد دفع الضر إلا الله، بما في ذلك الأئمة.
4. الرد من السنة النبوية
(أ) النهي عن طلب الحاجات من غير الله
- قال النبي ﷺ: “إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.” (رواه الترمذي).
- الحديث يحصر الاستعانة وطلب الحاجات في الله وحده.
(ب) دعاء النبي ﷺ نفسه لله
- النبي ﷺ، وهو أفضل البشر، كان يتوجه إلى الله وحده بالدعاء.
- مثال: “اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.”
- إذا كان النبي ﷺ لا يطلب الشفاء إلا من الله، فكيف يُطلب من الأئمة؟
(ج) النهي عن الغلو في الصالحين
- قال النبي ﷺ: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله.” (رواه البخاري).
- الحديث تحذير صريح من الغلو في الصالحين والأنبياء، فضلاً عن غيرهم.
5. الرد العقلي
(أ) الأئمة بشر لا يملكون النفع والضر
- الأئمة أموات، ولا يملكون القدرة على التصرف في الكون أو الإجابة على الدعاء.
- إذا كانوا لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم (مثل مقتل الحسين رضي الله عنه)، فكيف يُطلب منهم دفع الضر عن الآخرين؟
(ب) الله غني عن الوسائط
- الله قريب من عباده، كما قال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} (البقرة: 186).
- لا يحتاج العبد إلى واسطة للوصول إلى الله.
6. كشف تناقضات الشيعة في التوسل
(أ) استخدامهم روايات منكرة
- غالبية الروايات التي يعتمدون عليها في التوسل بالأئمة ضعيفة أو موضوعة.
- حتى الأئمة في رواياتهم دعوا إلى التوجه إلى الله وحده.
(ب) دعاؤهم لله مباشرة في مواطن أخرى
- نجد أن الشيعة أنفسهم في بعض المواطن يدعون الله مباشرة، مما يناقض ممارساتهم في التوسل بالأئمة.
7. أقوال العلماء في الرد على التوسل بالأئمة
- شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال: “من دعا مخلوقًا ميتًا أو غائبًا يطلب منه النفع أو دفع الضر، فقد أشرك شركًا أكبر.” - ابن القيم:
قال: “دعاء غير الله من الأموات أو الغائبين من الأمور التي جاء الشرع بتحريمها ونفيها.” - الإمام النووي:
قال: “الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك.”
8. توضيح الفرق بين التوسل المشروع والممنوع
(أ) التوسل المشروع:
- التوسل بأسماء الله وصفاته:
- {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: 180).
- التوسل بالأعمال الصالحة:
- قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة (رواه البخاري ومسلم).
(ب) التوسل الممنوع:
- التوسل بذوات الأشخاص، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.
- طلب الحاجات مباشرة من المخلوقين الأموات.
9. الخلاصة
- التوسل بالأئمة لجلب النفع أو دفع الضر مخالف للقرآن والسنة والعقل.
- العبادة والدعاء حق خالص لله، وصرفها لغيره شرك أكبر.
- التوسل المشروع محصور في الأدلة الشرعية الواضحة، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته أو بالأعمال الصالحة.
الفرق بين التوسل المشروع والممنوع
أولًا: تعريف التوسل
- التوسل لغة: التقرب بشيء لتحقيق غاية.
- التوسل شرعًا: التقرب إلى الله بدعائه أو بأسباب مشروعة لتحقيق مطلوب ديني أو دنيوي.
التوسل ينقسم إلى نوعين: مشروع وممنوع.
1. التوسل المشروع
(أ) تعريفه:
التوسل المشروع هو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء، وهو وسيلة تقرب إلى الله تعالى.
(ب) أنواعه:
1. التوسل بأسماء الله وصفاته
- الدليل:
- {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا} (الأعراف: 180).
- النبي ﷺ كان يدعو قائلًا: “اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.”
- المعنى:
- دعاء الله باسم من أسمائه الحسنى أو صفاته العلى، مثل: “اللهم يا رحمن ارحمني”، “يا غفور اغفر لي”.
2. التوسل بالأعمال الصالحة
- الدليل:
- حديث أصحاب الغار: “اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه.” (رواه البخاري ومسلم).
- المعنى:
- التوسل إلى الله بعمل صالح قام به العبد خالصًا لوجهه.
3. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء
- الدليل:
- طلب الصحابة من النبي ﷺ أن يدعو لهم.
- في حديث عمر بن الخطاب عندما استسقى بالعباس رضي الله عنهما، قال: “اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.” (رواه البخاري).
- المعنى:
- طلب الدعاء من شخص صالح حي يكون من باب التعاون على الخير.
(ج) حكم التوسل المشروع:
- جائز ومشروع لأنه ورد في النصوص الشرعية واتفقت عليه الأمة.
2. التوسل الممنوع
(أ) تعريفه:
التوسل الممنوع هو كل وسيلة تقرب إلى الله بطرق لم يشرعها الله ورسوله، أو ما يؤدي إلى الشرك.
(ب) أنواعه:
1. التوسل بالأشخاص وذواتهم
- المعنى:
- طلب الحاجات أو الدعاء بذوات الأشخاص، مثل: “يا محمد، اشفع لي”، “يا علي، ساعدني”.
- الحكم:
- هذا التوسل بدعة إذا كان يعتقد أن الشخص وسيلة إلى الله دون اعتقاد أنه ينفع بنفسه.
- يتحول إلى شرك إذا اعتقد أن الشخص المتوسل به يملك النفع والضر بذاته.
2. التوسل بالأموات
- المعنى:
- دعاء الأموات أو طلب شفاعتهم، مثل: “يا فلان، اشفع لي عند الله”.
- الحكم:
- محرم وشرك أكبر لأن الأموات لا يسمعون ولا يملكون الضر أو النفع.
- الدليل:
- {إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} (فاطر: 14).
3. التوسل بالأعمال المحرمة أو البدعية
- المعنى:
- التوسل بأعمال غير مشروعة، مثل التوسل بالأضرحة أو الطواف حول القبور.
- الحكم:
- بدعة محرمة لأنها لم ترد في الكتاب والسنة.
- الدليل:
- قال النبي ﷺ: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.” (رواه البخاري ومسلم).
(ج) أسباب المنع في التوسل الممنوع:
- الابتداع في الدين:
- التوسل بطرق غير مشروعة يدخل في دائرة البدع.
- قال النبي ﷺ: “وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.” (رواه النسائي).
- صرف العبادة لغير الله:
- دعاء الأموات أو طلب الحاجات منهم هو عبادة لغير الله.
- قال الله: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (البينة: 5).
- فتح باب الشرك:
- التوسل الممنوع يؤدي إلى الغلو في الصالحين ويجر إلى الشرك الأكبر.
- قال النبي ﷺ: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد.” (رواه البخاري).
3. مقارنة بين التوسل المشروع والممنوع
| النوع | المشروع | الممنوع |
|---|---|---|
| التوسل بأسماء الله وصفاته | التوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى، مثل: “يا غفور اغفر لي” | لا يوجد |
| التوسل بالأعمال الصالحة | التوسل بالأعمال الصالحة التي قام بها العبد، مثل: “اللهم بصلاتي هذه ارحمني” | التوسل بالأعمال البدعية، مثل: الطواف بالأضرحة أو الذبح لغير الله. |
| التوسل بالأشخاص | طلب دعاء الأحياء الصالحين، مثل: “ادعُ الله لي” | التوسل بالأموات أو طلب الحاجات منهم، مثل: “يا فلان اقض حاجتي.” |
| الدعاء | التوجه إلى الله بالدعاء مباشرة. | الدعاء لغير الله، مثل: “يا فلان ساعدني”. |
4. الخلاصة
- التوسل المشروع هو ما ثبت بالنصوص الشرعية، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته، والأعمال الصالحة، ودعاء الأحياء.
- التوسل الممنوع يشمل التوسل بالأموات أو الأشخاص، أو بطرق مبتدعة، ويؤدي في أحيان كثيرة إلى الشرك الأكبر.
- الدليل الشرعي هو الأساس: الالتزام بالنصوص هو الضمان الوحيد لصحة العمل، والابتعاد عن الشرك والبدعة.
خامسا: الرد على مفهوم الولاية التكوينية التي يدعيها الشيعة لأئمتهم
1. مفهوم الولاية التكوينية عند الشيعة
- الولاية التكوينية: مصطلح يستخدمه الشيعة للإشارة إلى قدرة الأئمة الاثني عشر على التصرف في الكون بقدرة إلهية، مثل التحكم في الطبيعة، وإحياء الموتى، وشفاء المرضى، وتدبير أمور الخلق.
- يعتقدون أن الله منح هذه السلطة للأئمة كجزء من مكانتهم الروحية الفريدة.
2. مصادر الشيعة في إثبات الولاية التكوينية
(أ) روايات من كتبهم:
- ورد في “الكافي” للكليني أن الأئمة يقولون: “إن لنا مع الله حالات لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل.”
- يزعمون أن الأئمة يمتلكون القدرة على التحكم في الكون بأمر الله وأنهم وسطاء في تحقيق المشيئة الإلهية.
(ب) تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية:
- {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (الجاثية: 13).
- يفسرون أن الله منح الأئمة السلطة على هذا التسخير.
- {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ} (الأنفال: 17).
- يستخدمون هذه الآية لتبرير أن الله يعطي القوة لبعض عباده، ويدعون أن الأئمة يمتلكون هذه القوة دائمًا.
3. الرد على هذا الاعتقاد من القرآن الكريم
(أ) حصر التدبير والتحكم في الكون بيد الله
- {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} (الأعراف: 54).
- الخلق والتدبير أمر خاص بالله وحده، ولا يشاركه فيه أحد.
- {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} (المؤمنون: 88).
- الله هو المالك الوحيد لكل شيء، ولا يملك أحد من المخلوقات أي سلطة تكوينية.
- {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} (السجدة: 4).
- خلق الكون وإدارته اختصاص إلهي لا يُفوض إلى أحد.
(ب) نفي قدرة المخلوقين على التصرف في الكون
- {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 17).
- لا يمكن لأي مخلوق أن يدفع الضر أو يجلب النفع إلا بإذن الله.
- {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} (الأعراف: 188).
- حتى النبي محمد ﷺ، أفضل الخلق، لا يملك لنفسه النفع أو الضر، فكيف يُنسب ذلك للأئمة؟
4. الرد من السنة النبوية
(أ) نفي النبي ﷺ امتلاك الولاية التكوينية
- النبي ﷺ قال: “يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا.” (رواه البخاري).
- لو كان النبي ﷺ يمتلك سلطة تكوينية، لما قال ذلك لأقرب الناس إليه.
- عندما طلب منه الصحابة الدعاء بنزول المطر، رفع يديه إلى الله بالدعاء، ولم يتصرف مباشرة:
- “اللهم أغثنا.” (رواه البخاري).
- هذا دليل على أن النبي لا يملك التدبير، بل يلجأ إلى الله.
(ب) تعليم التوكل على الله وحده
- قال النبي ﷺ: “إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.” (رواه الترمذي).
- الحديث يوضح أن كل ما يتعلق بالنفع والضر والدعاء يجب أن يُطلب من الله مباشرة.
5. الرد العقلي
(أ) التناقض مع بشرية الأئمة
- الأئمة بشر يمرضون ويموتون ويحتاجون إلى الله.
- إذا كان الأئمة يملكون الولاية التكوينية، فلماذا لم يدفعوا عن أنفسهم الضر، مثل وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه في كربلاء؟
(ب) خصوصية القدرة الإلهية
- القدرة على التحكم في الكون تعني العلم المطلق، والقوة المطلقة، والقدرة على التدبير الدائم.
- هذه الصفات هي من خصائص الله وحده، ولا يمكن أن تكون لمخلوق.
6. كشف تناقضات الشيعة في عقيدة الولاية التكوينية
- التعارض مع التوحيد:
- إثبات الولاية التكوينية للأئمة يعني مشاركتهم لله في صفة الربوبية، وهذا يناقض التوحيد.
- الغلو في الأئمة:
- عقيدة الولاية التكوينية تدفع إلى الغلو، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك بقوله:
“لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم.” (رواه البخاري).
- عقيدة الولاية التكوينية تدفع إلى الغلو، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك بقوله:
- الروايات المتناقضة:
- توجد روايات في كتب الشيعة نفسها تنفي قدرة الأئمة على التصرف المطلق.
- في بعض الروايات، الأئمة يدعون الله لحاجاتهم، مما ينفي عنهم الولاية التكوينية.
7. أقوال العلماء في تفنيد الولاية التكوينية
- ابن تيمية:
- قال: “من اعتقد أن لأحد من الخلق ولاية تكوينية تقتضي التصرف في الكون فهو مشرك بالله.”
- ابن القيم:
- قال: “الله هو المتصرف وحده، ومن ادعى لغيره مثل هذه السلطة فقد أعطى المخلوق ما لا يجوز إلا للخالق.”
- الإمام الشاطبي:
- قال: “الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادة غير الله، وهو ما وقع فيه أهل البدع.”
8. الخلاصة
- الولاية التكوينية لله وحده، ولا يملك أي مخلوق القدرة على التصرف في الكون.
- اعتقاد الشيعة بأن الأئمة يمتلكون هذه الولاية هو غلو يخالف القرآن والسنة والعقل.
- الردود الشرعية والعقلية تُبين بطلان هذا الاعتقاد، وتحذر من تبعاته التي تؤدي إلى الشرك بالله.
أمثلة إضافية من أقوال الشيعة حول الولاية التكوينية للأئمة من كتبهم
1. من كتاب “الكافي” للكليني
(أ) تفويض الأئمة في أمور الكون
- ورد في الكافي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال:
“إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصوّرنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه.”- هذه الرواية تزعم أن الأئمة يمثلون أركان تصرف الله في الكون.
(ب) التحذير من الشك في قدرة الأئمة
- جاء في الكافي: “إن الله خصنا بما لم يخص به أحدًا من عباده… خصنا بعلم الغيب، وحكم بين العباد.”
- هذه الرواية تنسب إلى الأئمة علم الغيب والتصرف المطلق.
2. من كتاب “بحار الأنوار” للمجلسي
(أ) الأئمة يتحكمون في أسباب الطبيعة
- في “بحار الأنوار” يُنسب إلى الإمام الصادق أنه قال:
“إن الدنيا بيد الإمام، يقلبها كيف يشاء، وينزل المطر ويُمسك.”- هذه الرواية تضع الأئمة في مقام المتصرفين بأسباب الطبيعة مثل المطر والرزق.
(ب) الأئمة يحيون ويميتون
- يورد المجلسي في كتابه: “إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، وإذا شاء أن يحيي أحيى، وإذا شاء أن يميت أمات.”
- زعم أن الأئمة يمتلكون صفات إحياء الموتى والإماتة، وهي من خصائص الله وحده.
3. من كتاب “الغيبة” للنعماني
(أ) الإمام المهدي يتحكم في الكون
- يقول النعماني عن الإمام المهدي:
“إن القائم بأمر الله (المهدي) إذا ظهر، يحكم في الكون ويُخضع له أهل السماوات والأرض.”- الرواية تنسب للإمام المهدي القدرة على السيطرة المطلقة على الكون.
(ب) علم المهدي بالغيب
- يُذكر أن الإمام المهدي يعلم ما في القلوب وما تخفيه الصدور:
“إن الإمام يعرف خواطر القلوب ونوايا الأعمال.”- هذا الادعاء يساوي الأئمة بصفات الله العليم.
4. من كتاب “مدينة المعاجز” للسيد هاشم البحراني
(أ) الأئمة يتحكمون في الكون كليًا
- ورد: “الأئمة هم أمراء الكون، بيدهم كل شيء، يحكمون بأمر الله في السماء والأرض.”
- يُنسب إليهم التحكم الكامل في جميع تفاصيل الكون.
(ب) الأئمة يعيدون الحياة للأشياء
- في قصة نُسبت إلى الإمام علي:
“أن عليًا رضي الله عنه أعاد حيوانًا ميتًا إلى الحياة بضربة من يده.”- هذه الرواية تدّعي قدرة الإمام على فعل المعجزات.
5. من كتاب “من لا يحضره الفقيه” للصدوق
(أ) الأئمة وسطاء بين الله وعباده
- جاء في الكتاب:
“الأئمة وسائط بين الله وخلقه، لا يتم شيء إلا بإذنهم.”- هذا ينسب للأئمة صفة الوساطة المطلقة التي تقترب من الربوبية.
(ب) الدعاء لا يُستجاب إلا بواسطتهم
- يقول الصدوق:
“إن الله لا يقبل الدعاء إلا إذا كان عبر واسطة الإمام.”- الرواية تربط العبادة والدعاء بوجود الأئمة، مما ينافي التوحيد.
6. من كتاب “الإرشاد” للشيخ المفيد
(أ) الأئمة يعلمون كل شيء
- ورد عن الإمام جعفر الصادق:
“إننا نعلم كل ما في السماوات والأرض، وما في الجنة والنار.”- هذه الرواية تزعم علم الأئمة بكل شيء، وهو ما ينافي صفة العلم المطلق المختص بالله.
(ب) الأئمة يتحكمون في الغيب
- في الإرشاد يُذكر:
“إن الإمام إذا أراد أن يظهر الغيب، أظهره بأمر الله.”- ينسب للأئمة مشاركة الله في صفة علم الغيب.
الخلاصة
- الروايات التي يوردها الشيعة في كتبهم تنسب إلى الأئمة صفات إلهية، مثل التحكم في الكون، علم الغيب، إحياء الموتى، وإنزال المطر.
- هذه الصفات من خصائص الله تعالى وحده، وقد رد عليها أهل السنة بأنها غلو يناقض نصوص القرآن والسنة، ويدخل في دائرة الشرك بالله.
- أقوالهم تتعارض مع التوحيد ومع صفة الأئمة كبشر مخلوقين يحتاجون إلى الله كسائر الخلق.
الرد على أقوال الشيعة حول الولاية التكوينية للأئمة من القرآن الكريم والسنة النبوية
أولًا: الردود من القرآن الكريم
1. حصر التصرف في الكون بيد الله وحده
(أ) الله هو الخالق والمدبر
- {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (الأعراف: 54).
- الآية تؤكد أن الخلق والتدبير بيد الله وحده، ولا يشاركه أحد في ذلك، سواء من الأنبياء أو الأئمة.
(ب) الله المالك الوحيد لكل شيء
- {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (المؤمنون: 88).
- الآية توضح أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله وحده، ولا يمكن لأي مخلوق أن يكون شريكًا له في هذا الملكوت.
2. نفي القدرة المطلقة عن المخلوقات
(أ) الله هو الكاشف الوحيد للضر
- {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 17).
- الآية تنفي صراحة أن يكون هناك مخلوق قادر على كشف الضر أو جلب النفع إلا بإذن الله.
(ب) الأئمة بشر مثل غيرهم
- {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ} (الكهف: 110).
- إذا كان النبي ﷺ بشرًا يُوحى إليه ويعبد الله وحده، فكيف يُنسب للأئمة ما لم يُنسب للنبي؟
3. العلم المطلق لله وحده
(أ) حصر علم الغيب في الله
- {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (الأنعام: 59).
- الغيب خاص بالله تعالى، فلا يعلمه أحد من المخلوقات، بما فيهم الأئمة.
(ب) الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بوحي
- {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ} (آل عمران: 179).
- حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بما أوحى الله إليهم، فكيف يُنسب هذا العلم للأئمة؟
4. الدعاء والشفاعة لله وحده
(أ) الله وحده مجيب الدعاء
- {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} (النمل: 62).
- الله هو الذي يُجيب الدعاء ويكشف السوء، وليس الأئمة أو غيرهم.
(ب) الشفاعة بيد الله
- {قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} (الزمر: 44).
- الشفاعة بيد الله وحده، ولا تُمنح لأحد إلا بإذنه.
ثانيًا: الردود من السنة النبوية
1. النبي ﷺ نفسه لا يملك التصرف في الكون
(أ) نفي قدرته على جلب النفع أو دفع الضر
- قال النبي ﷺ: “يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا.” (رواه البخاري).
- إذا كان النبي ﷺ لا يملك نفعًا أو ضرًا لأقرب الناس إليه، فكيف يُنسب ذلك للأئمة؟
(ب) النبي ﷺ كان يدعو الله ولا يتصرف بنفسه
- في غزوة بدر، دعا النبي ﷺ رافعًا يديه: “اللهم أنجز لي ما وعدتني.” (رواه البخاري).
- لو كان يملك القدرة المطلقة، لما احتاج إلى الدعاء.
2. نفي علم الغيب عن النبي
(أ) حادثة الإفك
- في حادثة الإفك، لم يعلم النبي ﷺ براءة عائشة إلا بعد نزول الوحي.
- لو كان النبي يعلم الغيب، لعلم ببراءتها مباشرة.
(ب) نفي علم الساعة
- عندما سُئل النبي ﷺ عن موعد الساعة، قال: “ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.” (رواه مسلم).
- هذا يدل على أن علم الغيب خاص بالله.
3. الدعاء والشفاعة لله وحده
(أ) النبي يأمر بالتوجه إلى الله وحده
- قال النبي ﷺ: “إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.” (رواه الترمذي).
- الحديث يحصر الدعاء والاستعانة بالله فقط.
(ب) نهي النبي عن الغلو فيه أو في الصالحين
- قال النبي ﷺ: “لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله.” (رواه البخاري).
- الحديث ينهى عن الغلو في الصالحين، فما بالك بنسبة التصرف في الكون إلى الأئمة؟
الخلاصة
- القرآن والسنة يثبتان أن التصرف في الكون بيد الله وحده، وأن الأئمة بشر لا يملكون القدرة على التدبير أو علم الغيب.
- النبي ﷺ نفسه لا يملك النفع أو الضر إلا بإذن الله، فكيف يُنسب ذلك للأئمة؟
- هذه الاعتقادات تتناقض مع التوحيد الخالص لله، وتدخل في دائرة الغلو الذي حذر منه الإسلام.
فائدة: بعض أقوال الطرق الصوفية المشابهة للشيعة في قولهم بالولاية التكوينية
1. الطريقة النقشبندية
- يدّعي النقشبنديون أن “الشيخ النقشبندي يعلم ما في القلوب”.
- ورد عنهم قولهم: “من اعترض على الشيخ النقشبندي بظاهره أو باطنه، فقد خسر دنياه وآخرته.”
2. الطريقة الشاذلية
- يُنسب إلى أتباع الطريقة الشاذلية: “شيخ الطريقة يشفع لأتباعه يوم القيامة حتى لو ارتكبوا الكبائر.”
- يُقال عن بعض شيوخهم: “كل من ذكر اسمي بصدق كان له نصيب من الخير في الدنيا والآخرة.”
3. الطريقة القادرية
- ورد عن الطريقة القادرية نسب قول إلى عبد القادر الجيلاني: “قدمي على رقبة كل ولي.”
- يزعم أتباعها أن “من استغاث بالجيلاني في قبره، فإنه يقضي حوائجه”.
4. الطريقة التيجانية
- يقولون إن قراءة “صلاة الفاتح لما أغلق” مرة واحدة تعادل قراءة القرآن ستة آلاف مرة.
- يُعتقد أن شيخ الطريقة التيجانية التقى بالنبي ﷺ في المنام وطلب منه نشر الطريقة.
5. الطريقة البكتاشية
- يزعم أتباع الطريقة أن “الولي البكتاشي يعلم ما في اللوح المحفوظ”.
- يقولون إن “الشيخ البكتاشي ينقل البركة من السماء إلى مريديه.”
6. الطريقة الرفاعية
- يُنسب إلى الطريقة قولهم: “إذا حلف الشيخ الرفاعي على الله، استجاب له فورًا.”
- يقول أتباعهم إن “الشيخ الرفاعي يملك كرامات تفوق المعجزات، مثل إحياء الموتى.”
7. الطريقة البدوية
- يعتقد أتباع الطريقة أن “السيد أحمد البدوي يطير في الهواء ويغيث الملهوفين”.
- يُنسب لهم قولهم: “من نادى: مدد يا بدوي، فإن حاجته تُقضى.”
8. الطريقة النقشبندية المجددية
- يقولون إن شيخ الطريقة يستطيع “التصرف في أرواح الأتباع وتطهيرها من الذنوب”.
- يُنسب إليهم: “الشيخ المجدد يرى الله في المنام ويأخذ منه الأمر مباشرة.”
9. الطريقة الخلوتية
- يعتقدون أن “الشيخ الخلوتي يسمع كل من يناديه، مهما كان بعيدًا.”
- ورد عنهم: “مَن أطاع الشيخ أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله.”
10. الطريقة المولوية
- يُنسب إلى أتباعها قولهم إن “الدرويش المولوي عندما يرقص، فإن أرواح الملائكة تحضر وترقص معه.”
- يقولون: “الموسيقى الروحية في الطريقة المولوية هي وسيلة للوصول إلى الله مباشرة.”
11. الطريقة السهروردية
- يُقال عنهم إن “الشيخ السهروردي يستطيع رؤية عرش الرحمن في لحظة صفاء.”
- يعتقدون أن “الشيخ يحفظ أتباعه من النار يوم القيامة مهما كانت ذنوبهم.”
الخلاصة
هذه الأقوال تُظهر المبالغات والغلو في مكانة الشيوخ والأولياء عند بعض الطرق الصوفية، وهي أمثلة على الانحرافات التي وردت في بعض الطرق الصوفية المعروفة.
سادسا: شرح منهج أهل السنة في عبادة الله وحده بلا وسيط
1. مفهوم العبادة عند أهل السنة والجماعة
- العبادة في الإسلام تعني الخضوع التام لله تعالى مع المحبة والتعظيم، وهي تشمل جميع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها.
- العبادة لا تُصرف إلا لله وحده، سواء كانت دعاءً، أو سجودًا، أو توكلًا، أو استغاثة.
قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56).
2. الأصل في عبادة الله عند أهل السنة
- العبادة حق خالص لله، ولا يجوز فيها الشرك أو الاستعانة بمخلوق كوسيط.
- {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة: 5):
- الآية تقرر حصر العبادة والاستعانة بالله وحده.
3. منهج أهل السنة في العبادة بلا وسيط
(أ) التوحيد في الربوبية
- الإيمان بأن الله هو الخالق، الرازق، المدبر، ولا شريك له في أفعاله.
{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ… فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ} (يونس: 31).- أهل السنة يؤمنون بأن جميع أمور الكون بيد الله، فلا حاجة لوسيط في الدعاء أو الطلب.
(ب) التوحيد في الألوهية
- تخصيص العبادة لله وحده دون شريك أو وسيط.
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (الكوثر: 2).- كل عبادة، مثل الصلاة، والدعاء، والنذر، يجب أن تكون لله وحده.
(ج) التوحيد في الأسماء والصفات
- إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات بلا تشبيه أو تعطيل.
- العبادة تتوجه لله باعتباره المستحق الوحيد للكمال المطلق.
4. أمثلة على العبادة بلا وسيط
(أ) الدعاء لله وحده
- قال الله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: 60).
الدعاء عبادة، ويجب أن يُصرف لله وحده دون أن يكون هناك وسيط، مثل الأئمة أو الأولياء.
(ب) الاستعانة بالله وحده
- قال النبي ﷺ: “إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.” (رواه الترمذي).
- النص واضح في حصر الاستعانة بالله دون غيره.
(ج) الشفاعة لله وحده
- الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، كما قال:
{مَّن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} (البقرة: 255).- أهل السنة يؤمنون أن الشفاعة ملك لله وحده، ولا تُطلب من المخلوقات.
(د) الذبح والنذر
- الذبح عبادة، ولا يجوز أن تُصرف إلا لله.
{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الأنعام: 162).
5. النهي عن اتخاذ الوسائط
(أ) شرك في العبادة
- اتخاذ الوسائط شرك أكبر يُخرج من الملة، كما قال الله:
{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ} (يونس: 18).- أهل السنة يرون أن الوساطة في العبادة تُبطل التوحيد.
(ب) التقليد الضال للأمم السابقة
- قال النبي ﷺ: “لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.” (رواه البخاري).
- الحديث تحذير من الغلو في الصالحين واتخاذهم وسائط.
6. أقوال العلماء في العبادة بلا وسيط
(أ) شيخ الإسلام ابن تيمية:
- قال: “من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد كفر إجماعًا.”
(ب) الإمام محمد بن عبد الوهاب:
- قال: “أصل الدين وقاعدته هو عبادة الله وحده، لا شريك له، والنهي عن عبادة ما سواه.”
(ج) الإمام النووي:
- قال: “الدعاء عبادة عظيمة، ولا يجوز صرفها لغير الله.”
7. كيف يعبد أهل السنة الله بلا وسيط؟
(أ) مباشرة العلاقة مع الله:
- الله قريب من عباده، كما قال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} (البقرة: 186).
- لا يحتاج العبد إلى وسيط ليدعو الله.
(ب) الدعاء والتضرع:
- الله يحب الدعاء مباشرة بلا واسطة، كما قال النبي ﷺ: “من لم يسأل الله يغضب عليه.” (رواه الترمذي).
(ج) الاعتقاد بأن كل شيء بيد الله:
- الرزق، الشفاء، الهداية، كلها بيد الله وحده، فلا يُطلب شيء إلا منه.
الخلاصة
- أهل السنة والجماعة يؤمنون أن العبادة حق خالص لله، ولا يجوز اتخاذ وسيط بين العبد وربه.
- العبادة بلا وسيط تعني التوجه إلى الله بالدعاء، والرجاء، والخوف، والتوكل، مع الإيمان بأنه المستحق الوحيد للعبادة.
- اتخاذ الوسائط ينافي التوحيد ويُعد من مظاهر الشرك التي حذر منها الإسلام.
الفرق بين العبادة والدعاء ولماذا سُمي الدعاء عبادة؟
1. تعريف العبادة والدعاء
(أ) العبادة:
- لغة: الخضوع والذل.
- شرعًا: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
- تشمل الصلاة، الزكاة، الصيام، الدعاء، التوكل، الحب، الخوف، الرجاء، وغيرها.
- قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56).
(ب) الدعاء:
- لغة: الطلب والسؤال.
- شرعًا: طلب العبد من ربه ما ينفعه أو يدفع عنه الضر.
- قال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: 60).
2. الفرق بين العبادة والدعاء
| الوجه | العبادة | الدعاء |
|---|---|---|
| المفهوم | تشمل كل أفعال وأقوال الطاعة لله، الظاهرة والباطنة. | طلب الحاجة من الله مباشرة. |
| الشمولية | أوسع من الدعاء؛ تشمل أعمال القلب والجوارح. | جزء من العبادة. |
| الأصل الشرعي | أصلها في الخضوع لله والقيام بما أمر به من طاعات. | أصلها في سؤال الله والتوجه إليه بالحاجة. |
| الدليل | {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ} (البينة: 5). | {وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا} (الأعراف: 56). |
3. لماذا سُمي الدعاء عبادة؟
(أ) النصوص التي توضح أن الدعاء عبادة
- الدعاء هو جوهر العبادة:
- قال النبي ﷺ: “الدعاء هو العبادة.” (رواه الترمذي).
الحديث يوضح أن الدعاء هو أعظم صور العبادة لأنه يُظهر التذلل والخضوع الكامل لله.
- قال النبي ﷺ: “الدعاء هو العبادة.” (رواه الترمذي).
- الدعاء أعظم مظاهر التوحيد:
- قال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (غافر: 60).
في هذه الآية عبّر الله عن الدعاء بـ “عبادتي”، مما يدل على أن الدعاء عبادة خالصة.
- قال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} (غافر: 60).
(ب) العلاقة بين الدعاء والعبادة
- الدعاء يُظهر معاني العبادة مثل:
- التذلل لله: حين يدعو العبد ربه، يعترف بحاجته وعجزه أمام الله.
- التوكل على الله: الدعاء يجسد التوكل الكامل على الله وحده.
- الإخلاص لله: الدعاء يتطلب إخلاص النية لله دون إشراك غيره.
(ج) الدعاء أعظم صور العبودية
- الدعاء يعبر عن ضعف العبد وفقره المطلق إلى الله.
قال الله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ} (فاطر: 15).
4. أمثلة على ارتباط الدعاء بالعبادة
(أ) في الصلاة:
- الصلاة تجمع بين العبادة (الأركان والأفعال) والدعاء (السجود والتضرع).
قال النبي ﷺ: “أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء.” (رواه مسلم).
(ب) في الصيام:
- الدعاء مرتبط بالعبادة في الصيام، كما قال النبي ﷺ: “إن للصائم دعوة لا ترد.” (رواه الترمذي).
(ج) في الحج:
- قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} (البقرة: 200).
- الدعاء هنا جزء من ذكر الله وعبادته.
5. الخلاصة
- العبادة: أشمل من الدعاء، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال.
- الدعاء: جزء من العبادة، وهو أعظم مظاهرها لأنه يُظهر التذلل والخضوع والتوكل على الله.
- الدعاء سُمي عبادة لأنه يحقق معنى العبودية لله وحده ويجمع بين الخضوع الكامل والتوكل التام عليه.
الباب الثاني: الإمامة وأصولها
يتبع…